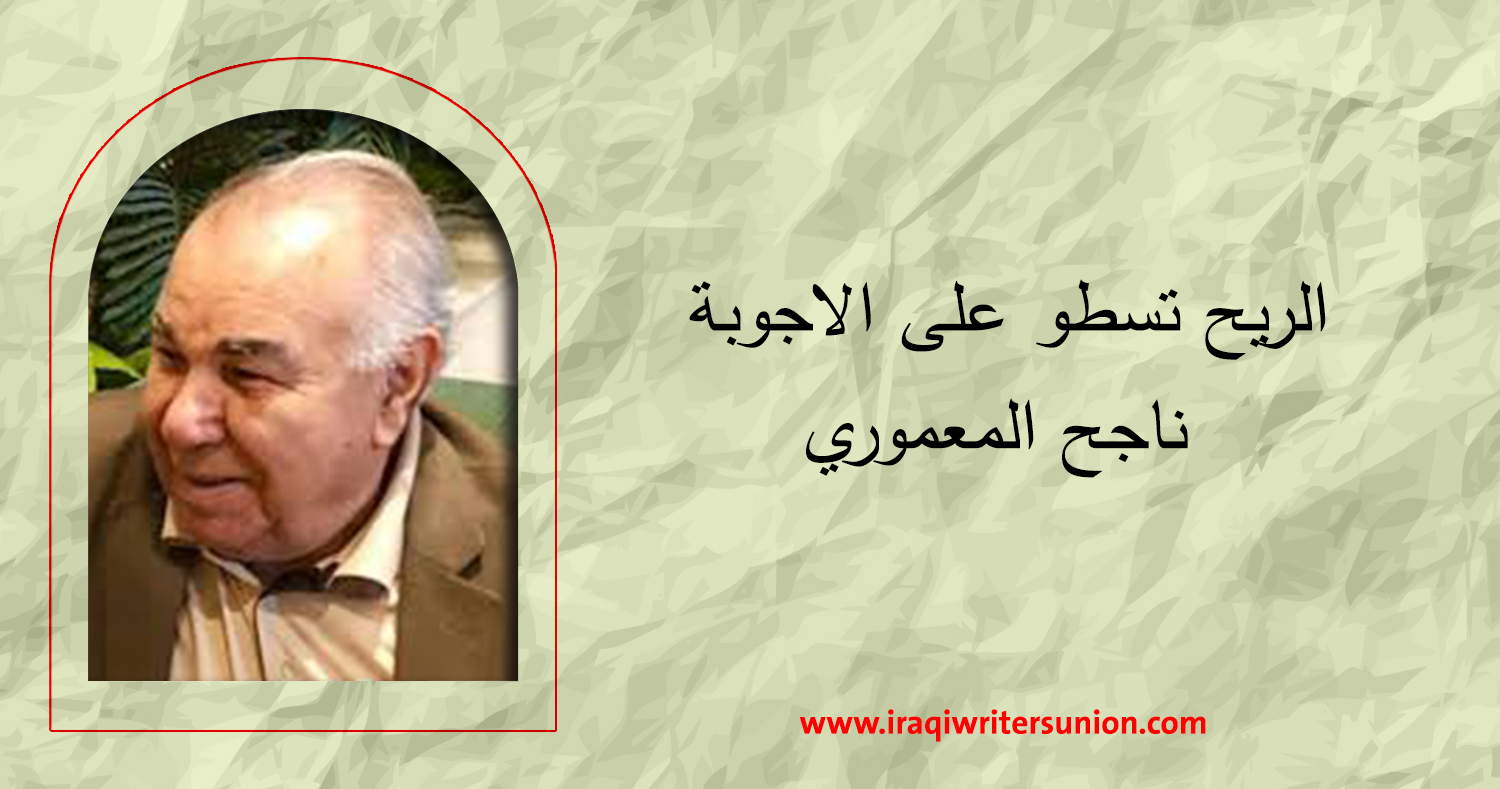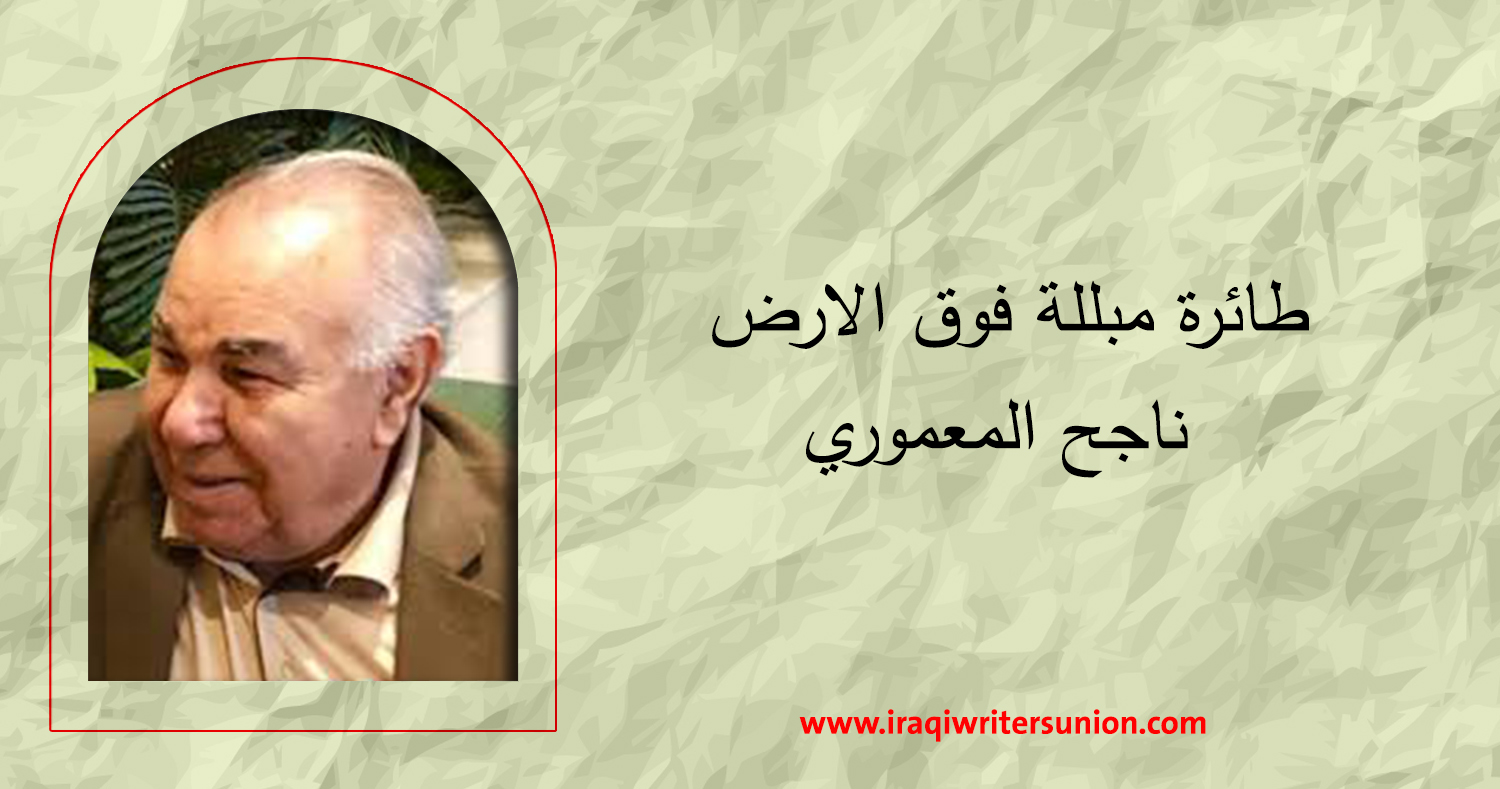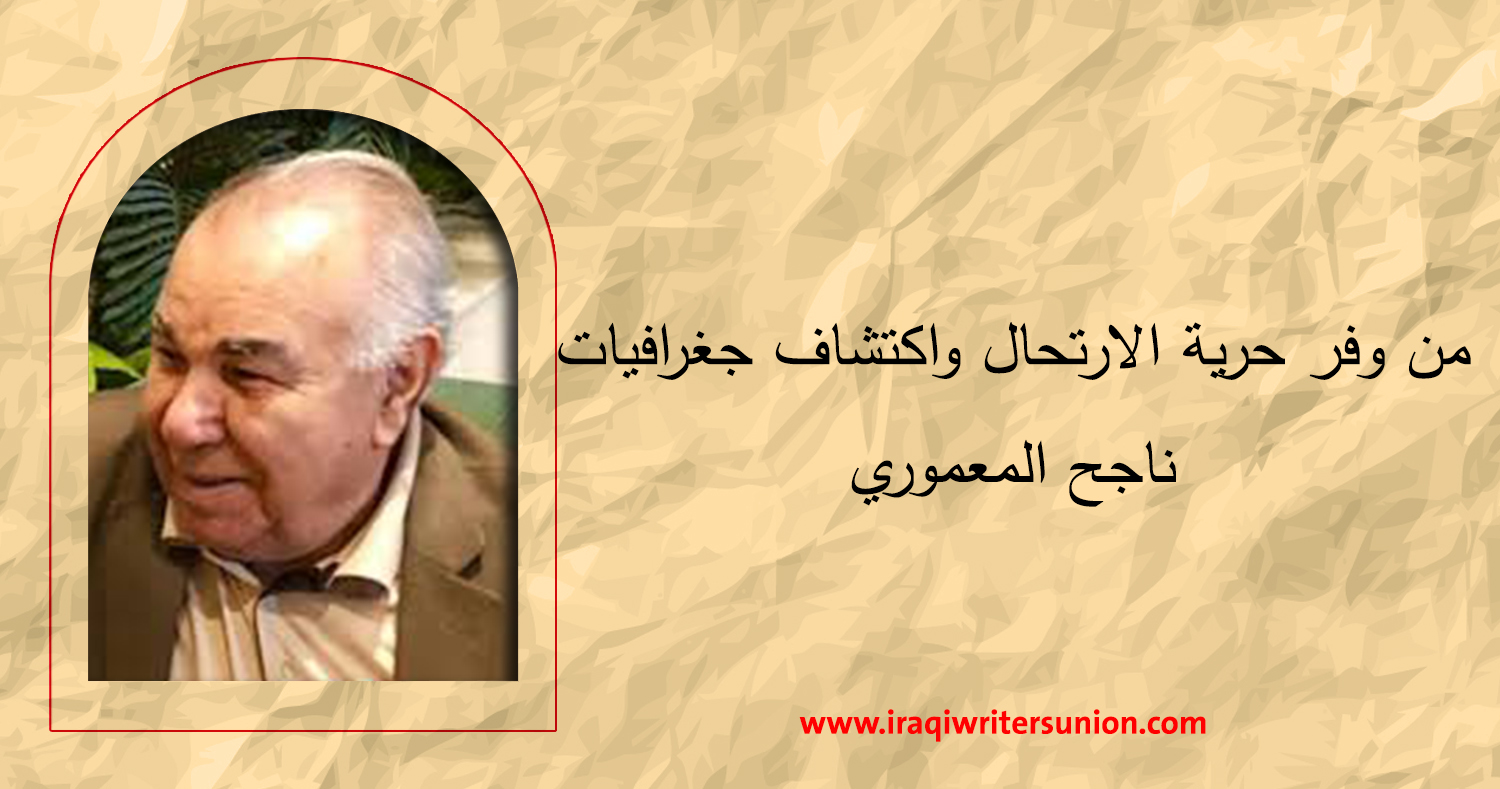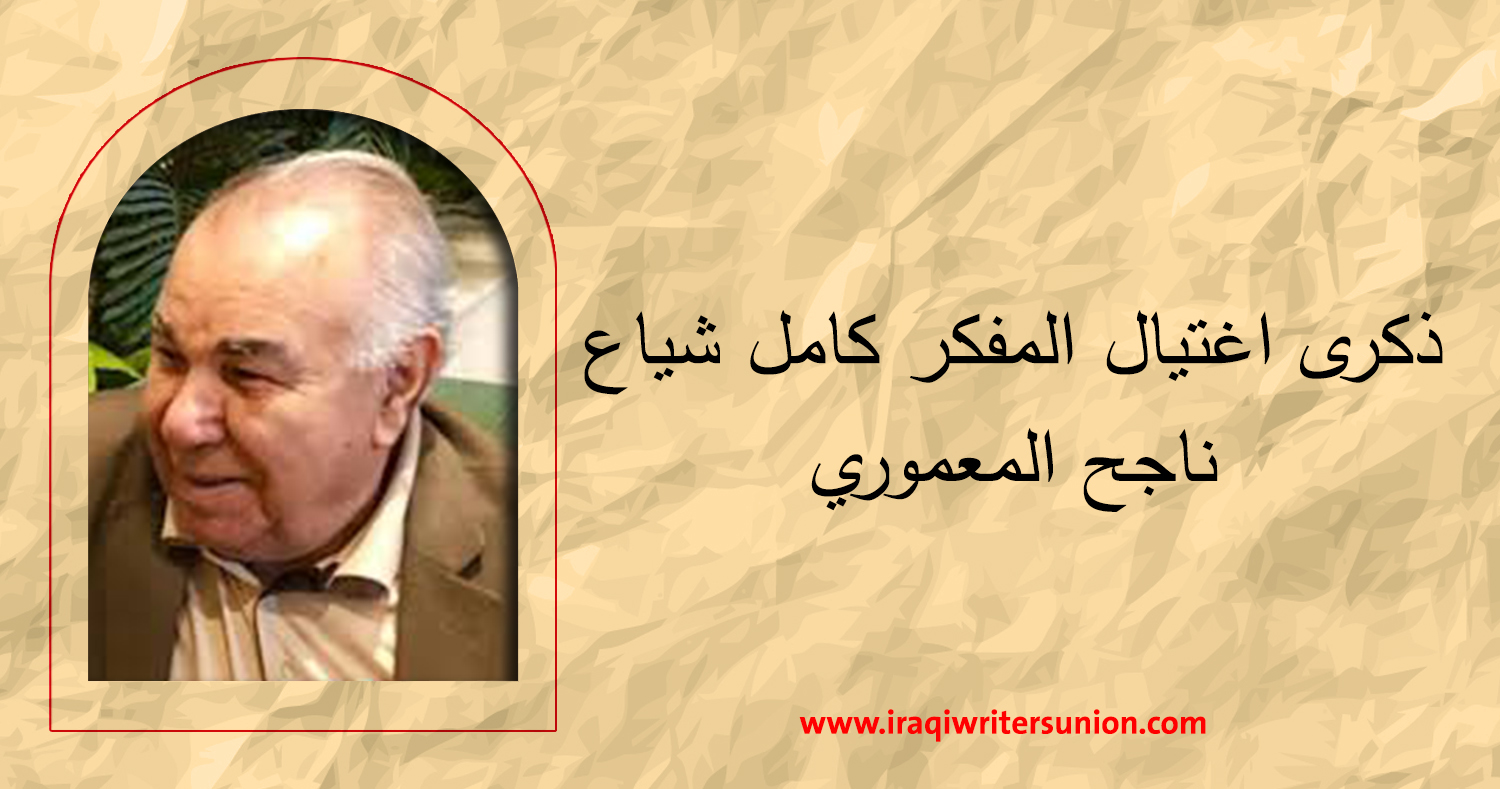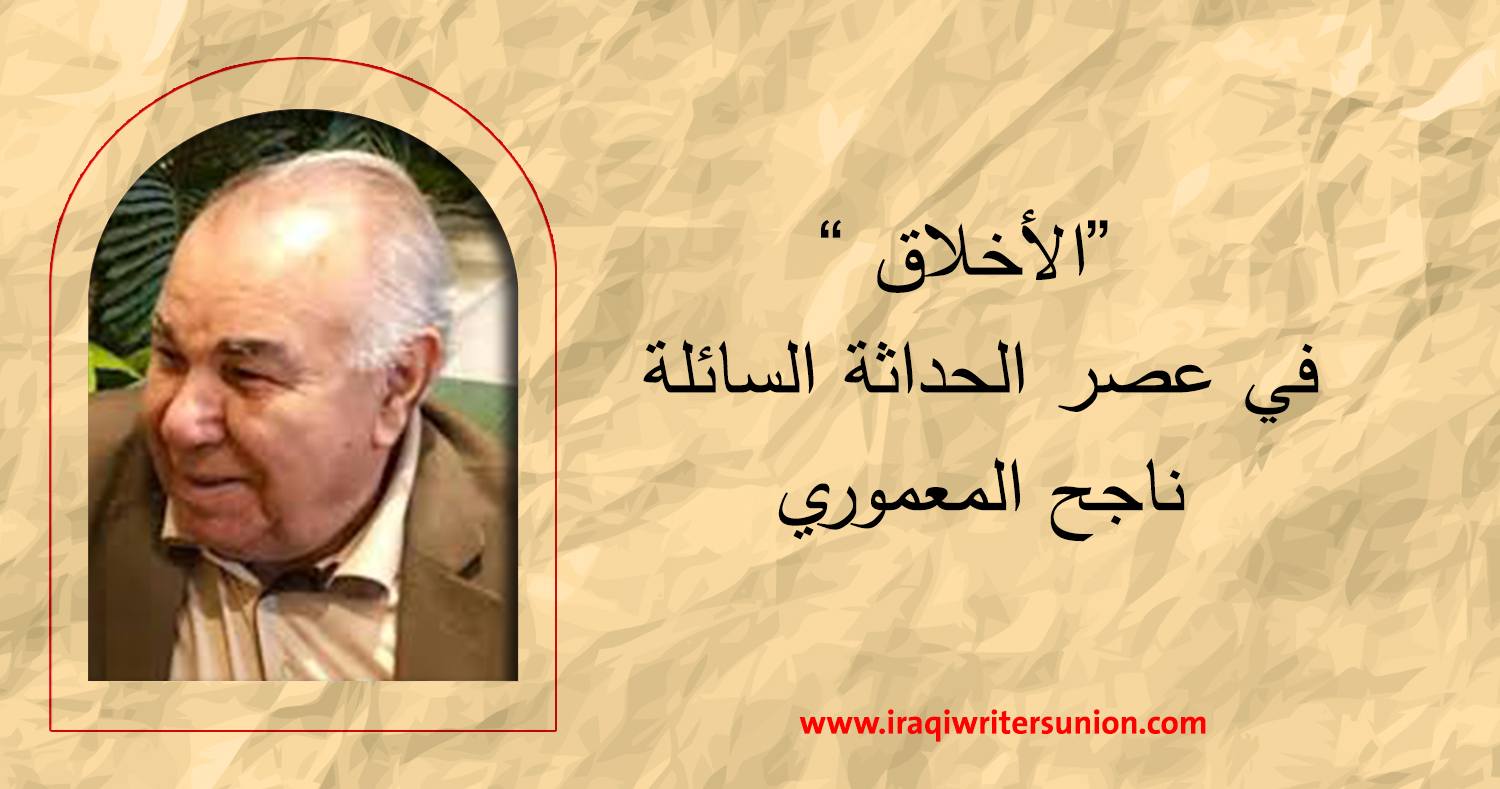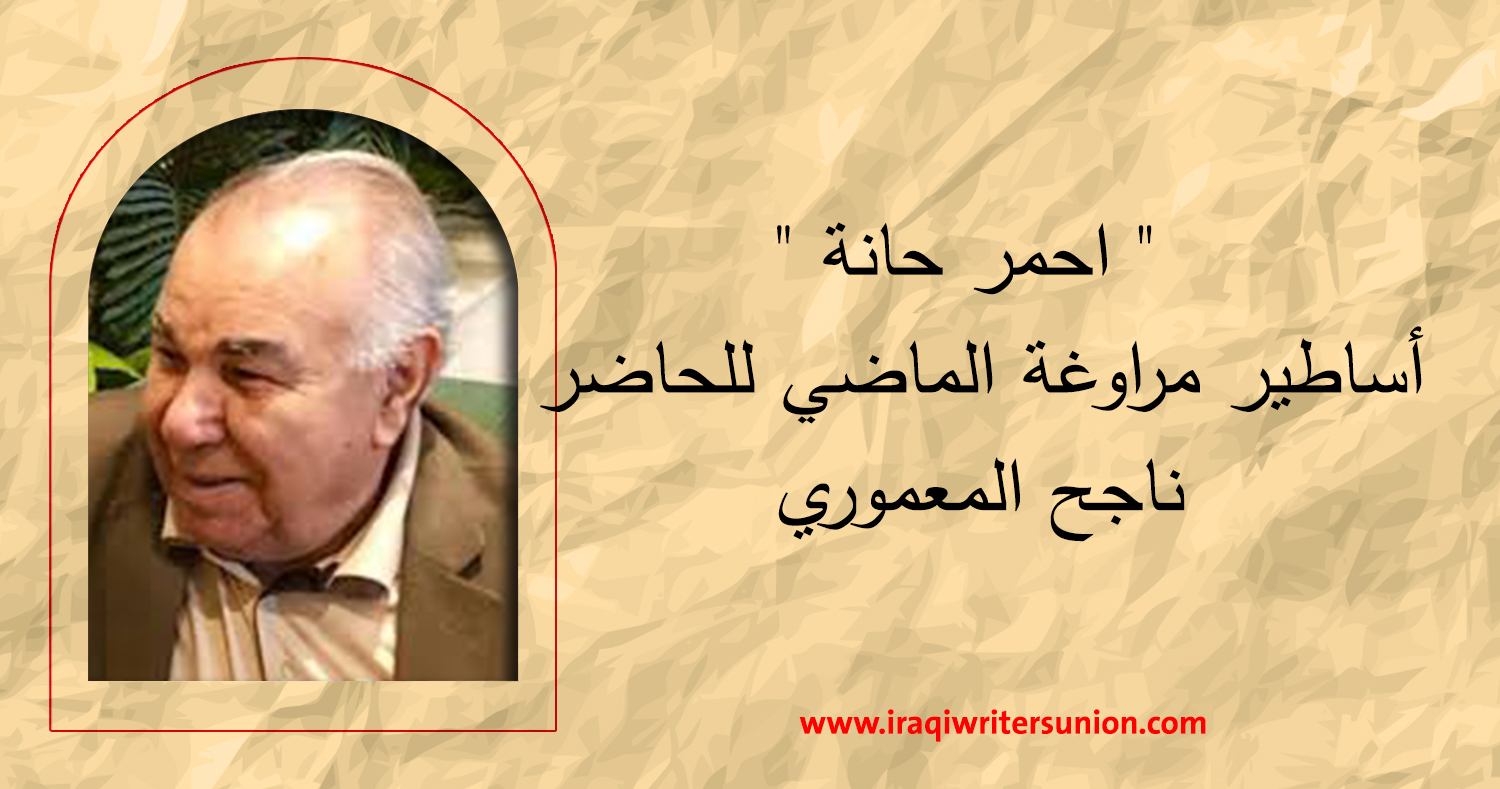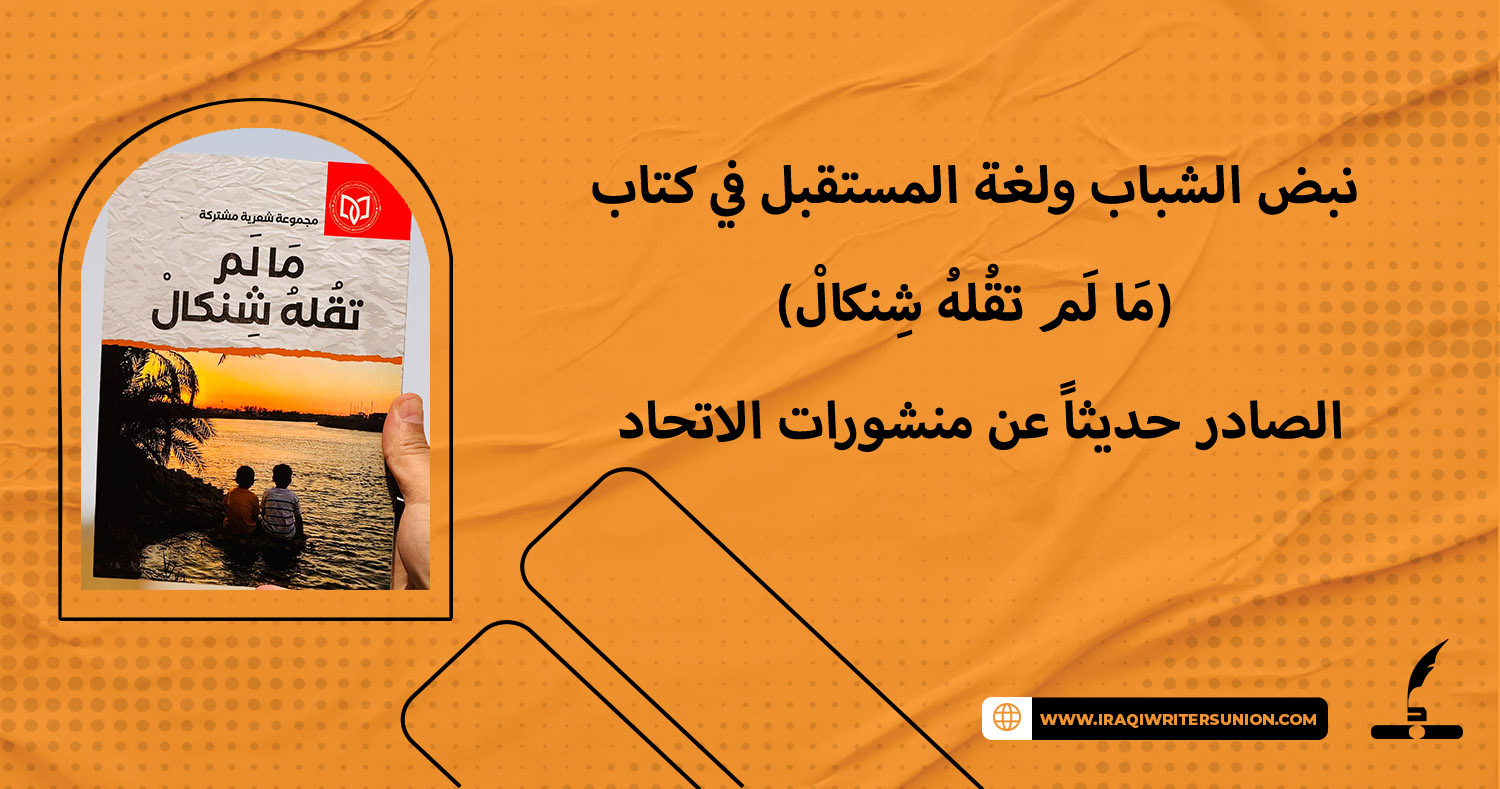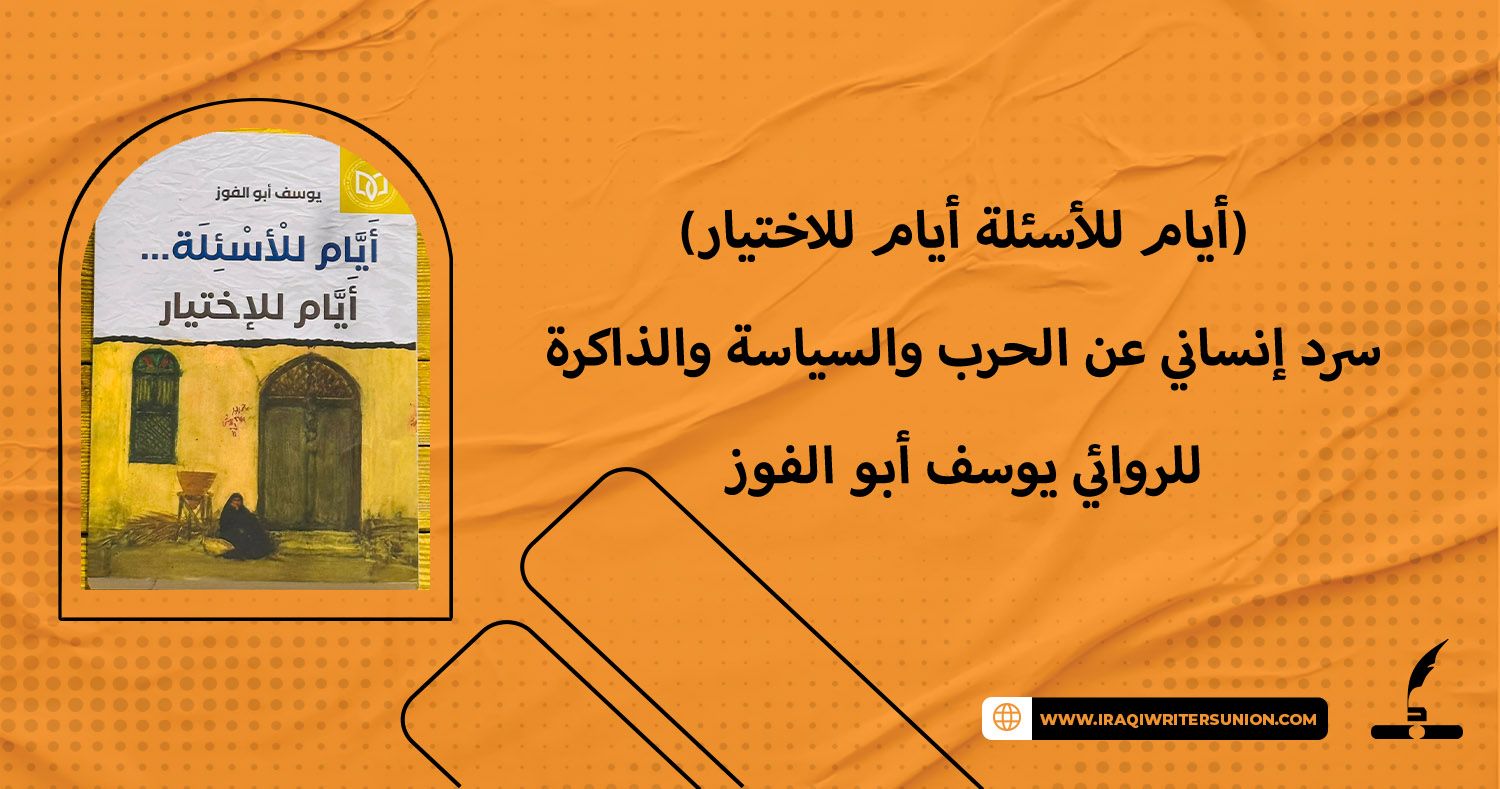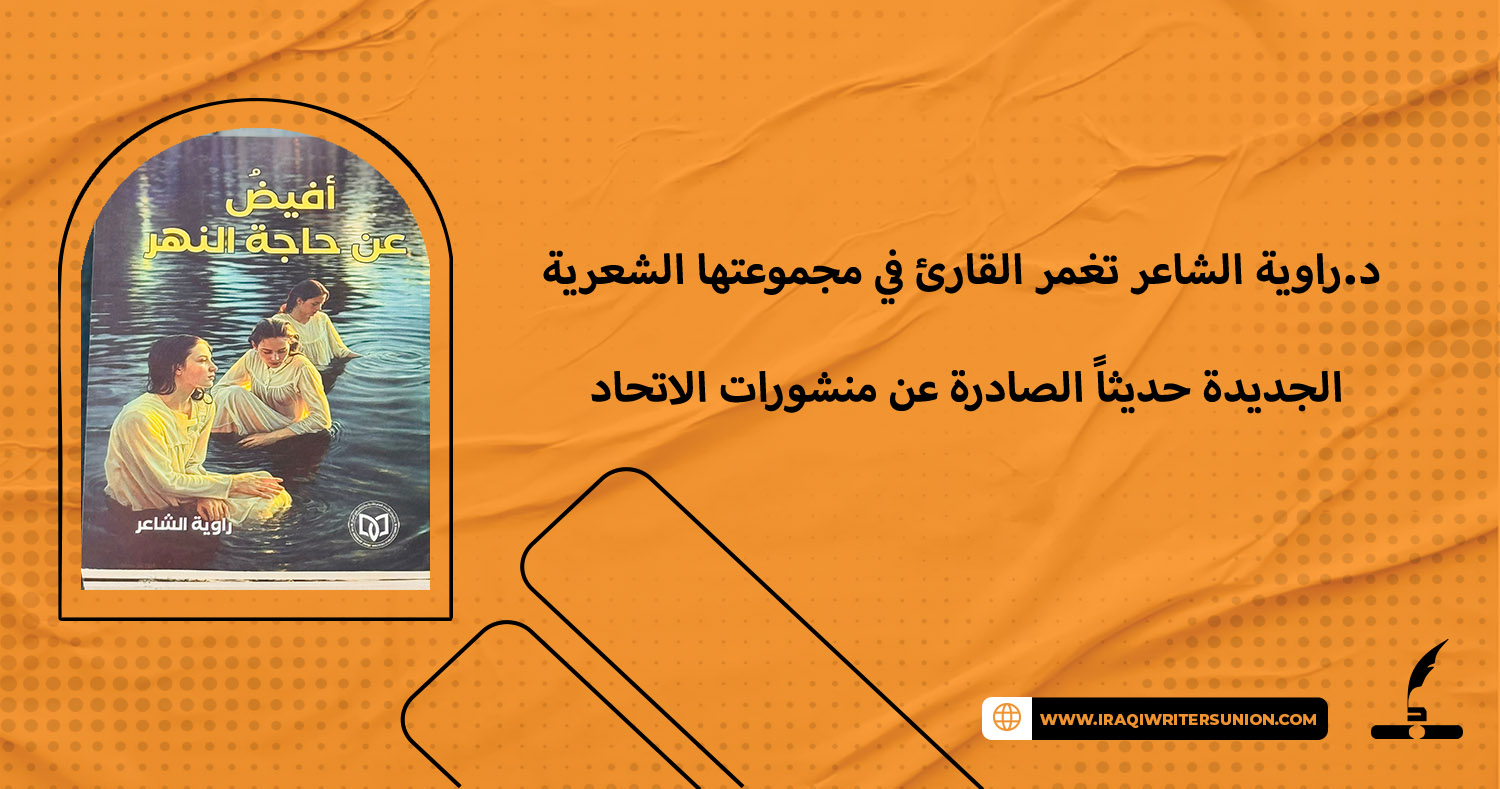المستقبل بناءً على الفكر المركّب
من جدل النظريّة نحو الموقف النقديّ لفهم العالم
عبّاس عبد جاسم في سجال مع أدغار موران
حاوره/ حسين محمّد شريف
* أهلًا بكم في حوار مهمّ مع كتاب " الفكر والمستقبل "لإدغار موران الذي يُعدّ من الكتب التي تطرح مستقبل الإنسان ، فكيف يمكنك تقديمه بشكل موجز على العموم قبل الدخول في تفصيلاته؟
- يسعى هذا الكتاب إلى تفكيك المنطق الداخليّ لمنظومة "العقل الأعمى" ، التي تحكّمت فيه "الابستيمولوجيّة التقليديّة" للفكر الغربيّ ، وقد تجاوز إدغار موران "لنظريّته الفوضويّة في المعرفة " لـ بول فييرباند ؛ التي أطاحت بكلّ ما هو نمطيّ ومألوف ومتداول في الفكر الغربيّ ، وذلك على وفق منهجيّة جديدة قائمة على براديغما جديدة أيضًا في فهم قوانين تطوّر حركة العالم.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على ترجمة هذا الكتاب ، فإنّه يمتلك حيوات متجدِّدة مع قوانين تطوّر حركة التاريخ والوعي الفلسفيّ في أوربا وأميركا ؛ بصيغ مستوعبة لإشكاليّات التحوّل والفوضى واللايقين ، ومتقدّمة عليها في آن ، وذلك بتنشئة بنى ومفاهيم علميّة وفلسفيّة تّتجه نحو زحزحة المنطق والحقيقة باستخدام آليّات البسيط والمركّب في فهم الظواهر الكونيّة.
لهذا يضمّ الكتاب "مجموع" أفكار مركّبة من منظور متعدّدة بـ "أفق مركّب جديد" ، يتجاوز الفكر التقليديّ الذي عجز عن فهم قوانين تطوّر حركة العالم ، فاصطلح عليه بـ "الفكر التعقيديّ" كنتاج لتطوّر ثقافيّ ، وتحوّل تاريخيّ ، يُعنى بالحدود الوجوديّة والمعرفيّة للفكر الغربيّ بأفق ما بعدي أو ميتا معرفيّ.
ولكن كيف يمكن النظر إلى التعقيد من غير تبسيط ؟ تلك هي الإشكاليّة الفلسفيّة والإبستيمولوجيّة من التبسيط إلى التعقيد.
ومن الخطأ أن نختزل إشكاليّة المركّب إلى فكر تبسيطيّ ، لأنّه يشوّه ما هو تبسيطيّ ، وقد يمحو الفكر المبسّط ما هو معقّد ، حتّى ولو كان التبسيط مجرّد انعكاس لواقع ما ، فالفكر المركّب متعدّد الأبعاد ، ويتّجه نحو الاكتمال الناقص ، أي ليس ثمّة اكتمال ولا يقين بالأساس.
إذن، فما "الواحد والمتعدّد" في الفكر المركّب؟
إنَّ "الفكر المركّب" مجموع من العلوم الإنسانيّة والطبيعيّة ، تتوحّد في أنّها ذات إبستيمولوجيا واحدة هي "إبستيمولوجيا التعقيد" ، وهي تتساوق مع نظريّات التعقيد مثل نظريّة "الكاوس والسبرنطيقا ونظريّة المعلومات" في تفسير الأزمات والتحوّلات الناتجة عن مآزم العصر والتقدّم العلميّ.
ولعلّ من أخطر التهديدات التي تواجه البشريّة - التقدّم الأعمى الخارج على قواعد الضبط المعرفيّ ، لهذا لابدّ من تحرير الفكر من العمى والتجريد والدوغمائيّة.
* إذن لنلج في أولى مقدّماته عندما يؤكّد موران على أن العالم أصبح أكثر تعقيدًا من أيّ وقت مضى ، ولا يمكن فهمه من خلال النماذج البسيطة أو الأحاديّة ؟
-نعم المنهجيّة الأحاديّة – ذات طبيعة خطيّة تنتج رؤى أفقيّة ، لا تخرج عن إطار المحاكاة ، وغير موثوق بها ، ولا ترتقي إلى فهم تعقيدات العالم المعاصر، وأيّ تعقيد من هذه التعقيدات هو نسيج - complexus من العناصر المتنافرة ، وفيه مفارقة الواحد والمتعدِّد ، وبقدر ما هو خليط غير متجانس ، فهو سيرورة في طور التفكّك والتنظيم في آن.
كما أنّ التبسيط الفائق يخلق تعمية بصريّة في تعقيد الواقع ، وهذا لا يمنع من القول بأن بصيرتنا مشوّشة في رؤية مشكلة التعقيد ، وإن كان العمى يشكل جزءًا من بربريّتنا، فهل بإمكان الفكر المركّب أن يُعيد إلينا عقليّتنا في عقلنة الأشياء من حولنا ؟
من هنا تستدعي استراتيجيّة فهم الفكر المركّب من التبسيط إلى التعقيد – استعادة الوعي بتعقيدات العالم من جديد ، لأن تبسيط الأشياء لا يعني تسطيحها بصيغة انتزاعها من جواهرها ، ولكن لابدّ من تبديد التعقيد الظاهر من أجل الكشف عن التبسيط الذي تنطوي عليه من جهة ، ويجب أن نتجنّب التبسيط المعرفيّ القائم على تشويه الجواهر والتمَسّك بالوقائع الظاهرة لها من جهة أخرى.
ولكن كيف يمكن النظر إلى التعقيد من غير تبسيط ؟ تلك هي إشكاليّة الكيفيّة في فهم فكر موران من السياق البسيط إلى النسق المعقّد ، فـ "التعقيد" عنده : أوّلا ً– في "الكميّة القصوى للتفاعلات وللتداخلات والارتدادات بين عدد كبير من الوحدات" ، وثانيًا – في "الحواريّة بين الاستقرار والاختلال والتنظيم" ، وثالثًا في "قراءة تكامل وتصادم اليقين واللايقين" ، الواحد والمتعدّد ، الجزء والكلّ ، الثابت والمتحرِّك ، الطبيعي والمختلّ ، المستقرّ والديناميّ ، الصدفويّ والحتميّ ، القائم والممكن" ، ورابعًا – في أنّ "فكرته الأساسيّة لا تكمن في القول بأنّ جوهر العالم معقّد وليس بسيطًا، وانّما في " القول بأن هذا الجوهر غير قابل للتمثّل" ، وخامسًا – في" ميتافيزيقيا النظام وميتافيزيقيا رفض النظام".
* ينتقد موران تقسيمات المعرفة – التقليديّة التي تتعامل مع التخصّصات بشكل منفصل ، ويقترح ضرورة دمج مختلف فروع المعرفة الإنسانيّة والاجتماعيّة ، والطبيعيّة من أجل فهم أفضل للواقع ؟
- من جدل النظريّة مع الواقع اتّجه الفكر النقديّ ؛ نحو نظريّة معرفيّة متحوّلة ، تتجاوز حدود النظريّة النقديّة التي توصّل إليها أدورنو وهوركهايمر ، وتتخطّى التفكير القائم على "البعد الواحد" لهربرت ماركوز ، لتنمو وتتشكّل في حقل متحرّك بحيوات متجدّدة ما بعد النظريّة ، لتتجاوز أساليب التفكير السائدة التي تفتقد إلى الأنساق المحكمة المتماسكة.
ومن هنا نعدّ إدغار موران – أوّل من تبنّى فكرة "عبور التخصّصات" في كتابه "الفكر والمستقبل" قبل أدورنو في كتابه "النقد البعديّ لنظريّة المعرفة – دراسات عن هوسرل والنقائض الظاهراتيّة" ، وقبل بسراب نيكولسكو في كتابه "بيان عبر المناهجيّة" ، وأنّ هاتين النظريّتين لا تسعيان إلى تفسير العالم ، وإنّما تعنيان بتغييره ، وقبل ذلك تغيير أدوات الفهم ، وخاصّة بعد أن انتهى التنوير والعقلانيّة إلى طريق مسدود ، لهذا فإن السؤال الذي يعنينا أكثر هل نظريّة موران بريئة من أيديولوجيّة الفكر أم ذات طبيعة إبستيميّة علميّة ؟
لقد "تجاوز الفكر النقديّ طور المرآة " كما رأى بودريارد – نحو طور لاحق للموضوع الذي يجعلنا موضع تفكيره" .
وإن كان "الفكر المركّب – لدى موران – قائم على إمكانيّة تجميع وتوحيد المتعدّد ، وهدفه هو تفجير المباحث داخل أفق مركّب جديد" ، فإنّ الفكر المركّب يقوم بتجميع المتعدِّد من المناهج بأفق معرفيّ عابر للمناهجيّة الأُحاديّة بالتعدّديّة ، وخاصّة أنّ الأحاديّة المناهجيّة لا تُعنى برؤية تعقيدات الواقع اللايقينيّة ، وإنّما تعنى بالوعي المضاعف للواقع الذي يعكس العالم بكيفيّة لا يقينيّة" ، لأنّ الواقع متغيّر، متحوّل ، متبدّل ، باستمرار، وبذا فهو بحاجة إلى وعي متحرِّك موازٍ له" .
ومع انهيار اليقين وظهور اللايقين وانحلال مفهوم الجوهر بالتعدّديّة وفق منطق التكاثر والتضاعف ، فإنّ المنهج الأحاديّ لا يمتلك أيّة قدرة في الوصول إلى الحقيقة ، فالحقيقة وهم من الأوهام التي انهارت بانهيار الميافيزيقيا التي أطاحت بها الحداثة البعديّة.
وعلى الرغم من تمسّك موران بالمنهجيّة في كتابه "الفكر والمستقبل" ، فقد انتهج منهجيّة متعدِّدة التخصّصات ، لهذا هناك فرق بين "عبور التخصّصات" و"تعدّد التخصّصات" من حيث الدمج والتركيب بينهما ، لهذا يتبنّى الخروج على التخصّصات المعرفيّة بالتخصّصات العابرة لها.
* يناقش الكتاب مستقبل البشريّة في ظلّ التحدّيات العالميّة مثل التكنولوجيا المتقدّمة والعولمة ، وكذلك الأزمات البيئيّة والاقتصاديّة. ويتساءل عن كيفيّة إدارة هذه التحدّيات بشكل يضمن تطوّرًا إنسانيًّا عادلا ًومتوازيًا ؟
- في مساءلة العلوم المتقدِّمة، يطرح موران –(العلمي داخل اللاعلمي) ، وبذا يتجاوز إشكاليّة غلق أيّ مفهوم من المفاهيم الأساسية للعلم والفلسفة ، وينفتح بها خارج أيّ إطار معرفيّ ، مركزيّ ، وذلك لتشكيل نسق جديد بأفق الميتا ، وهذا النسق بدوره قابل للمجاوزة بصيغ علميّة حيّة منظّمة لذاتها في علاقتها مع محيطها ، وعابرة للسبرنطيقا والنزعة النسقيّة ونظريّة المعلومة.
ويرى ضرورة تجاوز ما تبقّى من أيّ جهل جديد لتطوّر العلم ، كانكفاء العقل عند عمى جديد أيضًا ، لأنّ (العقل الأعمى) ينزع نحو تدمير منطق الأشياء ، وذلك بـ (عزل) موضوعاتها عن بيئتها ، وليس بإمكانه أن يتمثّل الرابط غير القابل للقطع بين الملاحظ والشيء الملاحظ .
ويدخل من "الثغرة" الماكروفيزيائيّة لفهم جديد للمفاهيم المتنافرة من حيث المكان والزمان والميتافيزيائيّة العابرة للظواهر الطبيعيّة ، ويقوم بتحطيم القاعدة الامبريقيّة لتشكّل الجوهر الإنسانيّ من جديد.
ولكنّ المسألة التي تشغلنا أكثر: الكيفيّة التي اختُزل فيها الإنسان إلى كائن مجرّد من الطبيعة البشريّة بذريعة البحث عن وحدة علم ونظريّة التعقيد البشريّ القائمة على دمج المألوف (البسيط) بالمختلف (المركّب) ، وذلك بغاية إعادة ترتيب البداهات من جديد.
ومن هنا تتقاطع نظريّة النسق والميتا نسق كذلك مع السبرنطيقا في منطقة – ملتبسة بين الفكر والمادّة ، بدءًا من الذرّة وصولاً إلى المجرّة ، ومرورًا بالجزيئة والخليّة والجهاز العضويّ ، أي نحن إزاء نسق تركيبيّ يتألّف من عناصر مختلفة .
كما رأى بأنّ نظريّة الأنساق أكثر عمقًا واتّساعًا من السبرنطيقا ، لأنّها تختزل النسق في "مجموع" أجزائه المكوَنة له ، لهذا تمثّلت في مستوى عابر للتخصّصات المعرفيّة التي تجمع بين الظواهر الإنسانيّة والطبيعيّة ، وبذا نحن إزاء نسق مفتوح في التمكين من الإحالة إلى كيفيّات ما بعديّة أخرى.
* هناك نقاش مهمّ في الكتاب حين يؤكّد على أن اللايقين أو المحتمل هو صورة صحيحة لحياة كلّ إنسان فهو لا يعرف مصيره في الحياة وأمراضه وتعاسته ولكنّه يعرف موته؟
- قبل الإجابة – يستدعي مفهوم "اللايقين" في مفهوم موران إشكاليّة علميّة وفلسفيّة ، فما "التعقيد" ؟ ويجيب عنه بأنّه " ظاهرة كميّة ، أي الكميّة القصوى للتفاعلات والتداخلات بين عدد كبير من الوحدات ، ويشمل التعقيد عددًا من اللايقينيّات والظواهر الصدفويّة ، وبذا فالتعقيد جزء من اللايقين ، وفي تصوّري لا يمكن اختزال التعقيد في اللايقين ، بل أن التعقيد هو ذاته اللايقين المترسّخ داخل الأنساق المنظّمة له .
كما أن التعقيد خليط من الاستقرار والاختلال ، وينطوي على نوعين من التعقيد : تنظيميّ ومنطقيّ ، وفيه – يتجاوز موران مأزق بياجيه في منطق التنظيم البيولوجيّ ، ويدخل بنا في عوالم جديدة من التعقيد .
ولكنّ موران لا يسير من البسيط إلى المركّب ، وإنّما من التعقيد نحو المزيد من التعقيد دائمًا ، لأنّ البسيط خلاصة (لحظة) أو (مظهر) من بين تعقيدات عدّة ؛ ميكروفيزيائيّة ومايكروفيزيائيّة وسيكو - اجتماعيّة .
وما يعنينا من التعقيد المتدنّي والمتوسّط والمتعالي ؛ التعقيد الفائق – كمقولة جديدة ، ومركزيّة من أجل النظر في المشكلة البشريّة ، ومن هذا التعقيد الفائق يمكن أن نفهم اللايقين من خلال نظريّة الكوانتم ، لأنّه يشكّل مركز مدار البنى العلميّة – المعرفيّة المتحوّلة ، ومنها بحسب تسلسل أهميّتها عندي " مبدأ الريبة " أو مبدأ" اللايقين" لفيرنر هازنبورغ ، و" قطّة ايروين شروديخر" والنظريّة الذريّة لنيلز بوهر و"ثابت بلاك" أو " الكمّات" لماكس بلانك ، وهي أهمّ الركائز التي استند إليها وعليها موران في رؤية "المستقبل".
ولكن قبل أن تقود أزمة العلم الميكانيكيّ إلى أزمة العقل ، تتبّع موران أهمّ تمظهرات التعدّديّة المضادّة في القرن التاسع عشر، بعد أن أطاح التيّار الكوانتيّ الجديد بالحتميّ السائد ، فتراجعت فلسفة كانط ، بعد أن أنكر الوجود الواقعيّ للمكان والزمان ، ومن ثمّ نعى واقعيّة كلًّا منهما ، وخاصّة بعد أن عجز المنطق الكلاسيكيّ عن فهم واستيعاب الواقع الجديد "وأعني به تحديدًا " واقع الكمّ غير الواقعيّ في الرؤية الجديدة لواقعيّة الكوانتم.
وعند ظهور الكوانتم تداخل الوعي بالواقع ، حتّى صار الواقع من صنع الوعي ، مّما بدّل الكوانتم واقعنا من الحتميّة إلى الاحتمال ومن الاحتمال إلى اللايقين.
إذًا مع مبدأ اللايقين ، أصبحت المعرفة متحوِّلة – مراوغة – ملتبسة ، لهذا فإنّ أوّل ما أطاحت به نظريّة الكوانتم هو " الحتميّة " ، فكان " الاحتمال " أوّلا ً، واللايقين ثانيًا – بداية انهيار أساس الحتميّة الماديّة "
أمّا السؤال الثاني من سؤالك حول حياة كلّ إنسان لا يعرف مصيره في الحياة ..." ؟
فأنّه يقود إلى متاهة فلسفيّة مفتوحة أخرى.
* باعتقادك هل توجد تجارب عربيّة اقتربت من قيمة موران بخصوص الفكر المركّب والمستقبل ؟
- يمكن أن نعدّ الفلسفة جوهرًا أساسيًّا في الفكر العربيّ ، فقد ارتبطت فكرة المستقبل في الفكر العربي الحديث بتاريخ الفكر الفلسفيّ ، ولم تخرج عن إطار الفكر العربيّ ، فقد أعطى العرب التاريخ العربيّ فكرة التقدّم ، والسؤال الذي يعنينا الآن :
"أيّهما يتحكّم بالآخر؟ الماضي أم المستقبل ؟ " ، وما يعنينا أكثر من ذلك :
كيف يمكن تحرير المستقبل من الماضي ؟
من هذا المنطلق نرى بأنّ فهم المستقبل يرتبط بتحليل" ثقافة الزمان" ، وما يصطلح عليه بـ"علم الأفكار" ، فقد ظهر الفكر العربيّ كبنى مهيمنة خلال السبعينات والثمانينات والتسعينات ، وكان [ نقد العقل العربيّ ] مركز مدار الاتّجاهات المتعاكسة لتلك البنى من حيث النيّات والتوجّهات ، منها لغرض الإشارة وليس المعاينة:
" طريق الاستقلال الفلسفيّ " لـ ناصيف نصّار 1975 ، و " نحن والمستقبل " لـ قسطنطين زريق 1980 ، و " نقد العقل الغربيّ " لمطاع صفدي 1986 ، و"نقد العقل العربيّ " لـ محمّد عابد الجابري 1990 ، و" نقد العقل العربيّ " لجورج طرابيشي 1996 ، ونقد العقل الإسلاميّ " لـ محمّد أركون 1999، و"اغتيال العقل" لـ برهان غليون 2005 ، وغيرهم .
ثمّ تراجع الفكر العربيّ بانحسار مفهوم " المثقّف العضوي" أو "المثقّف الشموليّ" ، حتّى حلّت " شعبويّة الثقافة " محلّ " نخبويّة الثقافة " ، فانتهت صلاحيّة النخبة ، وتحوّل المثقّف من قضيّة إلى سلعة تجاريّة وأيديولوجيّة خاضعة لقانون العرض والطلب .
وطلع جيل جديد يعاني من فصام الشخصيّة الناتج عن الازدواجيّة في التفكير والتعددّية في السلوك ، ونعدّ هذه الظاهرة من أخطر أمراض الثقافة العربيّة ، وإلاّ فما تعليل اضمحلال الفكر العربيّ في الواقع العربيّ .
* لعلّك في بعض كتبك مثل " نقطة ابتداء في النهضة والتنوير والنقد الثقافيّ " طرحت إلى حدّ ما معالجات مستقبليّة ، سيّما مع نقدك للأمركة الثقافيّة ؟
- اتّجهت العولمة الأمريكيّة نحو "رسملة العالم" ، وبامتلاك رأس المال العالميّ صارت العولمة تعني الأمركة ، فالعولمة كما توقّعت – صارت تعني الأمركة " ، وبذا فالنخبة الأمريكيّة تريد أن تكون نخبة عالميّة ما فوق قوميّة وما فوق دولتيّة لقيادة العالم من خلال رسملة الاقتصاد العالميّ كقوّة وأداة هيمنة في تطبيع ثقافات الشعوب وتكريس الاستتباع السياسيّ للمركزة الأمريكيّة بالقوّة والإكراه.
لهذا فالعولمة الأمريكيّة أكثر تمثّلًا لأخلاقيّات الرأسماليّة في كيفيّة تسويق الأنماط الاجتماعيّة والأفكار الثقافيّة ، وخاصّة (الخصخصة والتجارة الحرّة) إلى البلدان النامية والفقيرة ، وذلك لإضعاف الانتماء الوطني ، وتفكيك الإرث التاريخيّ للشعوب.
هذا بعض ما توصّلت إليه في المرحلة الأولى في كتابي " نقطة ابتداء" ، ولكن ما جديد الأمركة الثقافيّة في كتابي الثاني "النهضة والتنوير والحداثة البعديّة" ؟.
من أهمّ سمات التحوّل من الليبراليّة إلى النيوليبراليّة ؛ الزواج بين السلطة والمال ، وتحجيم الدولة ، وأدلجة السوق ، وتحرير التجارة ، وعلاج الاقتصاد بالصدمة ، وخصخصة التنمية الاقتصاديّة ، بما في ذلك خصخصة الخدمات الاجتماعيّة العامّة.
وبذا شهدت العقود الأخيرة من القرن العشرين تحوّلًا جذريًّا في الاقتصاد العالميّ يسمّيه الاقتصاديّ والأكاديميّ كارل بولاني بـ " التحوّل الكبير" الذي جلب تغيّرات اقتصاديّة واجتماعيّة مدمّرة لرأسماليّة السوق الحرّة .
وان كانت الارهاصات الأولى للنيوليبراليّة قد ظهر أواخر السبعينيّات نتيجة التضخّم الاقتصاديّ ، وفشل السياسات الاقتصاديّة (الكنزيّة) وركود الاقتصاد الاشتراكيّ فإنّ تطبيقاتها بدأت أوائل التسعينيّات بعد زوال الشيوعيّة كأيدولوجيّة شموليّة ، وانهيار الاتحاد السوفيتي كمنظومة اشتراكيّة.
ومع انهيار اليقينيّات في القرن الحادي والعشرين - دخل العالم في طور الاختلال ، وخاصّة أن اختلال العالم وصل إلى " طور متقدّم " كما ذهب ذلك أمين معلوف في كتابه "اختلال العالم" ، كما دخل العالم في اضطراب شامل ، حيث اختلّت فيه قيم ومعايير ومبادئ الحريّة والعدالة الاجتماعيّة ، وهدر حقوق الإنسان ، مّما شهد الاقتصاد العالميّ اختلالات عضويّة في بنياته التحتانيّة ، وهي اختلالات ناتجة عن التضخّم والركود وانهيار أسواق المال وتفاقم التفاوت بين الأغنياء والفقراء ، فقد توصّل الاقتصاديّ الفرنسيّ توماس بكيتي في كتابه "رأس المال في القرن الحادي والعشرين" إلى أن تراكم الرأسمال كان أسرع من النموّ الاقتصاديّ ، وقد أدّى إلى بنية منتجة للتفاوت الاجتماعيّ " ، كما أنّ ظاهرة " اللا مساواة المتصاعدة ستقضي على الديمقراطيّة كنظام سياسيّ" باعتبار الديمقراطيّة القائمة على حكم الأغلبيّة مصدر تهديد لحقوق الفرد أو الأقليّة.
ولكن كيف فكّكت النيوليبراليّة اقتصادات العالم ؟
في كتابها "عقيدة الصدمة" تقول الصحفيّة الكنديّة ناعومي كلاين إنَّ سياسات السوق الجديدة التي تدعمها المؤسّسات الدوليّة كصندوق النقد الدوليّ ، والبنك الدوليّ ، ومنظمة التجارة العالميّة – استطاعت أن تتمكّن من الهيمنة عالميًّا عن طريق "مبدأ الصدمة "كما يقول ديفيد هارفي – كما استطاعت رأسماليّة الكوارث تلك ، أن تصعّد من خلال استثمار" الكوارث الاجتماعيّة والسياسيّة والطبيعيّة ، واستغلال الشعوب التي صدمتها تلك الكوارث " كالحروب الأهليّة والإقليميّة والأزمات الماليّة والثورات الشعبيّة .
ولم تكتفِ النيوليبراليّة بصنع الأزمات الاقتصاديّة والاجتماعيّة ، وإنّما تقوم باستغلال الأزمات المجتمعيّة لاستنزاف الموارد الاقتصاديّة للدول النامية على وفق اتّفاقات تجاريّة لترسيخ علاقاتها بالسوق بقوّة إرادة الشركات الاحتكاريّة العابرة للجنسيّات ، وربط اقتصادات هذه الدولة بتبعيّة الاقتصاد الرأسماليّ ، ومدينونيّة النقد الدوليّ ، ولكلّ ذلك : هل هناك بديل للنيوليبراليّة التي فكّكت العالم ؟ ذلك هو الوجه الآخر من تطوّر الفكر الاقتصاديّ في القرن الحادي والعشرين من الأمركة الثقافيّة.
* يرى موران، وهو متفائل جدًّا، أنّ على الإنسان أن يتكيّف نحو أكثر شاعريّة مع الأخرين ، ليعيش أيّامه بشكل مستقرّ ، وهذا الملاذ الذي يشعرنا بالجماليّ في الحياة ، هل ذلك ممكن؟
- لم تعد بيئة الإنسان صالحة لتكيّف الإنسان في أيّ زمان ومكان من العالم ، وخاصّة بعد أن تضاعفت تعقيدات الحياة ، فماذا لو كانت طبيعة الإنسان ذات خاصيّة وجوديّة " بوصفه كائنًا ارتداديًّا يتحلّق دائمًا حول نفسه أوّلًا ، بوصفه كائنًا مفتوحًا (لا يتحكّم في ذاته) في آن ثانيًا ، حتّى "الذات والموضوع" – كما يرى موران –يظلّان غير ملائمين لبعضهما البعض"، ولكن هذا لا يمنعنا من التساؤل ثانيًا : أيّ بيئة صالحة لتكيّف الإنسان أكثر من غيرها ؟
وإن كنّا نبحث عن بيئة صالحة للتكيّف ، فإين نجد هذا العالم ؟ ، والجواب على ذلك: قد "نجد هذا العالم داخل فكرنا الذي يوجد داخل العالم" ؟
لهذا أرى بأن موران يحمل مبدأ اللايقين والإحالة إلى ذاته بحياد إيجابيّ كفعل وانعكاس لذات عارفة بنفسها ، وبذلك يقوم بفتح "ثغرة منطقيّة" داخل نسق لا يقيني بوعي ميتا نسقيّ مستوعب له ومتقدّم عليه ، هذا على الرغم من أنّني أزعم بأنّ ما أقوم به ، لا يعدو أن يكون نوعًا من التفلسف كشكل من أشكال التفكير الموازية لتجاوز اليقينيّات باللايقينيّات ، وذلك لكسر السياق المغلق والانفتاح به بأفق ميتا معرفيّ.
لهذا لا يمكن أن يتكيّف الإنسان "بنحو أكثر شاعريّة مع الآخرين" ، وخاّصة "أنّ كلّ كائن يحمل في داخله نزعة تعدّديّة في الهُويّات ، وتعدّديّة في الشخصيّات ، وعالمًا من الاستيهامات والأحلام التي تصاحب حياته" ، وترتبط هذه التعدّديّات بتعقيدات الذات الإنسانيّة في عالم قائم على "الانسجام" الذي يرتبط بحسب قول هيراقليط بـ "اللا انسجام".
* المستقبل ليس مكتوبًا، بل هو نتاج " اختياراتنا- الفكر المركّب هو أداة البشريّة للنجاة من نفسها ، هكذا ينتهي إيمان إدغار موران ، فبماذا ينتهي يقينك يا سيّدي الكريم؟
-إنَّ اللايقين عندي هو الطريق في الوصول إلى اليقين ، وبذا كنت أتحقّق مّما هو أمبريقيّ ومنطقيّ ، ولم يعنِني الخطأ إذا ما أخطأت ، ولكنّ ما يعنيني "إدراك الخطأ" ، لهذا فالفكر البسيط أو التبسيطيّ لم يعد يمتلك القدرة والإمكانيّة على الربط أو الوصول بين (الواحد والمتعدّد).
وما يعنيني أكثر في الفكر العابر لليقين "كيف يمكن ضبط" معقوليّة النسق" داخل النسق ذاته ، وفي علاقته مع المحيط ، ولكن من دون تبعيّة مسبقة ، أي ما نوع وطبيعة وحجم المحيط الذي يُعنى به النسق ويشتمل عليه ؟
كنت وما أزال أتمسّك بفكرة النسق ، وخاصّة الميتا نسق" من غير مركز ولا نهاية ، لأنّ الأشياء الحيّة كيانات مغلقة ، وتنتظم بأنساق منظّمة لانغلاقها وانفتاحها ، وبذا فهي كائنات ديناميّة متحرّكة من حيث الامتداد والارتداد.
ولكن لا يمكن أن يكتفي النسق أو يكتمل بذاته بدون
جدل صاعد نازل باتّجاه الاكتمال الناقص.
ومن هنا ينبغي تقويض اليقين باللايقين ، لزحزحة الفكر الأعمى السائد باللا مفكّر به لتحرير العالم من الحقائق المبدّهة أو المطلقة.












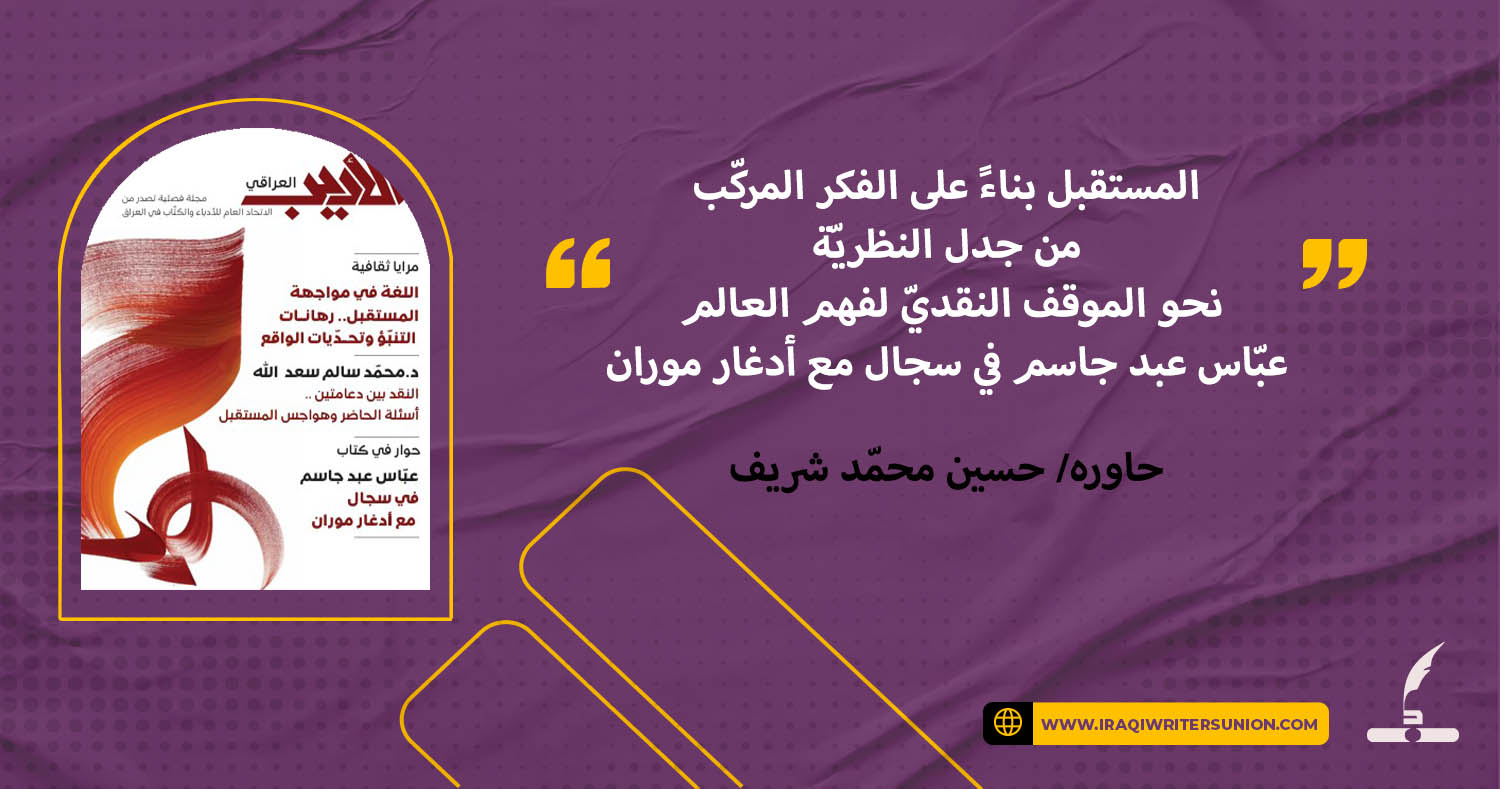
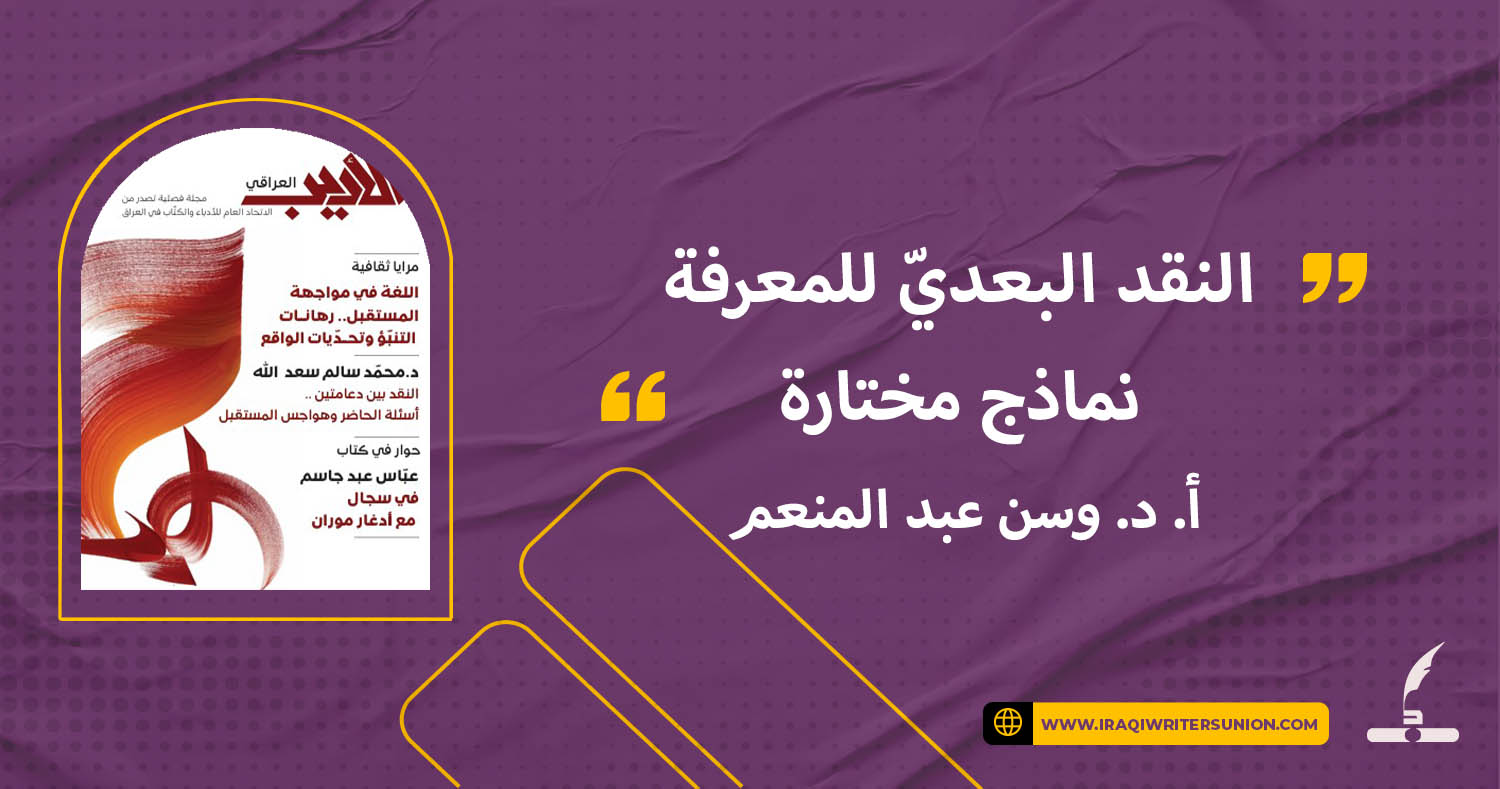

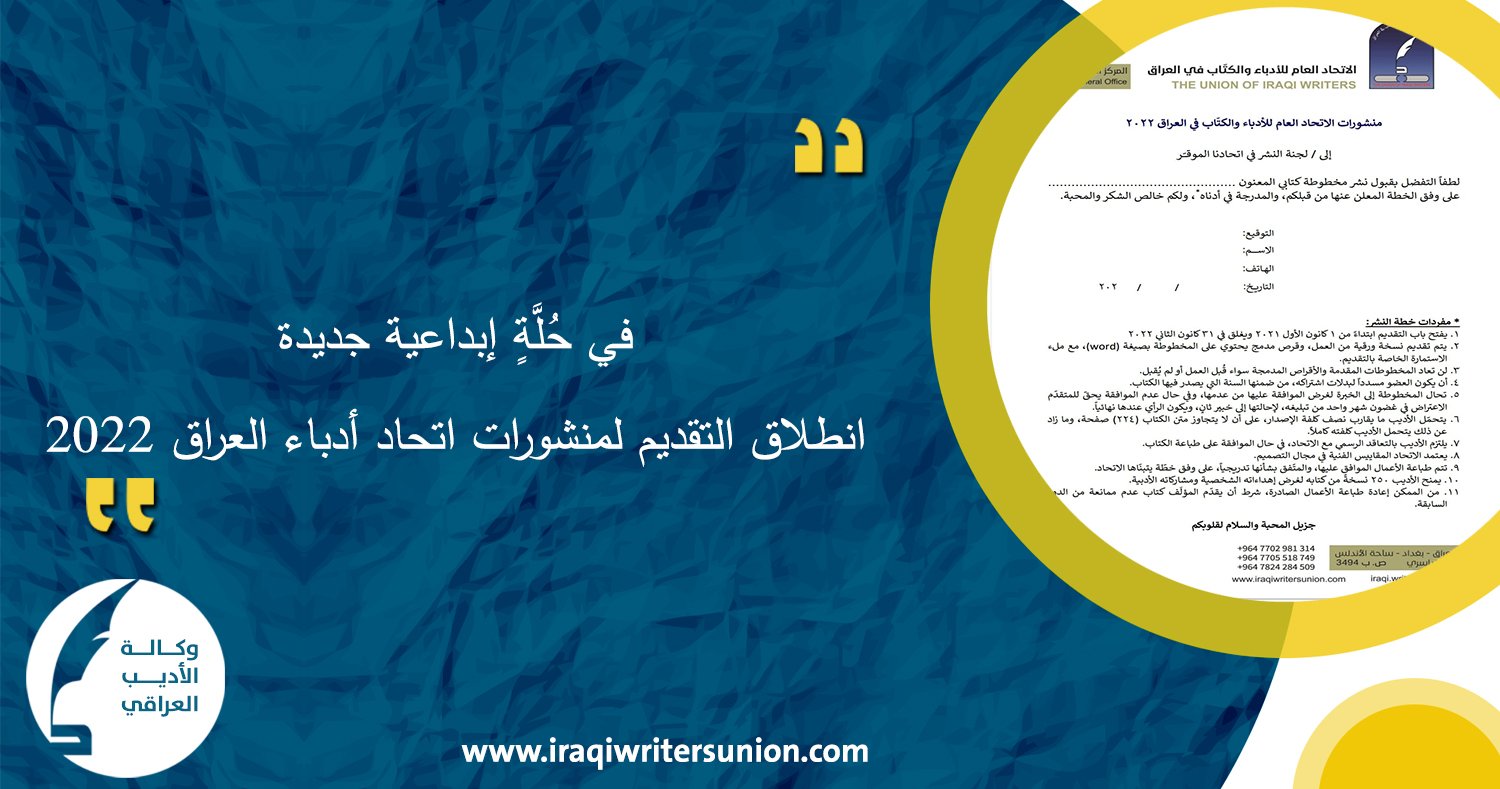
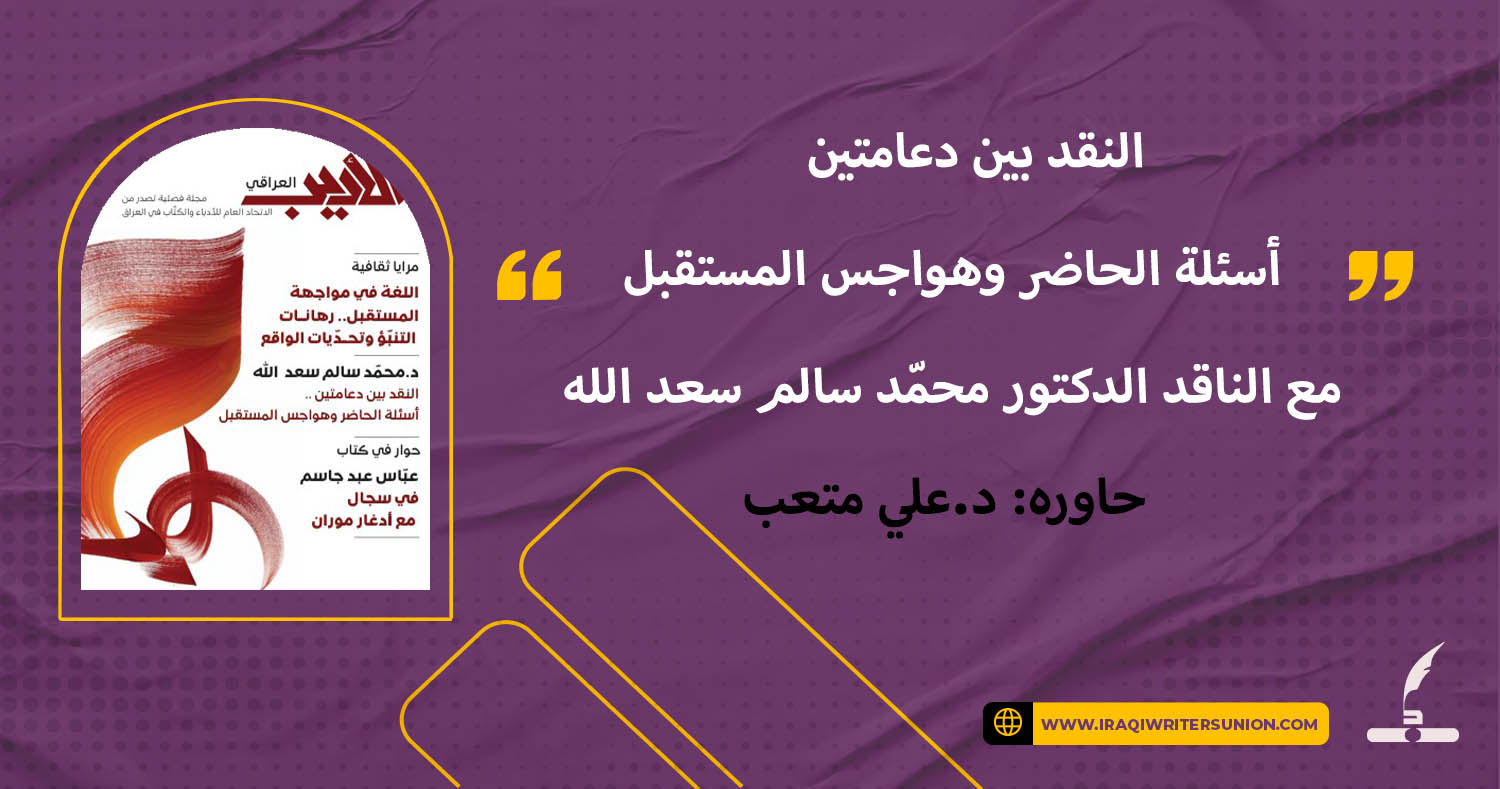
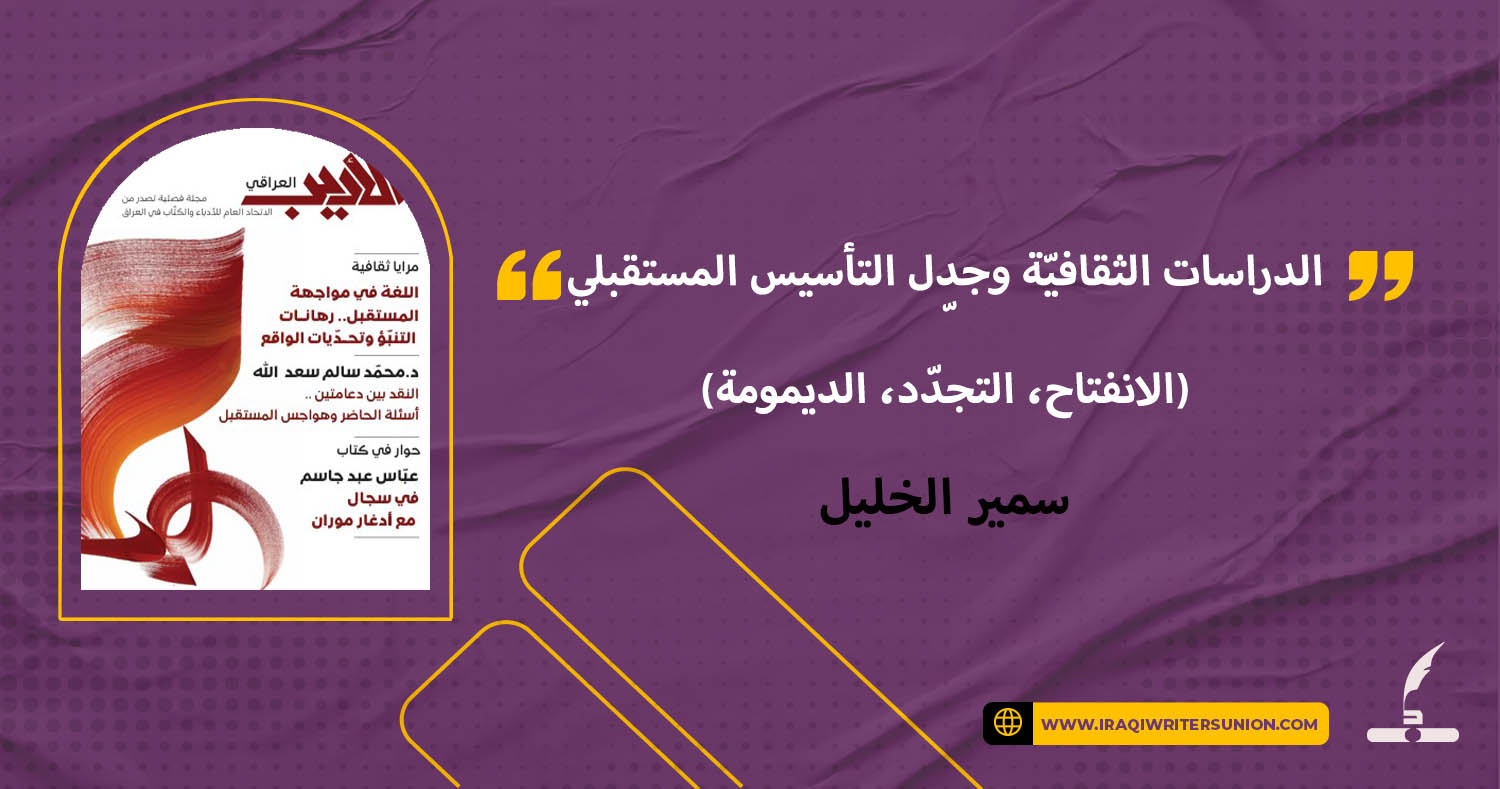

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي