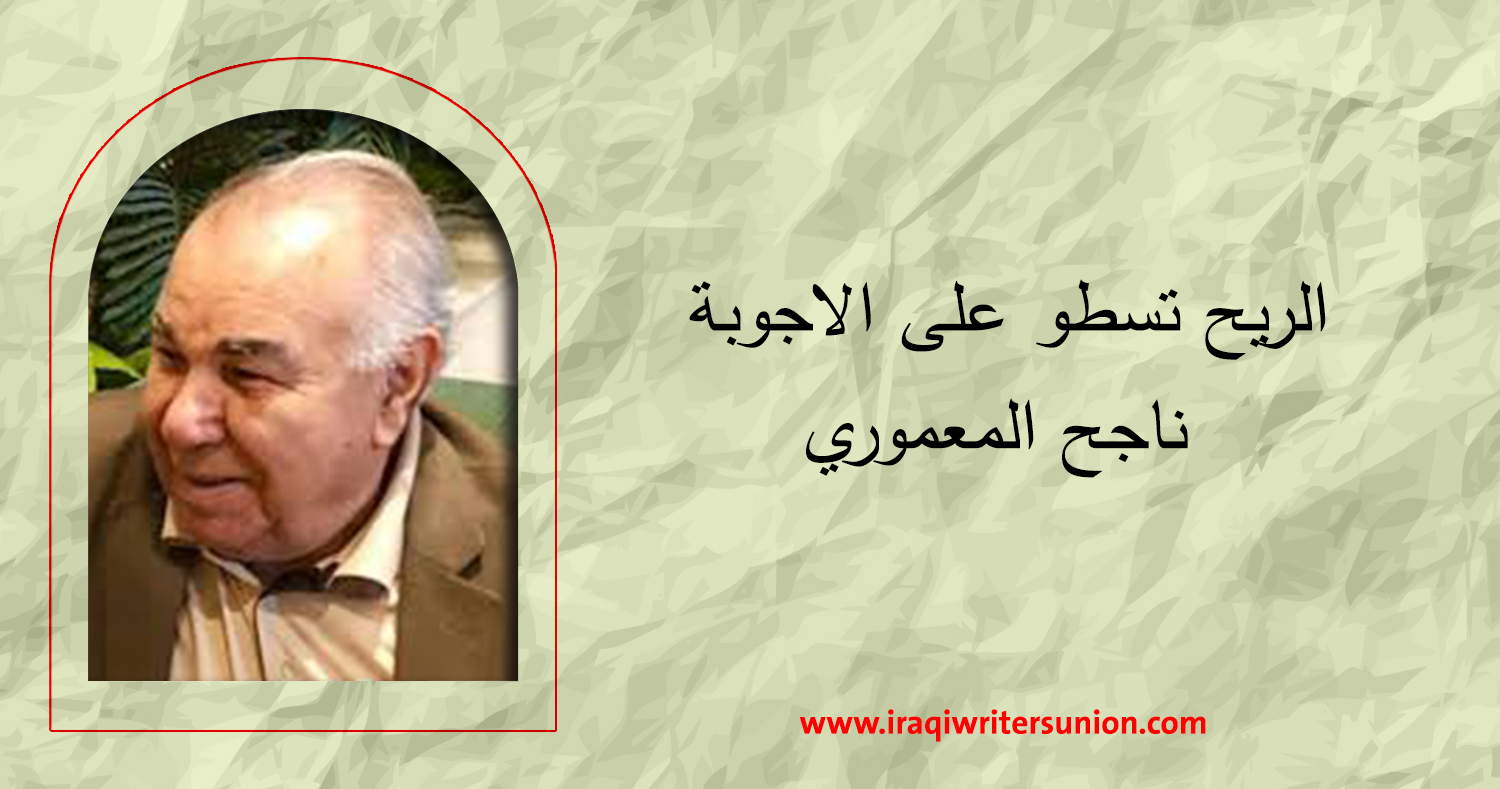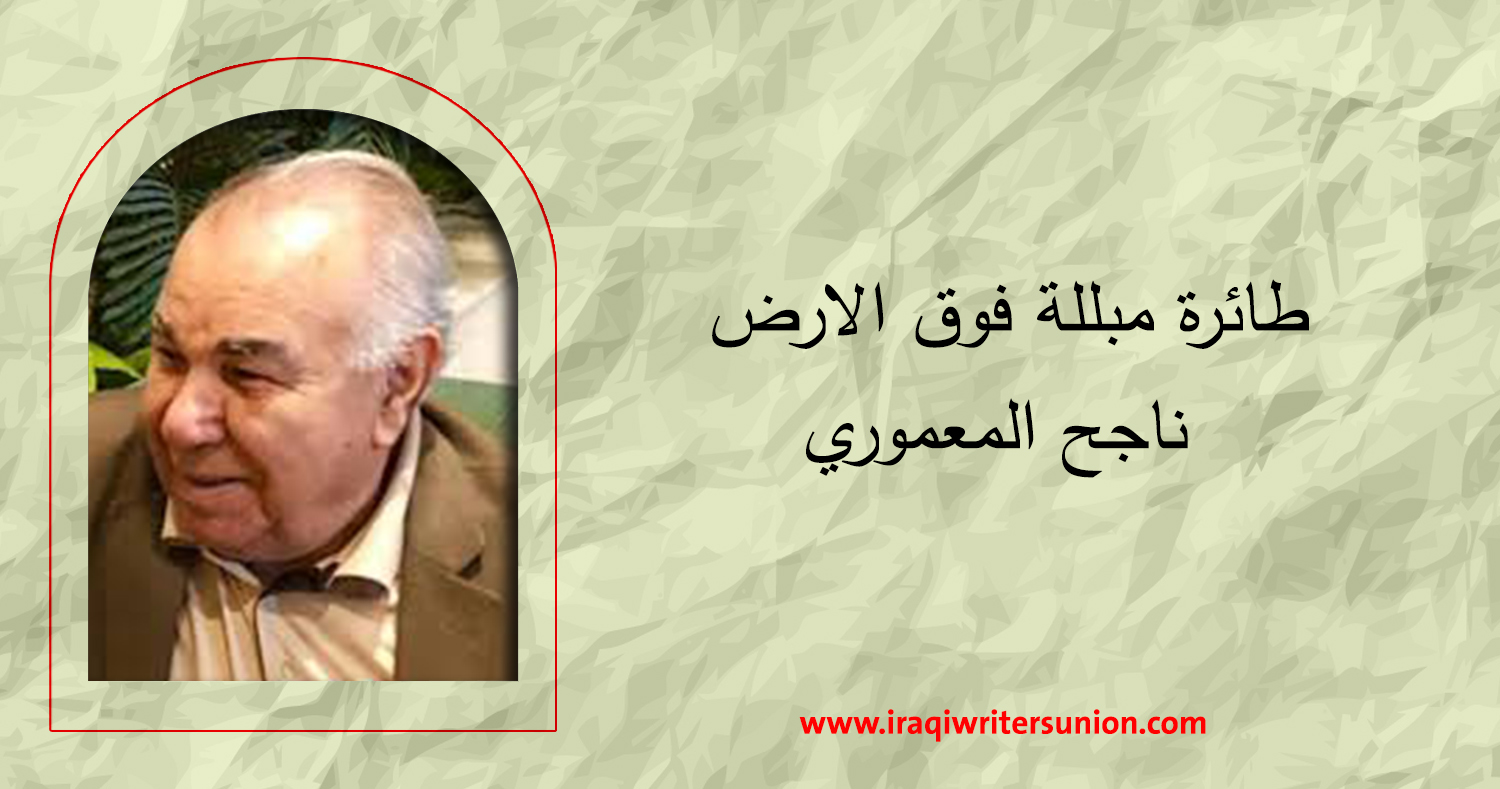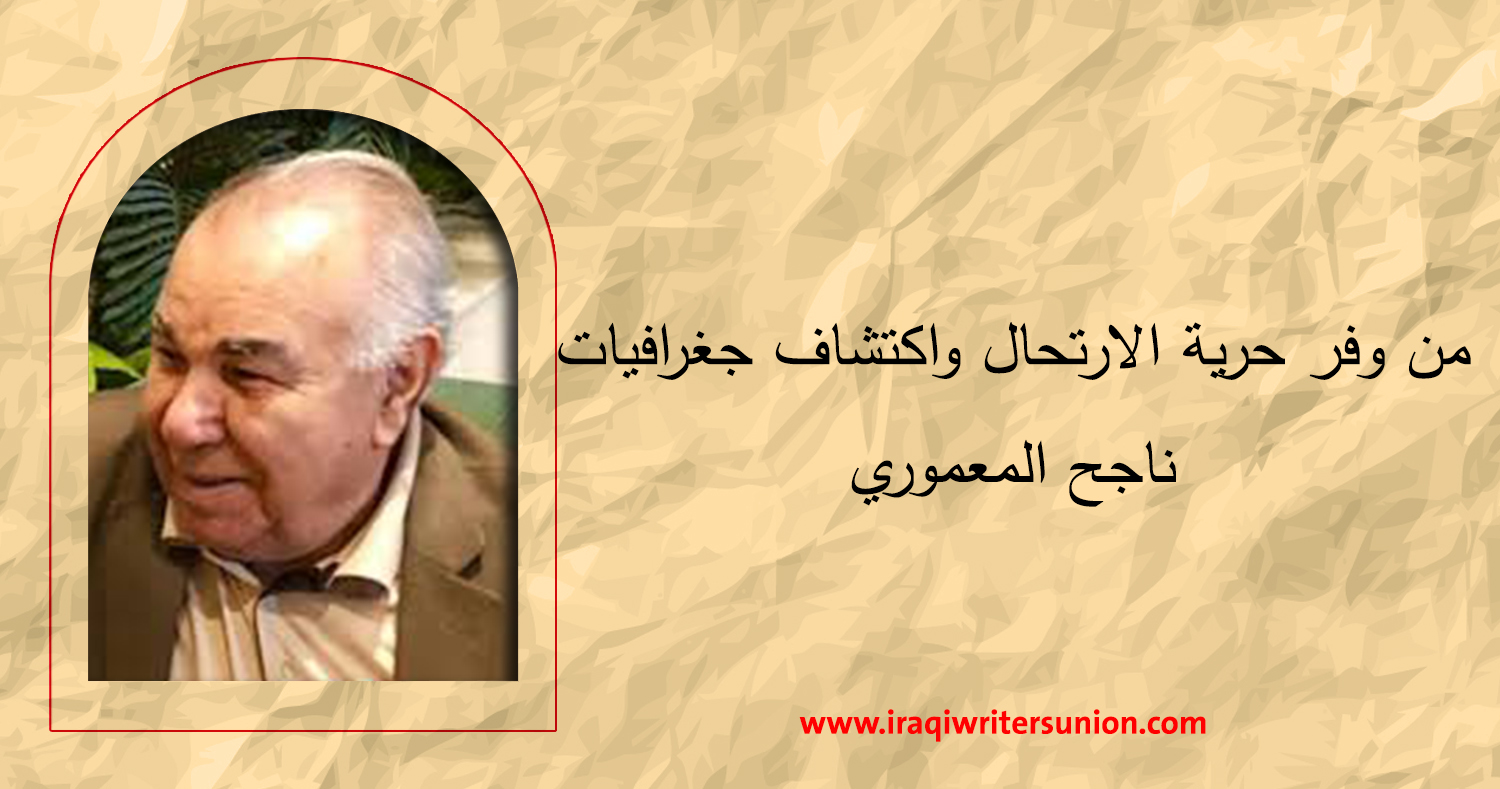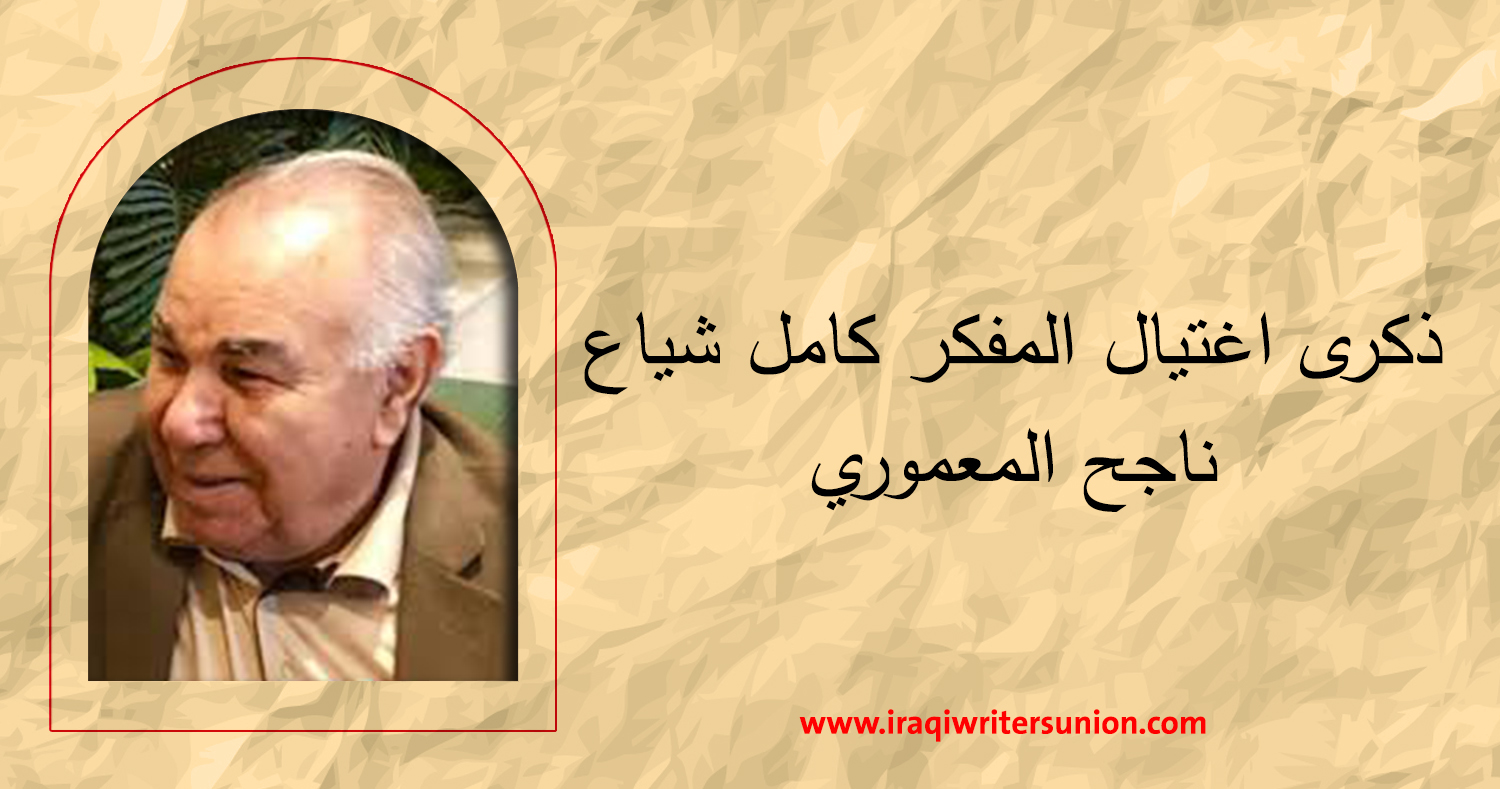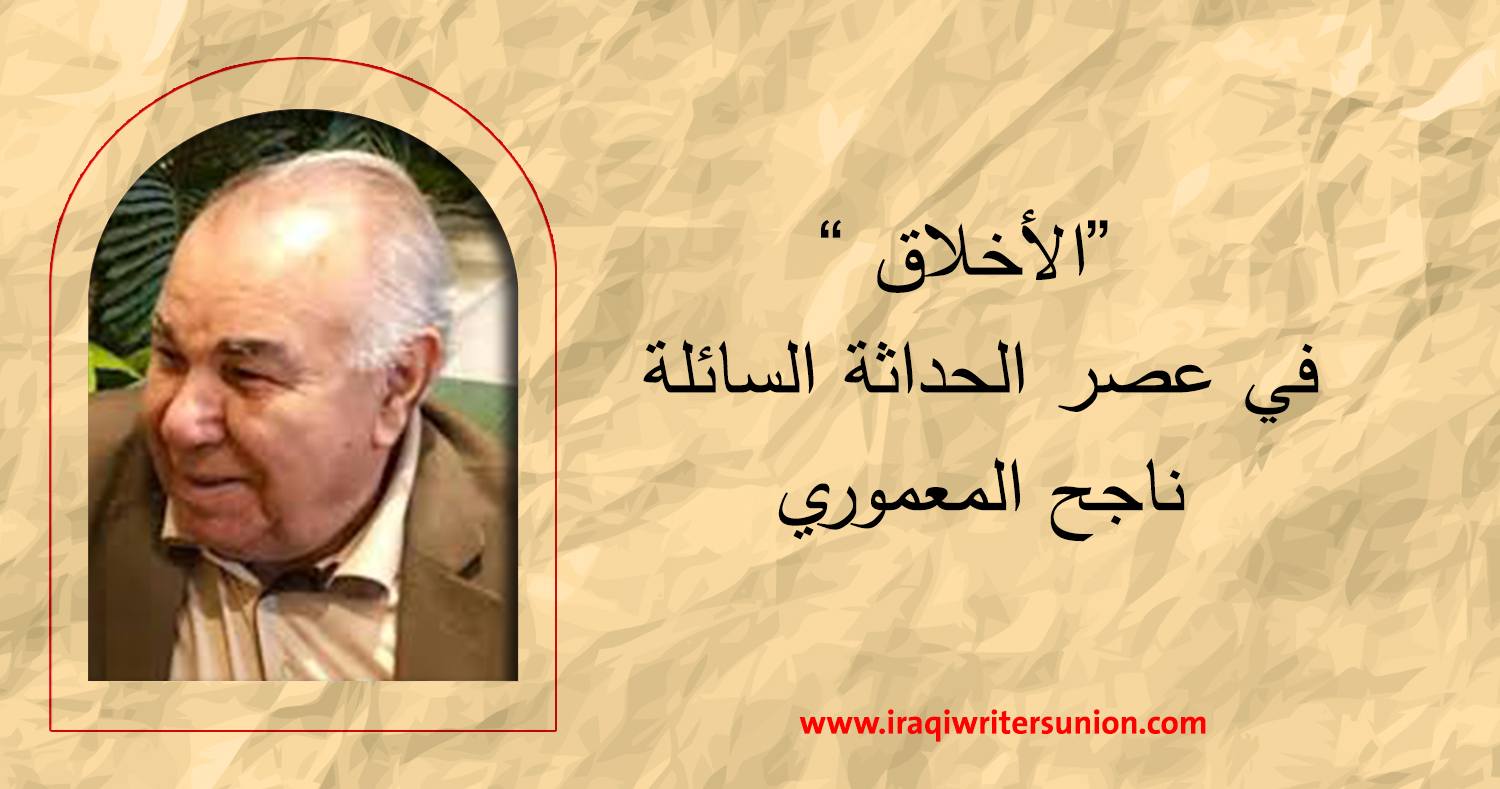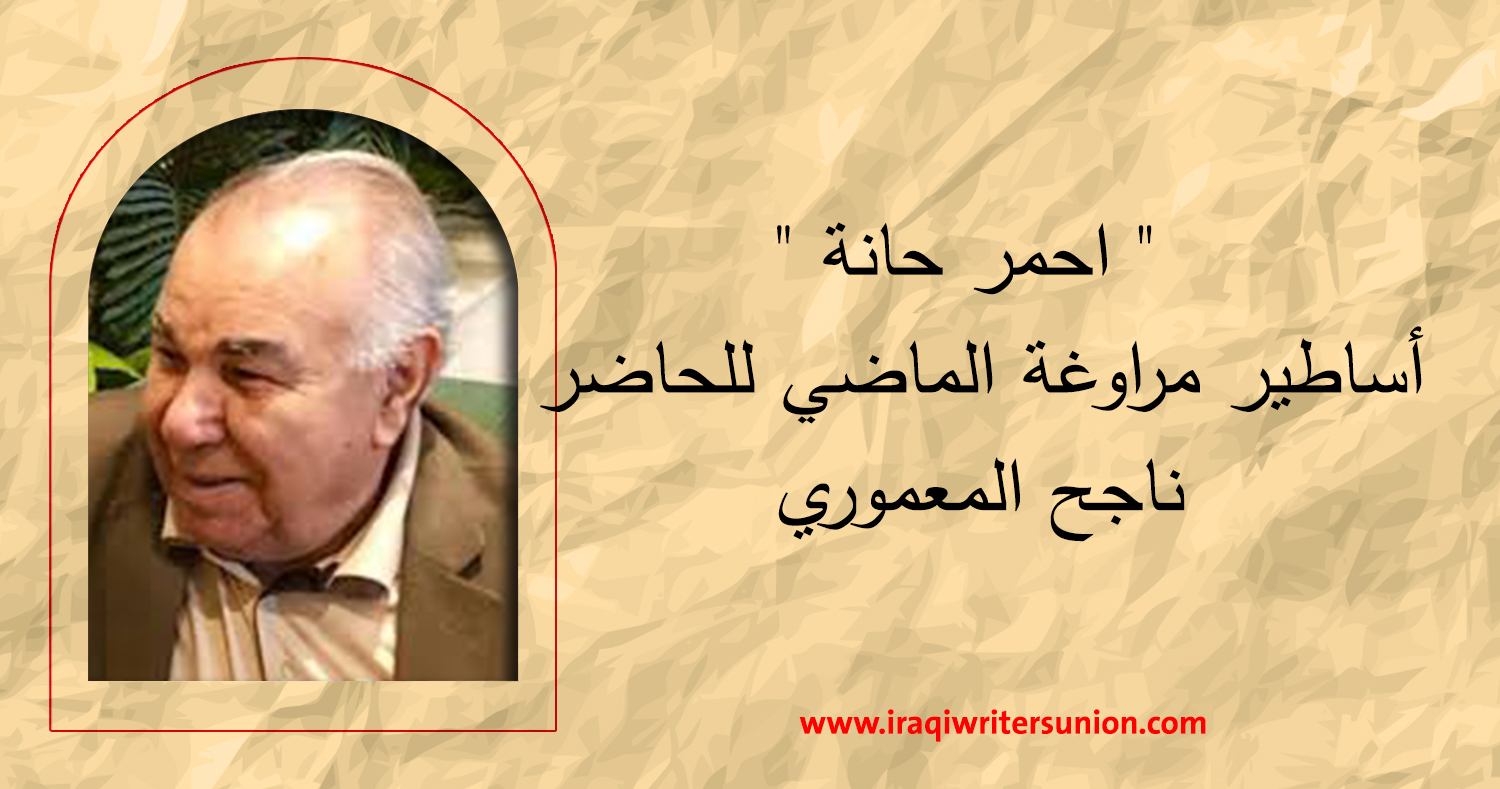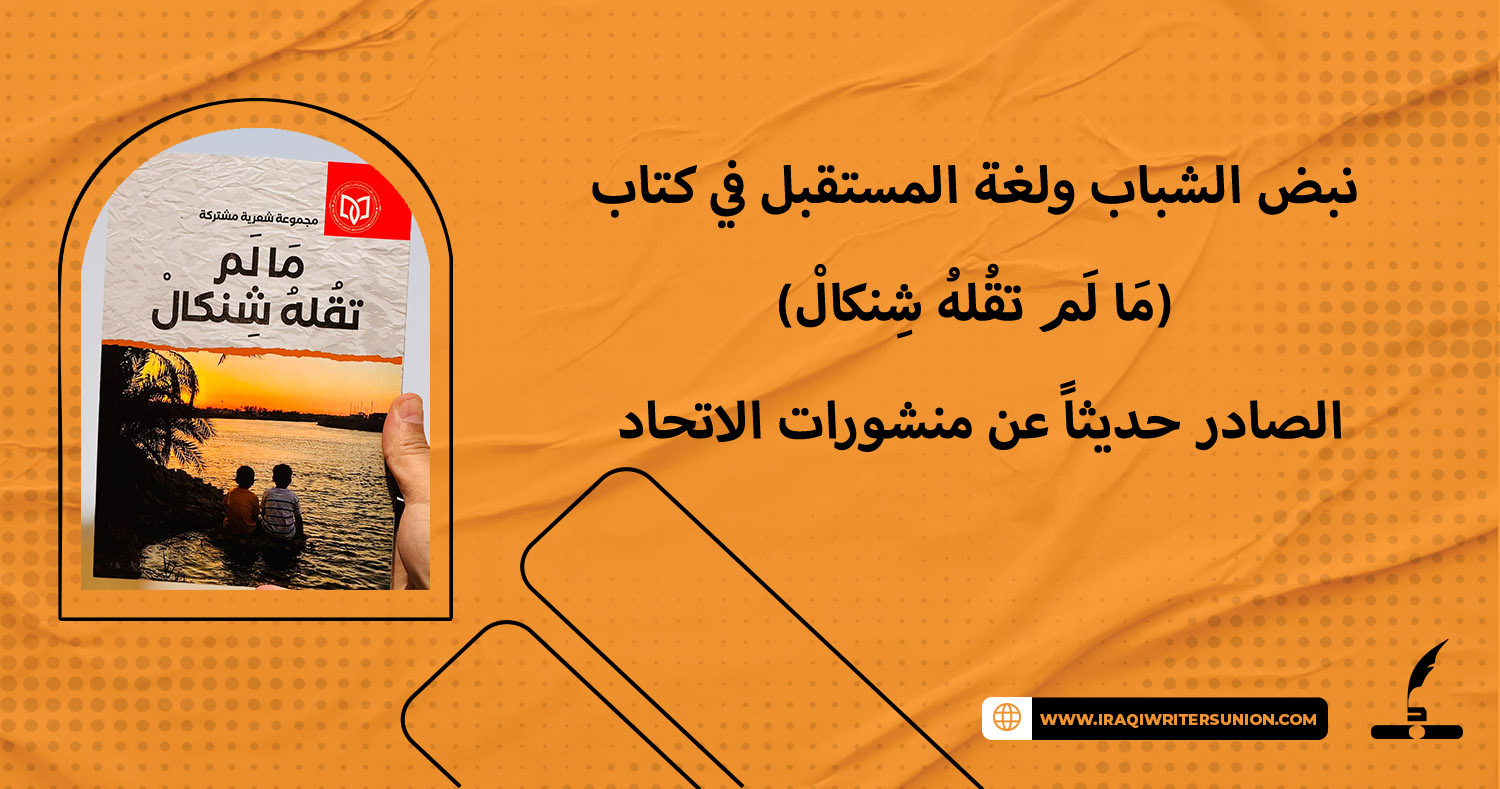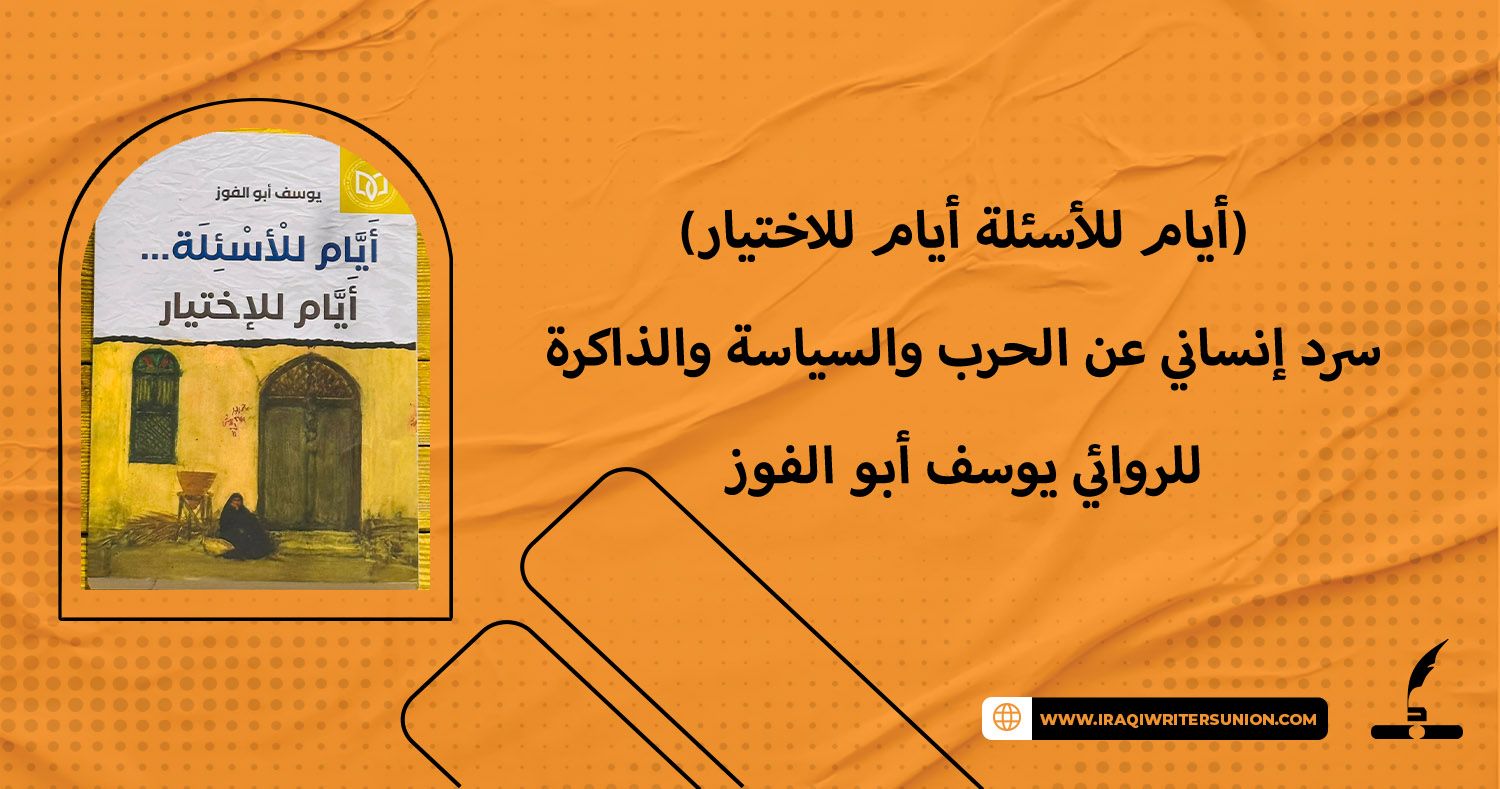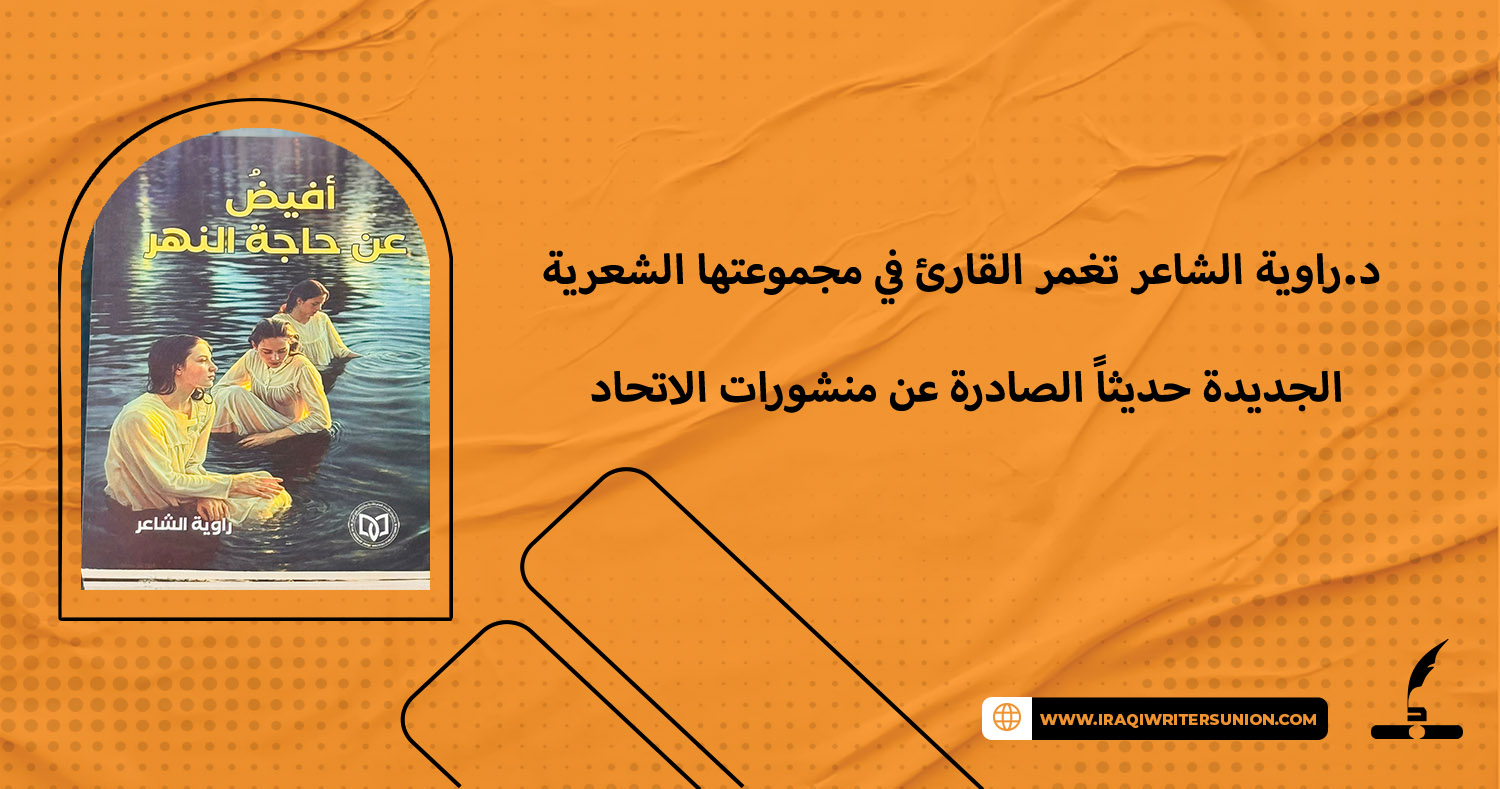النقد بين دعامتين ..
أسئلة الحاضر وهواجس المستقبل
مع الناقد الدكتور محمّد سالم سعد الله حاوره رئيس التحرير
الهاجس الأكثر حضورًا في ذهنيّة الناقد العربيّ يتمثّل بين ترقّب وإدراك ، إدراك الحاضر بغنىً ، وترقّب الآتي بقلق مشوب .. لم يتخطّ الناقد العربيّ هذا الزمن المتأرجح ، ولذلك قاس وقايس كلّ النظريّات النقديّة التي تمثَّلها وفق هذا المنطق . وسواء كان الميل إلى الإدراك أكثر وضوحًا من الميل إلى الترقّب ، فإن النتيجة التي أفضى إليها لم تكن بعيدة عن دائرة إشكالات الثقافة العربيّة الراهنة ، وهي إشكالات تتجذّر وتمتدّ بلا حلول .
الترقّب والإدراك خاصيّتان فلسفيّتان نقديّتان ، لكنّهما لا يعملان وفق منطق المغايرة المقطوعة عن سياقها ، أقصد السياق المعرفيّ المتكامل ، وهذا ما يلاحظه أيّ متتبّع لخطوط النقديّة العربيّة حين يدقّق في مجمل مساراته . اتّسع النقد بدوائره حتّى تولّدت منه دوائر أعمّ لكنّها دوائر مازالت تحتاج إلى الكثير من المساءلة ، والعميق من الأسئلة التي تنطلق إلى الداخل لا إلى الخارج ، تنمّي إدراكًا لتصنع ترقّبًا ، تجابه المقولات لا تحتمي بها ..
هذا الهاجس هو الذي انطلقت منه الأديب العراقيّ في إثارة هموم العقل النقديّ العربيّ في حوار مع الناقد والأكاديميّ الدكتور محمّد سالم سعد الله ، الذي شغلته أسئلة النقد والمعرفة ، وأبانت اجتراحاته النقديّة عن مشروع معرفيّ يضع النقد بوصفه مسارًا فلسفيًّا لا نتاجًا لاحقًا للنتاج الأدبيّ .
أوّلاً : أكثر من مئة سنة مرّت على ما يمكن أن نطلق عليه النقد العربيّ الحديث ، وعلى امتداد هذه المدّة وعلى ما شهدته من تحوّلات كبرى ، بقيت تلازمه (الأزمة) كما كتب نقّاد كثيرون في ذلك. ترى أهي أزمة نقد أم أزمة ناقد ؟ . ويرتبط بذلك أيضًا سؤال : كيف يمكن تحديد مشكلات النقد الأدبيّ الآن؟. بناءً على معطيات الحاضر أم على توقّعات القادم؟.
في البدء وقبل الشروع في تقديم رؤانا وقناعاتنا عن طبيعة الأسئلة المقدّمة المكتنزة همًّا نقديًّا، ووعيًا علميًّا بمسارات التشريع النقديّ ، ومعطيات التنفيذ المنهجيّ ، يمكن القول : إنّ مسيرة البناء المعرفيّ في الجوانب الحياتيّة كلّها بشكل عامّ ، والبناء النقديّ بشكل خاصّ ، لا تكتمل تنظيرًا ، ولا تزدان تطبيقًا إلّا بعد صياغة منظومةٍ واعيةٍ من الأسئلة المشروعة في مساءلة الراهن ، وفحص الماضي ، والتطلّع إلى المستقبل ، لأنّ غياب الأسئلة هو غياب للرؤى وتطلّعاتها ، وحضورها مرتبطٌ بالاستعداد الفكريّ للقابل من الزمن.
يمثّل السؤال الأوّل أطروحةً متكاملةً من مساءلة المنجز النقديّ العربيّ الحديث ، ومعرفة قيمة التحوّلات التي رافقت خطاباته ومقولاته ومساراته في جوانب كثيرة ومتعدّدة ومختلفة متعلّقة بمنطلقاته وغائيّاته وقصديّاته، وتمثّل الإجابةُ عن هذا السؤال الحديثَ عن مداخل ومخرجات ومعالجات عدّة ، إذ تتعلّق المداخل بالمغذّيات التي استقى النقد العربيّ الحديث مادّته منها ، وبالمرجعيّات التي تأثّر بها ، وتفاعل معها ، وتبنّى طروحاتها ، وقد أسهمت هذه المغذّيات والمرجعيّات بشكل فاعل في المسيرة النقديّة وتحوّلاتها ، وصاغت جملة من المشاريع الفكريّة التي أرّقت الفكر العربيّ طيلة عقود خلت ، ولم تكن هذه المشاريع ـ بطبيعة اشتغالها المتحيّزـ ذات وسطيّة منهجيّة في التعامل مع المستجدّات النقديّة ، أو الظواهر الحداثيّة ، وانشغل النقّاد الذين تجمعهم (البيئة العربيّة) باختصار الهمّ النقديّ والإشكال الفكريّ في ثنائيّات إشكاليّة وجدليّة عدّة من قبيل : (المقدّس والمدنّس ، التراث والحداثة ، الأصالة والمعاصرة ، الموروث والتجديد ، المنجز والوافد ، العربيّ والغربيّ) ، وأصبح المسار النقديّ ـ آنذاك ـ مرسومًا بين : (افعل، ولا تفعل)، بدلاً من أن يكون نهجًا من الخصائص بين : (احكم، ولا تجزم).
وإذا كانت تلك المداخل قد شغلت هذه الرقعة الفكريّة الإشكاليّة من مسيرة النقد العربيّ الحديث ، فإن مخرجات هذا النقد قد اصطبغت بإشكاليّات أكبر ، انطلاقًا من إشكاليّة التنظير والتطبيق ، مرورًا بإشكاليّة المنهج والتحليل ، وليس انتهاءً بإشكاليّة الاصطلاح والترجمة ، ولكلّ من هذه الإشكاليّات دوره في أزمة معيّنة من الأزمات التي رافقت مسيرة النقد العربيّ الحديث.
أمّا المعالجات فكانت نسبيّةً ، ولم تقدّم خارطة طريق ناجعة للتخلّص من الإشكاليّات ، وذلك بسبب الاختلافات الفكريّة للنقّاد، والتنوّعات الثقافيّة لهم ، والسلطة البيئيّة التي كانت تمارس دورًا مهمًّا في صياغة الخطاب النقديّ ـ غالبًـا , ولذلك فإن (الأزمة النقديّة) التي رافقت مسيرة النقد العربيّ في القرن العشرين هي أزمة وجود ، وأزمة هُويّة ، قبل أن تكون أزمةً منهجيّةً ، والبحث عن كلّ شيء له صلة بالصفة العربيّة : موروثًا أو إحياءً أو تجديدًا ، أمّا في القرن الحادي والعشرين فإن أزمة النقد العربيّ ـ وبشكل جليّ ـ لا تتعلّق بالهُويّة والبحث عنها وملاحقتها ، بقدر تعلّقها بالأداء التحليليّ والجماليّ والفنيّ والتأثيريّ والجماهيريّ ، وبقدر الانفتاح على التوجّهات العالميّة الفكريّة منها والتقنيّة.
وبين المداخل والمخرجات والمعالجات السابقة ، ثمّة سؤال يختصر تلك المسافات كلّها ، ويؤرق المشتغل في هذا الميدان : هل هناك حقيقة معرفيّة لما اصطلح عليه : (النقد العربيّ الحديث) في الدراسات النقديّة والأكاديميّة ؟ ، وإذا كان هذا الاصطلاح واقعًا متداولاً ، فهل هو اشتغال بيئيّ ، أم هو رابط لغويّ ، أم إبداع نصيّ، أم تحديد منهجيّ؟ .
ما أراه أنّ استخدام اصطلاح (النقد العربيّ الحديث) هو ممكنات تحليليّة ووصفيّة تنتمي إلى البيئة العربيّة ، وتزدان بصياغة لغويّة عربيّة وحسب ، إذ لا يمتلك هذا التحديد ملامح خصوصيّة ذات بصمة واضحة ، ولا طرائق منهجيّة ذات فرادة اشتغاليّة ، وذلك لأنّه يمثّل تكتّلات تراتبيّة لمجموعة من المقولات الغربيّة ومناهجها ومرجعيّاتها وتحيّزاتها ، فضلاً عن ارتباطه بالسلطة الثقافيّة والأكاديميّة التي نتج عنها أحكام (مُدجّنَة ومهجّنة) ، وأصوات أحاديّة ـ في هذا البلد أو ذاك ـ لم تشكّل ظاهرةً نقديّةً عربيّةً حديثةً بقدر تشكّلها وانتسابها لناقد معيّن ، وهذا الأمر نتيجة طبيعيّة لمآلات تطوّر النقد ، وأبجديّات تكوينه ، وارتباطه بالظاهرة الحضاريّة ، إذ يعدّ النقدُ منظومةً من الأحكام العلميّة والمنهجيّة المرتبطة عضويًّا بالفاعل الحضاريّ والأسّ الفكريّ المصاحب له ، فينتعش بازدهاره ، ويضمحلّ بأفوله ، والعرب اليوم يستندون على منجزات الآخر بوصفها الملاذ المعرفيّ ، ويعتمدون على الناتج الحضاريّ له بوصفه خلاصة ما وصل إليه الاشتغال العقليّ ، لذلك فإن توقّعات القابل من المسيرة النقديّة العربيّة الحديثة ستكون مؤلمةً ، إذ ستغدو أكثر انفصالاً عن هُويّتها، وأكثر انفصامًا عن موروثها.
ثانيًا : الطبيعيّ أنّ كلّ نقد تنتجه سياقات التفكير السائدة. إذا اقتنعنا بهذا ، هل يمكن أن نقول إنّه السبب نفسه الذي يجعل النقد العربيّ الحديث متأخّرًا عن الغربيّ؟ .
إن إجابة هذا السؤال مرتبطةٌ بشكل كبير بإجابة السؤال الأوّل ، ولنا في هذا الميدان وقفتان اثنتان هما : (المرجعيّة الفكريّة للنقد العربيّ ، والمسيرة المنهجيّة للنقد الغربيّ) ، والوقفتان كلتاهما تمثّلان مقارنات على مستويات عدّة ، أهمّها الناتج الفكريّ الحضاريّ وأثره في مجمل النشاطات الإنسانيّة ، فالكتابة عن تراجع النقد في بيئة معيّنة ، وتطوّره في بيئة أخرى هو حديث عن سياق الفكر المصاحب للمسيرة النقديّة ، ويكون هذا الفكر مرتبطًا بالواقع الحضاريّ الذي تعيشه الأمّة ، وعليه فإن مسيرة النقد العربيّ اليوم تعدّ متأخّرةً عن التطوّر النقديّ العالميّ بسبب غياب الناتج الحضاريّ الفاعل في البناء الفكريّ الحيويّ من حيث الخصوصيّة المنهجيّة ، والطرائق التحليليّة ، والأولويّات المعرفيّة ، والنماذج الإبداعيّة ، وأصبح الناتج النقديّ العربيّ مرهونًا بما يقدّمه الآخر من معطيات (التنوير) النقديّ ، وتحيّزاته ومنجزاته ومنطلقاته .
ولا يخفى أن المسيرة النقديّة العربيّة في عصور خلت كانت مفعمةً بالناتج الحضاريّ الفاعل المرتبط بالواقع المعرفيّ الإسلاميّ ، ومنتشيةً بالمرجعيّات الفكريّة التي أسهمت في تغذية الدرس النقديّ وانبثاق نظريّاته ، وتطوّر أدواته ، وكانت الحوارات العلميّة بين المسار النقديّ والمسارات والعلوم والمعارف الأخرى تترى في منظومةٍ معرفيّةٍ إسلاميّةٍ واحدة ، وعندما تراجعت هذه المنظومة بفعل التغيّرات التاريخيّة الحتميّة ، استجدّت فواعل حضاريّة أخرى ، وتطوّرت عوامل فكريّة عدّة ، أسهمت في ولادة مسيرة نقديّة جديدة ذات تصوّرات فلسفيّة متراكمة ومتوالية في الحضارة الغربيّة ، بدءًا من الأسّ الأفلاطونيّ والأرسطيّ ، مرورًا بعصور التنوير والنهضة والحداثة ، وليس انتهاءً بعصر ما بعد الحداثة وكشوفات التقنية والمعلوماتيّة وما يرتبط بها وما يتفرّع عنها ، لذللك غدت المسيرة المنهجيّة النقديّة الغربيّة الحديثة ، مقارنةً بالنقديّة العربيّة الحديثة ، معرفةً تُتحذّى ، وطرائق تُتبنّى ، ومناهج تُطبّق ، ومرجعيّة تُستدعى.
ثالثًا : أُثير سؤال كبير حول تراجع دور الناقد بعد أن أصبح للجمهور دور فاعل في تذوّق النقد وإمكانيّة التعليق على الكتابات الإبداعيّة ، ومشاركة المؤلّف أو حتّى يمكن القول الترويج للنصّ. إذ لم يعد الناقد مالكًا لزمام المبادرة ، وأن زمان الناقد بوصفه الحكم الفيصل الذي يحدّد ذائقة الجمهور قد ولّى كما يقول ( ماكدنولد ) بعد أن انتقلنا من ثقافة المراجع إلى ثقافة المدوّنات. كيف ترى الأمر ؟ .
تشير الكشوفات النقديّة لنظريّات التلقّي أنّ أساس العمليّة الإنتاجيّة للعمل الإبداعيّ يكمن في تصوّرات القارئ وممكنات تأويله ، وأصبح للقارئ ـ وفقًا لذلك ـ مساحة تأويليّة لإدراك المعاني ، وكشف الدلالات ، وبيان الجماليّات ، وإعادة إنتاج النصّ ، وليس ذلك وحسب ، بل تعدّى الأمر إلى تصنيف القارئ على : (قارئ نموذجيّ ، وقارئ ضمنيّ ، وقارئ متخيّل) ، وعلّة ذلك أن كشف المعاني والدلالات أصبح مرتبطًا بخبرة القارئ ، ومرهونًا بوعيه وحمولاته الفكريّة والمعرفيّة ، فكلّما زاد وعي القارئ وتنوّعت ثقافته وكثرت مرجعيّاته ، اتّسعت رؤيته ، واتّضح قصده ، وبان فهمه .
هذا الاستهلال سيكون ضروريًّا إذا أدركنا أن فعل إنتاج القارئ الرصين ـ نقديًّا ومعرفيًّا ـ ليس فعلاً استهلاكيًّا ، ولا مطلبًا شعبويًّا ، ولا استدعاءً جماهيريًّا ، بل هو حاجةٌ ثقافيّةٌ ، ورغبةٌ منهجيّةٌ ، يحدّدها المختصّون والمعنيّون بالهمّ النقديّ ، والعارفون باحتياجاته وتطلّعاته ، لذا فالقارئ ـ عندنا ـ هو الناقد النموذجيّ العارف بتحليل طبقات النصوص ، وبتأويل المسكوت عنه فيها ، وبتعليل قصديّاتها وكشف مراتبها ، وبيان جماليّاتها وفقًا لعقلانيّة تنويريّة مزدانة بمرجعيّة فكريّة .
أمّا ما يخصّ (الجمهور) في التعليق على النصوص الإبداعيّة ، فلا مقارنة موجودة عندي بين الجهد المعرفيّ الكبير الذي يقوم به الناقد المنهجيّ بوصفه القارئ النموذجيّ للعمل الإبداعيّ المزدان بفواعل : (التحليل ، والتأويل ، والتعليل) ، وبين ذائقة الجمهور القلقة والخاضعة لعناصر : (التغيير، والتبديل ، والتحريف) تبعًا لمستجدّات العصر وظواهره ، فإذا كان عصر التفاهة ـ حسب تعبير الناقد ألان دونو ـ الذي نعيشه اليوم قد خيّم بأحكامه وتعليقاته المزاجيّة على ترويج بعض النصوص الهجينة ، فإن النقديّة الرصينة ستزيح نماذج ادّعت الإبداع ، وأساءت للاتّزان الفكريّ الإنسانيّ ومشاعره النبيلة ، وسيمتلك الناقد الرصين ـ مرّة بعد مرّة ـ زمام المبادرة والإبداع والاحتراف ، وسيتحوّل الإشهار الثقافيّ من ثقافة المدّونات الاستهلاكيّة : (هذا ما يطلبه الجمهور) ، إلى ثقافة المعطيات المنهجيّة : (هذا ما يقدّمه الناقد) .
رابعًا : هل أسهم النقد الأكاديميّ بتراتبيّته وإشكالاته بتغيير بوصلة النقد وإحباط تطلّعاته؟ .
لم يبقَ للنقد الأكاديميّ اليوم سوى مُخرجات عمليّة كميّة لا كيفيّة ، واجترارات علميّة لا تستدعي معرفةً نوعيّةً وإبداعيّةً ، باتت أسيرة التقييد والتقليد ، وأضحت مكبّلةً ـ غالبًا ـ بالمتطلّبات المؤسّساتيّة التي تديرها (عقول مكتبيّة) لا تعرف حيويّة الواقع الإبداعيّ ، ولم تدرك طبيعة الاشتغال العالميّ المتسارع تطويرًا وإنتاجًا ، ونتيجة لما آلت إليه توجّهات النقد الأكاديميّ وواقعه ، بشّرتُ في مناسبات عدّة بـ(المرحلة النقديّة لما بعد الأكاديميّة) بوصفها مجموعة من الفرضيّات والتصوّرات والرؤى المستقبليّة التي ترسم صورة واقع النقد المتجاوز لأطره التنظيميّة والرسميّة ، والمنفتح على فضاءات من الإبداع المحاوِر للعلوم والمعارف المتنوّعة ، والمتمسّك بحريّة الاشتغال الفكريّ دون نسق سلطويّ يرسم له حدودًا معيّنة ، فـ(النقد ما بعد الأكاديميّة) هو كشف منهجيّ رصين للتصوّرات الاستشرافيّة ، والرؤى التنظيريّة ، والافكار الذهنيّة المستقبليّة ، والتوقّعات الإبداعيّة التنبؤيّة.
وانطلاقًا مّما ذُكر أكّدتُ ـ في مناسبات عدّة ـ أنّ بوصلة النقد في ميدان الأكاديميّة ، ستبقى آمنة ثابتة مطمئنّة سكونيّة ، لا يأتيها التغيير لا من بين يديها ولا من خلفها ، لذلك بات من الضروريّ تفعيل خارطة جديدة للنقد ، وانتشاله من أروقة الوصفيّة والتقريريّة ، والانتقال به من الدراسات الأكاديميّة إلى الدراسات ما بعد الأكاديميّة ، ومن الكميّة إلى الكيفيّة ، ومن التجريديّة إلى الإنتاجيّة ، ومن القواعديّة إلى التحديثيّة.
وقد نال النقد الأكاديميّ حظًّا وافرًا من اشتغالات المفكّرين والنقّاد الغربيّين المحدثين انتقادًا ونقاشًا وبيانًا ، وأكّدوا في معرض حديثهم عن مجمل النشاط الإبداعيّ الفكريّ منه والنصيّ ، أنّ مسيرة النقد الأكاديميّ لم تكن سوى مرحلة عانى منها النقد الحديث كثيرًا ، ولم ينتج عنها إلا معرفة مناسبة للأطر المنطقيّة والتنظيميّة اللازمة لضمان بقاء المؤسّسة الأكاديميّة ، التي ستبقى مرتبطة بنيويًّا ونسقيًّا بكلّ الإشكاليّات المصاحبة لدراسات النقد الأكاديميّ ، ويبقى الناتج الإبداعيّ مرتسمًا بجهود فرديّة بعيدة عن سلطة المؤسّسة وإجراءاتها .
خامسًا : ما يلفت النظر في مشهدنا الثقافيّ العربيّ بشكل عامّ ، اتّساع نشر الكتب والبحوث والمقالات النقديّة ، وبالمقابل انحسار النقد وشحوب الذائقة ؟ مفارقة .
يمثّل انحسار النقد وتراجع الذائقة العلميّة الرصينة للنصوص ظاهرةً عالميّةً ، وليست مخصوصةً بالبيئة العربيّة وحسب ، لأن الواقع المعيش الآن فرض طرائق جديدة للتعامل مع النشاطات الإنسانيّة والأنشطة الذهنيّة المصاحبة لها ، وأصبحت معاني الشذوذ ، والفوضى ، والتفاهة ، والاستهلاك ، وتراجع القيم ، وتماهي المقاصد ، مسارًا لحياة معاصرة يتزعّمها الهامشيّون والمهمّشون والجهلاء والشاذّون ، الذين أسهموا وبشكل فاعل في تفاقم ظاهرة جديدة أطلقُ عليها : ظاهرة (النفايات الفكريّة) التي سوّقتهاـ وبشكل متسارع ـ وسائل التواصل الاجتماعيّ ، إذ منحت منبرًا إعلاميًّا ومساحةً نصيّةً لمن لا يحسنون كتابة أسمائهم ، وأصبحوا يعبّرون ويتحدّثون وينتقدون دون أيّ واعظ أو رقيب ، لذلك لم تستطع حركة النشر العلميّة الرصينة أن تواكب هذا التسارع الخطير لتراجع الذائقة وانحسار الأحكام المُجوّدة في قراءة النصوص المكتنزة بالمعاني والدلالات ، وأصبحت النصوص المهيمنة على المشهد الثقافيّ ـ بشكل ملحوظ ـ هي النصوص فارغة المحتوى ، تافهة القصد ، عديمة القيم ، متجاوزة الخلق ، مفكّكة الدلالة ، راغبةً باستدعاء الاعجابات والمشاركات والتعليقات ، وموغلةً في الأحاديث التي لا تسمن ولا تغني .
هل يمكن أن يكون هذا الواقع ( مفارقةً ) ؟ .
لا يخفى أنّ ما يحصل اليوم من تغييب متعمّد للمسارات النقديّة والعلميّة والمنهجيّة والمنطقيّة ، والتركيز على تسويق النتاجات الخارجة عن التفكير الإنسانيّ المتّزن ، هو إفراز مقصود لإشاعة ثقافة الجهل ، وتقديم سرديّات ما بعد الحداثة بوصفها النموذج المُحتذى للتعبير عن الإنسان وما يحيط به ، ولهذه السرديّات أبعاد سلوكيّة في تسطيح النقد وتفريغه من محتواه ، وفي البعد عن اللغة التي تسهم في تنمية الذائقة النقديّة ، وقد أسهم هذا في ضعف قيمة المنشور بوصفه كتابًا أو مقالة أو بحثًا أو دراسة ، وبروز النشر التقنيّ السريع من تغريدات وتعليقات ومشاركات ، لذلك فلا مفارقة موجودة عندي في وصف كثرة النشر على تنوّعه ، وانحسار الذائقة على اختلافها ، لأنّ السلوكيّات واحدة ، والمخرجات واحدة ، ونتائجها واحدة.
سادسًا : هل يسهم النقد اليوم بإثراء العقل والمعرفة ؟ . أعني تحديدًا : إذا كان النقد في مرحلة الحداثة مشغولاً بهمومها ، وبما يتناسب مع طبيعة التفكير آنذاك. هل يحقّق الفعل نفسه ونحن نعيش تحوّلات ما بعد الحداثة ، ونتطلّع إلى بعد ما بعدها؟ .
نعم يسهم النقد بإثراء النشاط العقليّ ، وتحفيز الثراء المعرفيّ إذا كان يحمل همًّا ثقافيًّا ، ورسالة حضاريّةً تزدان بمرجعيّةٍ ذات خصوصيّةٍ منهجيّةٍ ، وهُويّة واعية بالإشكاليّات والأزمات التي تعتري مسيرته ، وقد أسهم الفعل النقديّ عبر عصوره المختلفةـ عربيًّا وغربيًّاـ بولادات قيميّة ، وكشوفات جماليّة ، أثرَتْ قراءة النصوص على صعيد التحليل ، وحقّقت التفاعل والتأثير على صعيد التلقّي.
ولا يمكن الحديث عن ممكنات الثراء النقديّ جملةً واحدة ، إذ كان لكلّ عصر من عصور المعرفة مساراتٌ علميّة وبيئيّة ونسقيّة أسهمت بشكل فاعل في المعطيات النقديّة ، وقد أدّى التسارع المعرفيّ في الميدانين : التجريديّ والتجريبيّ إلى تسارع الحركة النقديّة بنظريّاتها ومقولاتها وتحليلاتها ، وإذا كانت مرحلةُ التنوير والنهضة مشغولةً بتحقيق ذاتيّة الناصّ والإعلاء من إبداعه ، فإن مرحلة الحداثة عُنيت بتحقيق ذاتيّة النصّ وبيان جماليّاته ، وفي المقابل عُنيت مرحلة ما بعد الحداثة بمنظومة التلقّي ، ومنحت القارئ سلطاتٍ واسعةً في ترميم النصوص ، وملء فجواتها، وتحقيق انسيابيّتها ، وإعادة إنتاجها ، وفق المساحات الثقافيّة ، والخبرات الفكريّة التي يمتلكها المؤّول ، حتّى بات النصّ ميدانًا للتجريب التأويليّ ، وممارسة للتجريد الذهنيّ في كشف القصديّات.
ولم تكن مرحلةُ ما بعد الحداثة المرحلةَ النهائيّة في الثراء النقديّ ، إذ يتطلّع المشهد النقديّ اليوم إلى محاورة العلوم والمعارف والتقنيات ، وكشف آفاق جديدة تسهم في تقديم قراءات عصريّة ، وهذا ما تمّ فعلاً ، إذ بدأنا نشتغل على مساحات نقديّة جديدة أغنت الفعل النقديّ من قبيل : (النقد البيئيّ ، والنقد البينيّ ، والنقد التفاعليّ ، والنقد المعرفيّ ، والنقد الاستشرافيّ ، والنقد الحضاريّ ، والنقد ما بعد النصيّ ، والنقد القيميّ ، ...)، والملاحظ على هذه الاشتغالات النقديّة كلّها اتّساع الرقعة المعرفيّة التي تعالجها ، وشموليّة السياقات الفكريّة المضمّنة فيها ، وانتماء التشكيلات الواردة فيها إلى أكثر من ميدان علميّ ، وهذا يحقّق ثراء المشهد النقديّ ، ويقدّم قراءاتٍ جديدةً مناسبةً للتطوّرات الحاصلة والمؤثّرة في ولادة النصّ ، ويدعم تنمية المنهجيّة النقديّة ، ويسهم في تطوّرها.
سابعًا : يتوقّف النقد عادة لا ليشرح ما يقوله النصّ وإنّما ما يمكن أن يقوله ، بمعنى أدقّ ليفكّر ويقترح طريقة تفكير في النصّ ، ما معناه إنّه يرتبط بالفلسفة وهي مرتبطة به فكما يقول (دولوز) : "لا يمكن للفلسفة سوى أن تكون نقدًا ". هل ترى هذا الشرط متوفّرًا في نقديّتنا المعاصرة؟ .
وجد النقد في المرجعيّة الفلسفيّة مادّةً غنيّةً ثرّة بالتصوّرات العقلانيّة ، والمقاربات المنطقيّة ، وأصبحت الفلسفة بوصفها صانعة الأفكار مَعينًا مهمًّا نهلَ النقدُ منه واستقى من معطياته ، والنقد بوصفه صائغ التنظير الأدبيّ ومحلّل النص الإبداعيّ ، أصبح وجوده مرهونًا بقوّة الفلسفة المتبنّاة ، فكلّما كان الأسُّ الفلسفيّ للمعطى النقديّ راسخًا ومقنعًا ، كان المنجز النقديّ أكثر حضورًا وتداولاً ، لذا تتجسّد عناية الفلسفة في البحث عن الحقيقة ، وبيان القيم ، وإثارة الأسئلة لتحفيز الاشتغال العقليّ ، وقد انتفع المسار النقديّ في تبنّي الهمّ الفلسفيّ ، ووظّفه في الكشف عن الدلاليّ والجماليّ ، وإذا كانت المباحث الفلسفيّة هي النواة المعرفيّة لبناء الظاهرة الحضاريّة ، فإن المسيرة النقديّة مثّلت التجربة الحضاريّة ومعطياتها في الوعي الإبداعيّ تحليلاً وتأويلاً ، وقدّمت إمكانيّاتها المنهجيّة في كشف قصديّات النصّ وطرائق تفكيره ، وأيّ استحضار لروّاد المنظومة النقديّة عربيًّا أو غربيًّا، قديمًا أو حديثًا ، سيثبت أنّ المنجز النقديّ بنظريّاته وأحكامه وتحليلاته وكشوفاته ، كان مستنداً على أساس فلسفيّ ، أو منبثقًا من معيار فكريّ .
ولا يخرج عن هذه المنظومة الحتميّة إلا ثلاثة أصناف من النقد : (النقد التافه ، والنقد الفاشل ، والنقد الفاسد) ، الصنف الأوّل لا يستند إلى أيّة أدوات أو آليّات منهجيّة في التحليل، ويمثّله من لا يُحسن قراءة النصّ ، ولا يُدرك الاختلاف المنهجيّ وتنوّعه ، ولا يتبنّى طريقة معيّنة للتفسير والبيان والتوضيح ، ولا يمتلك فهمًا دقيقًا للمعاني ، غايته المجاملة أو الشهرة ، ويشير الصنف الثاني إلى النقد التقليديّ ذي الفكر الساكن ، والتحليل المجترّ ، والوصف المكرّر ، غايته الحفاظ على إرث النقد ، وإرضاء المؤسّسة ، والركون إلى الجاهز، وغايته ـ غالبًا ـ الحصول على شهادة ما!! ، أمّا الصنف الثالث فهو الأكثر انتشارًا اليوم لأنّه معنيٌ بمدح السلطات ، ودراسة النكرات ، والإعلاء من العاهات ، وتزيين القبيح ، وتقبيح الرصين ، وتشويه الحقائق ، وشراء الأقلام ، وتحقيق المنفعة الماديّة حتّى ولو كانت على حساب الرصانة والجودة والإبداع الحقيقيّ ، ويمثّله بعض المنتمين إلى بيئة غير بيئتهم الأولى ، وبعض المنتسبين إلى هُويّة مهجّنة غير هُويّتهم ، ولن ترجع هُويّة النقد القيميّ إلا بعد إبعاد (التافه ، والفاشل ، والفاسد) عن العمل النقديّ.
ثامنًا : أظهر الكثير من النقّاد (دعاوى) أن النقد الثقافيّ هو آخر محطّات النقد وإلى ما غير ذلك ، لكن تحوّلات المعرفة تعدّته ولربّما سيكون في وقت لاحق جزءًا من تاريخ . والآن ننشغل بالنقد المعرفيّ . هل تؤشّر بوصلة النقد لاتّجاه يلوح في الأفق ؟ .
في البدء لا يمكنني الاطمئنان إلى حديث بعض النقّاد المحدثين عن أولى محطّات النقد أو آخر محطّاته ، إذ لا بداية ولا نهاية في الأسهم النقديّة ، لأنّ النتاج النقديّ هو حياةٌ منهجيّةٌ حيويّةٌ لا تتوقّف ، والحديث عن نهايتها هو حديث عن موتها ، والحديث عن موتها هو حديث لا يمتلك الدقّة ، لأنّ الخصائص النقديّة متغيّرة ومتحوّلة بين سابق ولاحق ، بين مرجع ومغذٍّ ، بين مُنجَز ومُكمّل ، إنها دورةٌ حياتيّةٌ متكاملةٌ ، فبدلاً من الحديث عن أوّليّات النقد ومنتهاه ، يمكن الحديث عن أولويّات النقد وشموليّته واستجابته للتحوّلات العصريّة في ميادين عدّة .
عانى النقد الثقافيّ منذ ظهوره وهيمنته على الساحة النقديّة العربيّة منها والغربيّة من فجوات علميّة ، وتناقضات عمليّة ، وإشكاليّات منهجيّة وتحليليّة ، إذ حصر مجمل اشتغالاته على البحث عن النسق المضمر، وبيان القبحيّات ، وقدّم منجزه بوصفه البديل الأفضل لتمثيل مسارات الجهد النقديّ عبر الدعوة إلى نهاية النقد الأدبيّ !! ، لذلك لم يُكتب لهذا النقد الشيوع والاستمراريّة ، وأصبح مكتفيًا ببعض الدراسات النقديّة التي حاولت مقاربة مقولاته وتطبيقها على النصوص التراثيّة والحداثيّة.
لقد أساء النقد الثقافيّ قراءة النصّ من حيث اختزال منظومته اللغويّة والسياقيّة إلى نسق مضمر ، أو مجموعة أنساق ، ونقل النصّ من ثراء الدلالات والجماليّات ، إلى ميدانٍ لكشف الأنساق المهيمنة والقبحيّات ، وقد صرّح بعض النقّاد بـ(تهافت النسق) ، وعدم قدرته على الخروج بقراءات مقنعة تعالج خفايا النصّ وتكشف معانيه ، لذلك لم يزدن النقد الثقافيّ بالاستقرار المنهجيّ ، ولا بالتكامل النظريّ من حيث: (صياغة الافتراضات ، وصناعة المفاهيم ، وتوليد المصطلحات).
وإذا كان النقد الثقافيّ يبحث عن الأنساق المضمرة في منظومة النصّ ، ويختزل الجهد الإبداعيّ في وحدات معرفيّة مرجعيّة تمثّل مظهرًا ثقافيًّا ببيئة محدّدة ، فإن النقد المعرفيّ تجاوز الرؤية الاختزاليّة للنصّ إلى وعي شموليّ يتّسع لبيان منظومة النصّ الحضاريّة والإنسانيّة.
فالنقد المعرفيّ مسارات منهجيّة ، وتحديدات قيميّة ، متعلّقة بإمكانيّات التحليل في كشف حُجُب النصّ ، ويمتلك قيمًا فكريّة ومنهجيّة برؤى شموليّة وتعدّديّة وحواريّة بين العلوم والمعارف كلّها ، منها: (الفلسفة ، وعلم النفس ، وعلم الأعصاب ، ونظريّات الوعي ، والتحليل الاجتماعيّ ، وبحوث الإدراك ، ودراسة السلوكيّات ، والأنثروبولوجيا، ...) ، فضلاً عن أن له القدرة على إعادة تشكيل الدراسات النقديّة والأدبيّة ، لا سيّما وأنّ هذا النقد ينهض على نتائج الدراسات البيولوجيّة في الاستدلال وبناء المعنى عبر متابعة الأنشطة الإدراكيّة للعقل.
إن المرجعيّات المنهجيّة للنقد المعرفيّ هي مرجعيّات إنسانيّة بالدرجة الأولى ، وما يتعلّق بها من معطيات ثقافيّة وحضاريّة ومعرفيّة واجتماعيّة ومنطقيّة وبيئيّة ، هو إمكانيّات قرائيّة وتواصليّة لا حدّ لها في إطار من المعرفة الشموليّة التي تبغي الدقّة في التحليل ، وتتوخّى القصد في تحديد المعنى ، وتُعنى بالمسؤوليّة في تقديم المفاهيم ، وتّتجه لاستثمار القيم الإنسانيّة ، ورسم حواريّة معرفيّة مع النصّ ، متناسقة مع مُدركات التلقّي، ويتعامل النقد المعرفيّ مع المُنتج بوصفه بنية معرفيّة ، وينهض بتحويل النصيّ إلى معرفيّ لكشف القيم التي بُنِي عليها النصّ ، ويعيد تقييم المنجز الإنسانيّ في سياق معرفيّ ، ويعمد إلى تطبيق مبدأ الشمول المعرفيّ في تقييم النصّ.
ماذا بعد النقد المعرفيّ ؟ ، هل نحن أمام مستجدّات نقديّة تلوح في الأفق؟ .
إن الحديث عن مرحلة الـ(ما بعد) يقدّم مساحة مهمّة من التصوّرات العقليّة لمآلات القابل من الزمن ، ويمنح فرصة لمناقشة البدائل المناسبة للظواهر المعرفيّة والمسارات النقديّة ، وكما أكّدنا في دراسات سابقة أن الحركة النقديّة لا تعرف التوقّف عند حال معيّن ، ولا يمكن أن تطمئن لمنهجيّة محدّدة ، هي متسارعة ومتداخلة ومتأثّرة بكلّ المستجدّات الحضاريّة والعلميّة والإنسانيّة ، وأرى أن إمكانيّات النقد المعرفيّ اليوم هي إمكانيّات مستقبليّة هائلة في القراءة والكشف والبيان والتحليل ، وأن المعالجات والنظريّات التي تنتمي له ستقدّم مكتسبات مهمّة في تحليل النصوص ، وبيان جماليّاتها ، فضلاً عن أن النهج البينيّ والشموليّ والإنسانيّ في أصول منهجيّته سيكون منطلقًا ناجعًا في منح النصوص مزيدًا من الثراء الدلاليّ والقيميّ .
تاسعًا : أمامك مساحة بيضاء لما تحبّ أن تقول ... .
لا شكّ أنّ الواقع الذي يعيشه الخطاب النقديّ العربيّ الحديث هو عبارة عن مجموعة من الإشكاليّات الوجوديّة المتمثّلة بـ(بالهُويّة ، والمرجعيّة ، والخصوصيّة ، والحضاريّة) ، والأزمات المنهجيّة المتمثّلة بـ( المنهج ، والتنظير، والترجمة ، والمصطلح) ، وقد حاول الكثير من النقّاد العرب المعاصرين دراسة الأسباب والمُسبّبات ، وتشخيص بعض الحلول والمعالجات للوصول إلى تفعيل منظومة هذا النقد ، وتحقيق التوازن بين الذوات المعرفيّة الممثّلة له ، وتجاوز المشاكل التي اعترت مسيرته من قبيل : (فوضى المصطلحات ، وغياب التوافق المنهجيّ في بيئات عدّة ، والاجتهاد في تناول المعطيات ، والاختلاف في فهم المقاصد) ، ثمّ الإسهام في تحديد منهجيّة التعامل مع النصوص الإبداعيّة بعيدًا عن العوائق التي قيّدت التحديث النقديّ من قبيل : (التمسّك بالمألوف ، والخوف من المجهول ، والحذر من المستجدّات).
وأرى أن الخطاب النقديّ العربيّ الحديث مطالبٌ بتحقيق مسارين اثنين ، الأوّل مسار إجرائيّ : في التحوّل من الذاتيّة إلى المشاركة ، ومن الفرادة إلى الجماعيّة ، والثاني مسار منهجيّ : في تحقيق التكوين المفاهيميّ من حيث فهم التحوّلات المنهجيّة ، وتقييم المعطيات النقديّة ، فضلاً عن تحقيق التفاعل المرجعيّ البنّاء والواعي مع الموروث بكلّ منجزاته ومكاسبه.












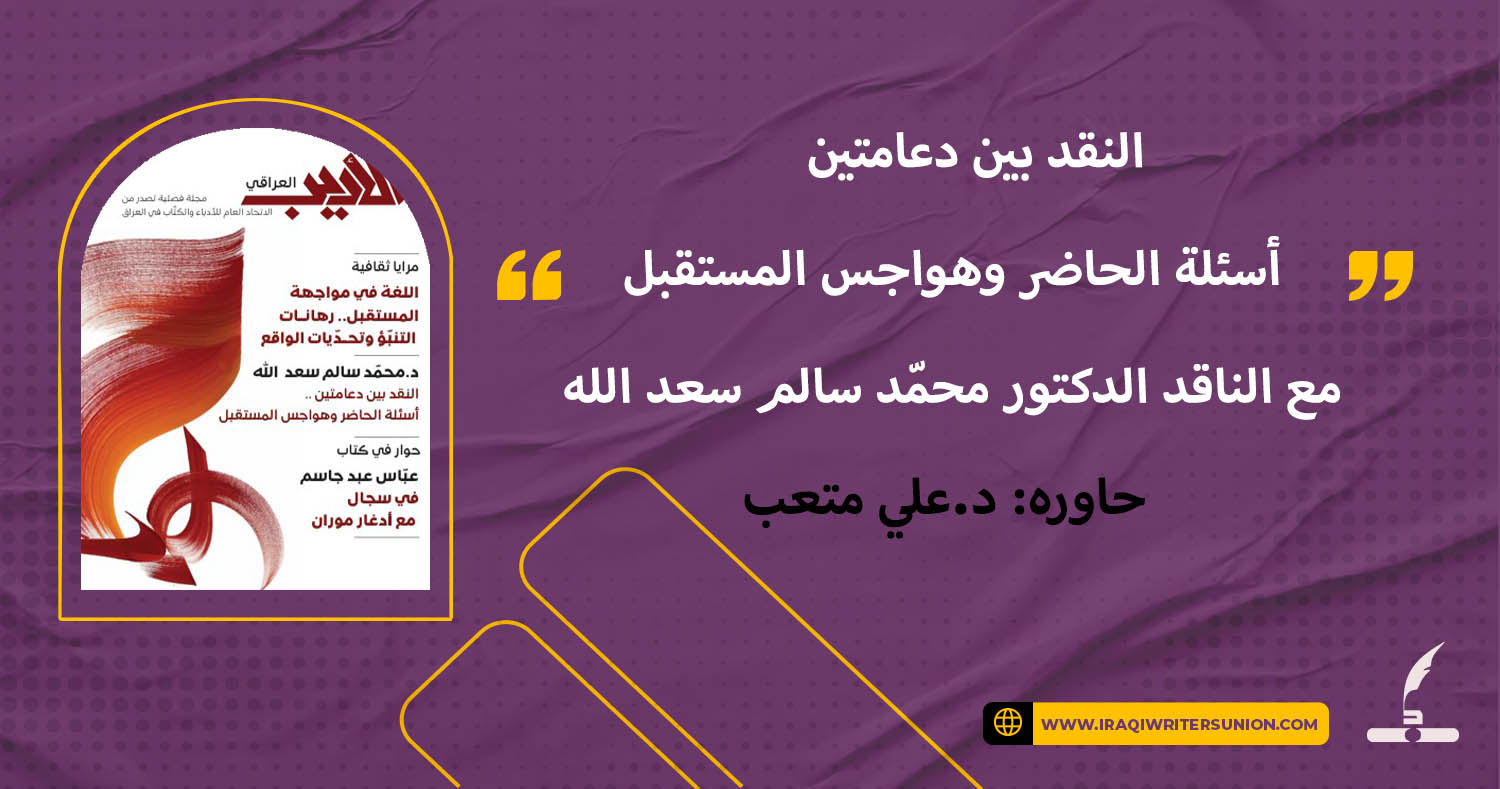
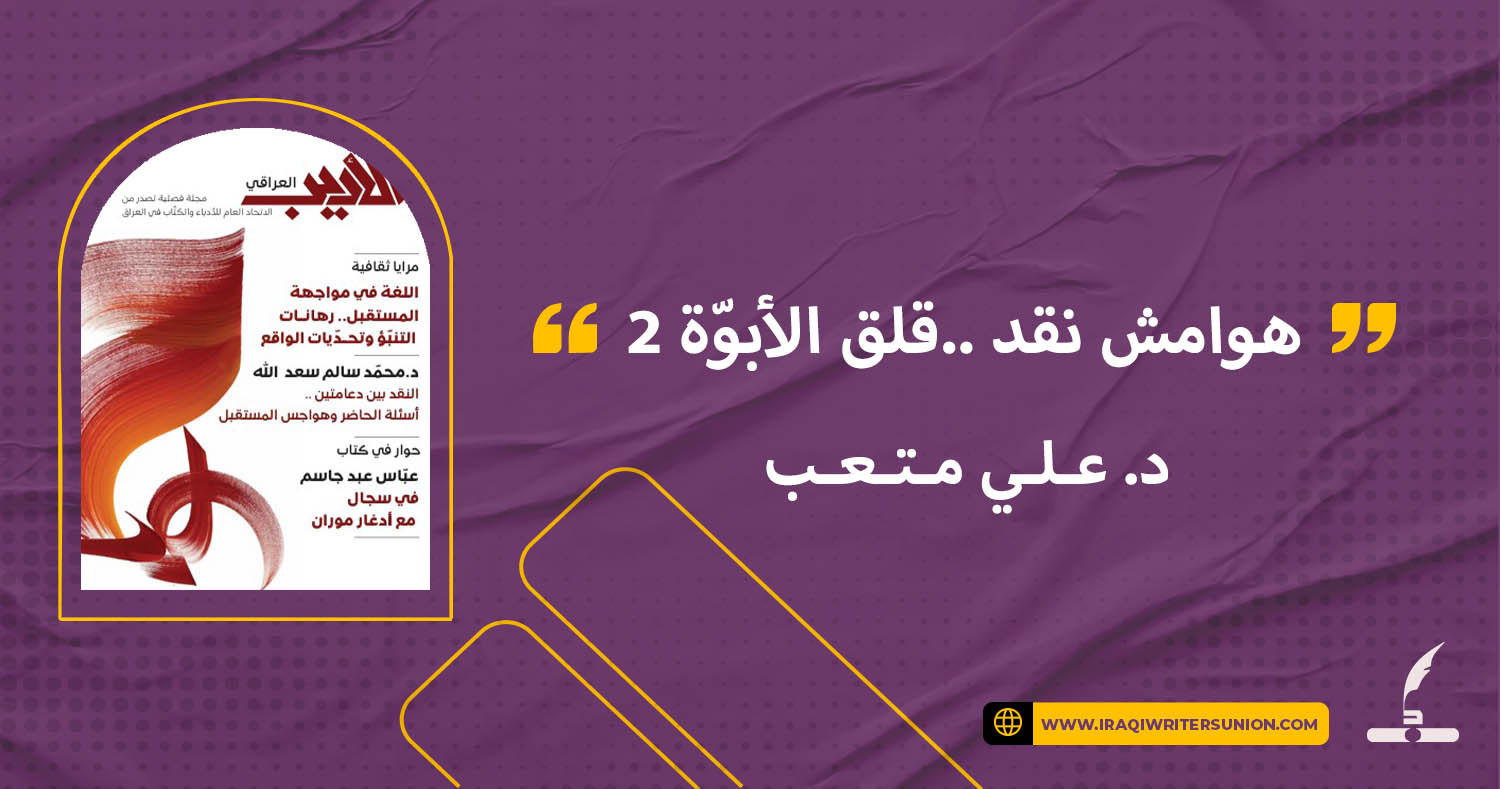
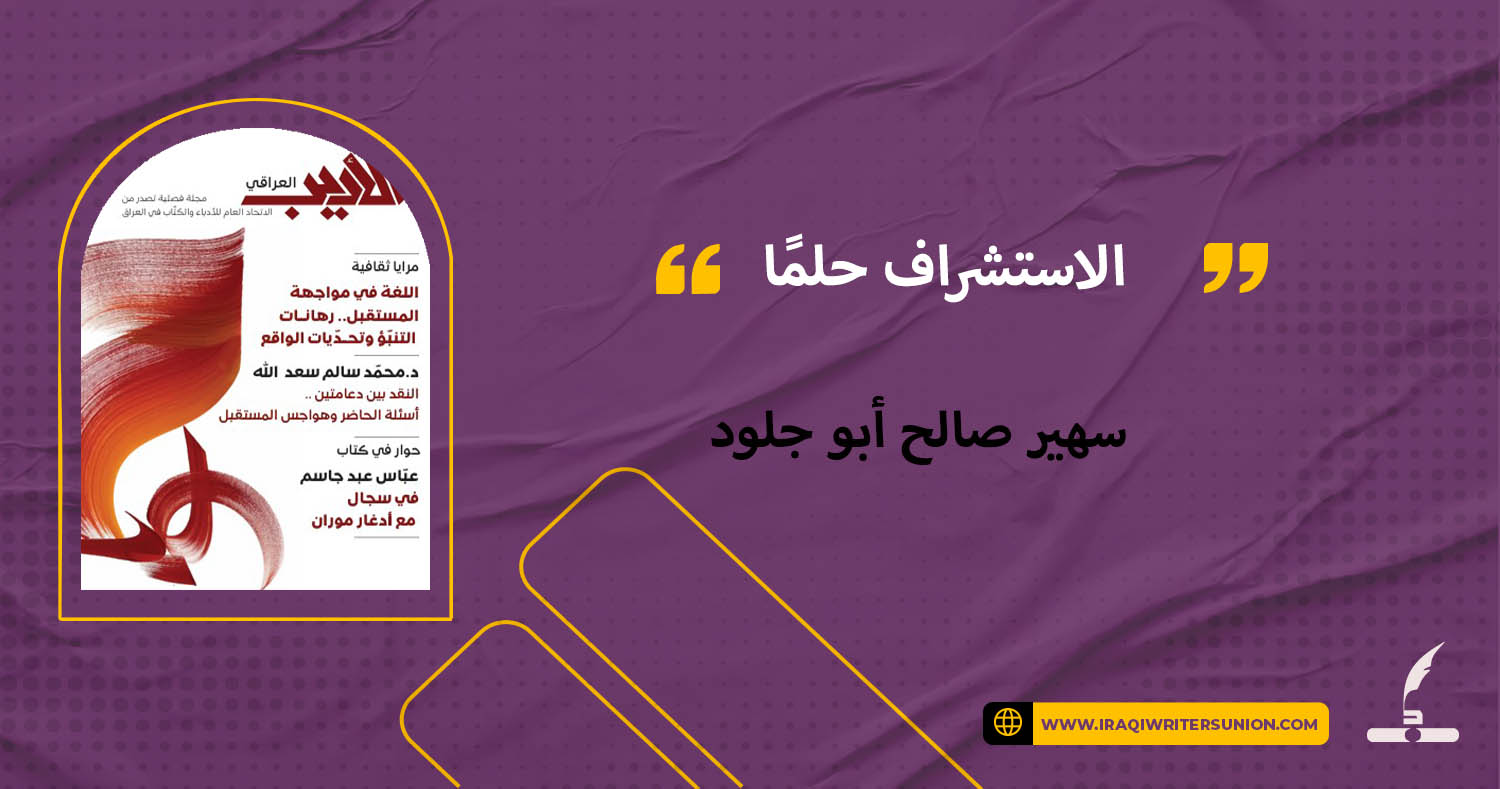
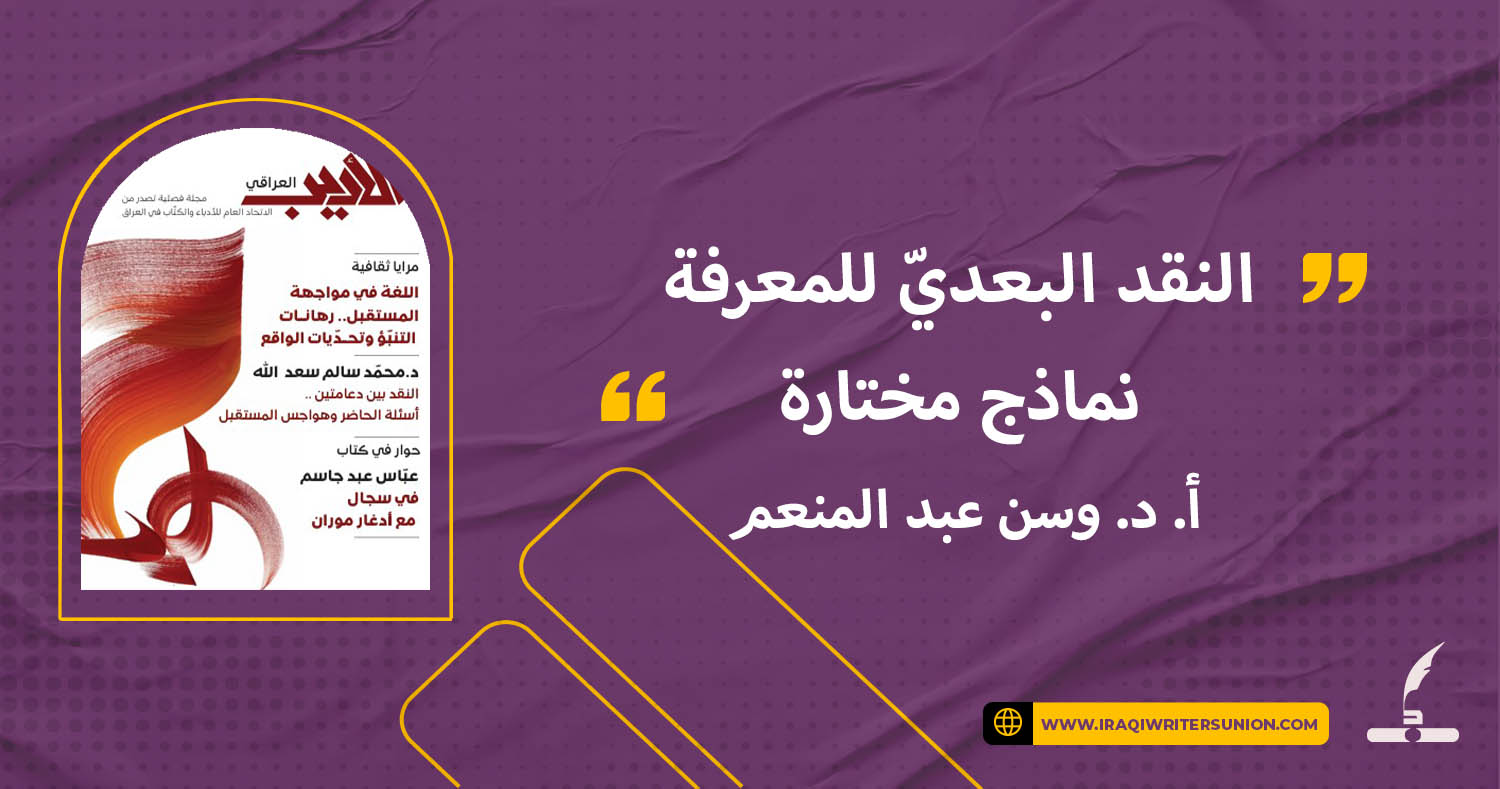

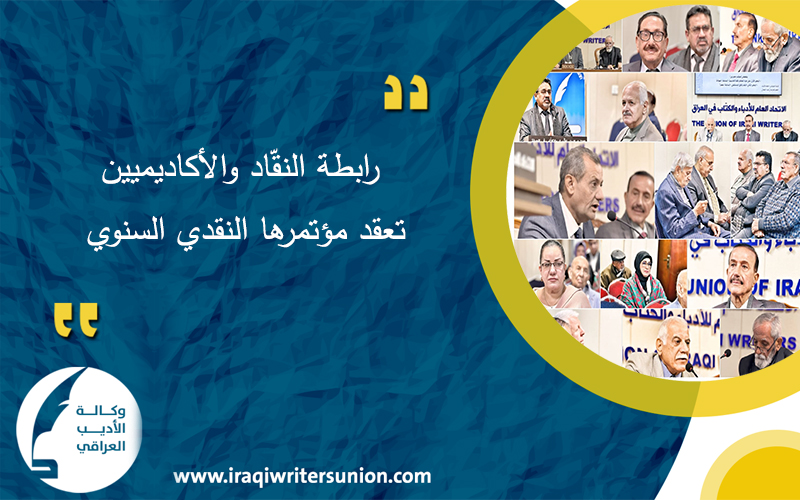

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي