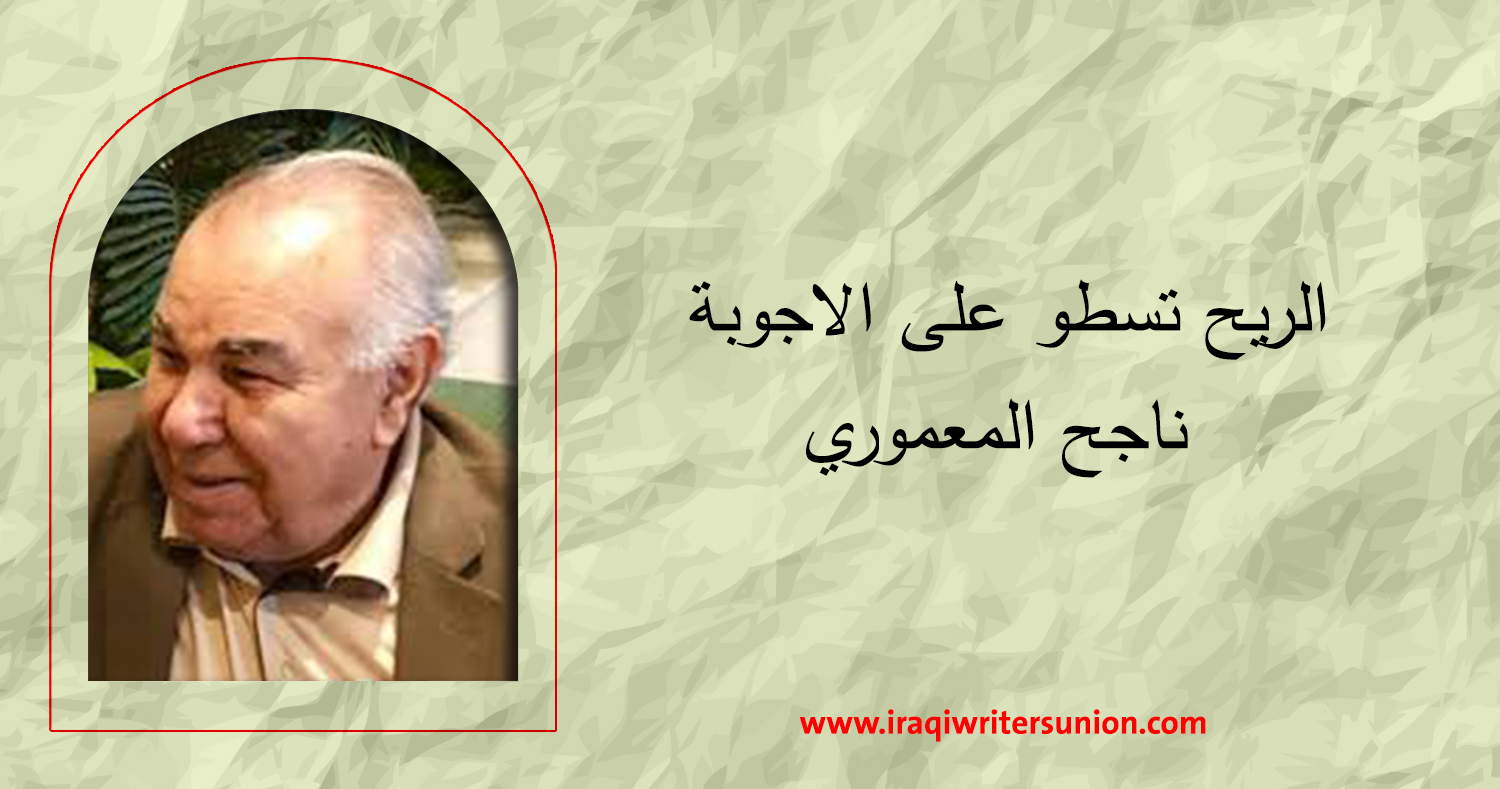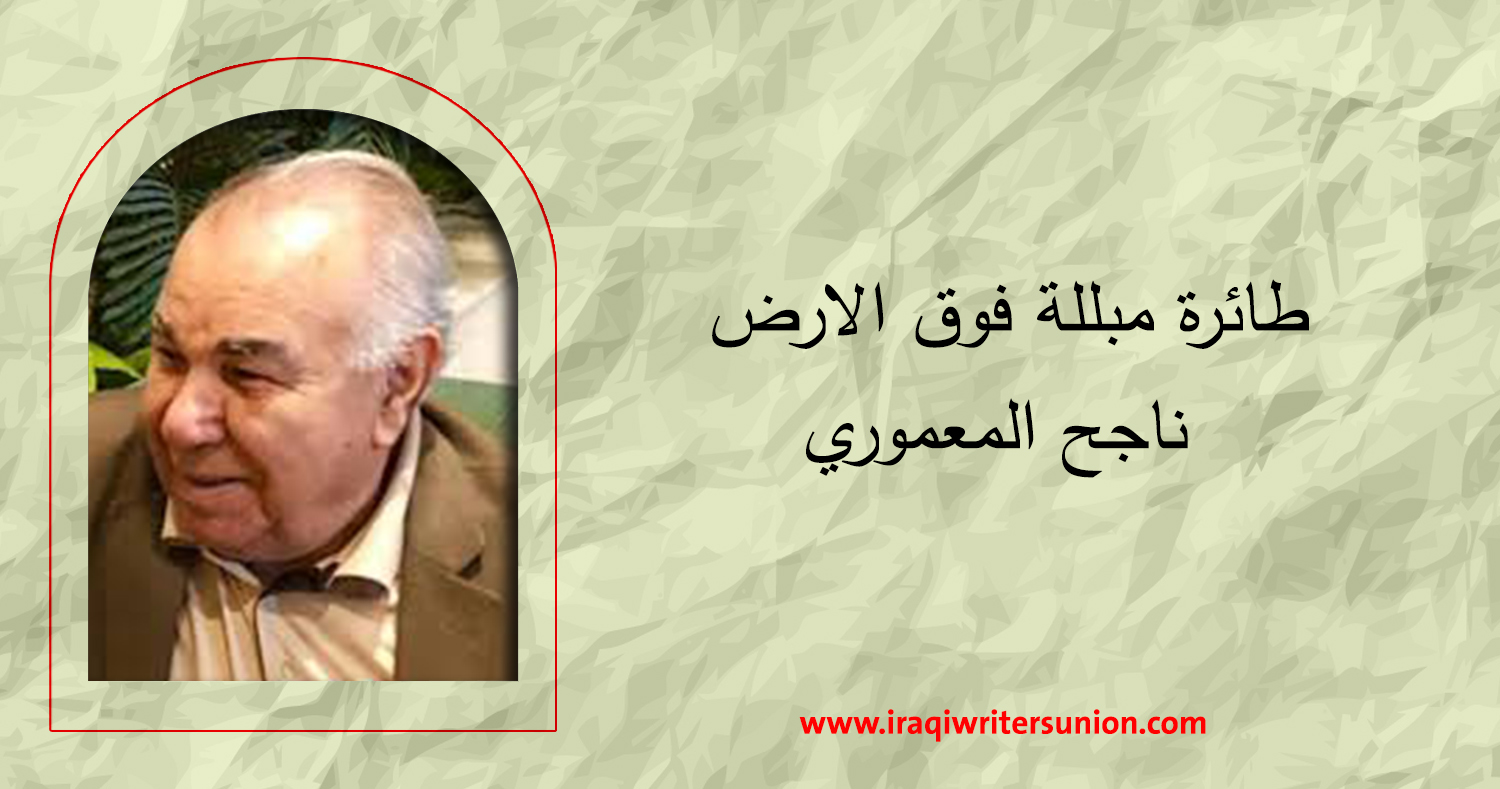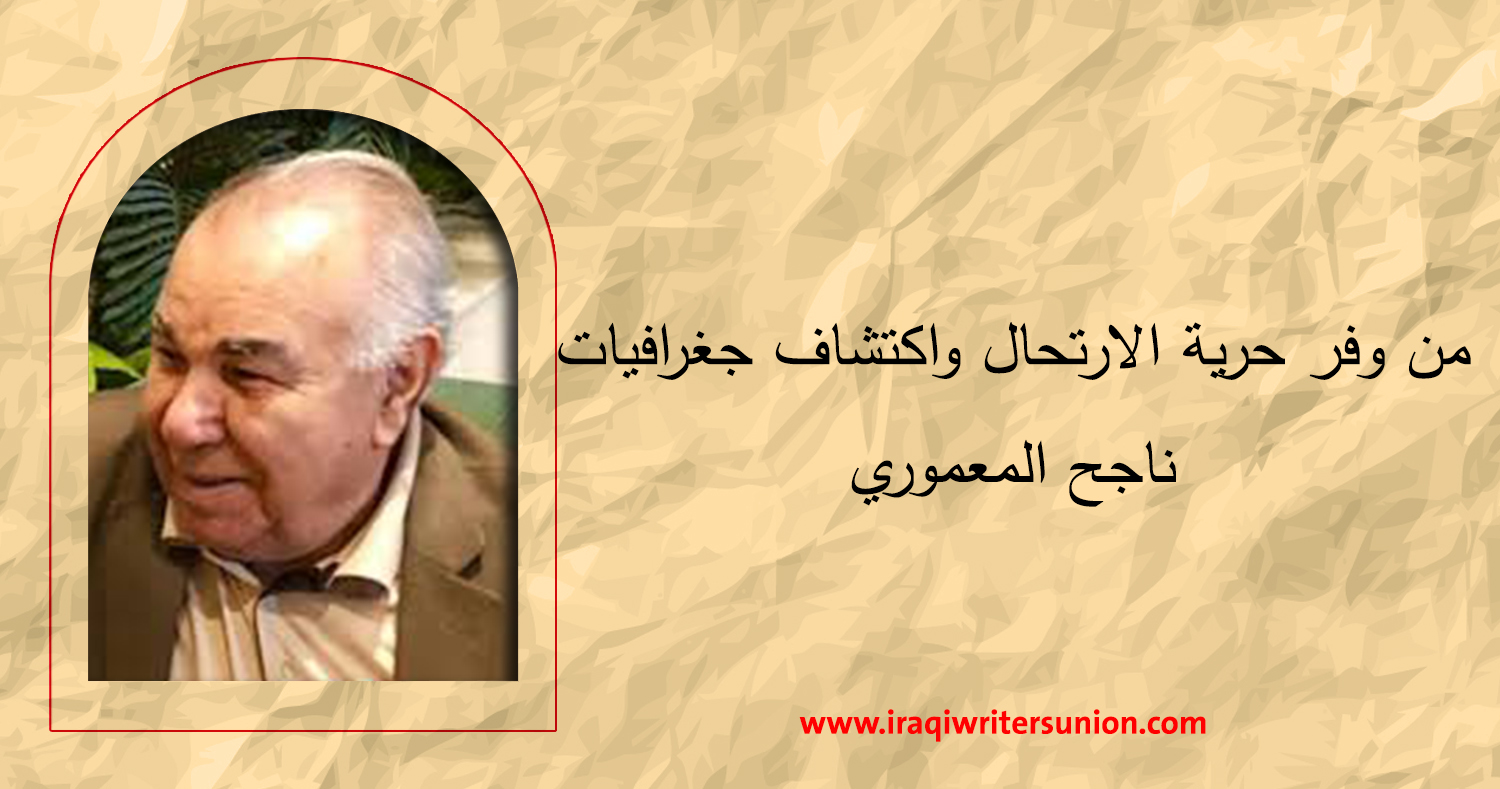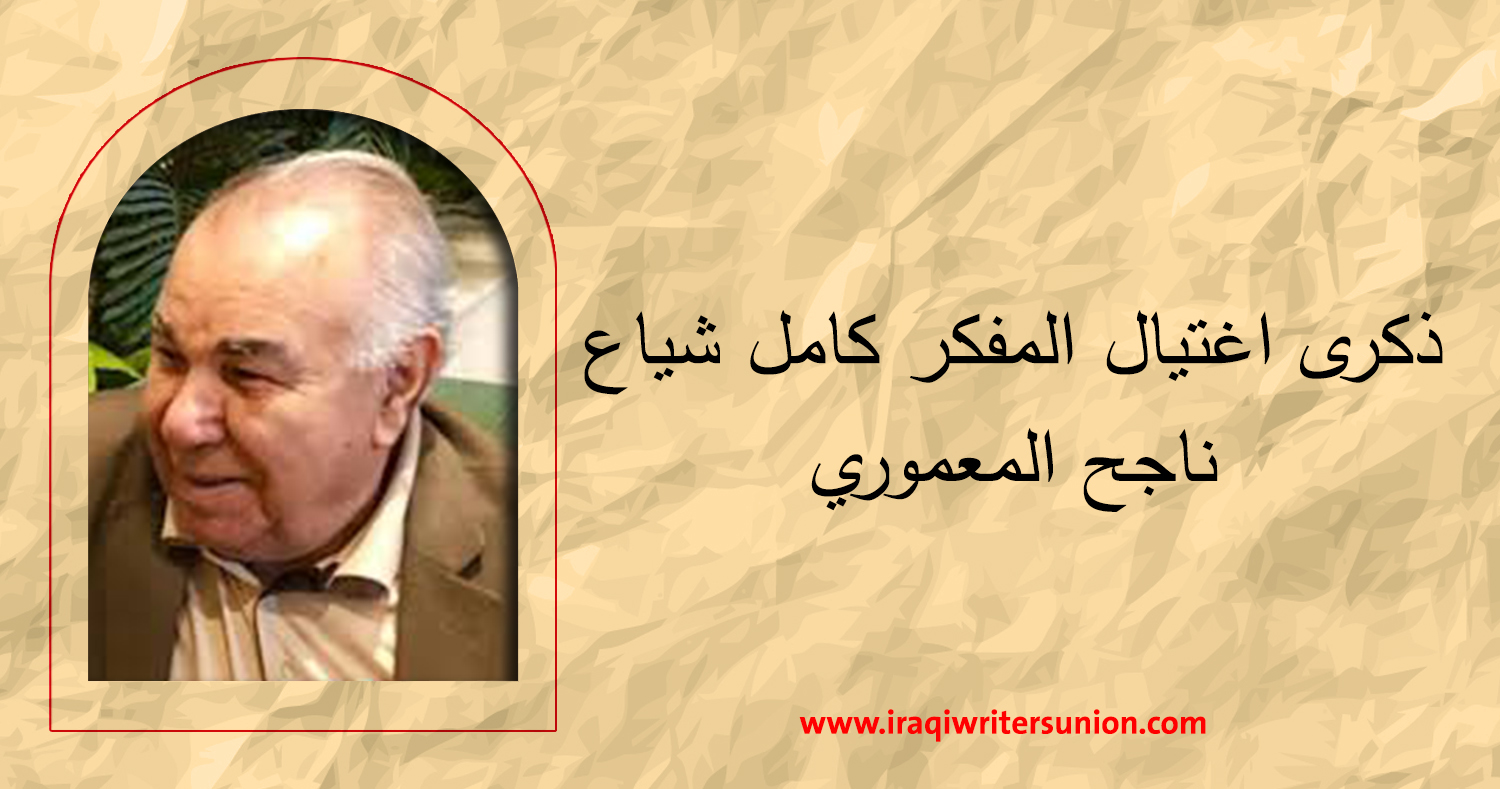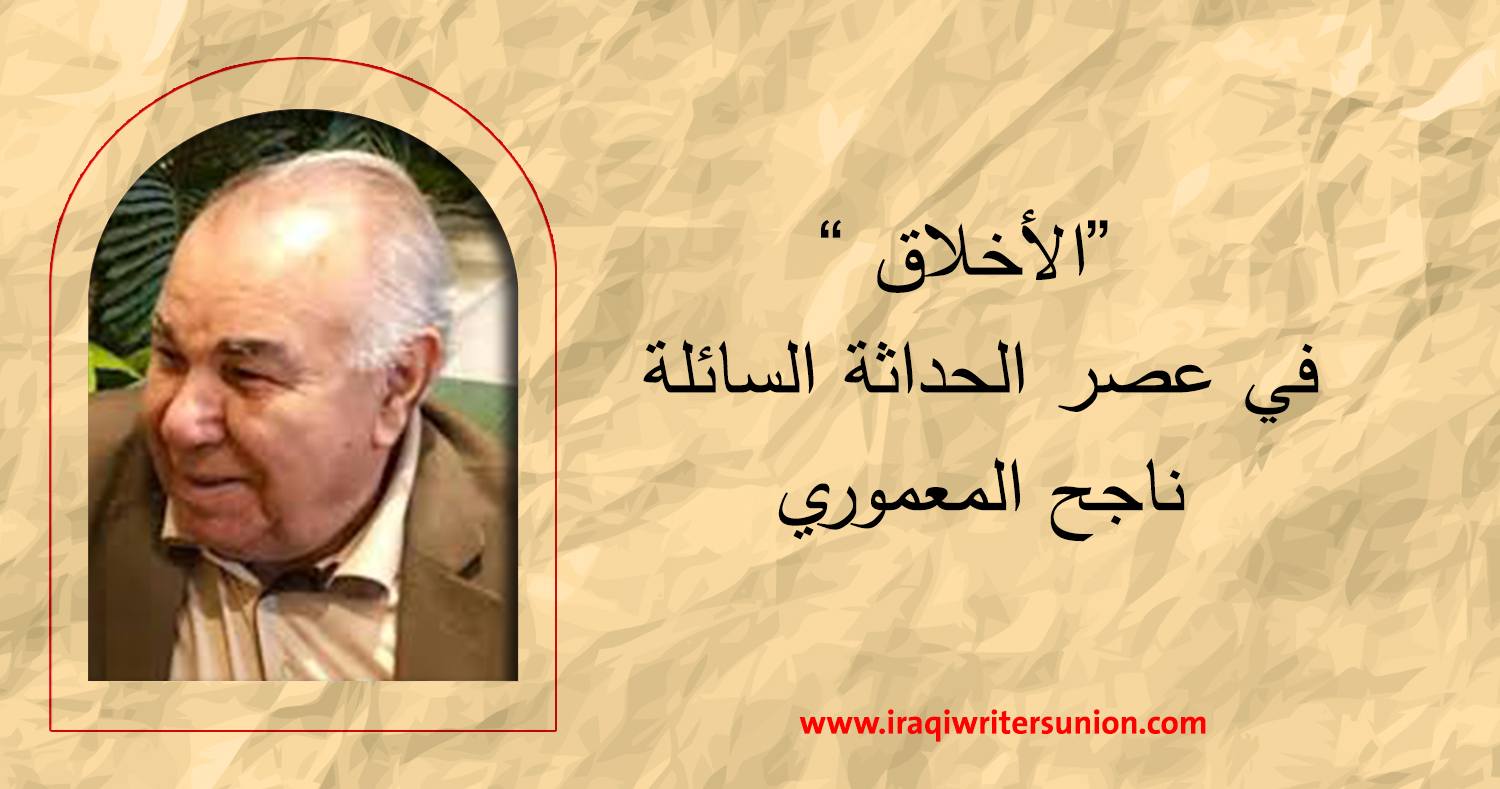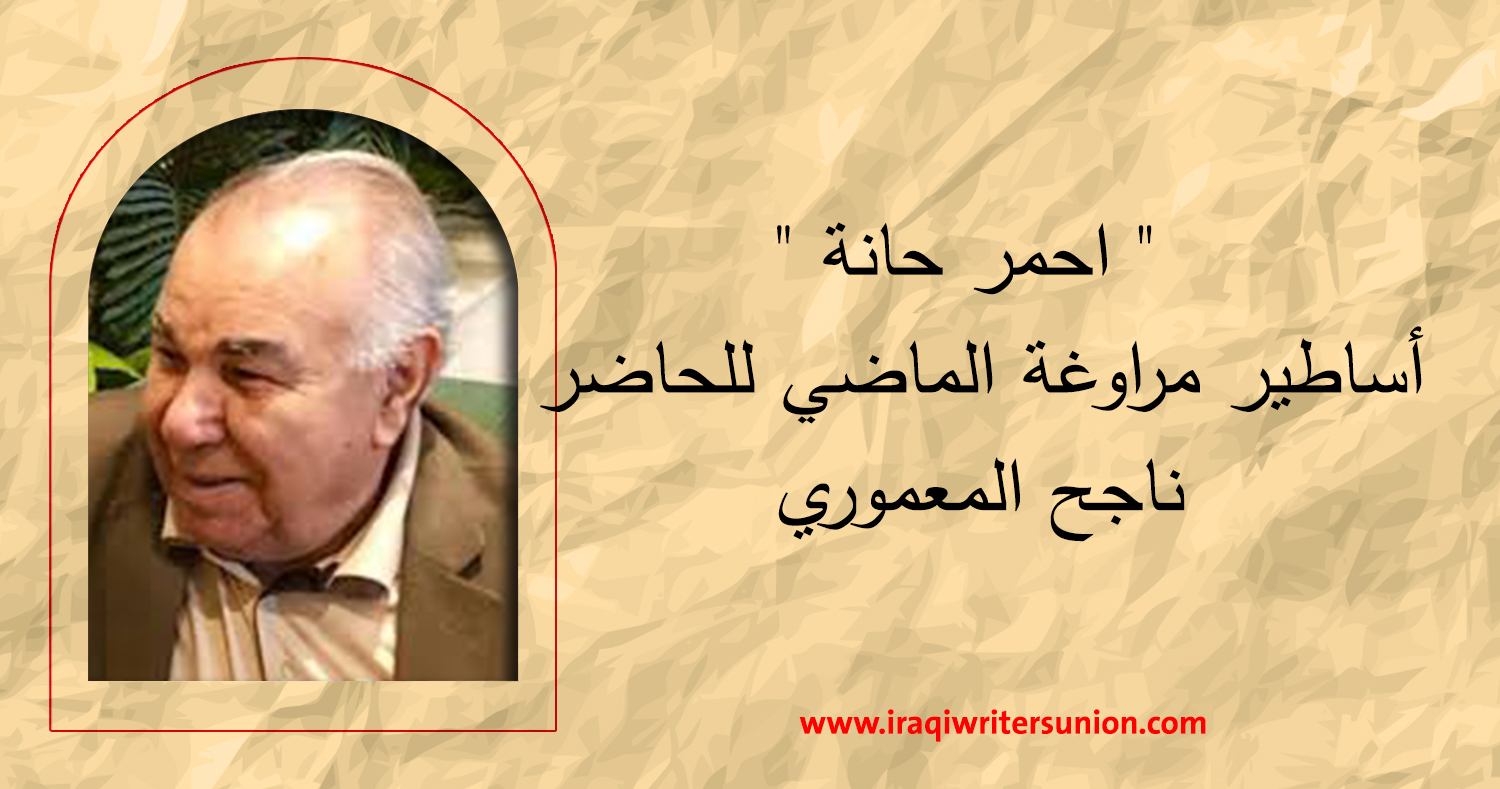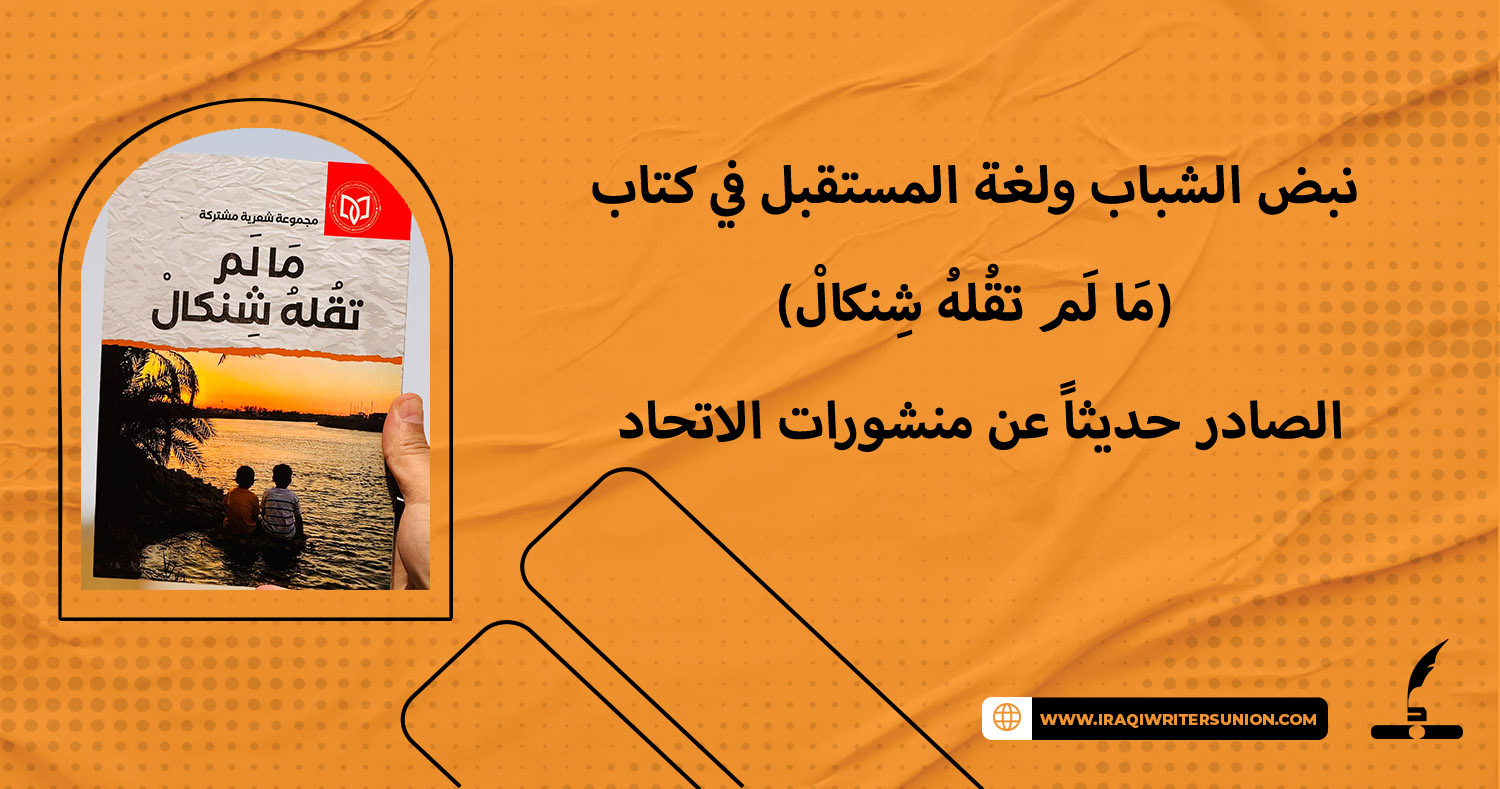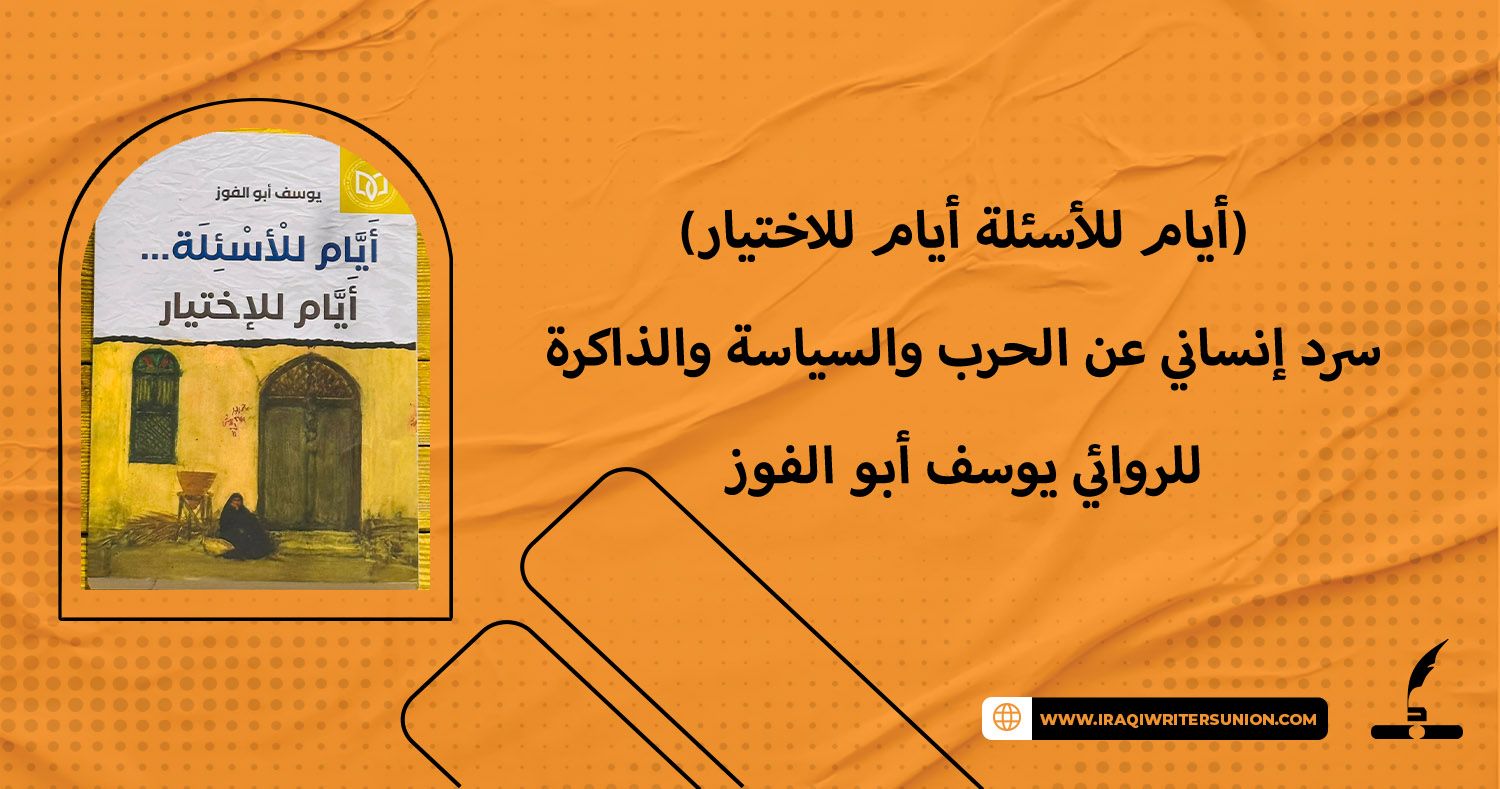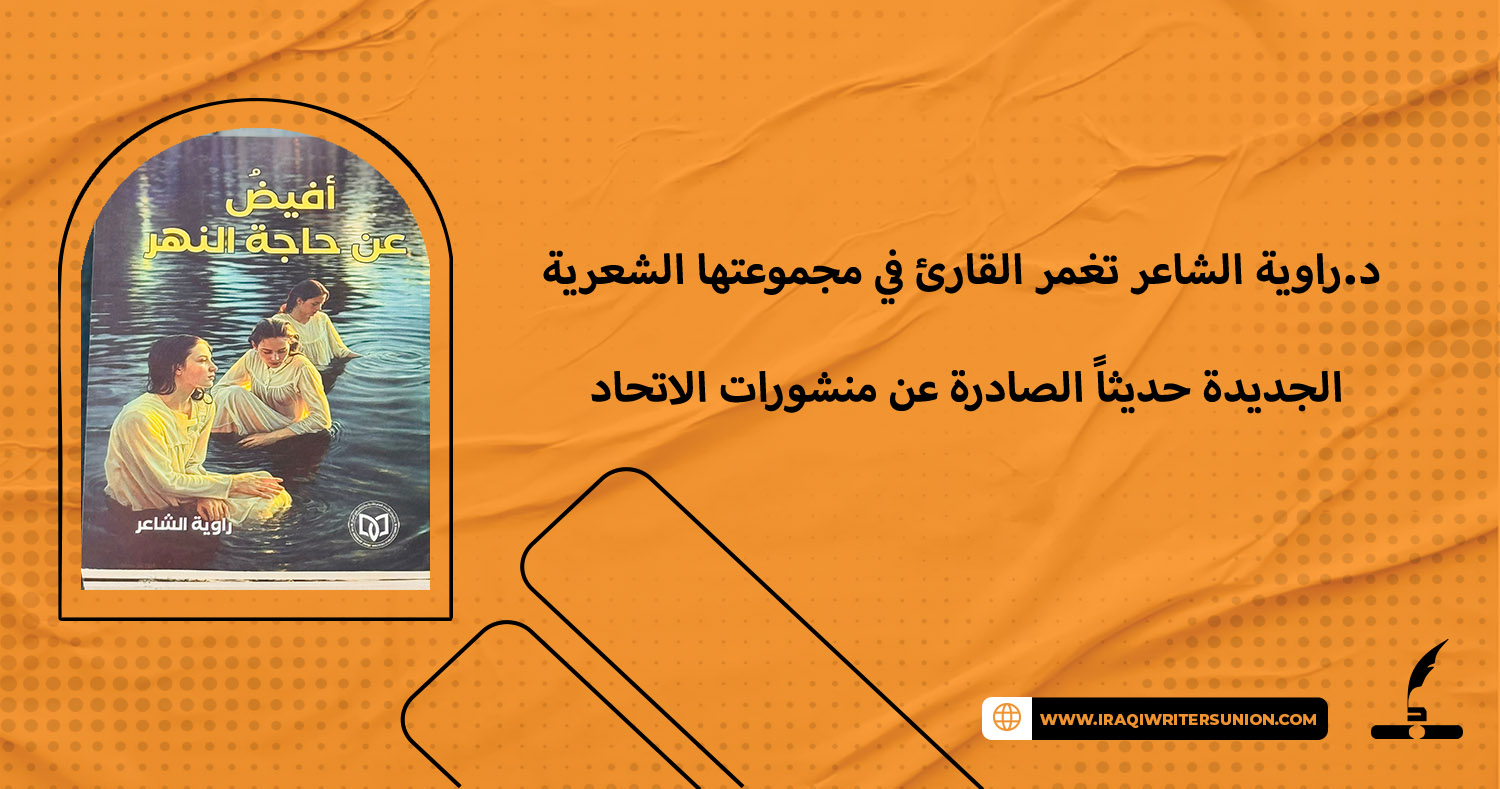الاستشراف حلمًا
د. سهير صالح أبو جلود
إنّ من أبرز مهامّ الشعر الجديد الكشف عن قلق الإنسان والتعبير عنه من خلال فهم الواقع ومعطياته(الاقتصاديّة والسياسيّة والاجتماعيّة) المقدَّمة أمامنا بشكل يعكس الحياة التي نعيش ضمن زمنٍ ثابت في حقيقته لكنّه متحرّك حين نبدأ بوضع الحلول ونحاول الكشف عن وجه العالم المخبوء والتعرّف على علائقه الخفيّة، يقول عبد الرحمن العكيمي عن الاستشراف أنه:(تجربة نافذة باتّجاه المستقبل من خلال قراءة معطيات الواقع بأدوات ترتكز على الوعي والنضج واستلهام التجارب الأخرى)(1) وليس ذلك ببعيد عن الشاعر فهو صاحب الموهبة التي تقتحم الأحاسيس وتقارن الصور والأفكار بعضها ببعض ورسمها بطريقة جديدة، وبذلك يسجّل كلّ شاعر مشروعه الخاصّ لحلّ شيء من هموم الإنسانيّة ، ونرى الكثير من الشعراء ممّن تراودهم تلك الأمنيات فيرسمونها على هيأة قصائد قريبة من الظنون بعيدة عن اليقين لكنّها تقودنا صوب إِنسانيّة جديدة ومستقبل يتّسع لأحلامنا الملغاة في الحاضر. وتكمن أهميّة الاستشراف في تنوّع أوجهه وأحلامه وهذه الأخيرة هي الأساس في رسم الصورة المستقبليّة. إنّ هذه الرغبة في خرق المجهول وتصوّر ما سيأتي مرتبطة بحواسّ تفهّم الإشارات التي يطرحها الواقع كما نعرفه لكنّها في الوقت نفسه تتأمّلها بمفهوم خاصّ مفرط في إماتة ما هو معرّف في الذهن أو متعارف عليه، وفي كلّ إماتة ينبثق حلمٌ جديد أو صورة تسكن في مخيّلة الشاعر وبمجموع هذه الصور تتشكّل لنا صورة مستقبل يختلف وفق اختلاف خيال الشعراء وتنوّع أحلامهم. وذاكرة الشعر العربي مليئة بأسماء الشعراء الذين وظّفوا بصيرتهم وإحساسهم لتصوّر ما سيكون كالمتنبي والمعرّي لكنها لم تكنْ تمثّل كشفًا جديدًا للمستقبل أو تقدّم لنا رؤية مختلفة له كما في قصائد شعرائنا المحدثين التي تسابق الزمن وتصوّر المستقبل بمفردات تحمل هموم الإنسان بإِحباطاته وقلقه، وكأنّ الشاعر باستشرافه ينجّي نفسه من هذه الهموم ويذهب إلى أبعد من ذلك بأن يصطحب الآخرين معه ليكتشفوا متعة المغامرة إلى المجهول. الاستشراف أشبه بالإعلان عن دور الشعر الخلّاق في إعادة صياغة الوجود لتكون القصيدة كما يقول أدونيس:( حدث أو مجيء ، والشعر تأسيس باللغة والرؤيا ، تأسيس عالم واتّجاه لا عهد لنا بهما من قبل لهذا كان الشعر تخطيًّا يدفع إلى التخطّي)(3) وقد اتّسمت النماذج التي اخترناها بهاجس القلق الذي يسكن النفوس من الآتي المجهول وجاءت بصور تجمع بين المستقبل وانتظاره وتخيّله وكأن الشاعر بهذه الصور يتصالح مع الخوف والقلق. ويأتي الشاعر محمود درويش في طليعة الشعراء الذين استشرفوا المستقبل فقد قرأ واقعه جيّدًا وفهم معطياته فتشكّلت في ذهنه رؤية خاصّة استعانت بخياله لترسم عالمًا برؤى شعريّة تملك الكثير من الحدس الإنسانيّ حيث يؤسّس شعره استشرافًا جديدًا تفرضه حاجات العصر إلى جانب ارتكازه على ما في مخيّلته من إبداع وقدرة على خلق الدهشة ليخترق بشعره عوالم غيبيّة يقفز بها إلى المجهول ويحلم من خلالها بعالم يراه ملجًأ آمنًا وملاذًا نحتمي به من واقعنا ويجرّنا معه لنتفكّر في هذا العالم المثاليّ الذي نطلّ معه على ملامحه :(أطلّ على نورس وعلى شاحنات جنود / تغيّر أشجار هذا المكان/ أطلّ على شجرٍ يحرس الليل من نفسه / ويحرس نوم الذين يحبونني ميتًا / أطلّ على الريح تبحث عن وطن الريح ، في نفسها / أطلّ على موكب الأنبياء القدامى .. وأسال : هل من نبيّ جديد لهذا الزمان الجديد؟ ) يحمل الشاعر همّ البحث عن بطل جديد يقودنا إلى المستقبل بأمان ويتخيّل صورة له فيهمّش أوّلاً الزمان والمكان الحقيقيّين ويحيلهما كتلة زمنيّة مطلقة ومكانًا مشاعًا لا حدود له في محاولة منه لخلق عالم بمزايا طالما حلم بها الإنسان الحرّ ومن أهمّ تلك المزايا خلق زمان نصنع فيه وجودنا ومكان نثبت فيه أنفسنا ، فدرويش الذي عاش واقعًا متوتّرًا مليئًا بالنزاعات كانت الحياة بمثابة خصم له ولأحلامه وأحلام الكثيرين فكان اللجوء إلى الاستشراف وسيلة ناجعة يخفّف بها من ذلك النزاع الذي أرهق الإنسان ، وهي أيضًا محاولة للاطمئنان على ما سيكون: ( أطلّ على ما وراء الطبيعة / ماذا سيحدث ، ماذا سيحدث بعد الرماد؟ أطلّ على جسدي خائفًا من بعيد / أطلّ كشرفة بيت على ما أريد / أطلّ على شبحي قادمًا من بعيد) وقد يصدق جزءٌ يسير مّما يحدس به الشعراء لكن يبقى المستقبل غامضًا فيجسّد الشاعر هذا الخوف والغموض بتكرار سؤال(ماذا سيحدث؟) بل إنه يذهب إلى ما هو أبعد من الخوف فيبدو متشائمًا لا يستطيع أنْ يكون جزءًا حقيقيًّا من هذا المستقبل فيرى نفسه شبحًا لا يكاد يعرف كنهه ، وتستمرّ مراوحة النصّ بين تحقّق الحلم وإخفاقه ، بين ولادة الأمل الذي قد يصيب أحيانًا وبين وأده. هي أسئلة تدعو إلى التأمّل في ما مرّ ويمرّ من أحداث وإلى التفكّر فيها وتوقّع ما ستؤول إليه الأمور ولا سيّما أنّ النصّ يفتح مجالاً للجدل في ما يطرحه من تصوّرات حول المستقبل ويدعو لأخذ العِبرة ، بمعنى أنّ الاستشراف في هذه القصيدة يبدأ حين ننتهي من قراءتها وذلك حين نبدأ التفكير وطرح الاسئلة التي تبقى في وعي المتلقّي وهو يستلم تلك الإضاءات التي تنير وعيه وعقله. أمّا الشاعر أجود مجبل فقد تمسّك بانتظار صورة المنقذ التي يحلم من خلالها بالآتي ، فيقول: ( سيرجع ، هكذا قالت له الأنهار/ وتتّكئ السنابلُ مرّتين على شقوق الباب / فانتظريه / كم دارتْ به الدنيا / ولكنّ الشراع بكفّه ما دار / سيلقي في الشبابيك الأليفة عُريَ فرحته / وأكداسًا من الأيّام / يجلدها الحنين بعطره الأزرق / على كتفيه مقبرة / هوتْ في قاعها الأسماء / سيرجع مثل عشبٍ راودته النار/ يفرقعه الغروب / شراسة سوداء يحدّق في الزوايا لا يرى غير انحناءاته / سيدهش بانخطافة وجهه الباقي على الأسوار/ به عبث الشراك وضيعة العصفور حين يهبّ مسلوبًا يطارده الشتاء وجرحُه الأعمق) الانتظار هنا بقطبين يمثّلان الحاضر ، الأوّل ملئ بضجيج واضح بدلالة أصوات الفرقعة وأصوات لهيب النار والآخر صامت متخفٍّ خلف الأبواب والأسوار والجرح الصامت كصمت العصفور حين يقع يائسًا في شرك الشباك ، قطبان حدّدا حلم الغد و ما سيكون عليه فجاء الشاعر بحيلة انتظار(الأمل / العودة) وسيلة هي الأقرب كما يراها لاستقبال أمانة إلهيّة من خلال تصوّر واقع لا مفرّ من الصبر عليه وعلى (الدنيا وهي تدور) واقع يكرّر الأخطاء فيغرس الإحباط أكثر فأكثر في النفوس، الأشطر مليئة ب(سين) الانتظار وترقّب الآتي ( سيرجع ، سيلقي ، سيدهش) وفيها الكثير من دلالات الصبر المنفتح على دوائر تُدخل النصّ في عالم التوقّع ( سيرجع مثل عشب راودته النار.. سيدهش بانخطافة وجهه الباقي على الأسوار) كلا الانتظارين مشوب بقلق وجوديّ تختلط فيه الأزمنة وتتحرّك فيه اتّجاهات متعدّدة تدور في فلك هذا المنتظَر الذي يخفي وراءه أملاً بحجم الدهشة التي يعلن عنها الشاعر في نهاية النصّ ، فهي دهشة متبقّية من عالم سحريّ مسلوب لأنّه واقع في شرك الترقّب وكأنّ في ذلك نجاته كما كان في الجرح العميق شفاؤه . يأتينا الاستشراف بصورة أخرى عن المستقبل وذلك حين يتعاضد الخيال والزمن في نصّ حسين المخزومي :( سيطهوك الزمن بالمشاهدة / ولن يبهرك شيء يخرج من قبّعة الساحر/ سيغادر كلّ مَنْ يجيد التلويح / أو يخطئه الدّمع / ويكتظّ الطريق بالراحلين / وحين تصلين لآخر النفق / ستعرفين أنكِ كنت ترافقين الضوء إلى حتفه الأخير) بإِيقاع رتيب حزين يبدأ هذا النصّ ، وعلى الرغم ممّا فيه من أفعال سريعة في إيقاعها الحقيقيّ و حاضرة بحركيّتها الواضحة للعيان ( يبهر ، يغادر، يكتظ) إلّا أنها أفعال بطيئة في واقعها المعيش لانّ الزمن الحاضر لا يمرّ بسهولة. وبداية النصّ ( الواقع / الحاضر) هي التي تحدّد ما سيكون عليه(المستقبل / الخيال) وهذا المستقبل سيأتي بوقع قويّ لأنّه بمثابة تنفيس عن الروح المعذّبة التي عانت طيلة حياتها لتصل في النهاية – كما تأمَل- إلى (آخر النفق) عندها فقط سنعرف أنّ الخيال هو آخر وسيلة نقاوم من خلالها تلاشي الحياة(حتفنا الأخير) قبل خوض تجربة كاملة وحياة أخرى تبدأ بعد الموت. ويتّخذ الاستشراف عند عبد العظيم فنجان منحى آخر حين يصنع صورة لما هو متوقَّع من خلال تأويلات متعدّدة لصورة الماضي الذي يطوّعه وفق شخصيّتي ( الرجل / الحكيم ) و(جموع الناس) الذين يحثّهم على اتّباعه إذا ما أرادوا الوصول إلى الحكمة من هذا الوجود ، ويصوّر الشاعر هذه الحكمة على هيأة طمأنينة منهكة وأمان مشوب بالمخاطر لا نملك إلّا انتظاره في قابل الأيّام : ( قال الناس: سنتبع آثار هذا الرجل الذي / يعرف طرقًا لم نسلكها ، مدنًا لم نتشرّد فيها ، وغصّات مكثّفة لم نشربها / لقد أنهكتنا الطمأنينة ونحتاج إلى متاهات مضاعفة / نعيش في هذا المكان النائي بعيدًا عن الخوف وعن الخطر/ و ما من أحد يمشي أمامهم / لكنّهم غادروا ، غادروا في كلّ اتّجاه / ثمّ توارَوا عن الأنظار / فصرتُ أتسقّط أخبارهم في مفارق طرق الخيال / حيث يتوفّر أدلّاء لا يخطئون.. / أضافوا: عمّا قريب ستلفظ هذه الجنّةُ أنفاسها الأخيرة وتموت بغية "دلمون الثانية" ستولد من رحم طرق أخرى في الكتابة: تؤدّي أو لا تؤدّي إليها ) تحكم هذا النصّ بنيتان تعينان الشاعر على الابتعاد عن الواقع لإعادة عمليّة التفكير في ما سيكون ، الأولى بنية حواريّة بين الرجل الحكيم والناس والثانية بنية دائريّة تنتهي من حيث تبدأ ، يجمع الشاعر هاتين البنيتين رغبة منه في تصوير متاهة تُحيل على حكمة تُنتزَع من هذه المتاهة من دون أنْ تُشعر الناس بالخوف منها ، أسلوب تجريديّ واستراتيجيّة معقّدة حيث يترك الشاعر التفاصيل كلّها – لأنها متاهة- ويلجأ إلى ما هو غامض ومبهم باختفاء هؤلاء التابعين ( تواروا عن الأنظار) لأنهم أضاعوا ( أدلّاء لا يخطئون) فعسى أنْ لا يخذلوا هذا الدليل الجديد ويسيروا على آثاره ، هي تجريديّة ممزوجة بنفسيّة من يعتزل الواقع ويرحل بفكره إلى مستقبل يصوّره بهيئة (دلمون) وهو المعادل الموضوعيّ للفردوس والمستقبل الذي ننتظر أو نحلم. يحقّق عبد العظيم فنجان الاستشراف وفق طبيعته الحقيقيّة وهي التغيير في نظام التفكير الذي يبدأ من تحوّل وجهة النظر إلى الواقع والتفكّر فيه لينتهي بتشكّل رؤية مستقبليّة قد تكون غامضة مرتبكة لكنّها تسكن في الأحلام وتنتظر أنْ يدركها الناس بوعيهم . لقد اشتركت النصوص التي تناولناها في ثيمة واحدة هي (الانتظار) على اختلاف تصويرها ملامح هذا المنتَظَر أو البطل المنقذ ، وكانت في جميعها تدور حول نماذج تجاوز الشعراء من خلالها ذواتهم فامتلكوا الخطاب الأقوى في ثقافة استشرافيّة أساسها التحذير مّما سيؤول إليه الحاضر وما سيتمخّض عنه واقعنا المحبط من مصير مقلِق فغامرَتْ تلك النصوص في الخوض في المجهول لاكتشاف ما لم يأتِ .
هوامش الدراسة:
1- عبد الرحمن العكيمي، الاستشراف في النص ، الانتشار العربي ، ط1 بيروت 2015 ،ص 85.
2- طلال المير، النبوءة في الشعر العربي الحديث ، مجد ، المؤسسة الجامعية ، للدراسات والنشر والتوزيع ، ط1، بيروت 2009،ص5.
3- أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار الساقي، 2009 ،ص92.وينظر للمؤلف نفسه: زمن الشعر، دار الساقي 2005 ص 9.












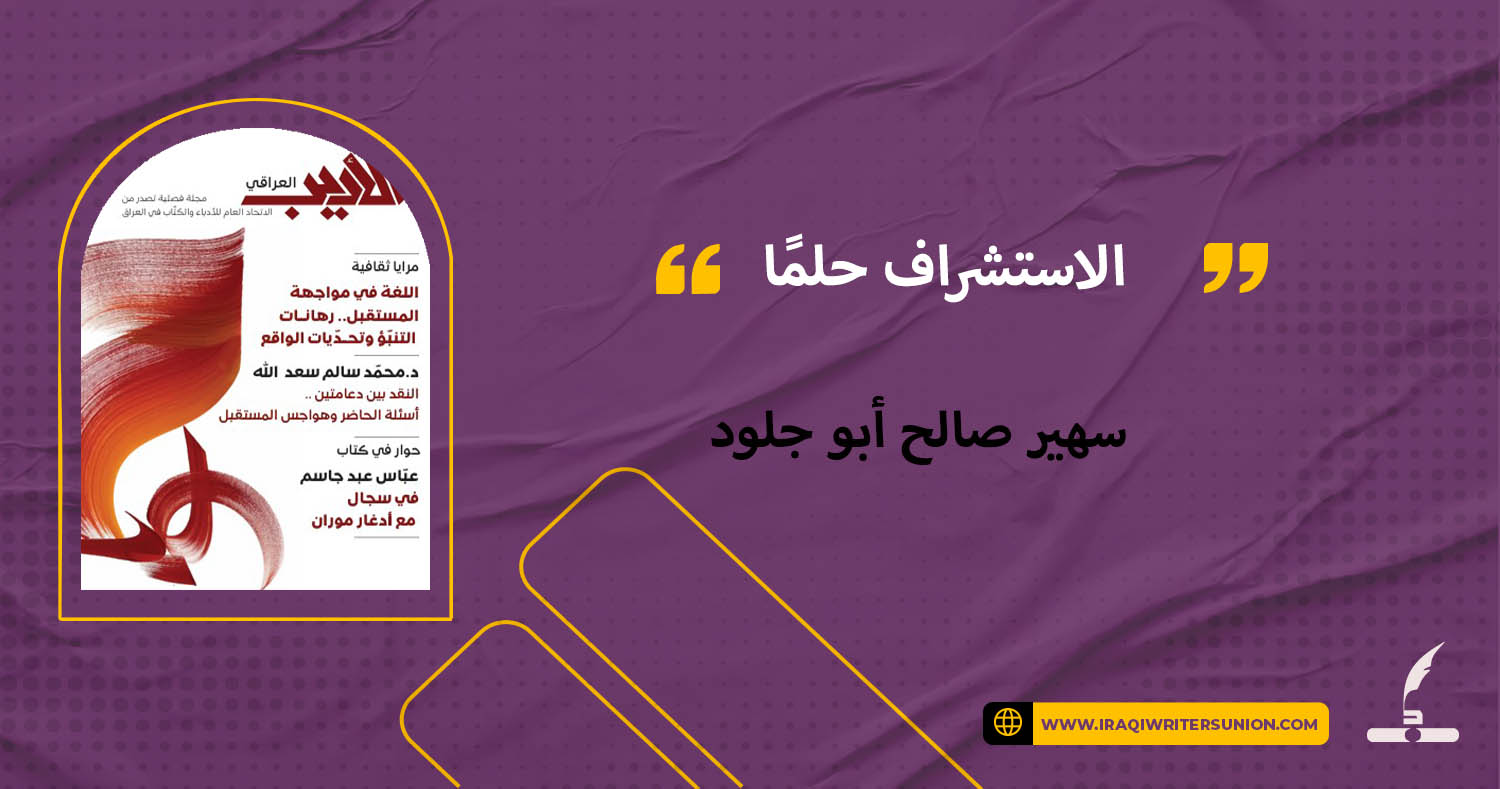
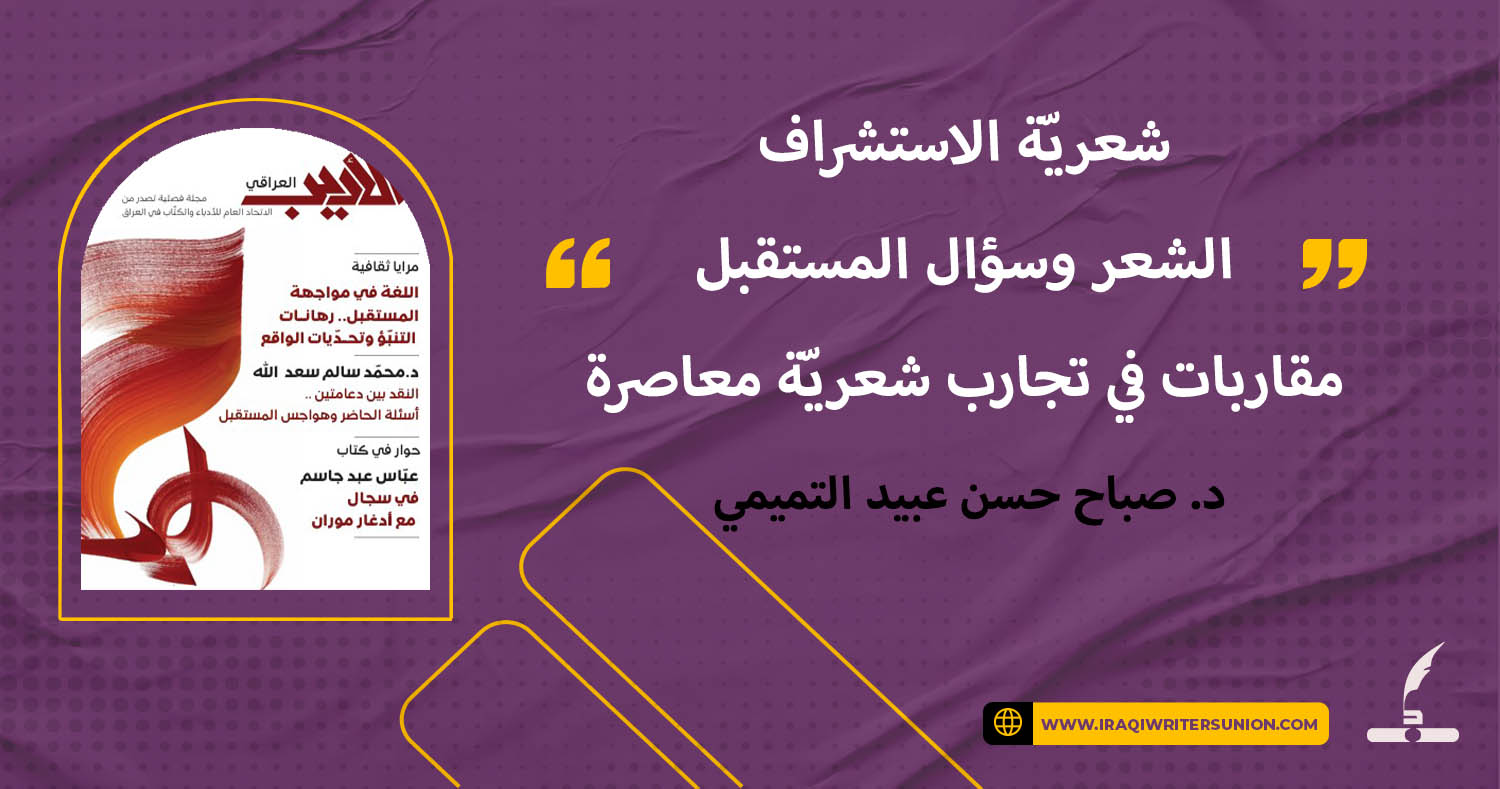
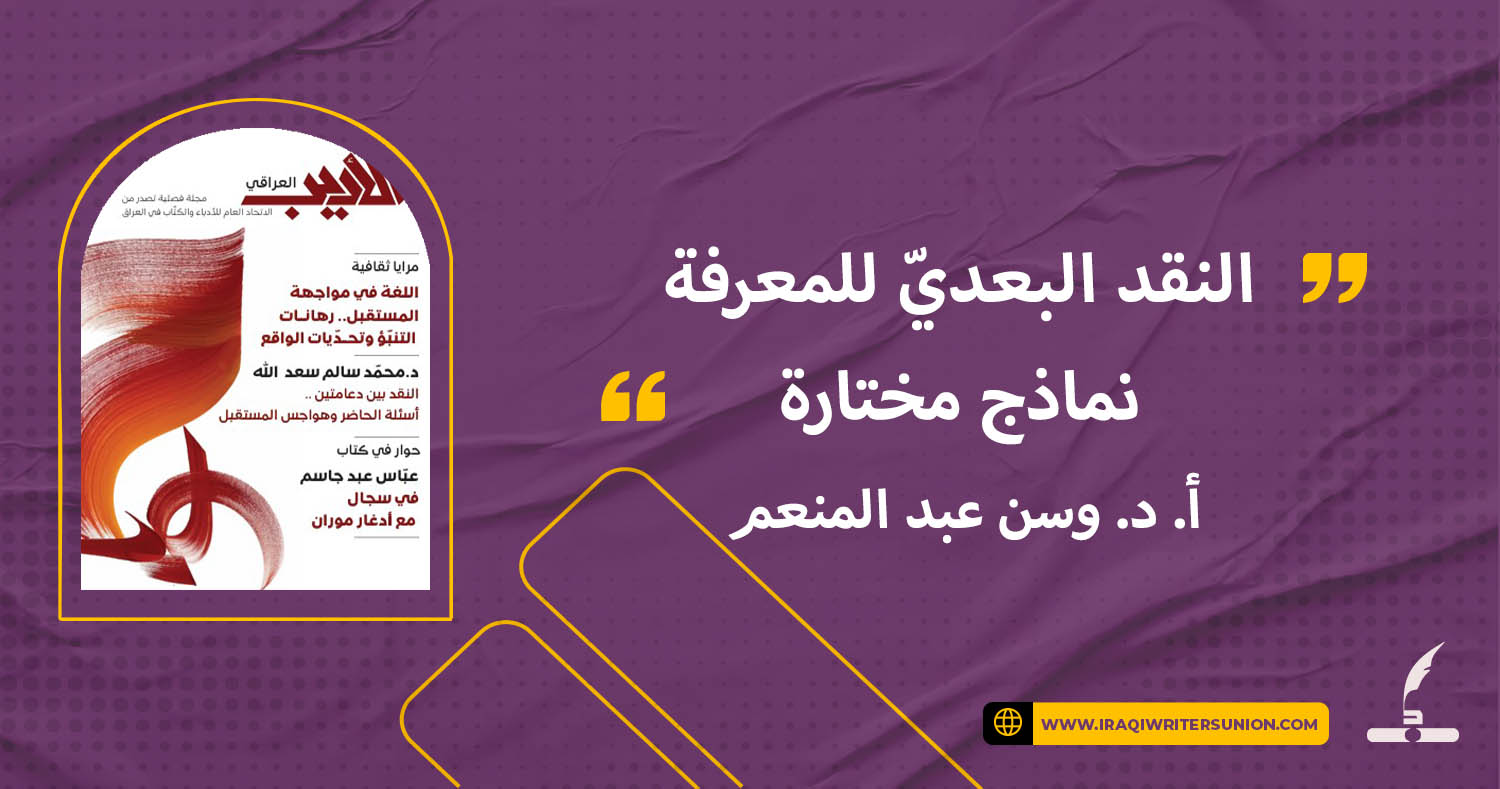
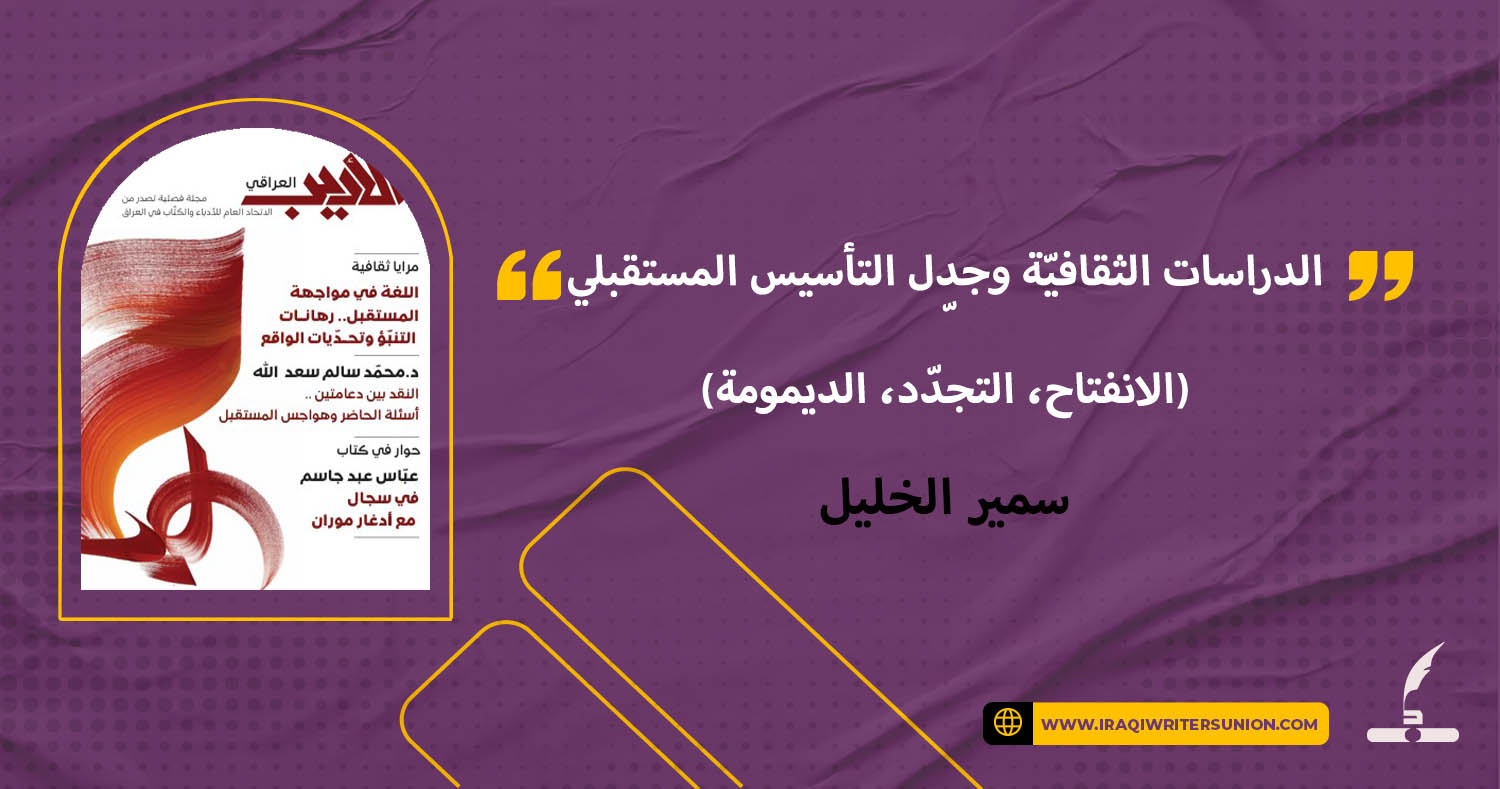

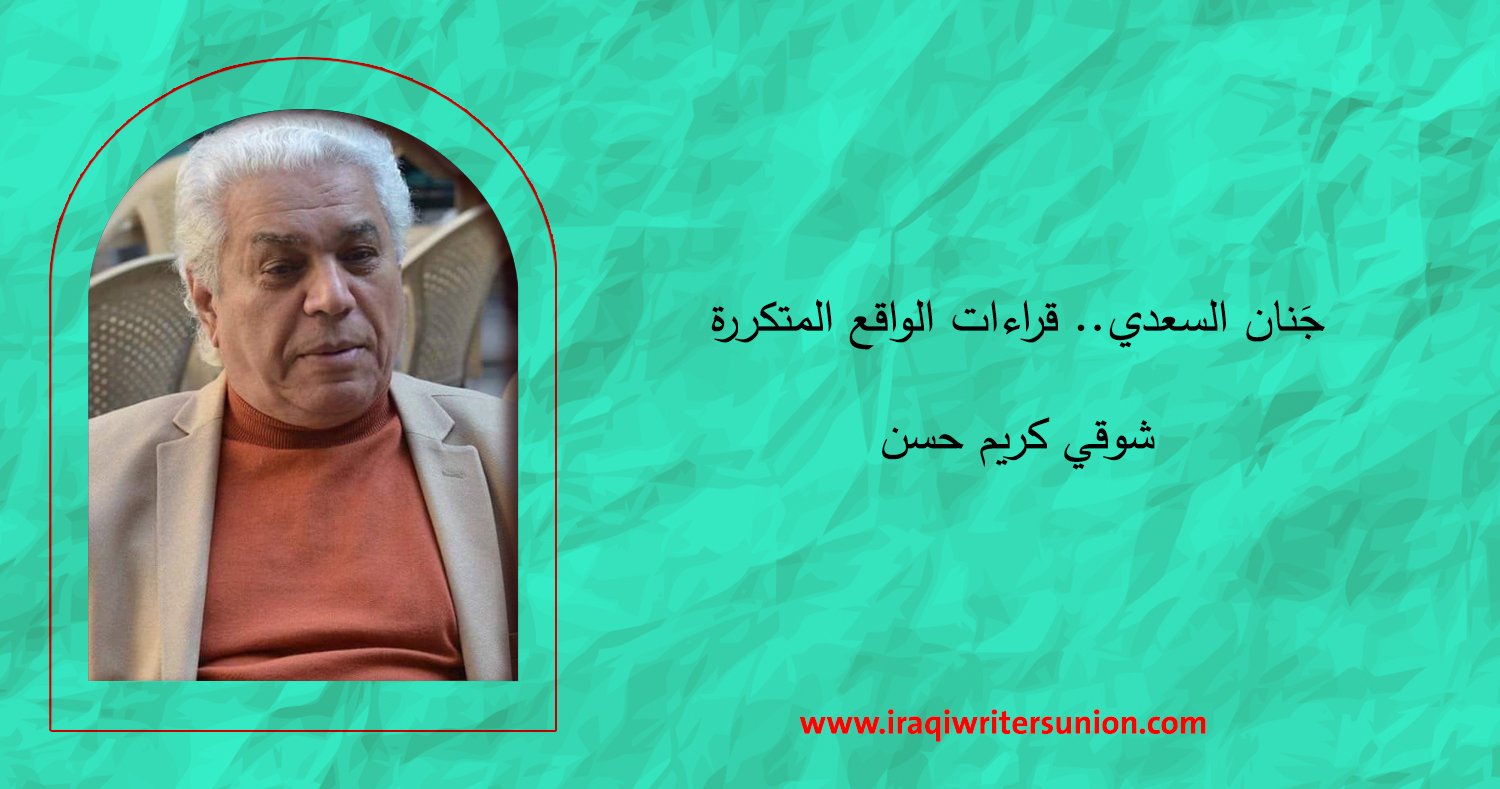

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي