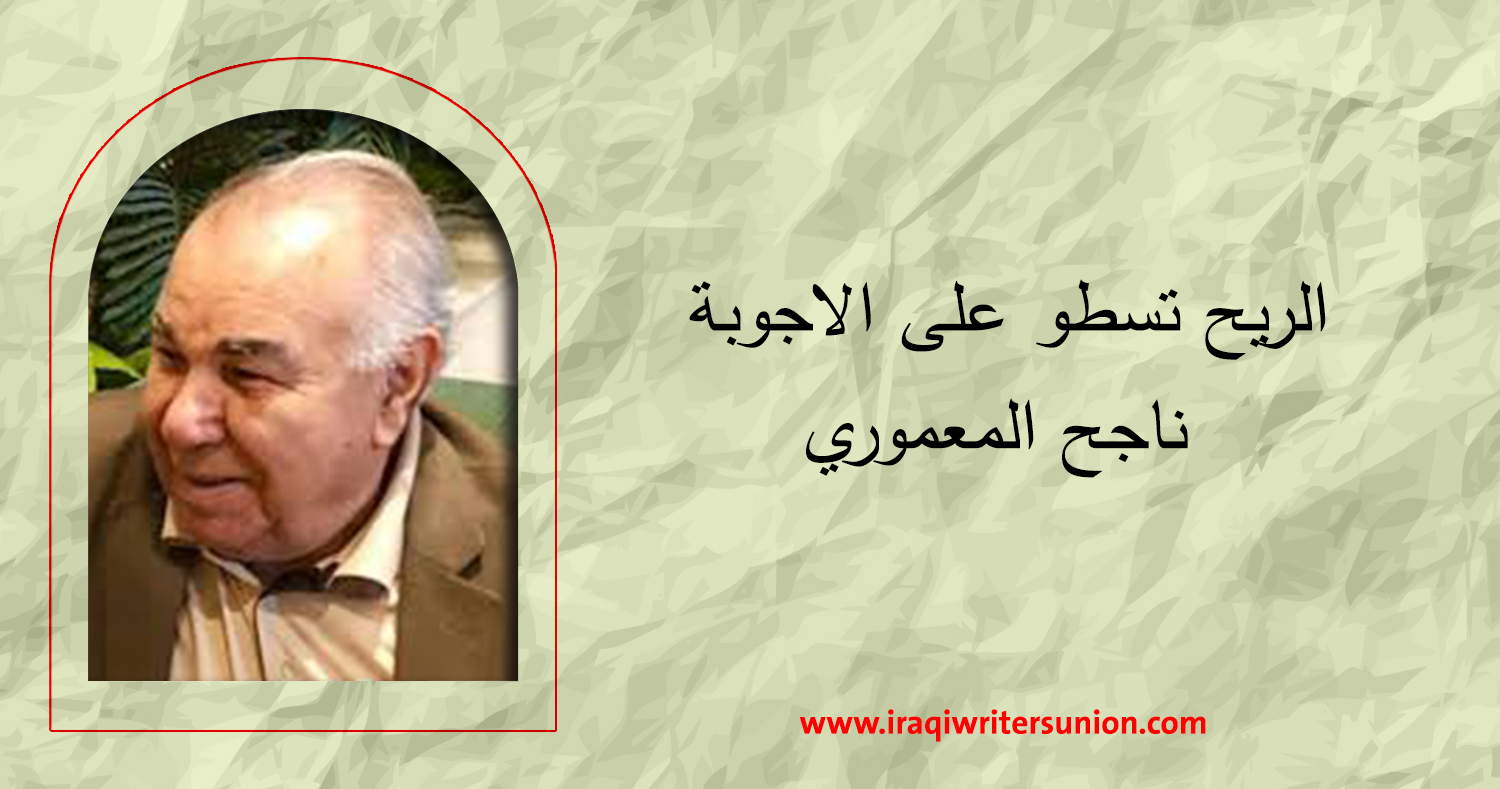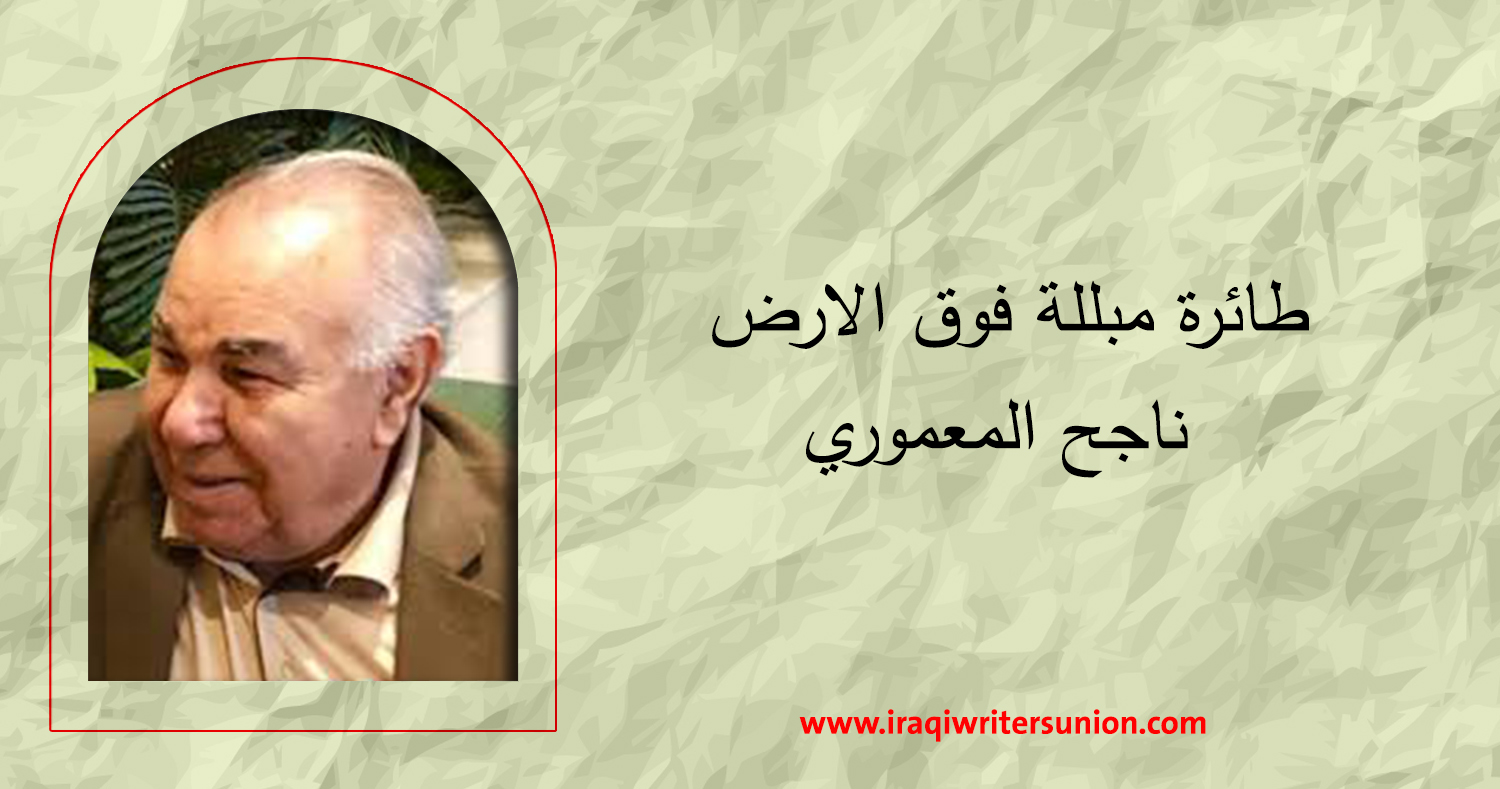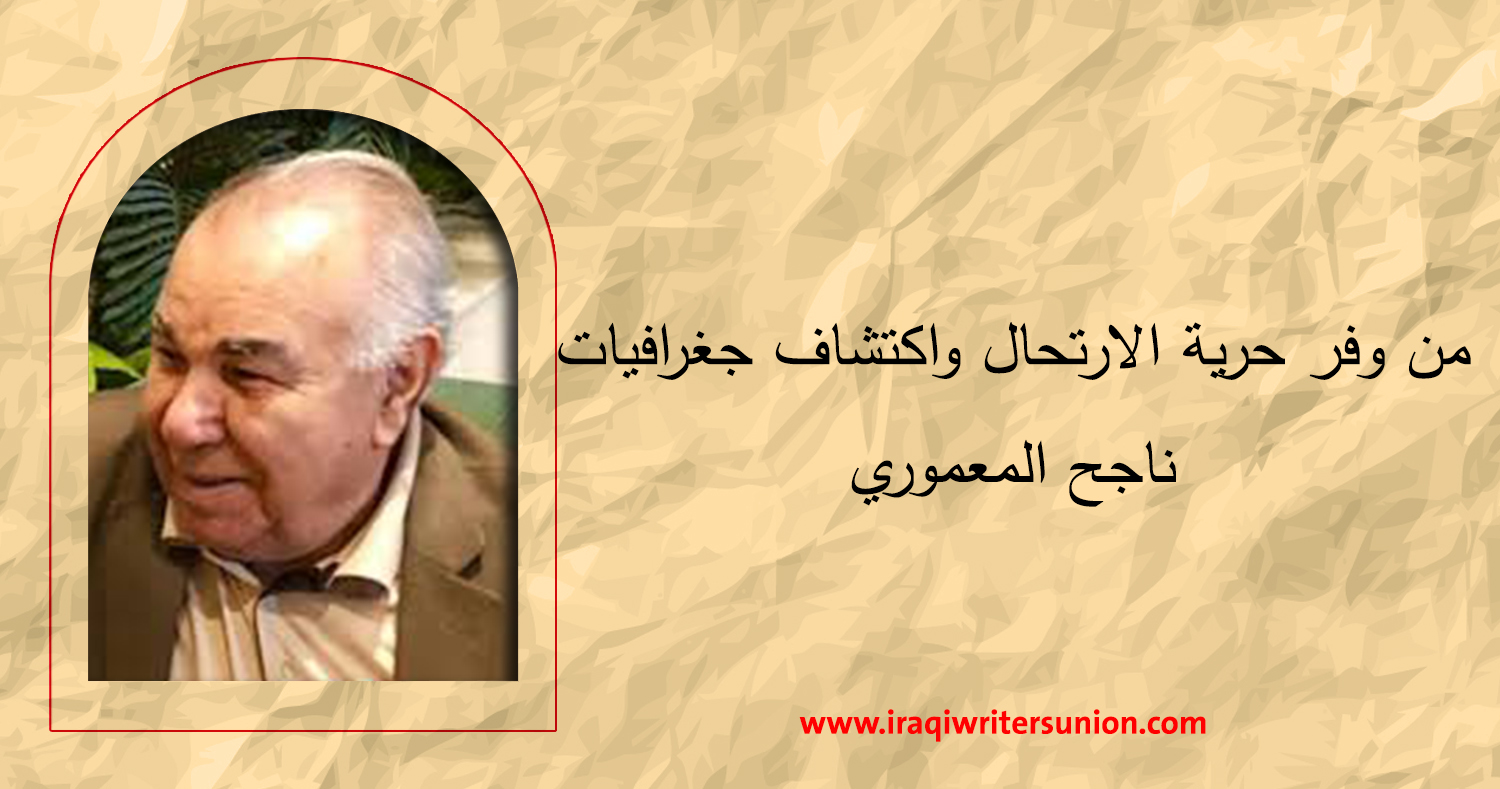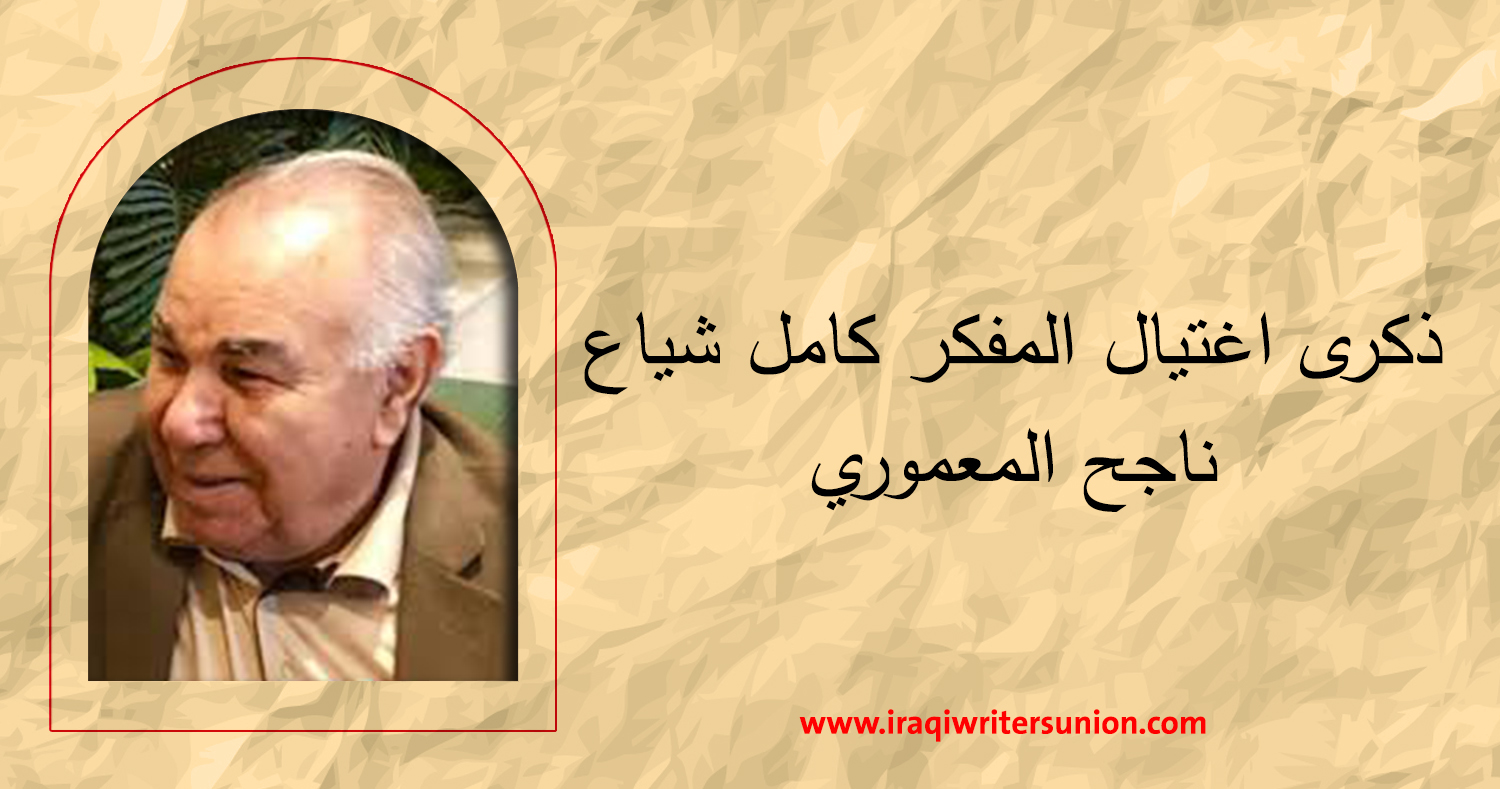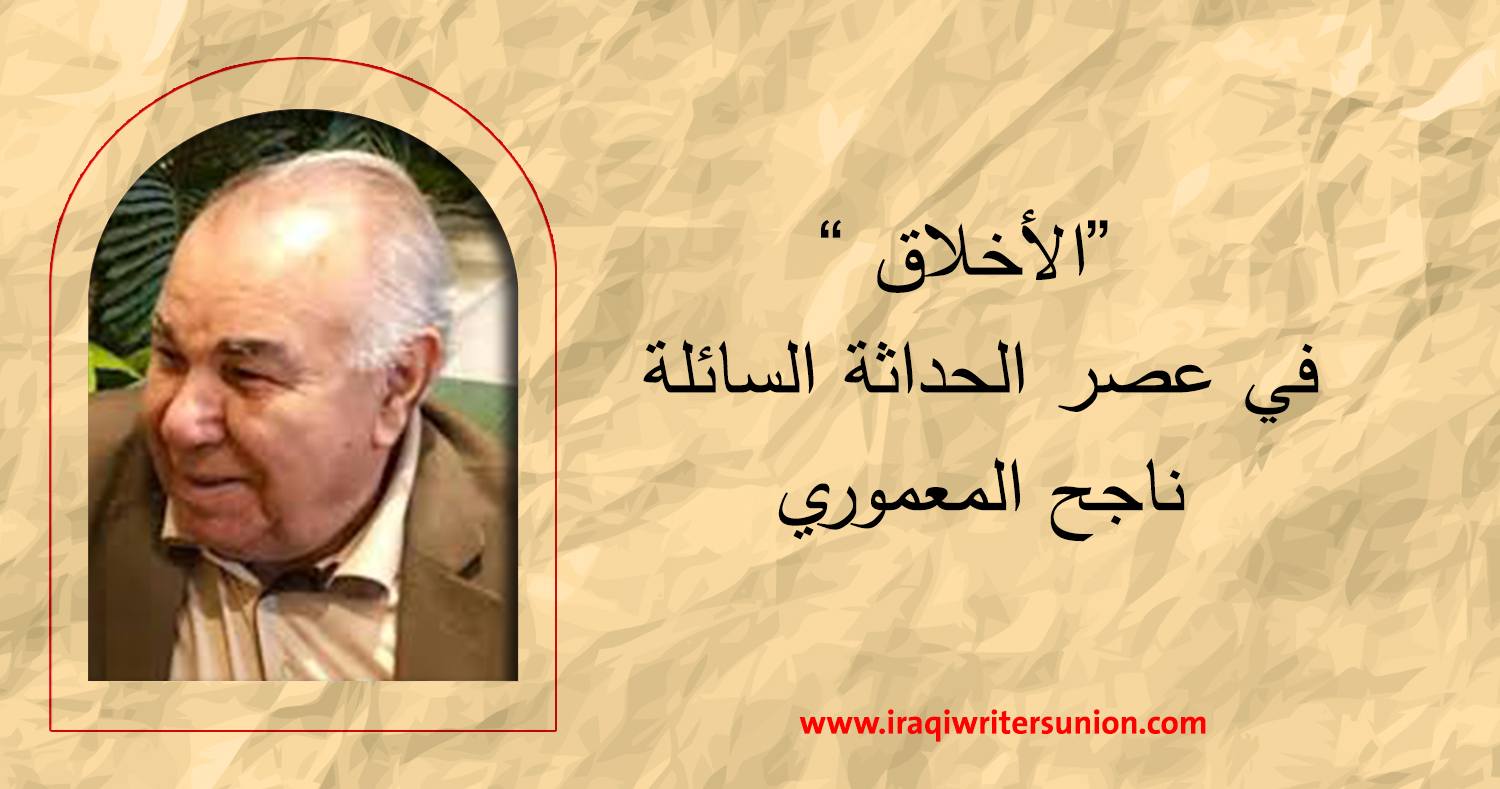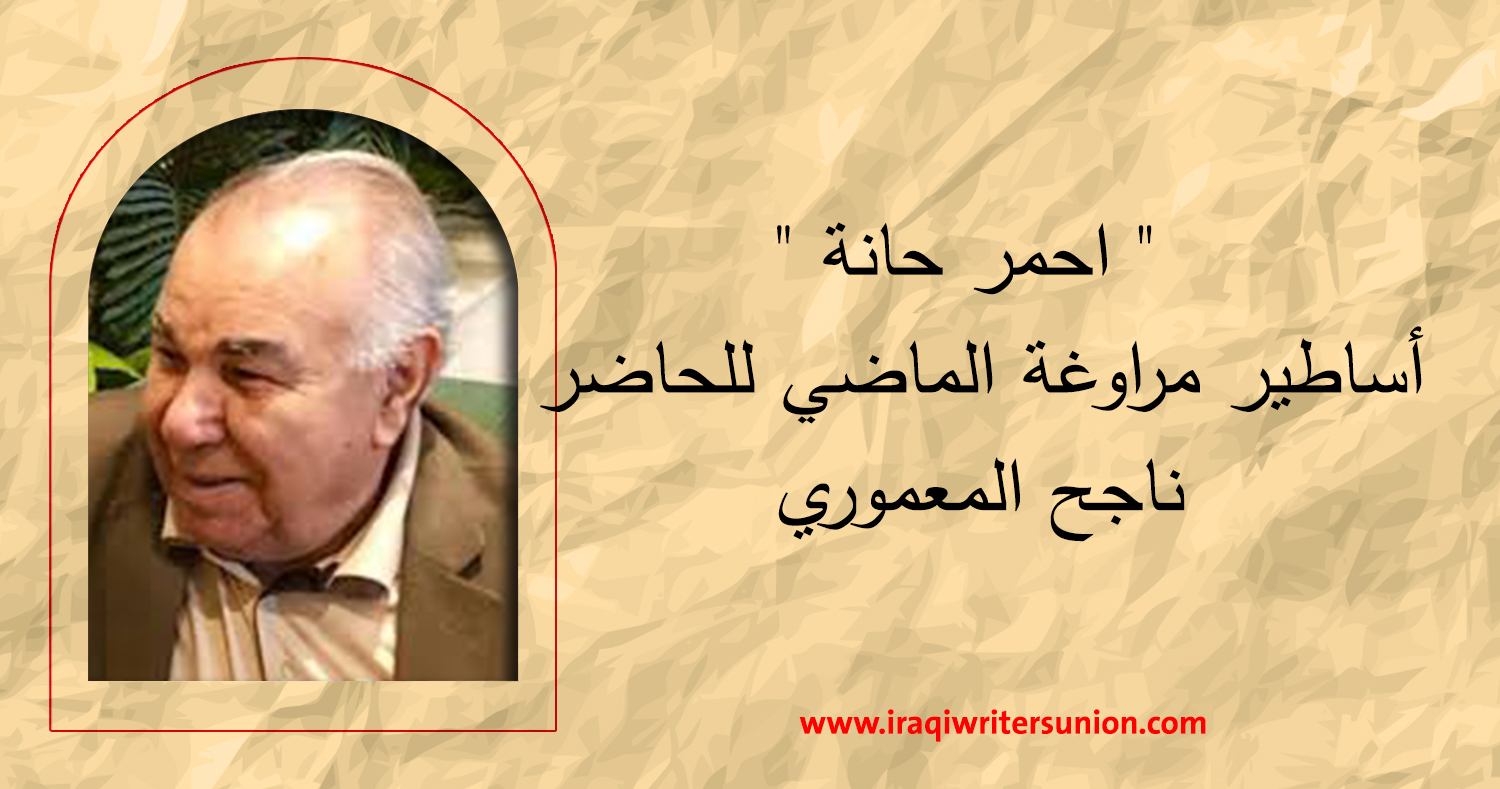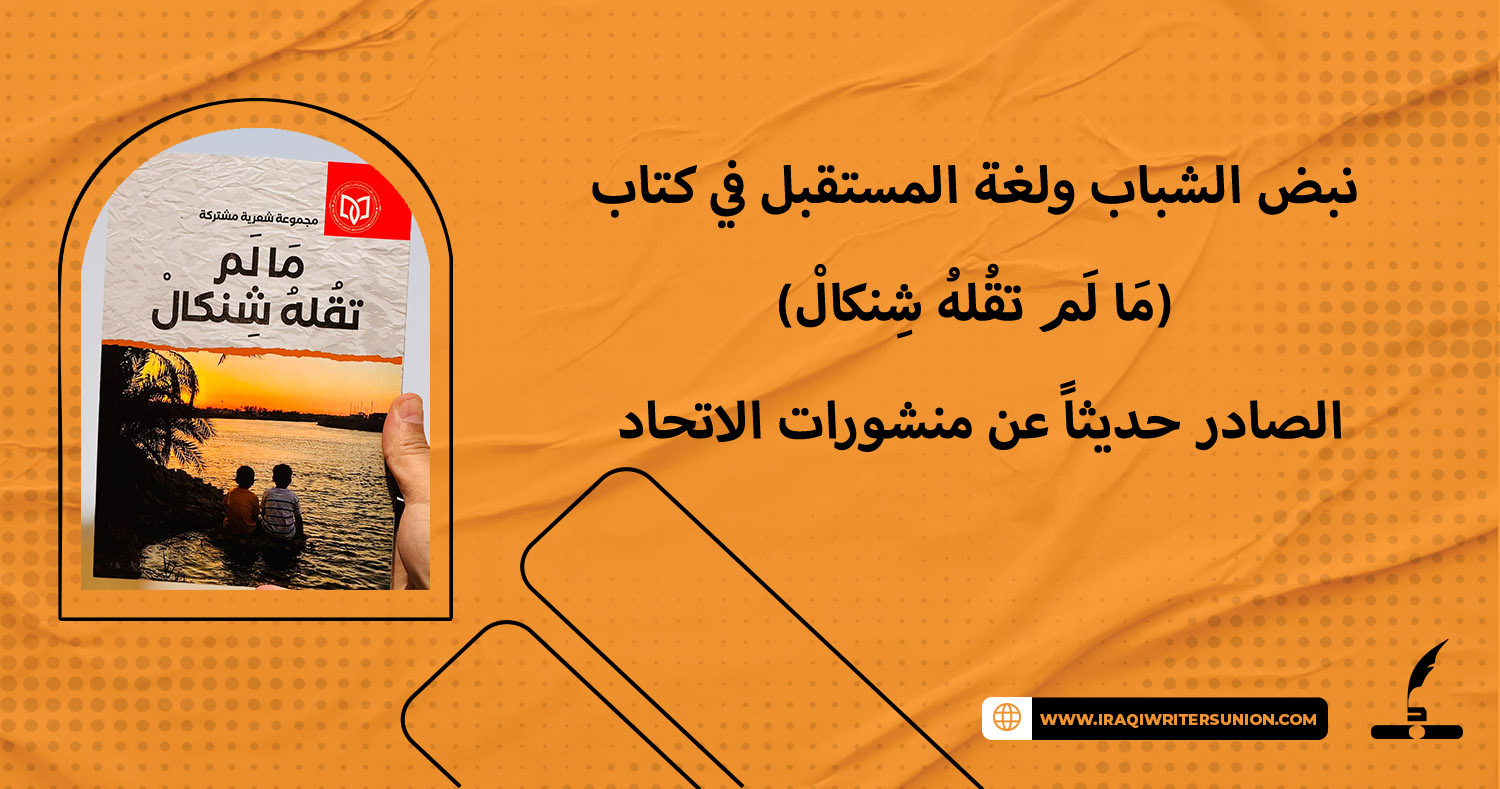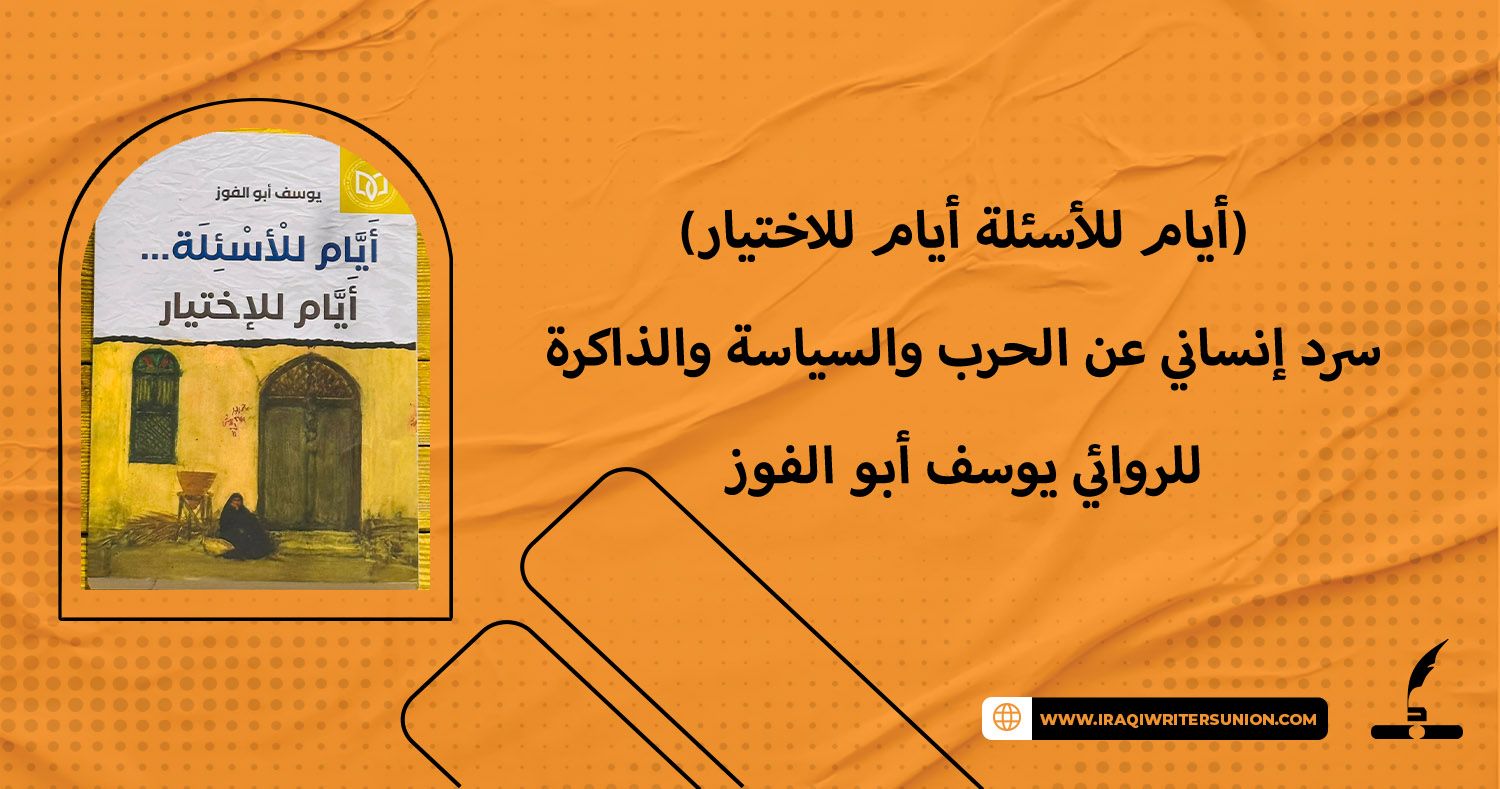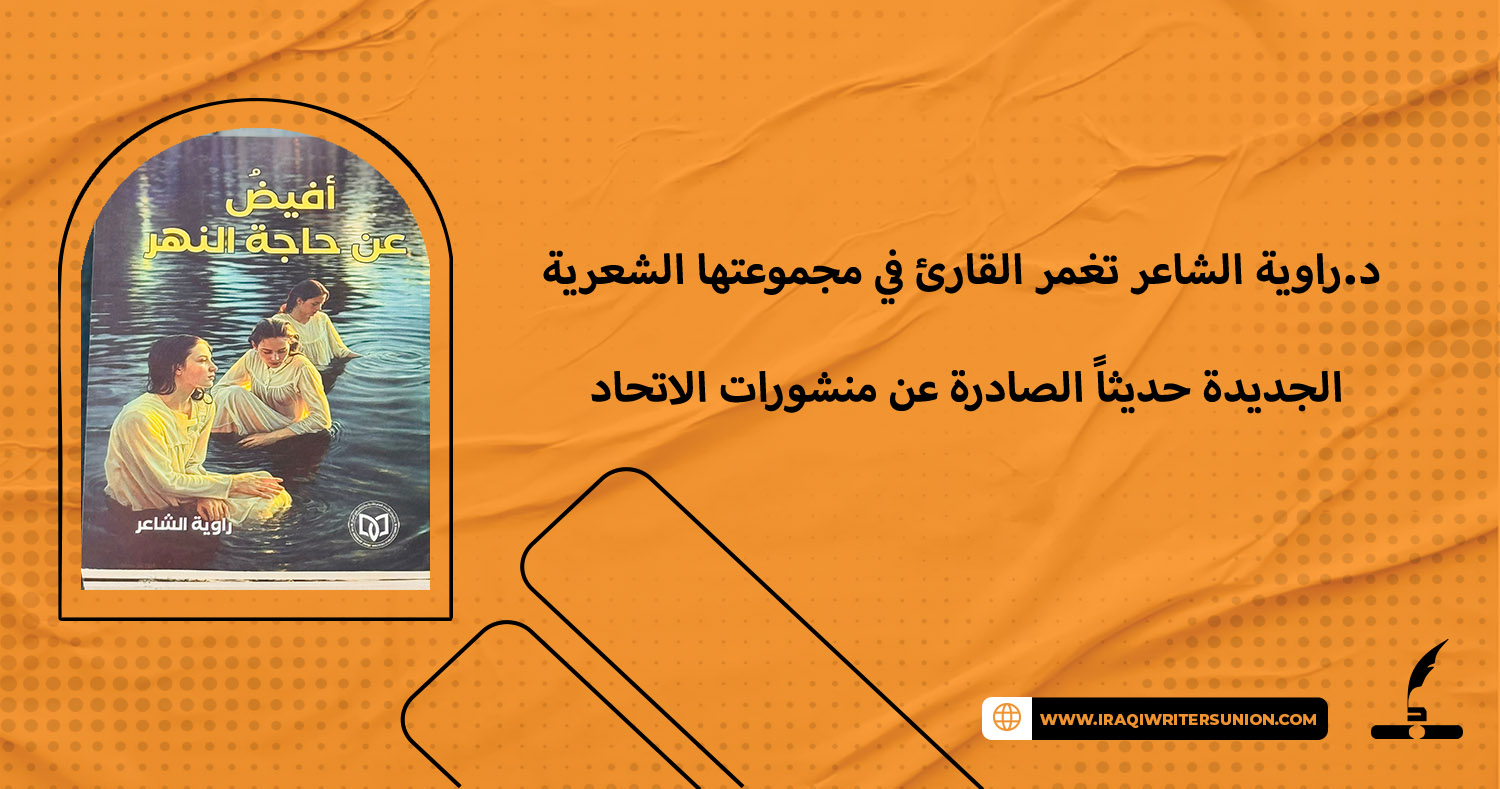شعريّة الاستشراف
الشعر وسؤال المستقبل
مقاربات في تجارب شعريّة معاصرة
د. صباح حسن عبيد التميمي
ناقد أكاديمي
"إن بين الأرض والسماء أمورًا كثيرةً
لا يحلم بها إلّا الشعراء، وهناك أمور
أخرى كثيرة فوق السماء، فما جميع
الآلهة إلّا رموز أبدعها الشعراء".
فردريك نيتشه
هكذا تكلّم زرادشت: 167
(1)
ثلاث عتبات للكشف
1-1-عتبة أولى (سؤال الشعر):
ليس سؤال الشعر بالجديد، فهو الكائن المتجدّد الذي حاولت العقول عبر التاريخ قراءته، وتحديد أطره، لكنّه ظلّ عصيًّا على الحدّ والتأطير، كائنًا أسطوريًّا لا يمكن تحجيمه بأطر ماديّة؛ ومع تفلّته وتمنّعه وعصيانه لحدود العقل ومنطقه، هو في الوقت نفسه، منفتح على القراءات الجديدة، يُظهِر مرونة عالية، تجعله ينساب بين أصابع الفكر، وهو يقلّبه محاولًا قولبته، فهو هارب على الدوام من القوالب الجاهزة؛ لكي لا يقع في الماضي، هو متحرّك مع حركة الزمن وجارٍ مع جريان نهره، وأيّ محاولة لإيقاف لحظته الزمنيّة وتجميدها، تبوء بالفشل؛ لذا فهو – من منظورنا – كائن مستقبليّ، هو فعل مضارع يقبل سين السؤال الدائمة، ومتى صار فعلًا ماضيًا سقط بالجاهز الجامد، وتحوّل إلى قطعة تاريخيّة ميّتة؛ لذا يظهر الفرق بين الشاعر والمؤرّخ -كما عند أرسطو طاليس- في أنّ ((الشاعر يروي ما يُحتَمل أن يحدث، أمّا المؤرّخ فيروي ما حدث))(1) .
ومستقبليّة الشعر، ومجانفته عن الماضويّة يُسوّغ لنا أن ننظر له بصفته (قراءة)، وهذا ما حاولتُ التشبّث به وترسيخه في مناسبات كثيرة (2)، فالشعر – في ضوء هذه الرؤية – قراءة للكون وأشيائِه باللغة، والقراءة هي كلام الكشف الصادر عن العقل الشعريّ الرائي، والرؤيا – كما سنقول – هي المنظور المستشرِف أو وجهة النظر الخاصّة الصادرة عن ذات شاعرة تقترف الانزياح عن معيّاريات الآخر ورسوخه.
2-1-عتبة ثانية (سؤال الاستشراف وشعريّته):
يقول التراث اللغويّ : ((الاسْتِشْرافُ : أَن تَضَع يدك على حاجبك وتنظر، وأَصله من الشرَف العُلُوّ كأَنّه ينظر إليه من موضع مُرْتَفِع فيكون أَكثر لإِدراكه))(3)، وهذا يعني بأنّ الاستشراف يَعْبُر مرحلة (الإدراك)، وحين نصل إلى ما بعد الإدراك ندخل في مرحلة (الوعي)...فإذا كان (الإدراك) وهو ((تمثيل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات ويُسمّى تصوّرًا، ومع الحكم بأحدهما يُسمّى تصديقًا))(4)، فهو لا يكتشف، أو يستشرف الحقيقة، أو يُصدر حكمًا على شيء يراها ماثلةً فيه، بعكس (الوعي) الذي يُمثّل مرحلة أكثر تقدّمًا من الإدراك، فالوعي من منظور آخر، نشاط يتحرّك صوب محاولة اكتشاف "الحقيقة" في تجلّياتها ومظاهرها المتعدّدة، وبهذا يتشكّل هدفه الأسمى، الذي يكمن في الرغبة الدائمة في تجاوز ما تمّ اكتشافه، والتحرّك إلى قارّة "المجهول" في الفكر والإبداع، فهو – بعبارة أخرى – فعاليّة متحرّكة لا تؤمن بالثبات والاستقرار(5).
ونستطيع أن نقول بأن للاستشراف تَجَلِّيَيْن: إدراكيّ، ووعييّ، ونحن نعوّل على الاستشراف الثاني، الذي يُنتِج رؤيا جديدةً بعد محاولة إعادة تعريف الأشياء من منظور الذات الشاعرة.
وشعريّة الاستشراف – كما نراها هنا - صيغة تشكيليّة فنيّة تصدر عن اللغة المنزاحة التي يقرأ بها الشاعر الكون وأشياء المستقبل من منظور خاصّ، وفيها تكمن طاقة اللغة الشعريّة الخاصّة، وفي تعالقات عناصرها تكمن كلّيتُها التي تقول رؤيتَها الخاصة بالمآلات.
3-1-عتبة ثالثة (سؤال الرؤيا):
فلسفيًّا يُفَرَّق بين (الرؤية) و(الرؤيا)، انطلاقًا من أنّ الأولى مختصّة بما يكون في اليقظة، فيما تختصّ الأخرى بما يكون في النوم، فالرؤيا بالخيال، والرؤية بالعين (6)، ومن هنا كانت الرؤيا حلميّة، والرؤية واقعيّة.
في الشعر تقترب وجهة النظر أو (منظور الشاعر) كما أسمّيه، من معنى (الرؤيا الحلميّة)، لا سيّما فيما أطلقنا عليه (شعريّة الاستشراف)، فـالرؤيا الشعريّة ((رديف الحلم، والنظر الصوفيّ، والامتزاج بالكون، والتوحّد بأشيائه، إنها تَغَيُّر في نظام الأشياء وفي نظام النظر إليها، وهذا النظام المختلف، في النظر إلى الأشياء، يعمّق صلة الشاعر بتجربته، ويُرصّن رابطته بالكون، والحياة، والأشياء، فيجعل من هذه الصلة، لا نقاط تماسّ مجرّدة، بل انصهارًا حارًّا، واندماجًا في تيّار جارف، شديد الفرادة)) (7).
إن العلاقة بين شعريّة الاستشراف بمبناها الفنّي، والرؤيا ببعدها المضمونيّ التخييليّ الحلميّ مبنيّة على قراءة الآتي، وهي عمليّة تبادل أدوار إنتاجيّة تحدث في النصّ، فحين يبدأ العقل الشعريّ الرائي بفعل الاستشراف من خلال اللغة، تبدأ الرؤيا بالتشكُّل محدثةً خلخلةً في الثابت من القراءات، مقترحةً بدائل رؤيويّة عن المتاح والجاهز والمرميّ في الطرقات؛ لذا فهذه العمليّة بكليّتها، عابرة للجاهز المتكدّس، مقترنة – دائمًا - بحداثة المنظور، وسيولة الرؤى المضادّة لجمودها.
ولنا أن نفرّق – في هذا المقام – بين شعريّة الاستشراف، والرؤيا، بوصف الأولى – عندنا – تمثّل المبنى الحلميّ، بينما تمثّل الأخرى – أي الرؤيا – المعنى الحلميّ، والاثنان يُشكّلان النص الاستشرافي المُتَخَيَّل القارئ للمآلات.
(2)
المقاربات
2-1- تجربة (آدم الأخير) لعارف الساعدي:
الشاعر المُستَشْرِف الرائي، هو الذي يرى كلَّ شيء في كلِّ شيء بعين الرؤيا لا بعين الرؤية؛ لذا فهو لا يقول قصيدةً آنيّة المفعول، بل يُنجِز قراءةً عابرةً للأزمنة والأمكنة الضيّقة، وهذا الكلام لا يعني بالضرورة ارتباط القصيدة بأزمنة الماضي أو الحاضر أو المستقبل؛ بل يعني ارتباطها بالحضور الدائم الخالد، كما تحضر بيننا اليوم قصائد المعرّي مثلًا، بمعنى أنها تُحقِّق صلاحيّة حضور مُنفَتِح على كلِّ الأزمنة والأمكنة، ((فالقصيدة الخالدة شعريًّا هي القصيدة التي تمتلك مبدًأ شعريًّا، بمعنى أنها ذات بعد فنّيّ خاصّ، يسمو بها فوق حدود الزمان والمكان الثابتين، إلى آفاق الزمان والمكان المتحرّكين والشاملين المرتبطين بحركة الفكر الإنسانيّ))(8).
برأيي يمكن أن ننظر إلى هذا المبدأ الشعريّ الذي يكسو القصيدة بُردة الخلود من زاوية المعالجة، فحين تُعالج القصيدة موضوعةً كونيّة، معنى هذا أنها تقرأ ثيمةً إنسانيّة عامّة، ما يجعلها صالحة المفعول على نحو دائم؛ لأنّها ببساطة تنطق بلسان الذات الإنسانيّة العامّة، وهي بذلك تنجح في كلِّ مرّة يتمُّ فيها استدعاؤها بإرضاء الذات الإنسانيّة الكونيّة المزروعة في كلٍّ منّا نحن البشر، كأَنْ تُعالِج مثلًا سؤالَ النهاية، هذا السؤال الكونيّ العالق في رؤوسنا: كيف سينتهي بنا هذا الكون؟ وهل من ناجٍ أخير؟ وماذا سيفعل بعد أن يكتشف بأنّه الناجي الأخير؟
في عموم تجربة الشاعر عارف الساعدي نلحظ انعطافاتٍ وتمرحلاتٍ رؤيويّةً أخذت بالظهور منذ (جرّة أسئلة 2013م)، وباتت لغة السؤال الوجوديّ تُشكّل المهيمن الأكثر نضجًا وفاعليةً فيها، وشاع – بعد هذا - ما يُمكن أن نُسمِّيه بـ(الاستفهام الاستشرافيّ) الذي بدأ المبنى الفنّيّ لشعريّة الشاعر بعامّة يعتمد عليه، ويُعنى بتشكيله على نحو خاصّ.
وقد سجّلَ بعض النقّاد هذا الانقلاب الرؤيويّ عادًّا (جرّة أسئلة 2013م) و(مدوّنات 2015م) المدوّنتين الشعريّتين اللتين بدأت معهما لحظة النضج الأكبر في رؤيا الشاعر الشعريّة تتّضح بشكل جلي(9).
لكننا نرى أن ديوان (آدم الأخير 2019م) هو المدوّنة التي مثّلت ذروة النضج الرؤيويّ والاستشرافيّ في تجربة الشاعر، لاسيّما في بؤرة الديوان الاستشرافيّة وأعني القصيدة التي اكتسب الديوانُ عنوانَه منها، وهي قصيدة (آدم الأخير) التي تبدأ بمفصل استشرافيّ مهمّ، يُبنى على ما أسميناه بـ(الاستفهام الاستشرافيّ)، الذي يحتقب معه رؤيا الشاعر القارئة لنهاية العالم:
((ما الذي يفعلُه آدمُ في هذا الفراغ المرّ؟
ماذا يسمع الآن؟
ومن يسمعه في لحظة الغيب النهائيّ؟
وعن ماذا يقولُ؟
هدأ العالمُ من ضجّته الكُبرى
وفزَّت بينَ عينيه الطلولُ
آدمُ المنسيُّ في خاصرة الوقت وحيدًا كالبداياتْ
ومنسيًّا كبيتٍ لم يُقَلْ يومًا
وملقىً في تُرابِ العمرِ
عافتْه الخيولُ
ما الذي يفعلُه آدمُ في هذا الفراغ المرّ
والناسُ جميعًا غادرتْ
أصحابُه انحازوا إلى التيه
وأغرتهم فراشاتُ الغيابِ الأبيضِ الفضيِّ
فامتدّوا مع السحرِ وغابوا
هدأ العالمُ، وانسابَ من الغيبِ الضبابُ
كلّما في هذه الأرضِ سؤالاً تائهًا يبقى
وبلدانًا يُغطّيها الترابُ
آدمُ الناجي من الموت وحيدًا يسألُ البحرَ
ويُلقي للبنايات عصاهْ
وحدَه يمشي فلا حرّاسَ في الأرضِ
ولا طيفًا يراهْ
آدمٌ يملكُ هذا الكون
هل آدمُ منسيٌّ على خاصرةِ الوقتِ أجبني يا إلهي
أم تُرى آدمُ في التيه إلهْ
.
.
.
آدمٌ يخرجُ من باريس أو روما ومن كلِّ العواصمْ
يزحفُ الآنَ إلى البحر المحيطاتِ فما من غرقِ الوحشةِ عاصمْ
ربِّ مَن أنتَ؟
وأينَ الآنَ ألقاكَ وما في هذه الأكوان إلاّكَ وهذا التائه المرميّ في الخوفِ غريقا؟
كنْ ولو يومًا لِمَن تأكلُه الوحشةُ يا ربّي صديقا.
.
.
........)) (10).
القصيدة طويلة ذات نفس ملحميّ، وهي تُبنى على هذا النمط المختلف من الأداء الذي يختلط فيه السرد القصصيّ بالقناع والرمز، ويُمثّل عند الشاعر أنضج تجربة لتقديم قراءة شعريّة كونيّة، تُخرجه من المحليّة الضيّقة، وتُعممّ التجربة؛ لتكون عابرةً لحدود الأمكنة، وفيزيائيّة الأزمنة.
إن هذه التجربة إفاقة جديدة تُوقظ القصيدة التفعيليّة القصصيّة الطويلة التي شاعت عند الروّاد، وهي – عند الشاعر في وقتها – إعلان فنّيّ رسميّ، عن ولادة شعريّة مغايرة، مفارقة للعمود الذي كان مهيمنًا على تجربته بشكل مخيف.
إنها تنجح في خلق نسق لازمانيّ عابر، له قدرة - عند كلّ قراءة استعاديّة - على الحضور بلا أنساق تُضمِر الخاصّ، الضيّق، المحلّيّ، وهذه الزاوية بالتحديد، تجعلها متنًا شعريًّا مفتوحًا قابلاً للدوران والتكرار في بيئات إنسانيّة مختلفة؛ لأنها تحتقب حالة إنسانيّة كونيّة، يشترك فيها إنسان هذا الكون بمختلف ألوانه، يُبئّرها سؤال النهايات والمآلات.
لقد أَثْرَتِ الشعريّةُ الاستشرافيّة الحاضرة باستفهاماتها الاستشرافيّة المتراكمة في القصيدة التجربةَ عامّةً، ونقلتها من مداها الشخصيّ إلى مديات إنسانيّة شاسعة، خالقةً جوًّا كونيًّا جديدًا تُنتِج فيه الذات الشاعرة رؤى وأسئلةً ذات تمثّلات إنسانيّة كونيّة، حاولت الذات الإنسانيّة – عبر العصور - أن تفكّكها وتهتدي لأجوبة مُرْضِية لها، أهمّها وحشةُ بني آدم في نهاية العالم، وما ستؤول إليه شؤون هذه الأرض، وغربتهم فيها؛ لذا لنا أن نعدَّ هذه القصيدة لسانَ حالٍ شعريًّا يتكلّم بالنيابة عن مخاوف إنسان هذا الكون الآتية، وهي تجربة ناجحة، تُقدّم المشهد الأخير لآخر إنسان في هذه الأرض مصوّرًا بكاميرا الشاعر اللغويّة.
بقي علينا أن نُنبّه إلى مسألة غاية في الأهميّة في تجربة الاستشراف العامّة عند الشاعر عارف الساعدي، وجديرة بأن تُثار هنا، هي إن في تجربة الشاعر يحضر آدمان، آدم الأوّل في (قصيدة آدم) التي هي من قصائد (جرّة أسئلة 2013م)، وآدم الأخير، القصيدة المنشورة سنة 2019م في ديوان (آدم الأخير)، والتجربتان مختلفتان – عندنا – أسلوبيًّا ورؤيويًّا واستشرافيًّا، ففي آدم الأوّل، يحضر الأسلوب الاسترجاعيّ الاستعاديّ، الذي يستدعي تجربة آدم الماكثة في التاريخ والأديان والميثولوجيا؛ لمساءلتها، وتقديم قراءة شعريّة عنها، وتبدأ قصيدة (آدم) – أعني آدم الأوّل – بدايةً استفهاميّةً أيضًا:
((أبتي يا أبتي آدمْ
ماذا أحسستَ
وأنتَ تفتحُ عينيكَ لأوّلِ يومٍ
كي تكتشفَ العالمْ
أبتي آدمْ
وبماذا كنتَ تفكّرُ يا أبتي
أحلمُ أن أدخلَ قلبَكَ هذا اليومْ
لأفتّشَ عن تلكَ اللحظاتِ الأولى
حيثُ العالمُ يخرجُ من بيضتِه مغسولاً
يخرجُ مندهشًا وقليلا
كيف خرجتَ إذًا يا أبتي؟
هل كنتَ صبيًّا مثلي في يومٍ ما؟
هل مرّت فيكَ مراهقةً وحشيّةً؟
هل كنتَ تُخبّئُ رأسكَ في حضنِ امرأةٍ ما؟
هل كنتَ تُقبّلُ أمّك؟
عفوًا
هل تعرفُ طعمَ الأم؟
إنّي أرثي وحشتَك المجنونةَ يا أبتي
ولهذا أنت صنعتَ جميلاً
حين أكلتَ التفاحةَ يا أبتي)) (11).
تنتهي القصيدة بهذا المنظور؛ لتمتاز عن سابقتها بتقلّص حجمها بنائيًّا ورؤيويًّا، ولعلّ الفارق المهمّ بين هتين القصيدتين يكمن في أن الأولى – قصيدة آدم - تسترجع الماضي المتاح للجميع في لحظة حاضر متسائلة، والثانية – آدم الأخير - تستشرف الآتي المجهول، ويمكن القول بناءً على هذا المُعطى، إن الاستفهام في الأولى استرجاعيّ، في حين في الثانية استشرافيّ، وبين الاثنين بونٌ تقنيّ شاسع، فالسؤال الاسترجاعيّ يبقى في دائرة الماضي، وهو استدعاء رمزيّ يحافظ على صيغة المُستدعَى، بوصفه رمزًا ثابتًا لا يمكن التلاعب بثوابته النسقيّة، بينما يكون السؤال الثاني استشرافيًّا، يعبُر لحظة الماضي والحاضر إلى المستقبل المجهول، ويستعين بتقنية القناع التي تُمثّل – برأيي – آليّة تفكيك متطوّرة عن تقنية الرمز، ففيها تحصل حالة محو للرمز المُستدَعى؛ فالشاعر فيها لا يكتفي باستدعاء الشخصيّة الرمزيّة بل يتعدّاها، عبر تذويبها وصهرها في التجربة؛ لتصير جزءًا من نسيجها الشعريّ.
إننا في التجربة الأولى أمام شاعر معزول، يقف خارج التجربة باحترام، وهو يحاور الرمز المقدّس (آدم) من طرف واحد، دون أيّ محاولة لاختراق حدود زمنه الماضويّ، بينما في الثانية نكون بإزاء كسر للحدود الزمانيّة والمكانيّة بين الشاعر والرمز عبر التقنّع به؛ لخلق لحظة اتحاد غرائبيّة تتّحد فيها الذات الشاعرة بالرمز وبالذات الإنسانيّة العامّة اتحادًا تامًّا، في مشهد تحوّلٍ استشرافيّ مُتَخَيّلٍ يرتفع بالتجربة إلى عوالم مثيرة للأسئلة تجعلها مختلفةً عن السائد الشعريّ.
ولم تكتسب القصيدة مبدأ الخلود هذا، إلّا حين تحوّلت في التعامل مع (رمز آدم) من الخارجيّ القشريّ إلى الداخليّ العميق؛ فـ((في القصيدة تماهٍ مع (آدم) الأوّل رمزًا، دينيًّا قرآنيًّا ولكنه التفت إلى كلّ (آدم) من بنيه متلبّسًا به قناعًا، متماهيًا معه، متبنّيات وأسئلة، كان صوت الشاعر ناطقًا باسم (آدم) مختفيًا بين عواطفه ودوالّه في التاريخ وفي الراهن غالبًا، جاعلاً من ذلك كلّه مسافة وصول كاشف عن حيرة آدم الآن)) (12) وبعد الآن.
2-2- تجربة (2073 - بغداد / نهاري خارجيّ) لعمر السرّاي:
إن أهمّ ما يُميّز شعريّة الاستشراف – كما نراها هنا - اشتمالها على علامات بنائيّة مفصليّة دالّة على المآلات، في حال تفريغها منها، تكفّ عن أن تكون شعريّةً استشرافيّةً، وتذوي الرؤيا الاستشرافيّة فيها، بمعنى إن الاثنين (شعريّة الاستشراف والرؤيا) يصدران عن نيّةٍ واحدة، هي التنبّؤ بالمآلات، واستشراف المشهد المستقبليّ للتجربة البشريّة بعامّة باختلاف طرق الأداء الشعريّ.
بهذه العلامات – التي تختلف من تجربة إلى أخرى – تكتسب الشعريّة هُويّتها الاستشرافيّة، وتُصبح شعريّةً صالحةً للآتي، تُنتِج لنا قصائد مستقبليّة، قد تكون عابرة للزمن، وقد تكون قادرة على امتلاك صلاحيّات لحظة وجودها الزمانيّ المستقبليّ، وهي بشكل عامّ تنبّؤيّة احتماليّة قائمة على الرؤيا الحلميّة الخياليّة.
إننا في تجربة عمر السرّاي المقروءة هنا أمام قصيدة نثر استشرافيّة واضحة المعالم الزمانيّة والمكانيّة منذ عتباتها، وهي تُوظّف آليّة استشرافيّة تنهض على (السرد الاستباقيّ) بِنَفَس تهكُّمي كوميديّ أسود:
(( حين تتحوّلُ حكاياتُنا بعد سنين..
إلى كاميرا .. ودراما.. وحوار..
سيستعيضون عنّي بشابٍ تدَّعِينَ بأنّي كنتُ أحلى منه..
وعنكِ.. بملاكٍ من غمامٍ وسُكَّر ..
وسنذوي ..
ونشيبُ ..
بسهولة ..
بسلطةِ الماكياج ..
لكنَّ ما سيعاني منه المخرجُ ..
هو كيف سيتدبَّرُ أمرَ مليون سلكٍ لمولّدات المناطق ..
تظهرُ خلفَ صورةِ يدينا المتشابكتين ..
وتذبحُ أرواح قبلتنا المُتخيَّلَةِ بدهليز فولتيتها الهاربة ..)) (13).
في هذه القصيدة القصيرة، نلحظ الذات الشاعرة وهي تحاول جاهدةً - مستعينةً بشعريّة الاستشراف وآليّاتها – أن تصنع عالمها الموازي المُتَخَيَّل المُسْتَشْرَف الذي يبني ملامح مآلات الأشياء في الزمان والمكان المُحدّدين عتباتيًّا: (2073 - بغداد / نهاري خارجي)؛ لإنتاج رؤيا شعريّة قائمة على استشراف التَغَيُّرات التي تُصيب أنظمة الأشياء الراهنة في المآل، وفي نظام النظر إليها؛ لتعميق صلة الشاعر بتجربته، ثم إشراك المتلقّي بها.
إنها تجربة استشراف ذاتيّة تستعين بالسرد الاستباقيّ؛ لترسيخ فعل الاستشراف المستقبليّ، وتلعب – لغويًّا بنائيًّا - (سين الاستقبال) وما تعالق معها من أفعال المستقبل: (سيستعيضون – سنذوي – سيعاني -سيتدبَّرُ) دورًا جوهريًّا؛ لنقل التجربة من الأوان إلى المآل.
بَطَلَا التجربة الاستشرافيّة – هنا - هما الشاعر وحبيبتُه، اللذان أُضمِرا في النصّ، في ضمائر (التكلّم والخطاب)، وتدور التجربة في إطار زمانيّ ومكانيّ محدّد منذ عتبة العنوان، وهذا برأيي محاولة لإضفاء الواقعيّ على المُتخيّل؛ لتحقيق نسبة تصديق بالفعل الاستشرافيّ المُنجَز، ويأتي توظيف معجم اليوميّ: (كاميرا – دراما - سُكَّر –ماكياج - مخرج – سلك - مولّدات – فولتيّة)؛ لإضفاء شرعيّة على فعل الاستشراف المُتخيَّل، فبيئة الاستشراف المكانيّة صادرة عن بيئة المتلقّي المحليّة، ما يُقوّي عنده نسبة الإحساس بالتجربة، ويُعمّق فكرة التعايش معها بوصفها حقيقةً واقعيّةً ستأتي في يوم من الأيّام، مع هذا التسارع المخيف لكائنات التكنولوجيا المحيطة بنا.
وتأتي تلقائيّة اللغة وعفويّتها؛ والابتعاد عن المجازات والاستعارات والانزياحات وعموم الزخارف الصوريّة في سياق السعي؛ لتقريب العالم الشعريّ المُستَشرَف في التجربة، من عوالم الواقع المحيطة بنا، وهي نيّة شعريّة يُضمرها الشاعر، ولكنّها تظهر في إطار سعيه العامّ؛ للتخلّص من شعريّة التزويق الغنائيّة التي هيمنَت على تجاربه الأولى، لاسيّما في عموديّاته المُنجزَة ضمن ملف ما عُرِف بـ(قصيدة الشعر) في العراق.
هوامش الدراسة:
- في الشعر، د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت – لبنان، ط3، د.ت: 21.
- من ذلك ما قلته في ورقتي النقدية التي قدمتها في أمسية الاحتفاء بصدور مجموعة (صيف أسمر) للشاعر عمار المسعودي في اتحاد أدباء كربلاء سنة 2024م، وقد وسمتها بـ(الكلمات والأشياء في صيف عمار المسعودي الأسمر)، وهذا رابط الأمسية على اليوتيوب : https://youtu.be/zf0CGCCCN9w?si=%F0%9D%99%AD%F0%9D%98%BC%F0%9D%99%85%F0%9D%99%86%F0%9D%99%A2%F0%9D%99%9F%F0%9D%99%A7%F0%9D%99%AA%F0%9D%99%91%F0%9D%99%A3%F0%9D%99%93%F0%9D%99%9A%F0%9D%99%8D%F0%9D%99%876
- لسان العرب: مادة (شرف).
- التعريفات، السيد الشريف الجرجاني، وضع حواشيه: محمد باسل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2003م : 18.
- ينظر: الخطاب والتأويل، نصر حامد أبو زيد، الناشر: مؤمنون بلا حدود، المملكة المغربية – الرباط، ط1، 2017م : 16.
- ينظر: المعجم الفلسفي، د. جميل صليبا، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1982م: 1 / 604.
- في حداثة النص الشعري، د. علي جعفر العلاق، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط1، 1990م: 17 - 18.
- مستقبل الشعر وقضايا نقدية، الدكتور عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1، 1994م: 9.
- ينظر: رهانات شعراء الحداثة، فاضل ثامر، منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، بغداد، ط1، 2019م: 446.
- آدم الأخير، عارف الساعدي، دار عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، 2019م: 10 - 30.
- الأعمال الشعرية (1995 - 2015)، عارف الساعدي، دار سطور للنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2018م: 169 - 170.
- الانزياح الشعري في كلام (آدم الأخير) لـ(عارف الساعدي)، د. رحمن غركان، 17 نقد الشعر الآن، سلسلة شهرية في نقد الشعر العربي المعاصر، دار تموز - ديموزي، دمشق، ط1، 2022م: 100.
- وجهٌ إلى السماء نافذةٌ إلى الأرض، الأعمال الشعرية إلى 2016م، عمر السَرّاي، الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، بغداد، ط1، 2016م: 307.












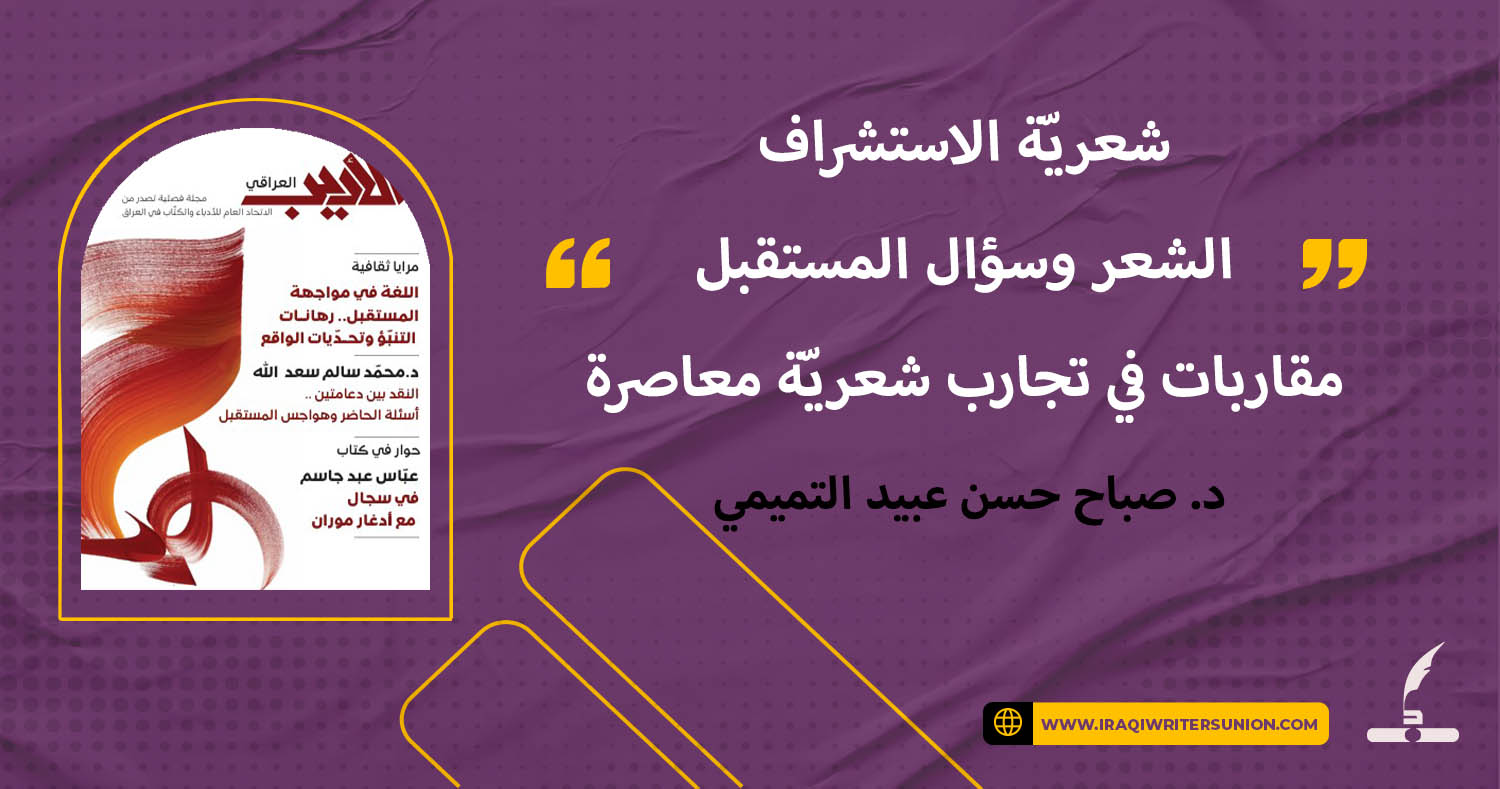

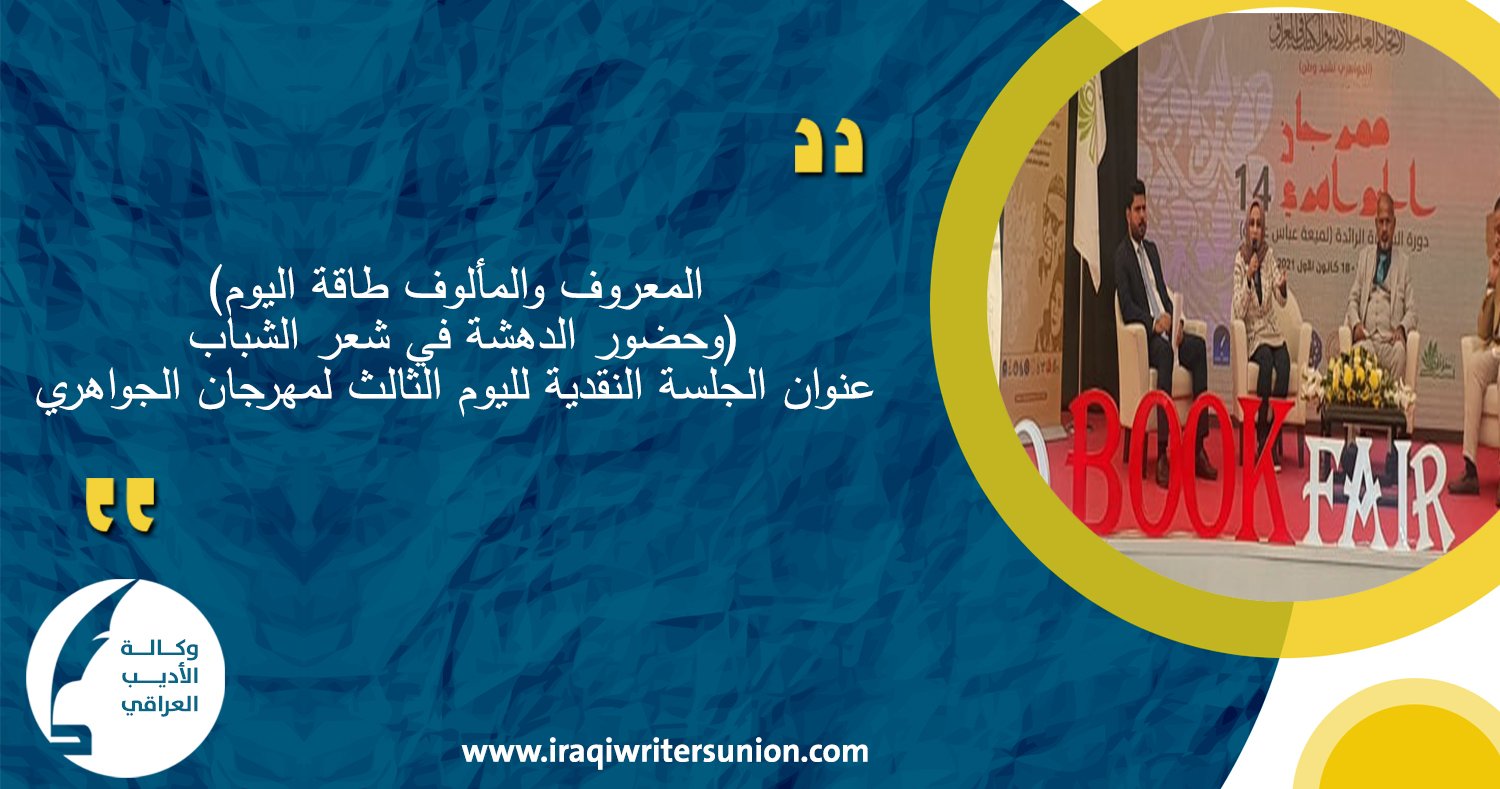

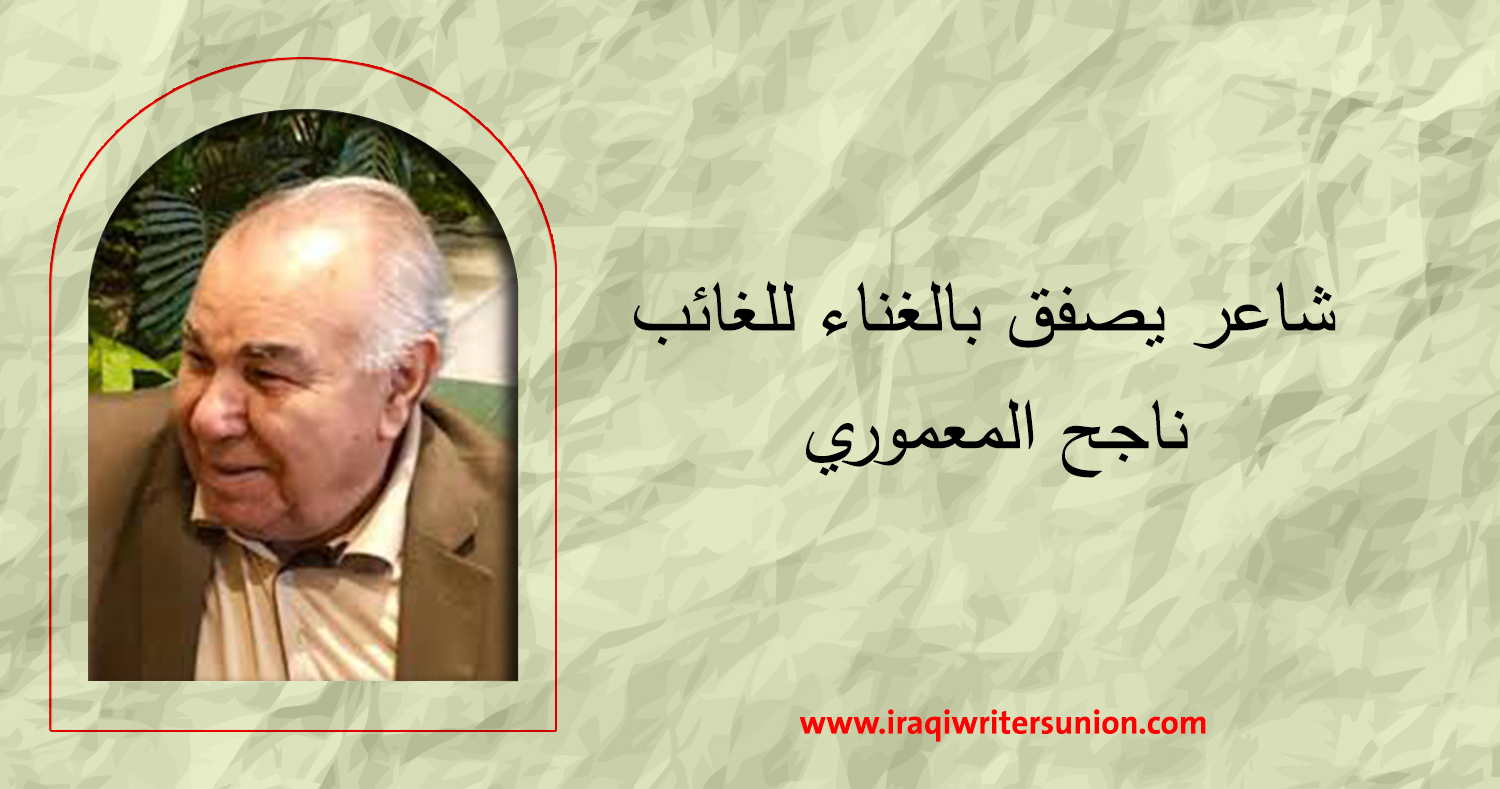
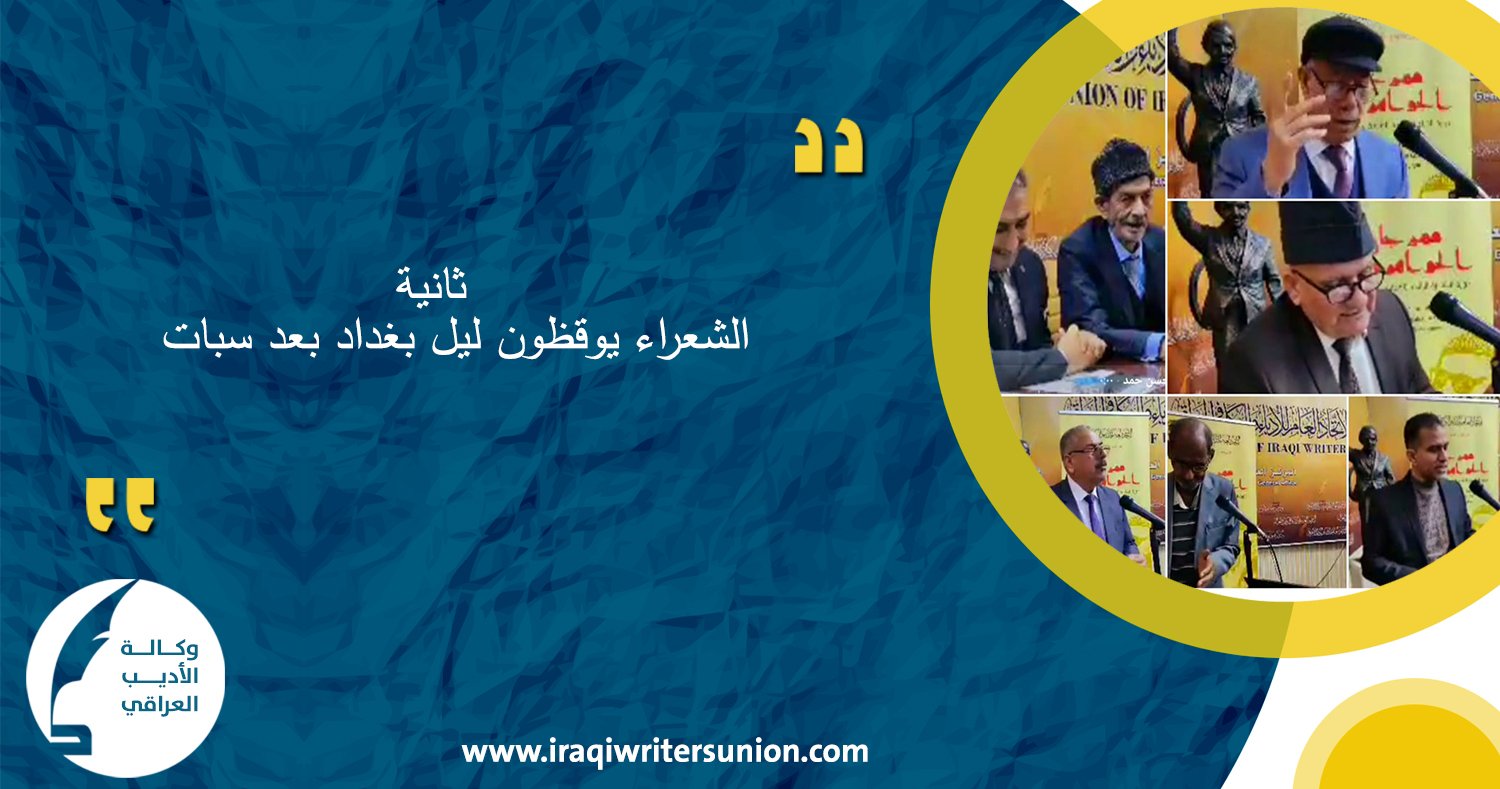

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي