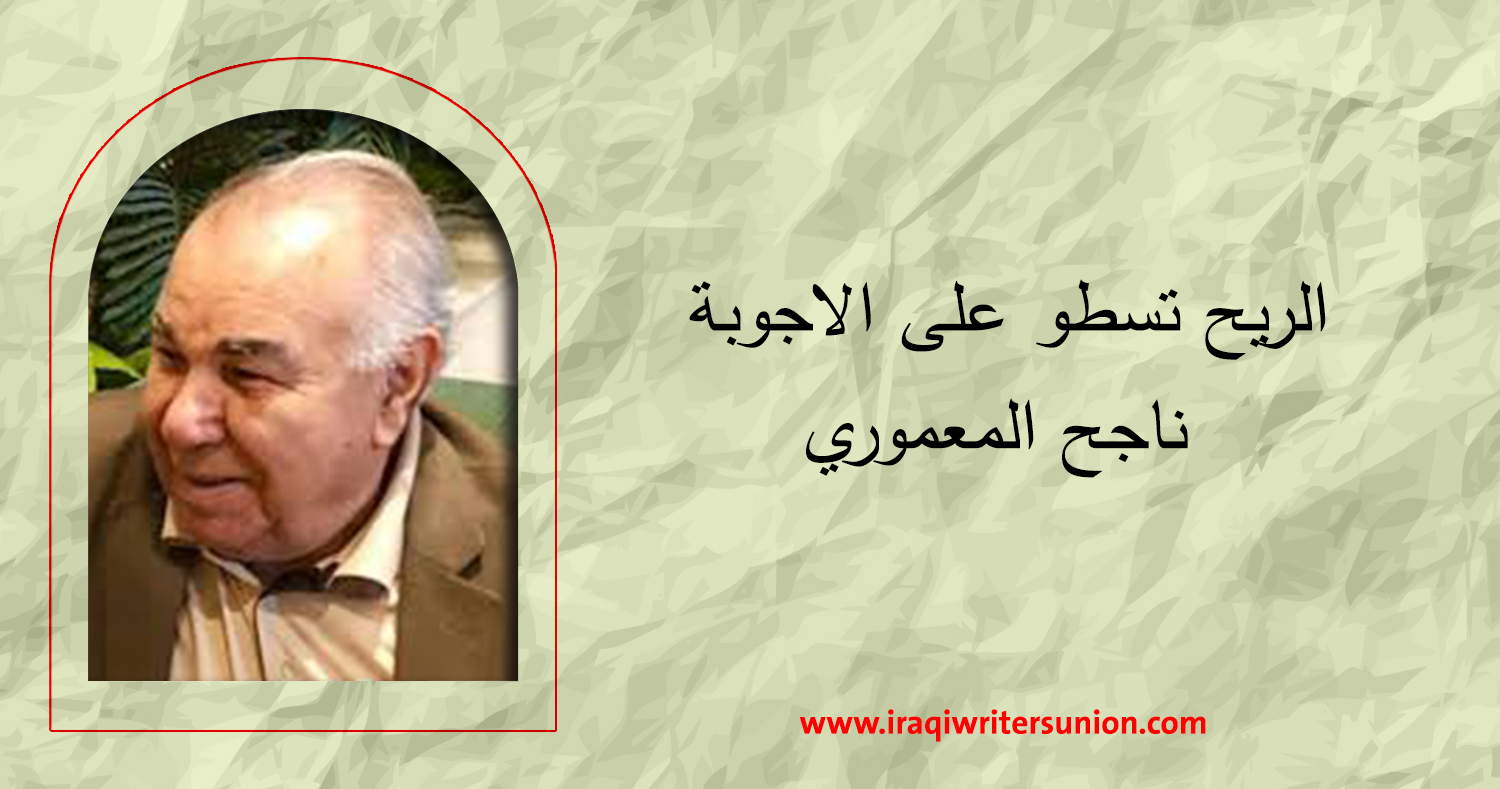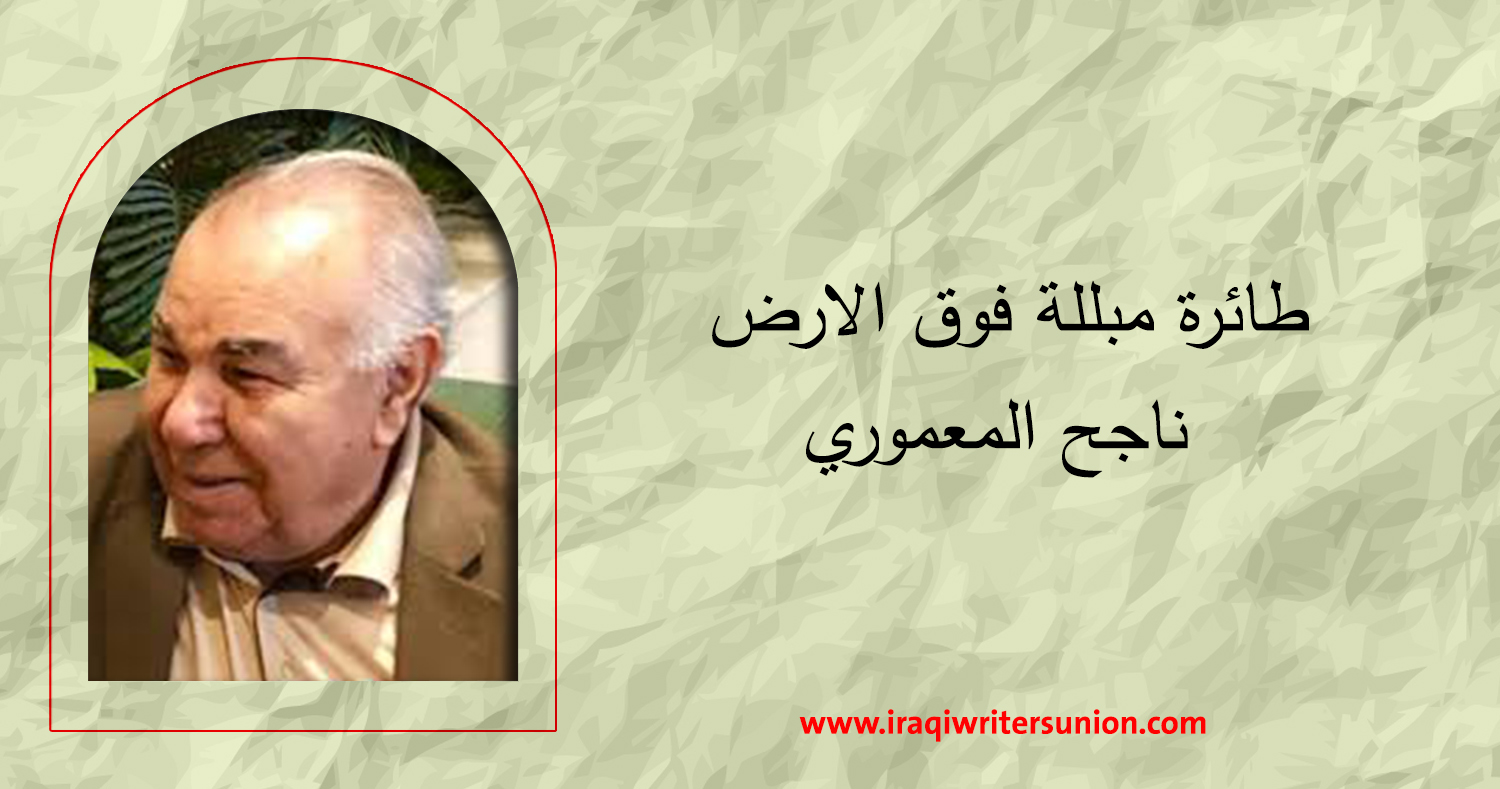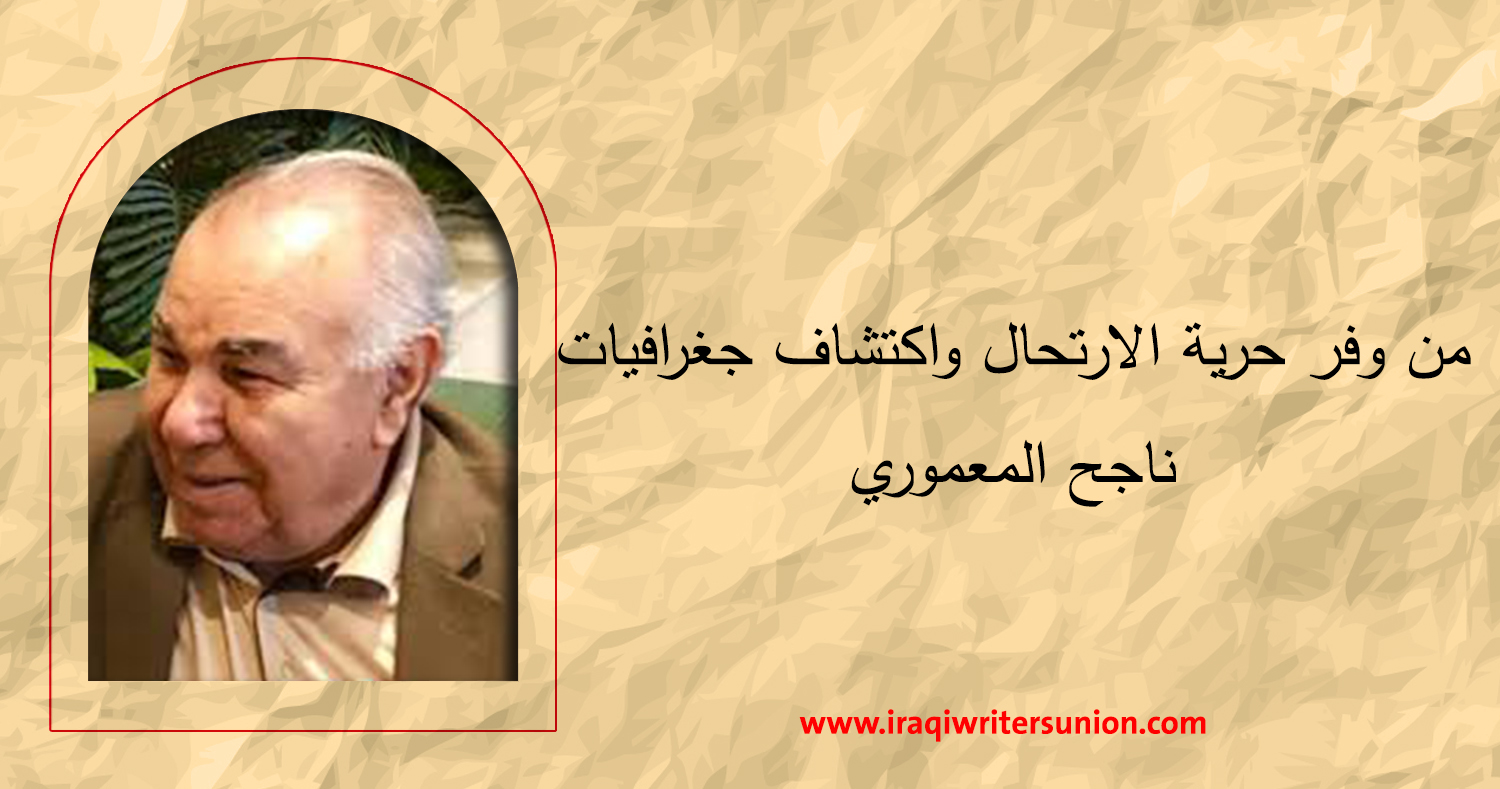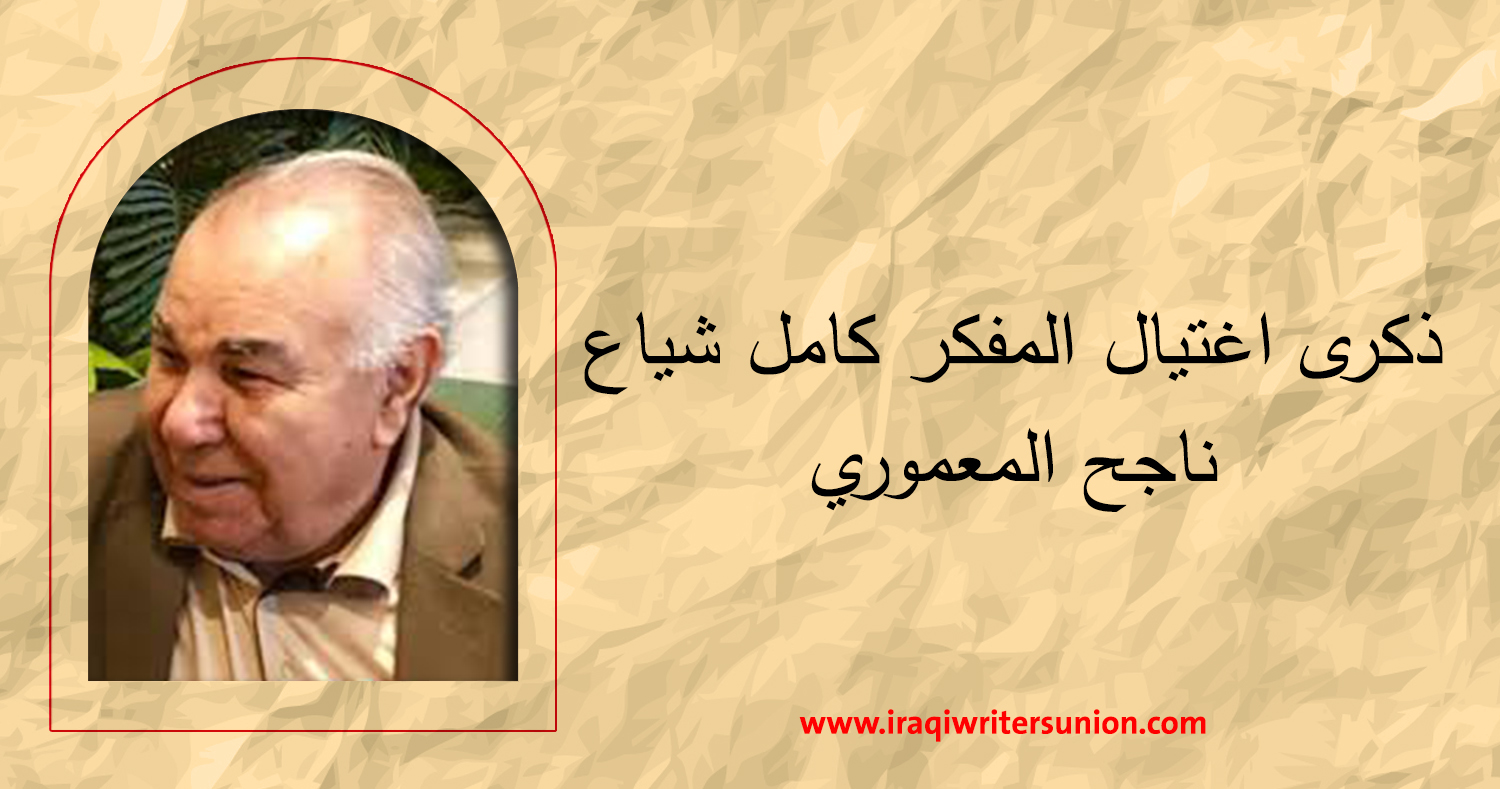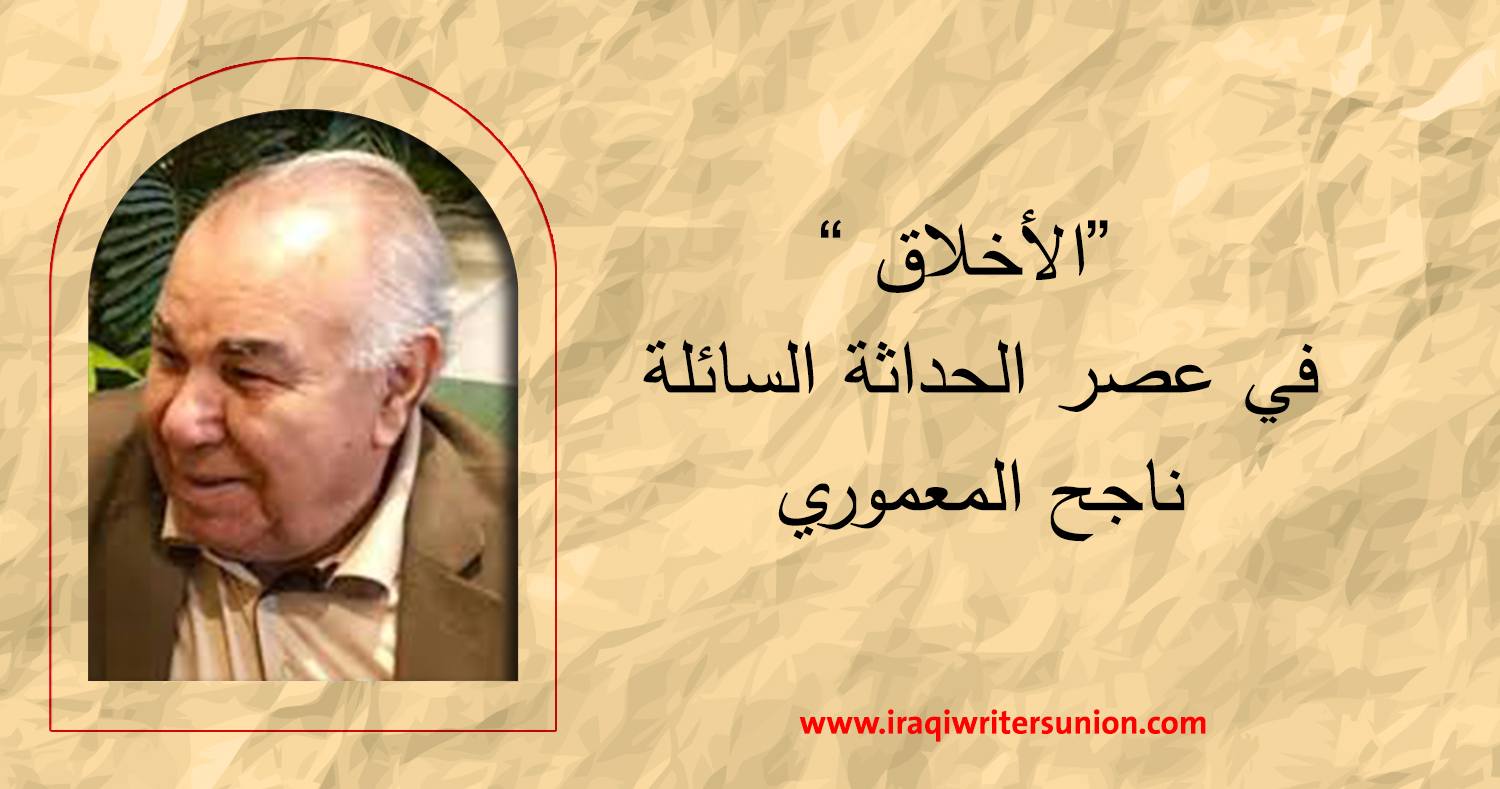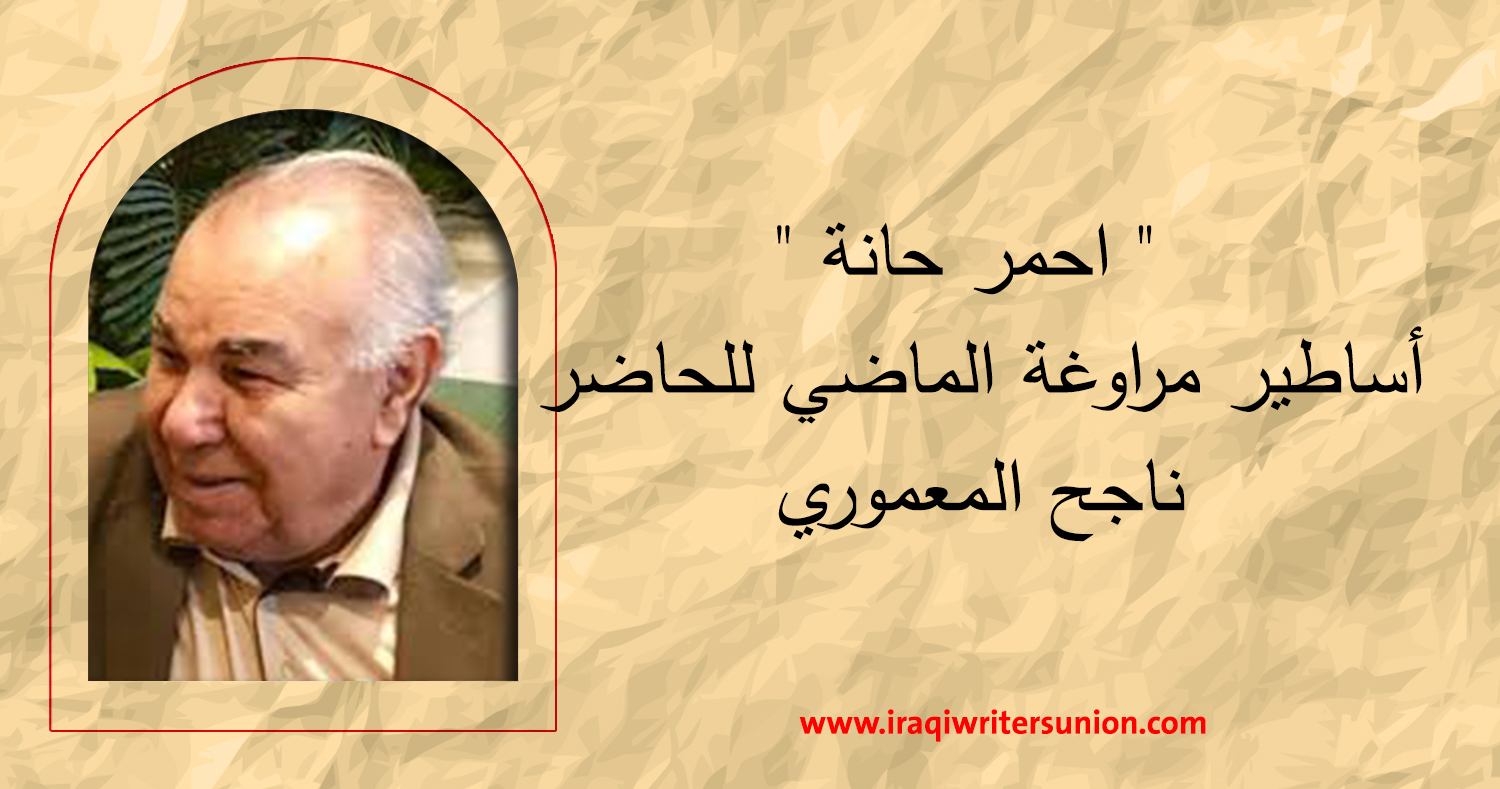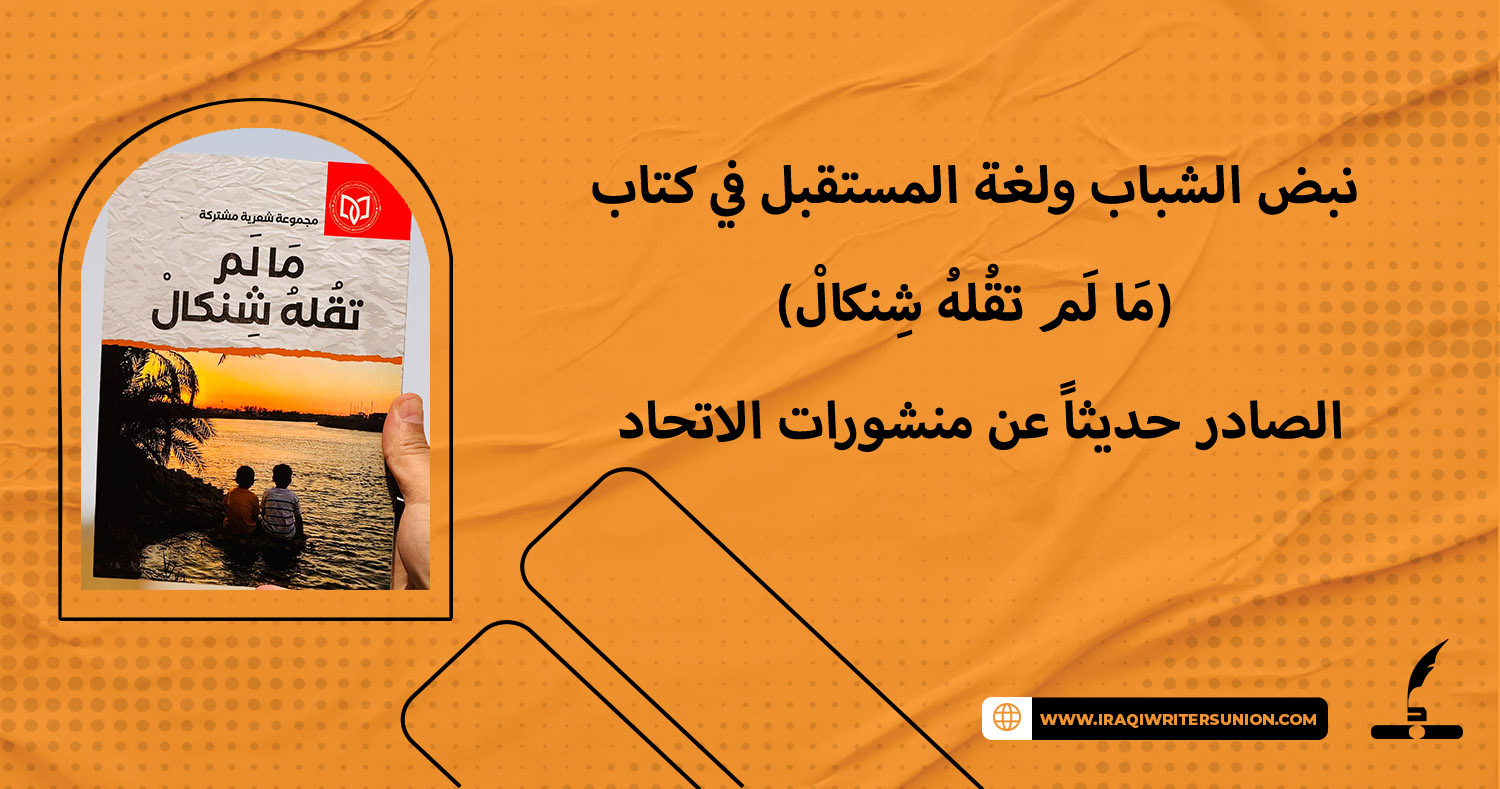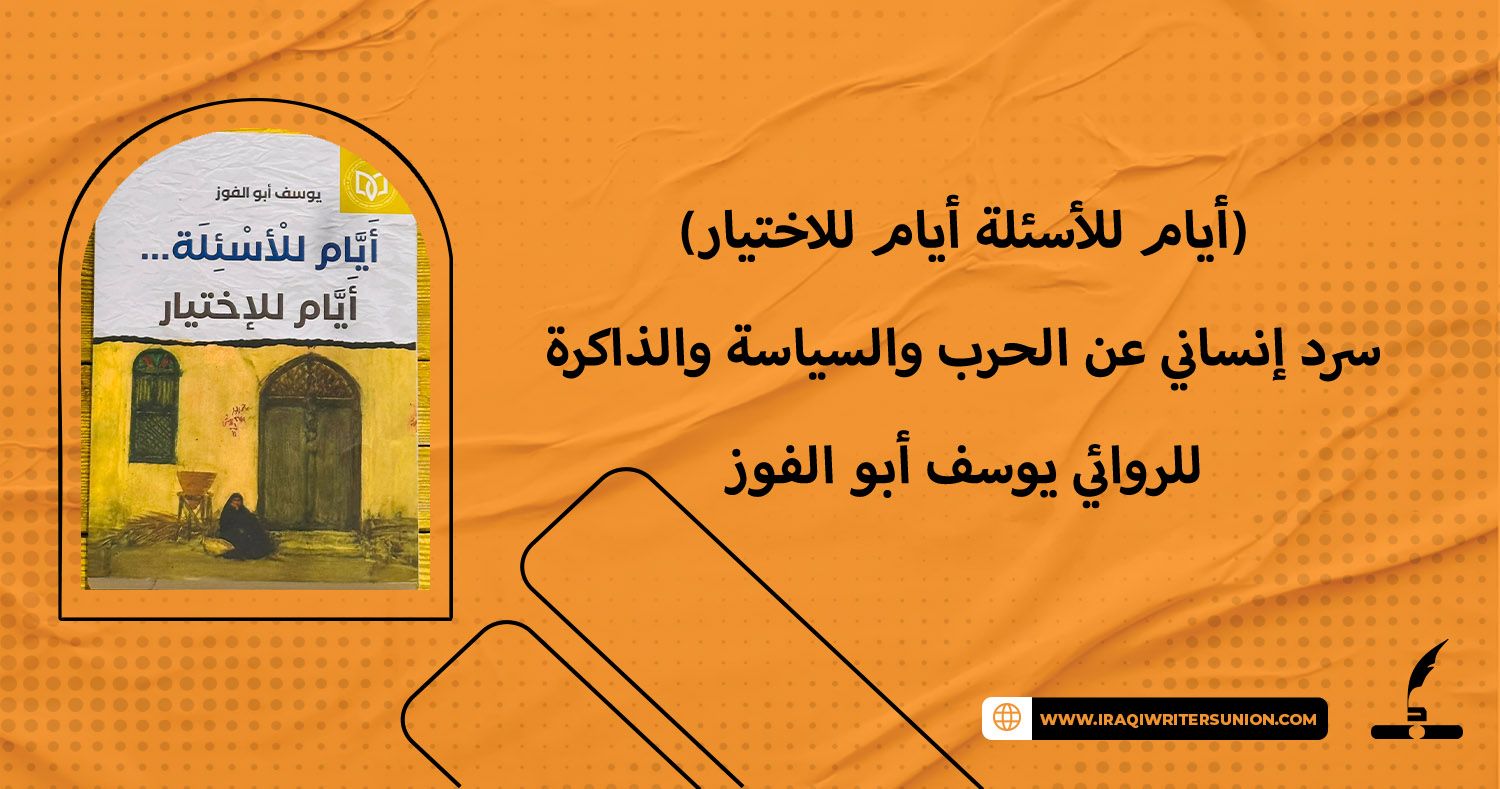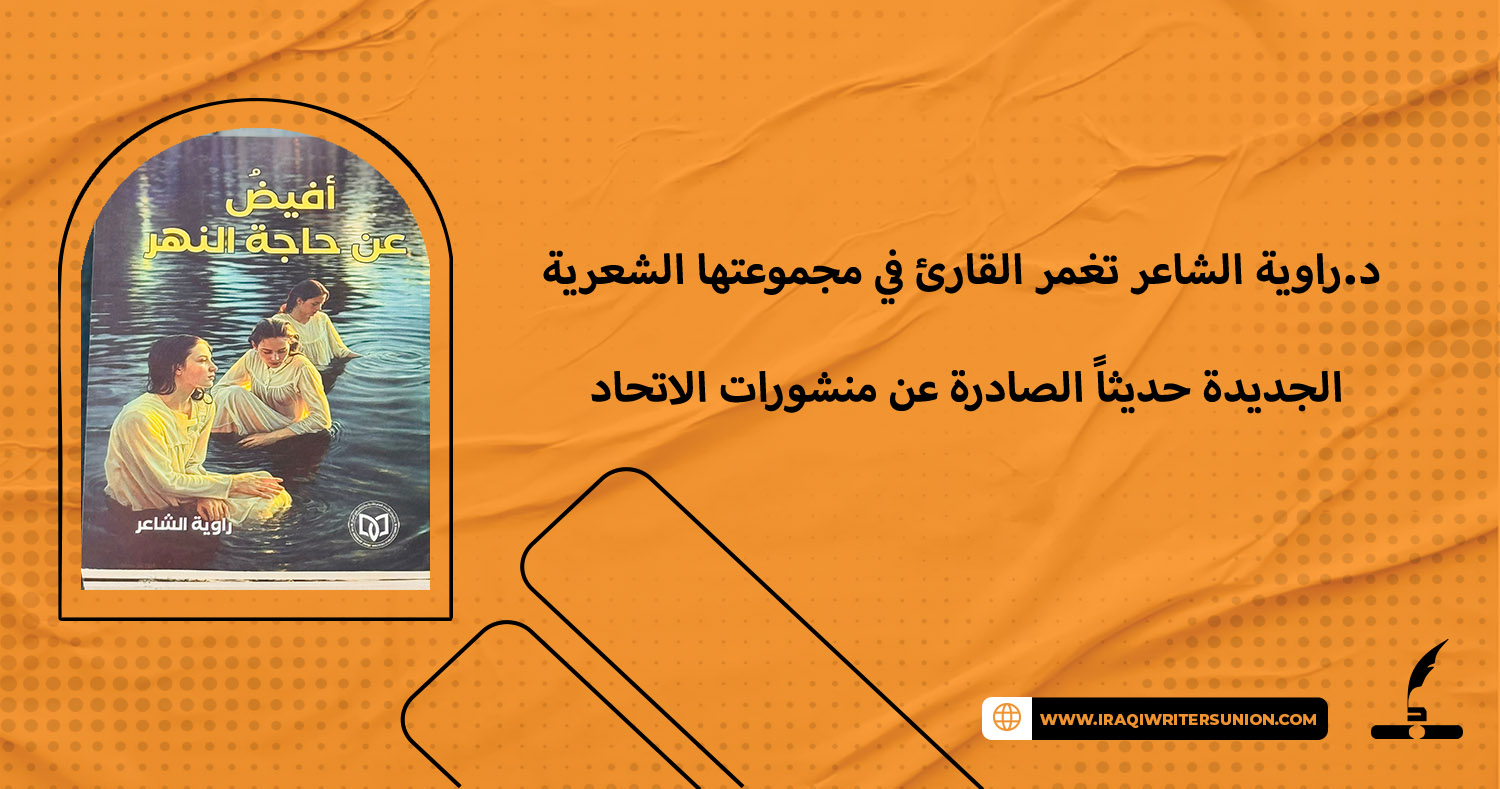هل ينقذنا التذبذب بين الحداثات من مآسي عصرنا؟
الأدب في عصر الحداثيّة المتذبذبة
أماني أبو رحمة
" كاتبة وناقدة ومترجمة فلسطينيّة"
نحن نروي الحكايات لنستطيع تحمّل الزمان .
لطفيّة الدليمي .
توطئة
انتهت ما بعد الحداثيّة في شكلها الأكثر نقاءً، بعد أن قتلتها العولمة؛ حيث أدّى الانتصار الصريح للرأسماليّة على كلّ أيديولوجيّة معارضة إلى انتشار ثقافة استهلاكيّة واسعة النطاق تتعارض مع أجندة الثقافة المضادّة التي ميّزت النموذج ما بعد الحداثيّ؛ وظهرت نظريّات جديدة تقف فوق الجثّة الهامدة، وتحاول تحديد النماذج الثقافيّة المتنوّعة التي ظهرت مع الموت المفترض للنمط الثقافيّ ما بعد الحداثيّ، فيقترح العديد منها إعادة تقييم المبادئ الحداثيّة، بينما يقترح بعضها الآخر الانفصال التامّ عن النمط والانخراط في شيء معاصر تمامًا، حيثُ ظهرت هُويّات ثقافيّة جديدة، مع تركيز بعض المنظّرين على مواضيع متنوّعة مثل الذات الحبيسة، والاستقلاليّة الشبكيّة، ومشاعر مناهضة المؤسّسيّة، أو موت التهكّم الساخر، ومع ذلك، وفي حين يركّز كلّ منها على تفاصيل متباينة، فإنها جميعًا تصف عناصر كلٍ أكبر يتلخّص في فكرة: إننا نعيش في عالم مليء باليأس، ونحاول بإخلاص إحراز تقدّم، حتّى لو كان بلا هدف، وإننا نتوق إلى مستقبل أفضل، ولكنّنا نعلم أنه لن يأتي، وهذه هي توقّعات بعد ما بعد الحداثيّة؛ عالم مليء بالقلق إزاء الحاضر يسعى بشكل محموم إلى الأمام والخلف لحلّ قضاياه.
وتمكن ملاحظة الرغبة الصادقة في تجاوز ما بعد الحداثيّة في مفهوم (الحداثيّة المتذبذبة) لتيموثيوس فيرمولين وروبين فان دان آكر من التعامل مع الواقع المعقّد وتحديد مساحة للخيال، ونحن هنا سننضمّ إلى من يعتقدون أن الحداثيّة المتذبذبة هي الخليفة الأكثر ترجيحًا لمشكلة العرش الفارغ في مرحلة بعد ما بعد الحداثيّة، وهو وصف ثقافيّ مفصّل ومحدّد يتناسب بشكل وثيق مع ردود الفعل الملحوظة ضدّ الممارسات ما بعد الحداثيّة في الأدب والفنّ، وعلى هذا سنعرض هنا داخل هذه الدراسة قصّة انتصارات ما بعد الحداثيّة التي كانت هي بالذات ما أودى بها في نهاية المطاف، ثمّ سنصف مجتمعًا يتأرجح على الحافّة بين حداثتين، مع إنتاج أدبيّ غزير ومتنوّع ،كلّ ما يمكن استخلاصه منه، دون كبير جهد أو تعسّف، ليس سوى ملامح الحداثيّة وما بعدها تتمازج لمنحنا أملًا وتفاؤلًا تحفّزه العودة إلى اليقين والواقع والإخلاص، ويجري ذلك من خلال الاعتراف بالذات ممثّلة بالمؤلّف والشخصيّات المؤمنة المقرّرة بشأن حياتها ومسؤوليّاتها؛ لبّ نظريّة الحداثيّة المتذبذبة.
ما بعد الحداثيّة: نصر بطعم الهزيمة
منذ تسعينيّات القرن الماضي، صدرت بيانات نعي ما بعد الحداثيّة، النموذج الثقافيّ والفنيّ السائد منذ منتصف القرن الماضي، فتزعم ليندا هتشيون، وهي واحدة من أعظم الأصوات ما بعد الحداثيّة في عصرنا، أن "لحظة ما بعد الحداثة قد انقضت"(1)، وأنها الآن "شيء من الماضي"(2)، وتدعونا إلى "أن نقول ببساطة: لقد انتهت"(3)، ويبدو أن ما بعد الحداثيّة، بعد أن كانت في حالة انحدار بطيء وتدهور شديد منذ أواخر ثمانينيّات القرن العشرين، "تقف على أعتاب الموت، تتريّث قليلًا قبل أن تغادرنا"،(4) لقد هلكت، وفقًا لديفيد سيكوريكو، " صباح الحادي عشر من أيلول 2001 على وجه التحديد"؛(5) وحينها أشعلت الهجمات على مركز التجارة العالميّ جدلاً عالميًّا حول دور ما بعد الحداثيّة في الغرب، وطالب النقّاد بـ "وجهات نظر أخلاقيّة متعالية "transcendent ethical perspectives جديدة، إلى جانب عودة الإيمان بالسّرديّة الكبرى للشرّ، ونهاية السخرية من أجل استجابة تتناسب مع الكارثة(6)، وبإيجازٍ شديد يمكننا القول؛ إن أيّ خروج مزعوم من ما بعد الحداثيّة، لا بدّ وأن يعالج ثيمتين رئيسيّتين: التهكّم الساخر، والانهيار اللانهائيّ للعلامات؛ أو التفكيك.
إن السخرية، التي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من أجندة ما بعد الحداثيّة، لا يمكنها تفسير هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويقول ويليام زينسر، "لم يكن هناك أيّ شيء ساخر في الحادي عشر من سبتمبر؛ أو في الحروب التي لا تنتهي التي اشتعلت في العراق وأفغانستان؛ أو في تعذيب السجناء السياسيّين في خليج غوانتانامو... كان كوكبًا جديدًا وعصرًا جديدًا، عصر ما بعد التهكّم الساخرPost-ironic! (7)
إن أحد أقدم الرسائل وأكثرها تأثيرًا في هذه الحملة ضدّ السخرية، مقال كتبه ديفيد فوستر ولاس (كثير من واحد: التلفزيون والتخييل الأمريكي، 1993)؛ (8) ويجادل فيه والاس بأن الثقافة التجاريّة، وخاصّة التلفزيون، تشبّعت بتقنيات ما بعد الحداثيّة: أخذ التليفزيون يمتصّ ببراعة، ويجانس، ويعيد تمثيل جماليّات ما بعد الحداثيّة الساخرة التي كانت في يوم من الأيّام أفضل بديل لجاذبيّة السّرد الرديء، والسهل للغاية، والمسوَّق على نطاق واسع."(9) وهذا يعني أن "أشكال فنّنا المتمرّد أصبحت مجرّد إيماءات، كوميديا مكرورة ليست عقيمة فحسب؛ بل استعبادًا منحرفًا"، وهو هنا يقترح بديلًا يعتمد بشدّة على الإخلاص: "وربّما يأتي العمل الجيّد حقًا من الرغبة في الكشف عن نفسك، والانفتاح على الطرق الروحيّة والعاطفيّة التي تخاطر بجعلك تبدو مبتذلاً أو ميلودراميّ أو ساذجًا أو غير موحّد أو بائس".(10)
حقّقت ما بعد الحداثيّة، إذن، انتصارًا باهظ الثمن ؛(11) حين نفت وظيفتها ضرورةً فنيّة وتحوّلت إلى القوّة الثقافيّة المهيمنة، وليس القوّة الراديكاليّة أو المزعزعة، انهارت في اللحظة نفسها التي تحقّق فيها انتصارها،(12) والمثال الأعظم على هذا الانتصار باهظ الثمن لما بعد الحداثيّة، هو هيمنة تقنية ما وراء القصّ حدّ الابتذال؛ إذ ظهرت في كلّ جانب تقريبًا من جوانب الفن المعاصر وإنتاج الوسائط بشكل أو بآخر، وتشكل إعلانات سينما الواحة Oasis cinema مثالاً على هيمنة أسلوب ما بعد الحداثيّة ما وراء القصيّ، حيث تملأ صورة كرتونيّة لمنتجٍ الشاشة بينما يعلن صوت ممثّل، بطريقة مصطنعة، أن نجم هوليوود الرئيسيّ المفترض أن يؤدّي دور السارد انسحب من المشروع، تاركًا المجال لسارد آخر لأداء المهمّة بأفضل ما يستطيع، ويلعب الإعلان بأفكار ما وراء القصّ الراديكاليّة، ويسلّط الضوء على بنائه وينخرط في لعبة واعية ذاتيًّا من خلال مطالبة الجمهور "بالاستمتاع بالفيلم" عند نهايته، حيث يبدو أن المعلّق قد نفد وقته(13).
من ناحية أخرى، يؤكّد هارت ونيغري، أن "المرحلة التفكيكيّة للفكر النقديّ، والتي وفّرت من هايدغر وأدورنو إلى دريدا مخرجًا قويًّا من الحداثة، فقدت فعاليّتها"،(14) ويعتقد جيفري نيلون أن النظريّة النقديّة بحاجة إلى مراجعة، فبحسبه: "الروايات التي نميّز من خلالها تلك الفترة المسمّاة الستينيّات - روايات عن تمرّد ومقاومة وتحرّر غير مسبوق - لا تفيدنا كثيرًا في الشرح أو التدخّل في إطار وضع تاريخيّ مختلف جدًّا"(15)، وبالفعل، فإن "روح التحرّر التي تحيط بثقافة ما بعد الحداثيّة (تجاوزات التهجين، والأخلاق الفرديّة للتشكيل الذاتيّ، والاحتفالات الديونوسيّة للتعدّديّة، وجعل الأشياء جديدة إلى ما لا نهاية)(16)، أصبحت، في الواقع، مفاتيح وشعارات الرأسمالية النيوليبراليّة".(17)وفي النهاية، أصبحت ما بعد الحداثيّة سائدة للغاية بحيث لا يمكنها البقاء، وأصبحت منتشرة للغاية بحيث لا يمكنها دعم أيديولوجيّتها الأساسيّة، وانهارت تحت ثقلها الأيديولوجيّ، وعجزها عن خلق ردود الفعل التي أنتجتها ذات يوم ذاتها.
ماتت "ما بعد الحداثيّة الخالصة"، وفي أعقابها اندلعت حرب المصطلحات؛ إذ سعى عدد كبير من النقّاد الأدبيّين والفلاسفة المعاصرين والنقّاد الثقافيّين إلى تسمية العصر؛ أو إلى تصوّر المناخ الثقافيّ الحالي (الذي لا يزال غير مكتمل، أو بالأحرى متنوّعًا للغاية)، وتتنوّع المواقع الرئيسيّة لهذه الأنماط الثقافيّة الجديدة إلى حدّ كبير، غير أن استجوابًا دقيقًا للواقع في العالم أجمع يكشف عن نمط أيديولوجيّ مميّز لعصرنا أيًّا كانت التسمية التي سنطلقها عليه؛ توقّع مستقبل بائس نشأ عن فقد الإيمان بالقوى الثقافيّة المهيمنة، والمشاعر المناهضة للتوحيد القياسيّ الاستهلاكيّ التي تحرّض على الاندفاع نحو الإخلاص.
كيف يبدو العالم على الحافّة بين ما بعد الحداثيّة وما بعدها؟
لا يمكن إنقاذ العالم، إن نهاية العالم حتميّة، والواقع أن الديستوبيا حقيقة مؤكّدة؛ ومع التحوّل من ما بعد الحداثيّة إلى ما بعدها، سادت هذه الرسالة بشكل متزايد في وسائل الإعلام الجماهيريّة والثقافة الشعبيّة، ليحلّل بريان ماك هيل هذا الاتّجاه المتشائم، فيقول: طوال النصف الثاني من القرن العشرين "كنّا نعيش على أنقاض حضارتنا، ولو في خيالنا فقط"،(18) إن التعبير الأكثر وضوحًا، وبشكل مدهش، عن هذا الاتّجاه هو سرديّات التلفزيون والأفلام وروايات الشباب المعاصرة، والتي تعرض غالبًا العوالم المدمّرة: سيناريوهات ما بعد نهاية العالم أو القياميّة، والديستوبيا.
في الماضي، كان العالم كما عرفناه يستحقّ الحفاظ عليه.؛ يستحق الإنقاذ، يمكن هزيمة الشرّ في نهاية المطاف، وكلّ ما عليك فعله، هو إلقاء نظرة على السرد الرئيسيّ لسلسلة (المتحوّلون The Transformers 1984-7 ) أو (سادة الكون He-Man and the Masters of the Universe 1983-5 ) أو (قطط الرعد (Thundercats1985-9)، ومن المدهش رؤية التفاؤل غير المقيّد في هذه الأعمال، ولكنّ هذا الموقف المفعم بالتفاؤل والثقة في قدرة أصحاب السلطة على الحفاظ على التوازن بدأ يتضاءل في السنوات الأخيرة، إلى حدّ عدم التصديق الصريح، مّما يوحي بانعدام الثقة في المؤسّسات الحكوميّة، وربّما يكون المثال الأكثر صلة بالتحوّل نحو الشعور بالاستسلام لليأس هو سلسلة ) ساموراي جاك، 2001Samurai Jack ). ويمكن تلخيص الحبكة الرئيسيّة للعمل من خلال افتتاحيّة العرض نفسه:
"منذ زمن بعيد في أرض بعيدة، أطلقت أنا، أكو، سيّد الظلام المتغيّر الشكل، شرًّا لا يمكن وصفه! لكنّ محارب ساموراي أحمق يحمل سيفًا سحريًّا تقدّم لمواجهتي، وقبل توجيه الضربة النهائيّة، مزّقت بوّابة الزمن وألقيته إلى المستقبل؛ حيث شرّي هو القانون! الآن يسعى الأحمق إلى العودة إلى الماضي، وإلغاء المستقبل الذي هو أكو!"
بدأت هذه السّرديّات القياميّة والديستوبيّة في الصعود منذ أواخر الثمانينيّات، ولم يكن الهدف انقاذ الموقف بقدر ما هو إيجاد الوسائل للعيش الكريم في الأراضي المنكوبة، فهذا أحد النقّاد عن عام 2017 يكتب: "تتبع الديستوبيا اليوتوبيا كما يتبع الرعد البرق، وفي هذا العام، يزأر الرعد"(19)، وفي عالم بعد ما بعد الحداثيّة، يمكننا أن نرى أدلّة على جيل جديد من المبدعين والفنّانين الذين يُعبّرون عن تشاؤم كامن بشأن المستقبل، مع تبنّي السّرديّات لعناصر الاستسلام الديستوبي ... انتقلت الديستوبيا من خيال المقاومة إلى "خيال الخضوع، خيال القرن الحادي والعشرين الذي لا يثق بأحد، وحيد، وكئيب"(20)، وانظر مثلًا إلى هذه الأعمال: ( كتاب إيلاي، 2010 (Book of Eli، و(الطريق،2009The Road)، و(محطّم الثلج، 2014(Snowpiercer.(21) وفي الأدب، عادت أيضًا "الرواية الديستوبيّة" لتتربّع على عرش أكثر الكتب مبيعًا، وسارت على درب الأفلام في تفضيل سرديّات الاستسلام على الخلاص، وتشمل الأمثلة، على سبيل الاستشهاد لا الحصر، (ثلاثيّة أوريكس وكريك،2003، 2009، 2013 Oryx and Crake trilogy) لمارغريت أتوود، وفيلم (ريدي بلاير وان، 2018 Ready Player One )لإرنست كلاين، و(سحابة أطلس، 2012 Cloud Atlas) لديفيد ميتشل، و(بصيص، 2008 (Glister لجون بيرنسايد، وفي العالم العربيّ كانت روايات مثل: (في ممرّ الفئران، 2019 ) لأحمد خالد توفيق، و(عطارد، 2015 ) لمحمّد ربيع، و(العراق+100، 2016) لحسن بلاسم، و(سيّدات زحل، 2003) للطفيّة الدليمي.
ويحدّد أندرو هوبرك السرد الديستوبي باعتباره "الجانر الرئيسيّ" في بعد ما بعد الحداثيّة، أي الجانر الذي يكمل بشكل موجز جانرات التقصّي والخيال العلميّ للحداثيّة وما بعد الحداثيّة على التوالي، بينما يقترح أيضًا أن صعود هذا السّرد "قد يكون له علاقة بالحاضر الذي يرفضه على ما يبدو".(22) والواقع أن هذا الانتشار للسّرديّات الديستوبيّة يتزامن ليس فقط مع نهاية ما بعد الحداثيّة، بل وأيضًا مع القلق المتزايد بشأن قضايا الحاضر وعدم كفاءة الهيئات الحاكمة في منع الكوارث المحليّة والعالميّة، وفي مقابل هذا، وفي أعقاب الجمعيّة الفاشلة، يشهد عصر بعد ما بعد الحداثيّة توسّعًا في التعبيرات الفرديّة عن الذات وعودة ناشئة إلى أفكار الإخلاص . لقد نشأ جيل البحث عن أشكال ما بعد السخرية: لم يعد الفنّانون من جميع الجانرات يبتكرون أعمالاً تكشف عن عمليّات بنائها الخاصّة لمجرّد التأثير التهكّمي أو التسلية الساخرة، وفي الأدب، تتجلّى هذه الرغبة بوضوح في طفرة إنتاج قصص ( التخييل الذاتيّ auto-fiction)، والاستقبال الإيجابيّ لها.
وقد عرّف جوناثان ستيرجن هذا النوع من الروايات التي تحكي السيرة الذاتيّة بأنّها: "فئة جديدة تتناول المذكّرات، وهي الروايات التي تتخلّى عن منطق التفكيك والمحاكاة الساخرة؛ لكي تصبح "أكثر شبهًا بتعريف كينيث بيرك للأدب باعتباره "معدّات للعيش"، والروايات التي تتناول السيرة الذاتيّة هي تلك التي يتمّ فيها إضفاء طابع التخييل على خبرات المؤلّف الخاصّة وكتابتها كحبكة، وكثيرًا ما تتّخذ هذه الروايات شكل لحظة محدّدة أو عاصفة بالنسبة للمؤلّف، بدلًا من كونها رواية سيرة ذاتيّة لحياة كاملة، ويقترح ستيرجن أن الرواية التي تتناول السيرة الذاتيّة تعزّز الاعتقاد بأنّ القصّ لم يعد زائفًا أو كاذبًا أو "مصطنعًا"، بل يعمل كمثال مبنيّ على سرد تخييليّ للحقيقة التي يرويها المؤلّف، والتي يمكن من خلالها استخلاص دروس تعليميّة ضمنيّة(23) ، ويشهد غيبونز أيضًا على ازدهار الإخلاص في الأمثلة المعاصرة لهذا الجانر، حيث يصف التخييل الذاتيّ بأنه "نوع أدبيّ يدمج السيرة الذاتيّة في القصّ [...] ليس كلعبة، ولكن كتعزيز لواقعيّة النصّ ومعالجة الأبعاد الاجتماعيّة والظاهراتيّة للحياة الشخصيّة".(24)
وعلى النقيض من ما وراء القصّ ما بعد الحداثيّ، الذي استخدم إدراج المؤلّف في المقدّمة لإبراز حيلة النصّ، فإن التخييل الذاتيّ بعد ما بعد الحداثيّ، يحدّد المؤلّف من أجل "الإشارة إلى الواقع"، ومن الأمثلة هنا قصّة صوفي كالي (اعتنِ بنفسك، 2007 Take Care of Yourself)، حيث تقوم كالي، بعد تلقّيها رسالة بريد إلكترونيّ تفيد بإنهاء علاقتها بفنّان لم تذكر اسمه، بإعادة توجيه البريد الإلكترونيّ إلى مائة وسبع نساء أخريات، وجمع تفسيراتهن وردود أفعالهن وتقديمها على أنّها رواية.
إن هذا المثال من التخييل الذاتيّ، الذي يتّسم بالطابع التجريبيّ في شكله، يُظهِر صدقًا في جميع أنحاء النصّ، وضعفًا عاطفيًّا وارتباطًا؛ حيث تقدّم كلّ مشاركة شيئًا يتجاوز تفكيك الرسالة البريديّة الإلكترونيّة نفسها، بهدف دعم كالي عاطفيًّا، الأمر الذي يحرّك النصّ إلى ما هو أبعد من ما بعد الحداثيّة.
التذبذب بين الحداثات: أملنا في الخلاص
في(ملاحظات حول الحداثيّة المتذبذبة)،(25) يصف تيموثيوس فيرمولين وروبين فان دان آكر نظريّتهما عن بعد ما بعد الحداثيّة والتي يطلقان عليها (الحداثيّة المتذبذبة Metamodernism) على النحو التالي: "وجوديًّا؛ فإن الحداثيّة المتذبذبة تتأرجح بين الحداثيّة وما بعد الحداثيّة. إنّها تتذبذب بين حماسة الحداثيّة ومفارقة ما بعد الحداثيّة؛ المفارقة بين الأمل والحزن، بين البراءة والمعرفة، بين التعاطف واللامبالاة، بين الوحدة والتعدّديّة، بين الشموليّة والتشظّي بين النقاء والغموض، وقد مكّنها تأرجحها جيئة وذهابًا بين الحداثيّة وما بعد الحداثيّة من مفاوضتهما معًا"؛(26) ولكن ينبغي ألّا نفهم هذا التذبذب بوصفه توازنًا، إنّه بندول يتأرجح بين عدد لا يحصى من الأقطاب.
يزعم فيرمولين وفان دان آكر أن الحداثيّة المتذبذبة تجد تعبيرها الأوضح في الحساسيّة الناشئة المشابهة للرومانسيّة، ومن أجل (الالتفاف) حول التعريفات "المتعدّدة الغامضة" للرومانسيّة، يقترحان أن الموقف الرومانسيّ الجديد يتحدّد بالتذبذب بين قطبين متقابلين في محاولة "تحويل المحدود إلى لانهائيّ، مع الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق ذلك"، وفي حين أن الرومانسيّة الجديدة التي وضعها فيرمولين وفان دان آكر تبدو غامضة مثل تعريفات الرومانسيّة السابقة، إلّا أنّها تركّز على فكرة الفشل، والمحاولات التي تسعى إلى الإنتاج على الرغم من المزالق الواضحة لمثل هذه المساعي، والتي ترمز إلى الرغبة في تجاوز الإيديولوجيّات ما بعد الحداثيّة التي تبدو عصيّة على التجاوز في عصرنا.
تصف الحداثيّة المتذبذبة، في سعيها إلى الأفق اللامتناهيّ، أيضًا حركة ثقافيّة أُخرى، وتحديدًا الرغبة في اليوتوبيا، إن فيرمولين وفان دان آكر يحدّدان حقيقة مفادها: أن "اليوتوبيا" - باعتبارها مجازًا أو رغبة فرديّة أو خيالًا جماعيًّا - أصبحت مرّة أخرى، وبشكل متزايد، ملحوظة في الممارسات الفنّيّة؛ مع أن هذه الممارسة ليست أكثر من رغبة؛ حيث تعبّر اليوتوبيا عن "عدم وجود آفاق يوتوبيّة واضحة بعد عقود من تينا تيرنر والاستهلاك غير المبالي".(27)، إلّا أننا "نتوق إلى اليوتوبيا، على الرغم من طبيعتها العبثيّة".(28)
لا تسعى الحداثيّة المتذبذبة إلى ذلك المجتمع اليوتوبي، بل بالأحرى إلى مفاهيم جديدة للوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق وضع يختلف بشكل إيجابيّ عن الوضع الحالي، فالتطلّعات اليوتوبيّة ليست آليّة هروب، إنّما منهجيّة يمكن من خلالها فحص البدائل، وكما افترض فيرمولين وفان دان آكر، فإن التطلّعات اليوتوبيّة المعاصرة، هي أكثر من مجرّد أداة، "مرآة" لـ"مسح هذا العالم بحثًا عن إمكانيّات بديلة؛ ولا يتمّ استدعاؤها لإبعادنا عن شيء وفقًا لهذه الدوغما أو تلك".(29) إن المخاوف بشأن الحاضر الديستوبي تحرّض تطلّعات يوتوبيّة جديدة، يُعبّر عنها من خلال البحث عن المعنى والغرض في الإبداع الفنيّ، وهي استجابة متفائلة في أعقاب السخرية والتهكّم ما بعد الحداثي؛ إنّنا نتأرجح بين الخوف من الديستوبيا والرغبة في اليوتوبيا، والحاجة إلى المحاولة واليقين بالفشل، والرغبة الحداثيّة في الهدف والقبول ما بعد الحداثيّ بانعدام المعنى.
الأدب في الحداثيّة المتذبذبة
لا يزال التحليل الأدبيّ في الحداثيّة المتذبذبة مجالًا غير مكتمل إلى حدّ ما؛ لذلك يميل النقّاد إلى تقصّي اتّجاه بدأ في الظهور لحظة الحداثيّة المتذبذبة؛ ويتّضح في الانخراط في السّرديّات الأسطوريّة والفولكلوريّة التي تمثّل السعي السيزفي المعاصر للخلاص في ظلّ انعدام اليقين وتتابع الكوارث وفقدان الثقة المتزايد في المؤسّسات الدينيّة والعلميّة على حدّ سواء، ويوظّف الأدب المعاصر والذي يمكن إدراجه ضمن أدب الحداثيّة المتذبذبة استراتيجيّتين مهمّتين؛ توظيف الأساطير لمواجهة الألم، وتعثّر وغموض الخيال، ليس لأجل التفكيك، وإنّما بحثًا عن طرق يمكن من خلالها تجاوز انعدام العمق في ما بعد الحداثيّة، وهما ما سنشرحه على النحو التالي:
- توظيف الأساطير لتخفيف الألم
تزعم سارة هيلين بيني أن الأدب المعاصر يتميّز بالتشكيك في مفهوم التنوير عن الإدراك البشريّ الملموس والكامل والقدرة على تحليل كلّ ظاهرة يواجهها الإنسان(30)، فالعديد من الروايات المعاصرة تبثّ هذه المشاعر المناهضة للتنوير، وتبرز "الاهتمام الناشئ [...] بما لا يمكن تفسيره، بالأشياء التي لا يمكن للعقل احتواؤها".(31) وعلى وجه التحديد، يمكن تعريف اللحظة المتذبذبة، جزئيًّا، بالعدد المتزايد من الروايات المعاصرة التي تشجّع على "إلقاء نظرة ثانية" على السّرديّات الفولكلوريّة أو الأسطوريّة، وإعادة فحصها بطريقة تختلف عن التفكيك ما بعد الحداثيّ الخالص الذي تمثّله روايات مثل (الغرفة الدمويّة،1979) لأنجيلا كارتر و(جلد الغزال، 1993) لروبرت ماكينلي.
وتستكشف رواية (زوجة الكركي،2013 The Crane Wife) لباتريك نيس الأسطورة في تقابل مع المألوف، وتتمتّع الرواية بصفات محدّدة تميّزها عن ما بعد الحداثيّة وتحدّدها كنصوص متذبذبة، إذ تدور رواية (زوجة الكركي) حول قصّة جورج دنكان الذي يجد نفسه فجأة، بعد مساعدة طائر كركي أحمر التاج في حديقته في لندن، في علاقة رومانسيّة مع كوميكو الغامضة، وهي فنّانة تعمل بالريش، ويتعاونان معًا في مشروع فنّيّ ناجح، بينما يصبح جورج وابنته أماندا مرتبطين بشكل متزايد بالشخصيّة الغامضة، قبل الكشف النهائيّ عن مكانتها كإلهة كركي أسطوريّة، في إعادة صياغة للحكاية الفولكلوريّة تسورو نو أونجاشي Tsuru no Ongaeshi، ومن حيث الحداثيّة المتذبذبة، يمثّل النصّ انحرافًا كبيرًا عن ما بعد الحداثيّة من خلال التذبذب بين السخرية والإخلاص، مّما يدلّ على موقف أكثر تذبذبًا يتأرجح بين القطبين الأيديولوجيّين ما بعد الحداثيّة والحداثيّة دون تفضيل أيّ منهما.
إن الأسطورة والسرد، وفقًا لكوميكو، بطلة الرواية، ليسا حلَّين للعالم المحبط وغير المضياف من حولنا، بل عنصران ضروريّان لإضافة شيء آخر إلى الحياة في شكل ذلك الذي ( لا يمكن تفسيره)، شكل أسطوريّ؛ فالأسطورة، في نصّ نيس، ليست أداة للتفسير، بل هي مساعدة للكشف الشخصيّ عن الرغبة في شيء يتجاوز الدنيويّ... إن ذلك الذي( لا يمكن تفسيره) يساعدنا على البقاء في عالم أصبح صعبًا بسبب معرفتنا وذكائنا، كما يتّضح من تراجع جورج إلى قصّته التاريخيّة الخاصّة، والتي بعدها "اختفى الألم، واختفى الخوف، وأصبح كلّ شيء دهشة وعجبًا"... إن (ما لا يمكن تفسيره)، في عصرنا، يعزّز الواقع ويشير إلى الرغبة في التحرّك إلى ما هو أبعد من معنى ما بعد الحداثيّة: كما تقول كوميكو، "كيف يمكننا أن نعيش في هذا العالم الذي لا معنى له؟"... يوفّر تدخّل الأسطورة راحة مؤقّتة من الألم والظلم الظاهريّ ، أو على الأقل اللامبالاة ، في الحياة اليوميّة.
ويندرج نصّ (القيامة : العمل المفقود للدكتور سبنسر بلاك ، 2013 The Resurrectionist: The Lost Work of Dr. Spencer Black ) لإي. بي. هدسبيث، ضمن فئة الأدب بعد ما بعد الحداثي، ليس فقط بسبب تاريخ نشره، بل وأيضًا بفضل محاولته الواضحة تجاوز السخرية ما بعد الحداثيّة من خلال بناء نصيّة صادقة، وتشهد القصّة على حساسيّة الرومانسيّة الجديدة، وخاصّة محاولة "تحويل المحدود إلى لانهائيّ، مع الاعتراف بأنه لا يمكن تحقيق ذلك أبدًا"؛ حيث يحاول سبنسر بلاك بشكل يائس إعادة المخلوقات الأسطوريّة إلى الحياة اليوميّة، والفشل المؤسف والنجاحات المروّعة التي حقّقها أثناء القيام بذلك... يجري بلاك تجاربه على ابنه الأكبر، ألفونس، "لإكمال عمليّة جعله "خالدًا"، وتحويله إلى الرجل الذي لا ينام، كما يجري عمليّة جراحيّة لزوجته المصابة بجروح خطيرة حين حاولت تدمير عمله مّما حوّلها، كما يوحي رأسها الذي ظهر على المخطّطات الوحشيّة داخل المخطوطة، إلى مجموعة كاملة من الوحوش الأسطوريّة قبل أن تقتله في النهاية... إن العين ما بعد الحداثيّة تفكّك الصور في مخطوطة الحيوانات المنقرضة، في حين أن العين الحداثيّة تندهش من تفاصيلها، والتذبذب بين الرعب والدهشة يؤكّد الحساسيّة المتذبذبة، ومرّة أخرى، وعلى غرار نصّ نيس، يدرس نصّ(القيامة) الأسطورة من منظور الفيض؛ الزيادة المرغوبة في الحياة، وإن كان مسعىً كئيبًا ومهووسًا ومحكومًا عليه بالفشل.
يكشف هوس بلاك فكرة تقترب من مفهوم فيرمولين عن "العمق"؛ النظر تحت السطح ما بعد الحداثيّ وعدم العثور على شيء، ولكنّ الأمل في أنّه قد يعثر عليه... إن هوس بلاك بالبحث عن شيء يتجاوز الألم والطبيعة الفوضويّة للوجود يتجلّى في الرغبة في تعزيز الحاضر بالأسطورة حين يسعى إلى جرّ الأسطورة إلى عالم الحياة اليوميّة من خلال التلاعب التجريبيّ بالأنسجة الحيوانيّة والبشريّة.
- تعثّر الخيال في روايات الحداثيّة المتذبذبة
يشارك توظيف الأنماط الأسطوريّة والفولكلوريّة في تذبذب معيّن بين الرغبة في العمق ومعرفة أنّه لا يمكن العثور عليه فضلًا عن وجوده، وهو ما يتفاعل "ليس ضدّ فكرة مرفوضة عن التجاوز فحسب، ولكن أيضًا ضدّ السطحيّة غير المرضية والارتباك الوجوديّ الناجم عن السطح ما بعد الحداثيّ".(32)، وفي حين أن التذبذب بين هذين القطبين الأيديولوجيّين والطوبوغرافيّين، السطح والعمق، مهمّ في حدّ ذاته، فإنه يجد أيضًا تأكيدًا خاصًّا في سرديّات الحداثيّة المتذبذبة من خلال التلاعب بالخيال، الذي يتذبذب "بين تفسير طبيعيّ وخارق للطبيعة للأحداث الموصوفة"، ففي (القيامة)، جرت مواجهة الخيال لأوّل مرّة عند اكتشاف بلاك لـ "لظبي صغير". وهنا، يقدّم سارد النصّ تشخيصًا سريريًّا للتشوّهات الظاهرة على الجسم، واصفًا الجثّة بأنّها "تعرض حالة تقويم للعظام تسبّبت في ثني ركبتيه بطريقة خاطئة. .. كانت العظام مشوّهة، وكان الشعر الزائد موجودًا على كامل الجلد"، وتتبع ذلك تأكيدات بلاك الأكثر خياليّة، حيث يصف الجسم بأنّه "قريب من السّاطير"(33)، وهكذا يُجبر القارئ على اتّخاذ موقف بين التفسيرين، دون أن يلقى أيّ منهما اهتمامًا أو مصداقيّة أكثر أو أقلّ من الآخر، وعلى الرغم من أن رسوم بلاك التوضيحيّة للجسم تعزّز حجّته إلى حدّ ما، يُجبر القارئ مرّة أخرى على اتّخاذ موقف خلال النصف الأخير من النصّ، والذي يتكوّن من مخطوطة الحيوانات المنقرضة The Codex Extinct Animalia، حيث يتمّ تقديم المخلوقات الأسطوريّة - حوريّة البحر، والكيمير(34)، والتنين- جنبًا إلى جنب مع الأوصاف والرسومات التشريحيّة التفصيليّة (والدقيقة من حيث تسمية العضلات والعظام).
تنشأ مجاورة بين تفكيكيّة ما بعد الحداثيّة، حين يتّضح جنون بلاك، فالوجوه في العديد من الرسومات تحمل تشابهًا واضحًا مع وجه زوجته (وهو ما يحمل دلالات متعدّدة ومزعجة)، والحماسة الحداثيّة التي تتمثّل في الاهتمام بالتفاصيل والإخلاص في مقدّمة بلاك لكلّ قسم مّما يشير إلى معقوليّة معيّنة لمزاعمه في تحويل المحدود إلى لانهائيّ، حيث يصبح الطبيعيّ خارقًا للطبيعة، وبالمثل كما في (زوجة الكركي) يجد القارئ نفسه متردّدًا بين الإيمان والشكّ حول سبب الحريق الذي يبدأ في منزل جورج، ونحو نهاية الرواية، تشرح فقرة خمس طرق محدّدة يمكن أن يبدأ بها الحريق، أوّلاً، مجرّد خطأ في إنتاج شمعة مضاءة، ثم جورج نفسه، وكوميكو، وشريكها الأسطوريّ المهجور؛ البركان، وأخيرًا راشيل، صديقة أماندا وحبيبة جورج السابقة، ويوفّر الغموض هنا تفسيرات تتراوح بين العرضيّ والقصديّ، تفسيرات دنيويّة وأسطوريّة على الرغم من أن النتيجة النهائيّة هي نفسها. هذا التذبذب بين الإيمان وعدم الإيمان، إلى جانب الرغبة في ما هو خارق للطبيعة (الذي قد يحلّ العديد من آلام البطل) وتفسير الطبيعة الخارقة (الذي من شأنه أن يحلّ أسئلة النصّ).(35)
إن هذه النصوص التي تنتمي إلى بعد ما بعد الحداثيّة، والتي لا تّتسم بالخيال المحض حيث يشير التردّد بين الإيمان وعدم الإيمان إلى فشل اللغة وتعبيرات السخرية، كما في رواية فونيغوت(المسلخ رقم خمسة) توظّف الخيال للتعبير عن الرغبة الملموسة في تجاوز عدم المعنى ما بعد الحداثيّ، وتسلّط فيسلر الضوء على موضوعات ناشئة مماثلة في مناقشتها لوظيفة الخيال في روايات أليسون لويس كينيدي:
"كما يفعل ماك إيوان في (التكفير)، أو أنطونيا سوزان بيات في (امتلاك)، أو مارغريت أتوود في (القاتل الأعمى)، فإن [كينيدي] تنصب الخيال أداةً قويّة يستخدمها الأبطال بشكل استراتيجيّ بدلاً من إخضاع الأبطال للطبيعة الطاغية لّلغة والسياق... إن عدم القدرة على الحسم بين الخيال والواقع الذي كان بمثابة الدليل على العديد من روايات ما بعد الحداثيّة لم يعد مشكلة، وبدلاً من ذلك، يتمّ تسليط الضوء على قيمة الجماليّات من خلال خلق حاجة عاطفيّة لدى القارئ لمثل هذه الأنواع من التجارب الجماليّة (فكّر على سبيل المثال في (حياة باي) ليان مارتل."(36)
يدشّن الغموض الخياليّ الذي يخلقه كلّ نصّ مساحة تظهر فيها الرغبة في العمق؛ لا تشير النصوص إلى عودة أيّ عمق، أو أيّ واقع أسطوريّ خاصّ، ولا تقترح عالمًا سطحيًّا فقط (في الواقع تتحرّك بنشاط ضدّ هذا العالم)، بل تشير، بدلاً من ذلك، إلى رغبة مجتمعيّة في البحث عن طرق يمكن من خلالها تجاوز انعدام العمق في ما بعد الحداثيّة، وفي الواقع، وفقًا لفيرمولين، يجيب الأدب المتذبذب بشكل مباشر على الديستوبيا من خلال خلق عالم (بعد ما بعد) حداثيّ؛ "إن رغبة الحداثيّة المتذبذبة في تجاوز ما بعد الحداثيّة تتوافق مع الرغبة المعاصرة في تجنّب عواقب النشاط البشريّ الحالي والواقع المرير الذي لا مفرّ منه، وغير المرغوب فيه، والذي سيأتي حتمًا، مّما يؤدّي إلى خلق مساحات خياليّة معيشيّة للعلاقات والتاريخ حيث يمكن للمرء أن يحاول "العيش مرّة أخرى".(37)
تصف الحداثيّة المتذبذبة الرغبة المعاصرة في تجاوز ما بعد الحداثيّة مع الارتباط بها إلى ما لا نهاية حينما يتأرجح الفرد باستمرار بين الإيمان والشكّ بطريقة تعكس ليس فقط الاستسلام الديستوبي، ولكن أيضًا الرغبة في التقدّم بغضّ النظر عن العواقب أو الوجهة. لا شيء واضح حقًّا، لكن يبدو أن ذلك لم يعد مهمًّا.
هوامش الدراسة:
- Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, 2nd edn (Abingdon: Routledge, 2002), 181.
- المصدر السابق:165
- المصدر السابق: 166
- Jeffrey Nealon, Post-Postmodernism; or, the Cultural Logic of Just-in-Time Capitalism (Stanford: Stanford University Press, 2012), X.
- David Ciccoricco, What [in the World] Was Postmodernism? An Introduction, Electronic Book Review, 2016 https://2u.pw/tq4RDfCH
- Edward Rothstein, CONNECTIONS; Attacks on U.S Challenge the Perspectives of Postmodern True Believers, The New York Times, 2001 https://2u.pw/dFxH55Kpz
- William Zinsser, Goodbye and Don’t Come Back, The American Scholar, 2011 https://2u.pw/rwgzUTGG
- Wallace, David Foster, E Unibus Pluram: Television and U.S. Fiction, Review of Contemporary Fiction, 13(2), 1993, 151-194
- المصدر السابق:52
- المصدر السابق: 148-149
- المصدر السابق:113
- Josh Toth, The Passing of Postmodernism (Albany: State University of New York Press, 2010), 113.
- Oasis, Oasis “Star” Cinema Advert (advertised in British cinema), 2015 https://2u.pw/ZvqJTLbe
- مايكل هارت و أنطونيو نيغري. 2002. الإمبرطورية: إمبرطورية العولمة الجديدة ترجمة: فاضل جتكر. مكتبة العبيكان-الرياض/السعودية.
- Jeffrey Nealon, 28
- المصدر السابق:37
- المصدر السابق:38
- Brian McHale, What Was Postmodernism, Electronic Book Review, 2007 https://2u.pw/WGiitq3N
- Jill Lepore, A Golden Age For Dystopian Fiction. The New Yorker, 2017 www.newyorker.com/magazine/2017/06/05/a-golden-age-for-dystopian-fiction
- المصدر السابق
- Daniel Ian Southward, The Metamodern Moment: Post-postmodernism and Its Effect on Contemporary, Gothic, and Multifuctional Literature, University of Sheffield, Department of English, 2018.
- Andrew Hoberek. Epilogue: 2001, 2008, and after, in: The Cambridge History of Postmodern Literature, ed. by Brian McHale and Len Platt (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 497–514, 508–9.
- Jonathan Sturgeon, The Death of the Postmodern Novel and the Rise of Autofiction, Flavorwire, 2014 https://2u.pw/wg2pp1Bg
- Alison Gibbons, Postmodernism Is Dead. What Comes Next?, TLS Online, 2017 https://2u.pw/B7VcKOgv
- Timotheus Vermeulen and Robin van den Akker. 2010. Notes on Metamodernism. Journal of Aesthetics & Culture 2.
- [1]انظر فصل (الحداثة المتذبذبة) في أماني أبو رحمة 2013. نهايات ما بعد الحداثة : ارهاصات عهد جديد، أماني ابو رحمة . مكتبة ودار عدنان للنشر ووزارة الثقافة العراقية، بغداد، ص: 402-426، ص:413
- Timotheus Vermeulen & Robin van den Akker, Utopia, Sort of: A Case Study in Metamodernism, Studia Neophilologica, 87:sup1, 2015, 55-67, 65.
- المصدر السابق
- المصدر السابق
- Sara Helen Binney, Oscillating Towards the Sublime, Notes on Metamodernism, 2015 https://2u.pw/TQ60WcTQ
- المصدر السابق
- Brendan Dempsey, [Re]construction: Metamodern “Transcendence” and the Return of Myth, Notes on Metamodernism, 2015 https://2u.pw/Z3RkbONo
- إله من آلهة الغابات عند الإغريق له ذيل وأذنا فرس
- كِمِّير هو مخلوق في الأساطير الإغريقية له رأس أسد وجسم شاة وذيل أفعى.
- Daniel Ian Southward
- Nadine Feßler, To Engage in Literature, Notes on Metamodernism, 2012 https://2u.pw/POjFYXp2
- Timotheus Vermeulen, Hard and Soft, Notes on Metamodernism, 2011 https://2u.pw/LYLIIfPD












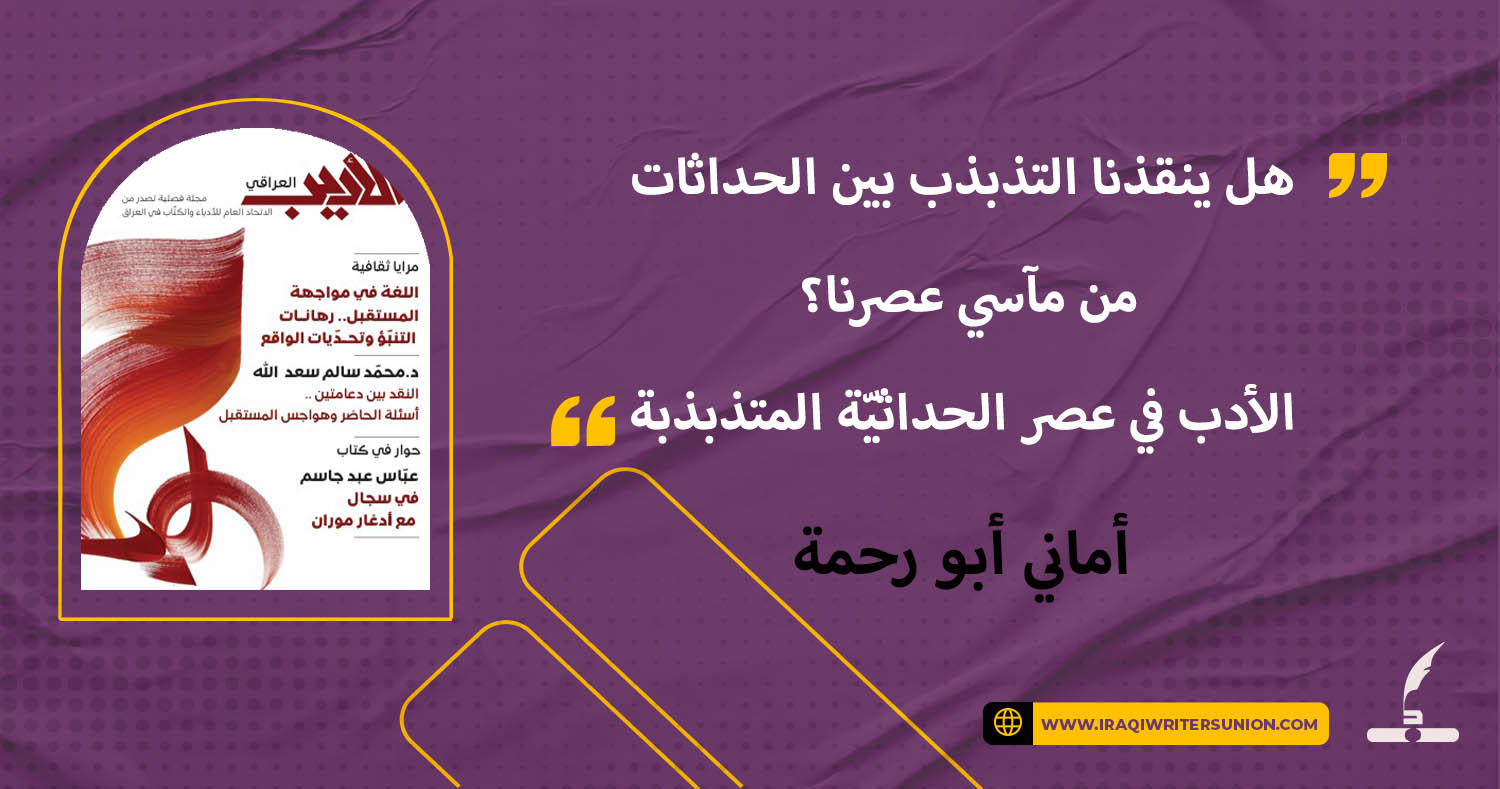
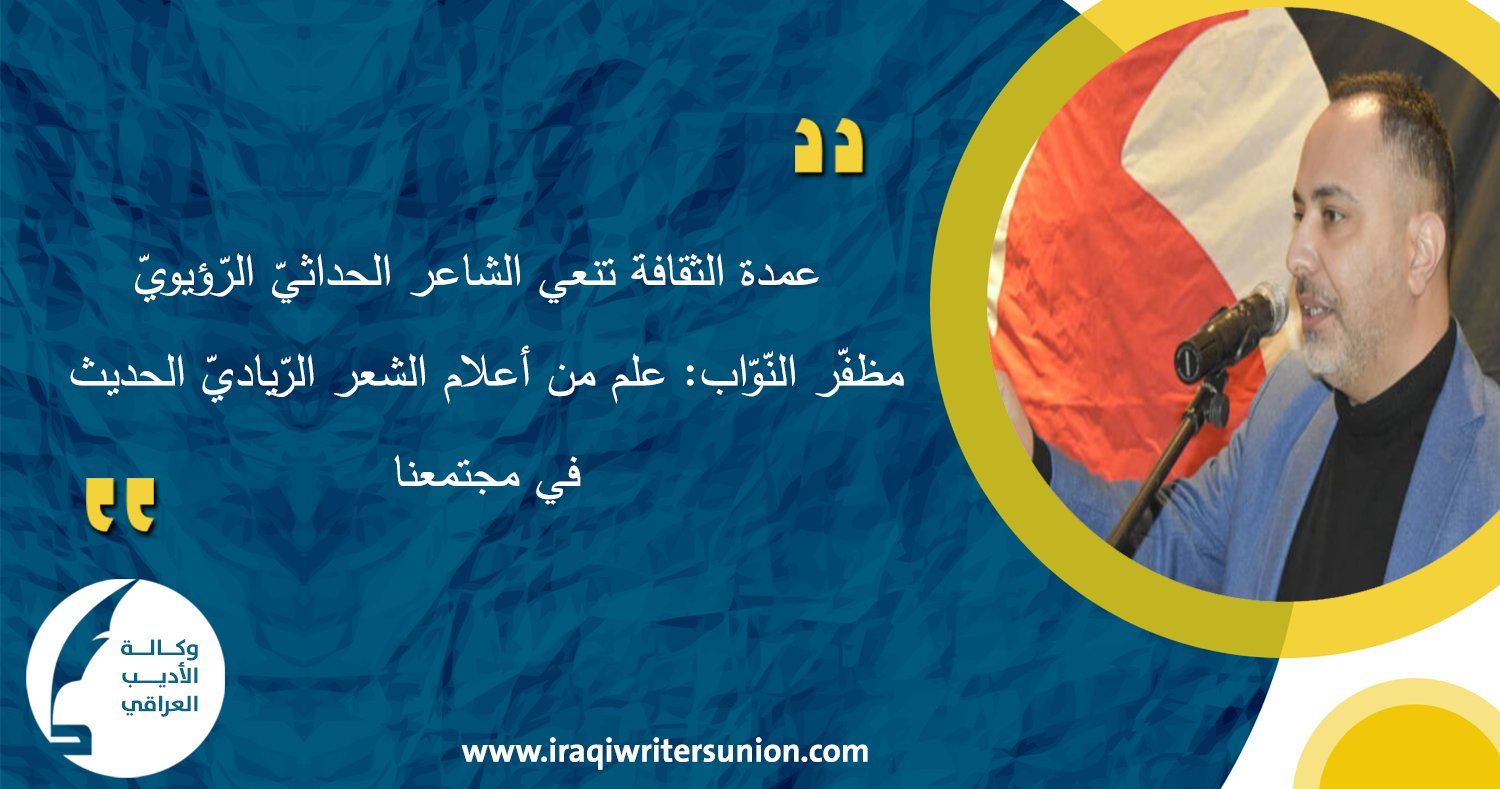
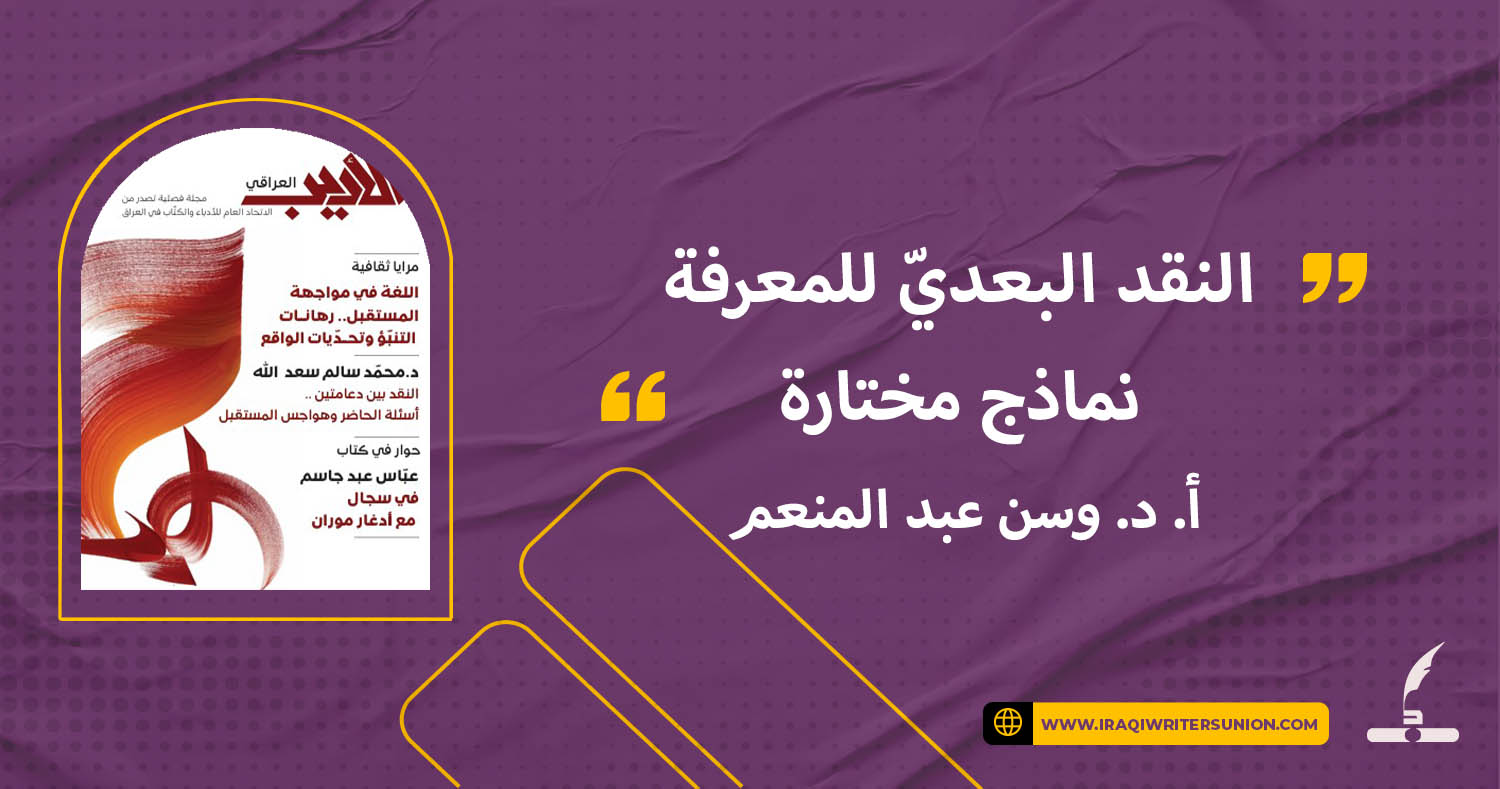




 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي