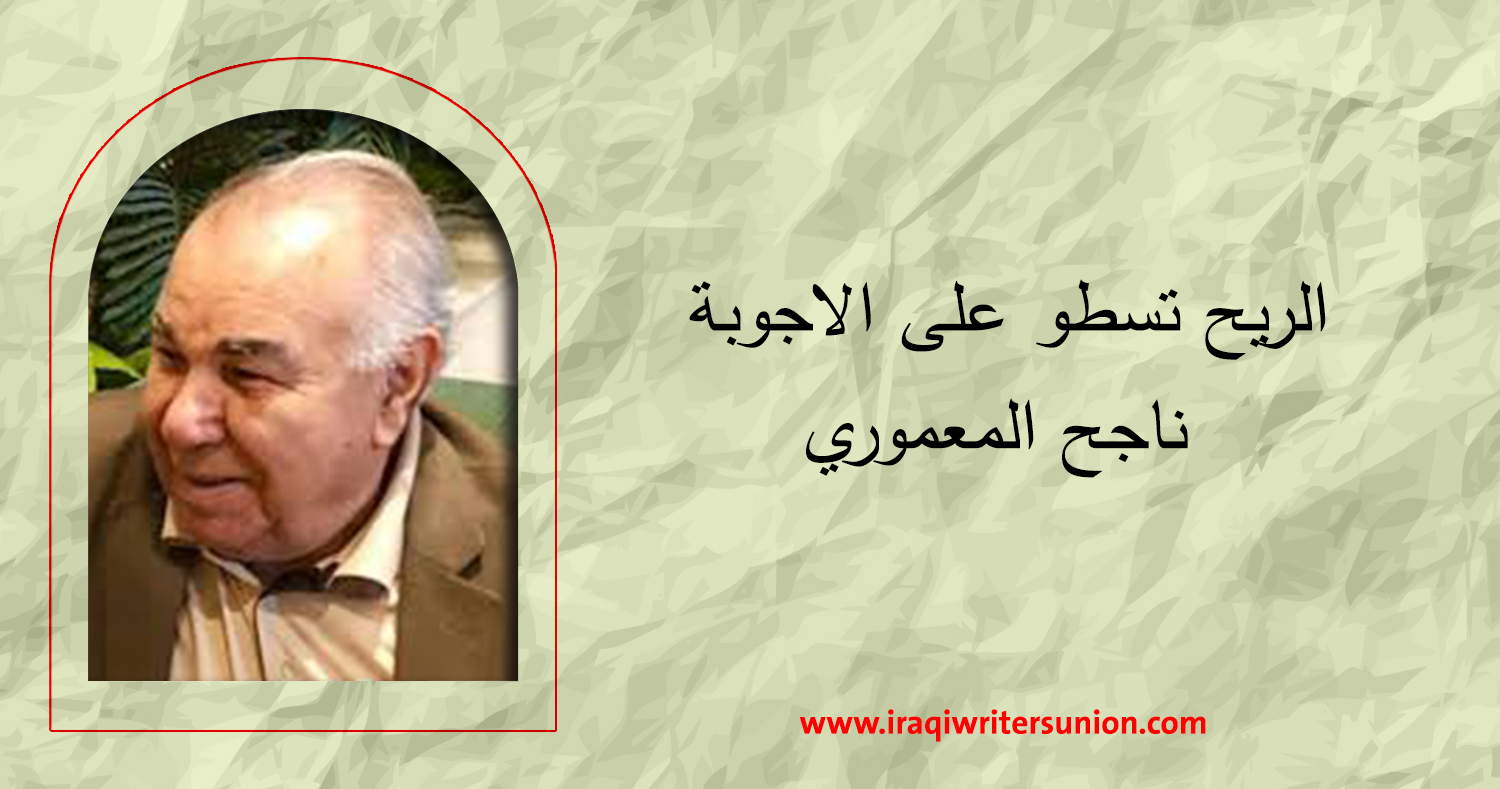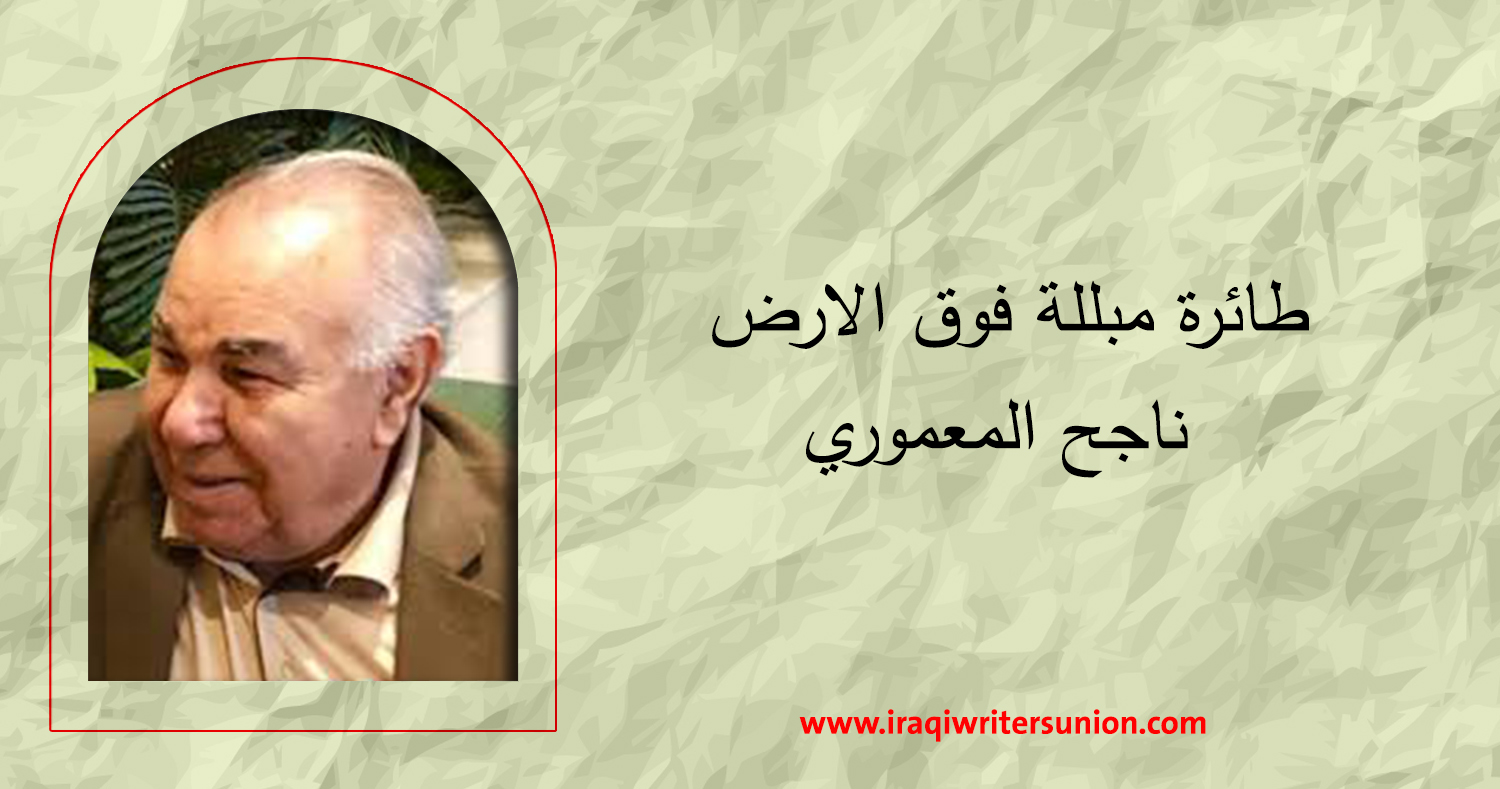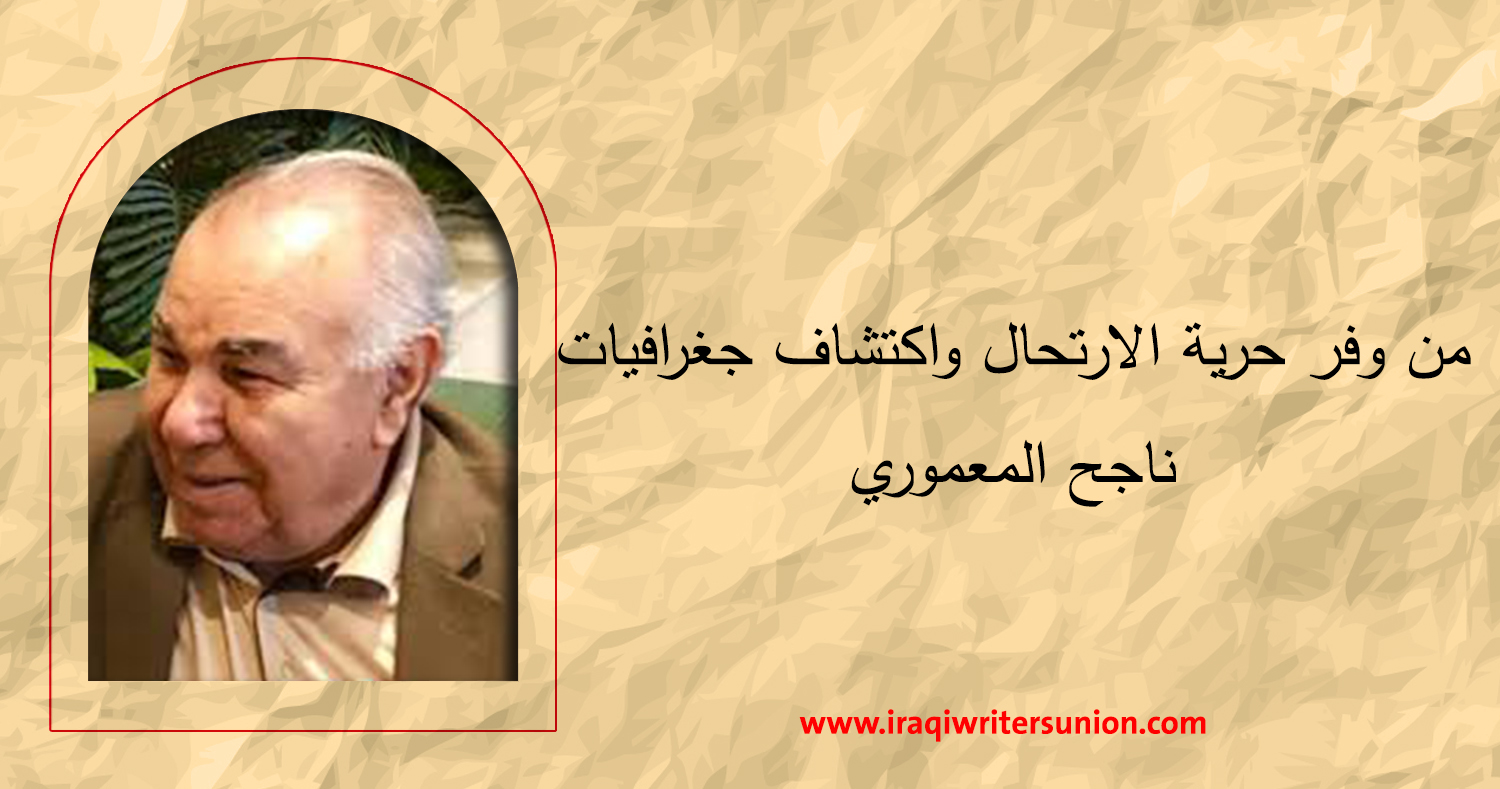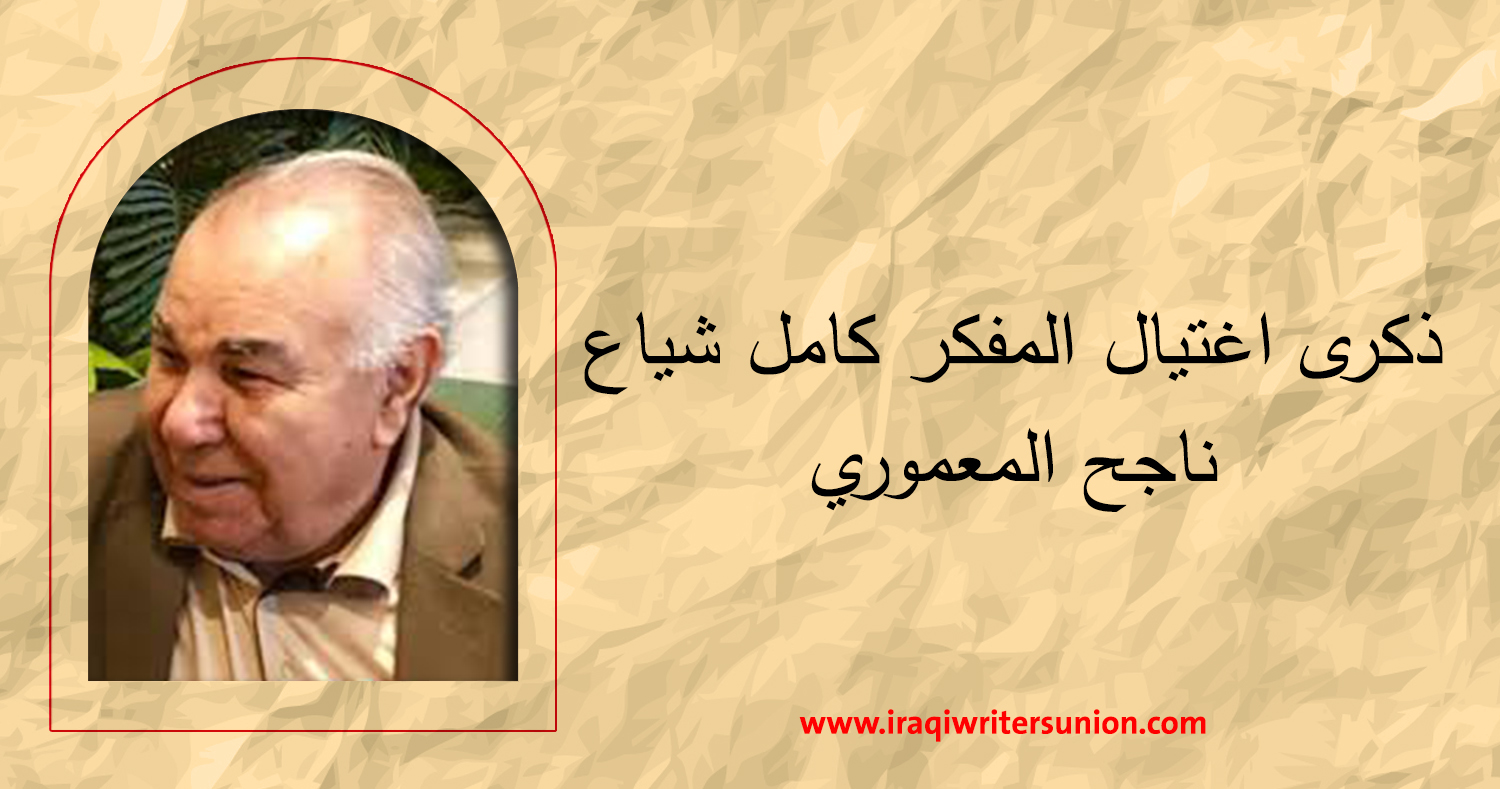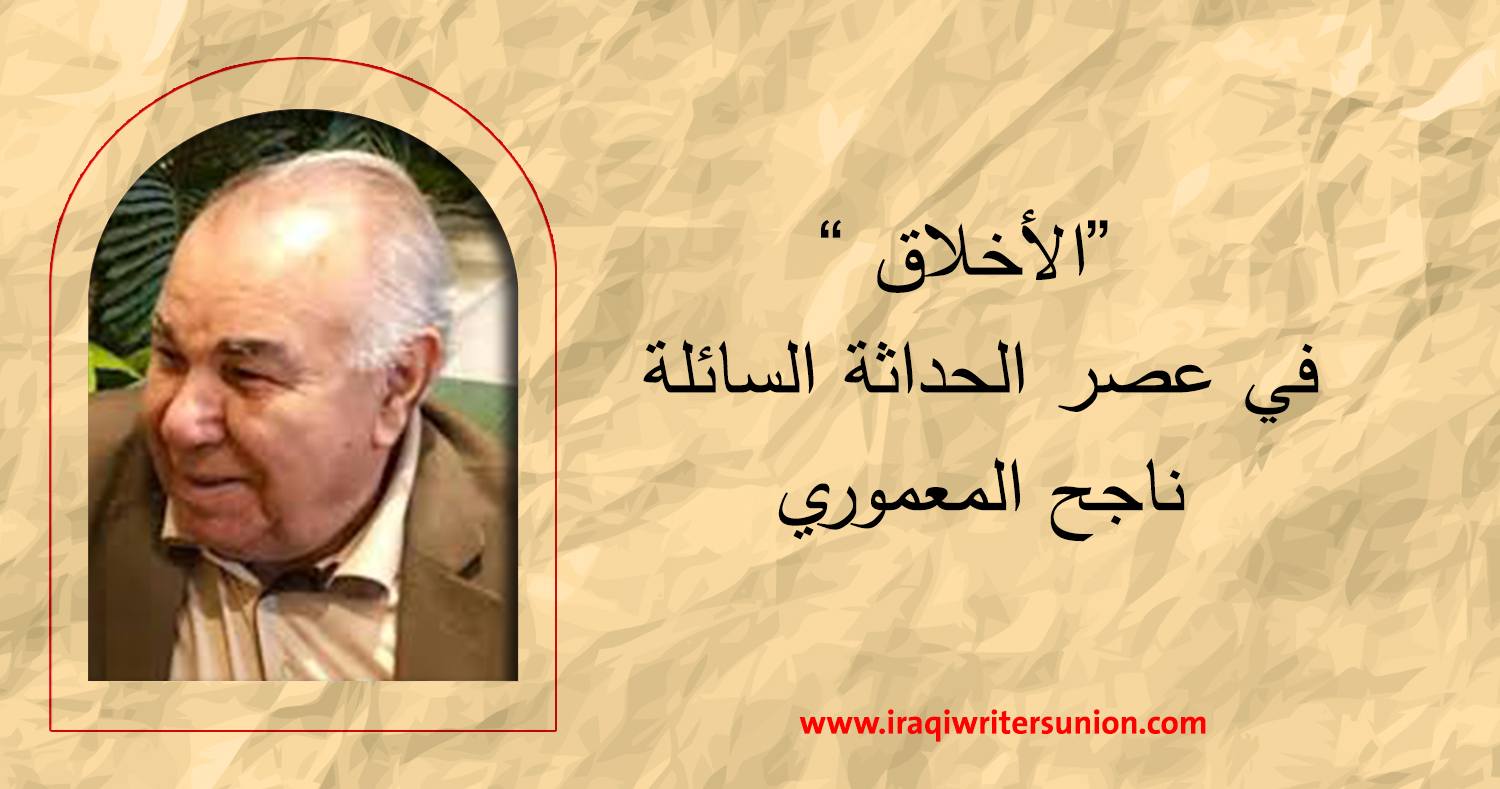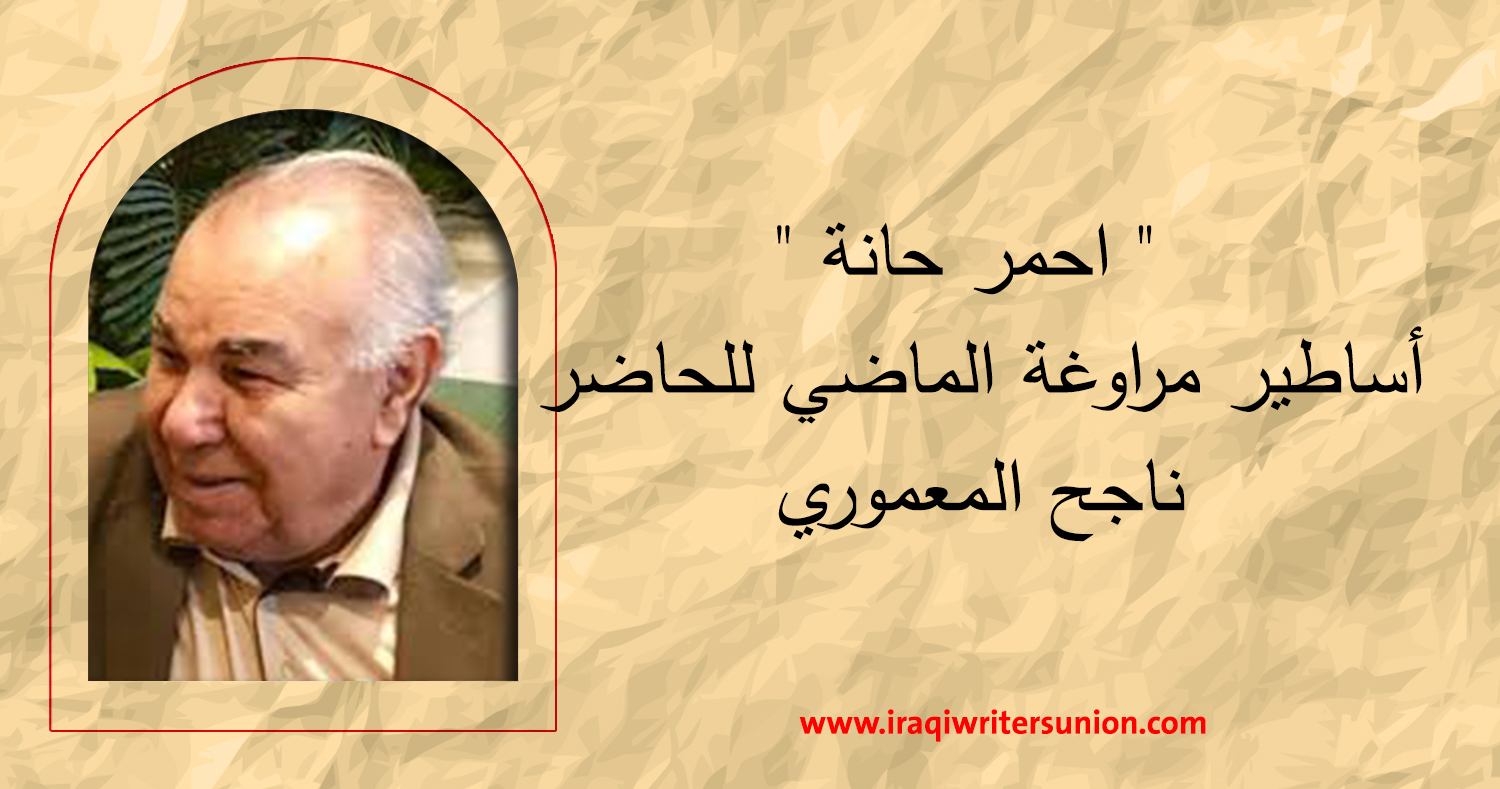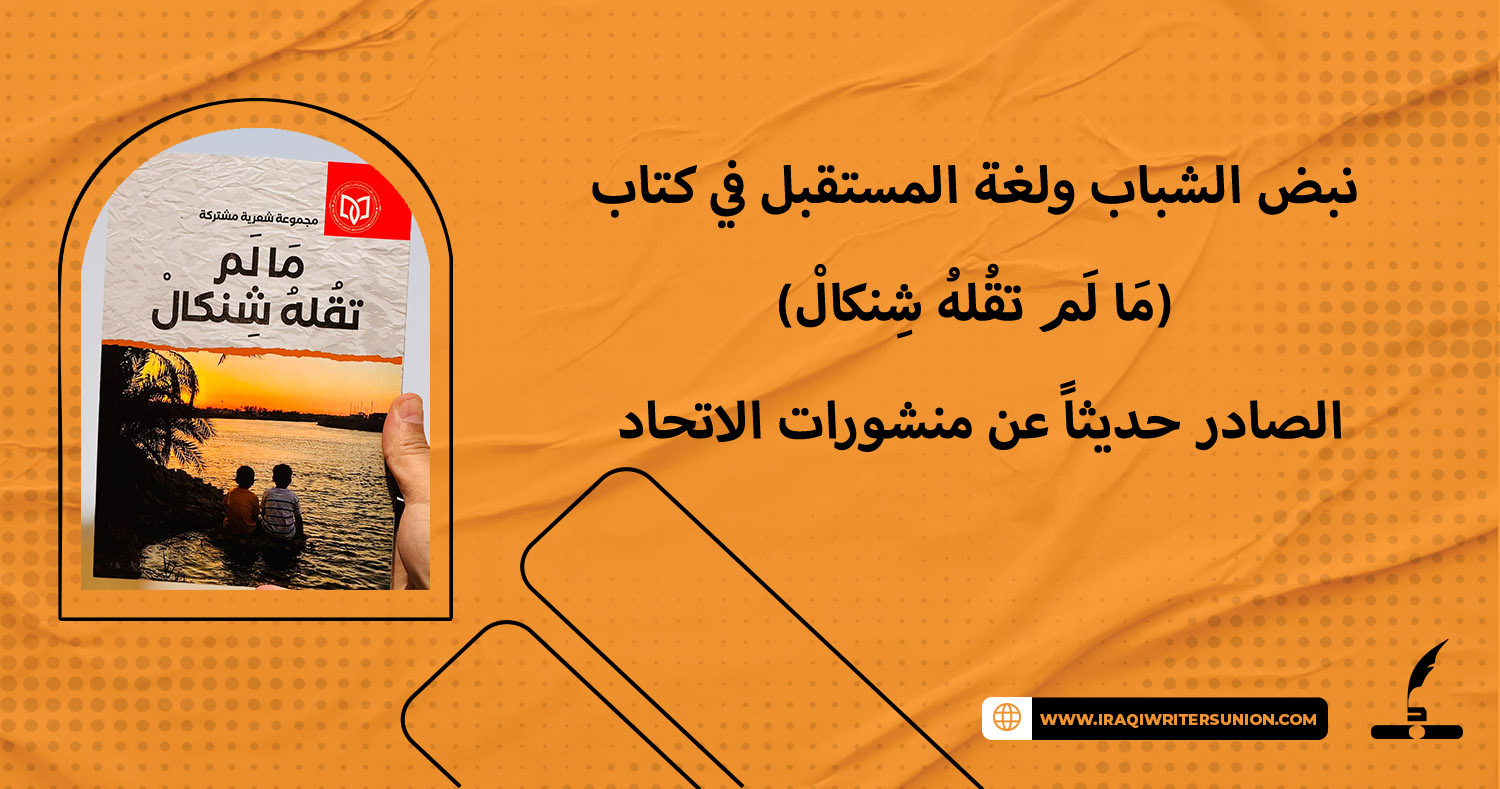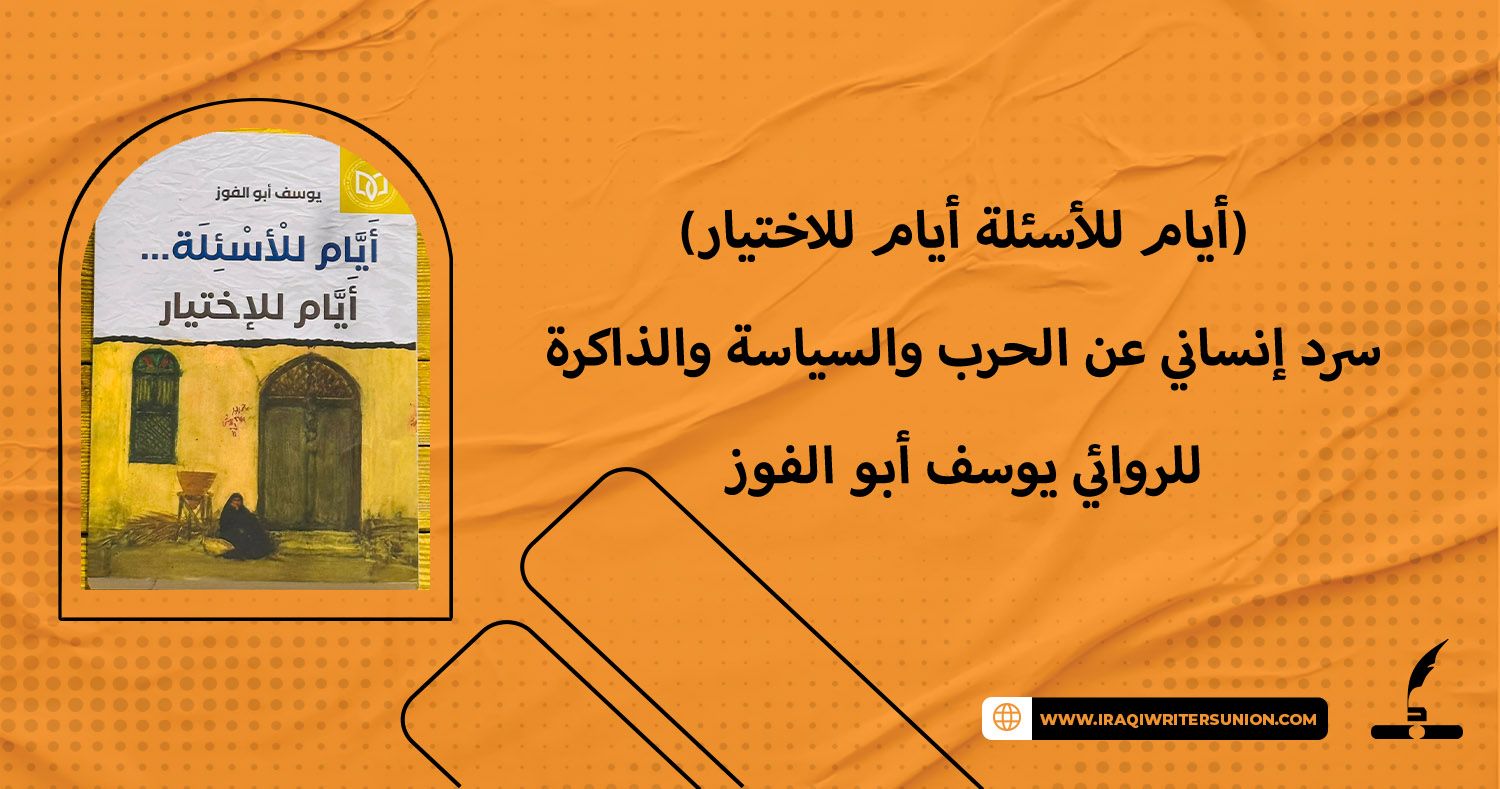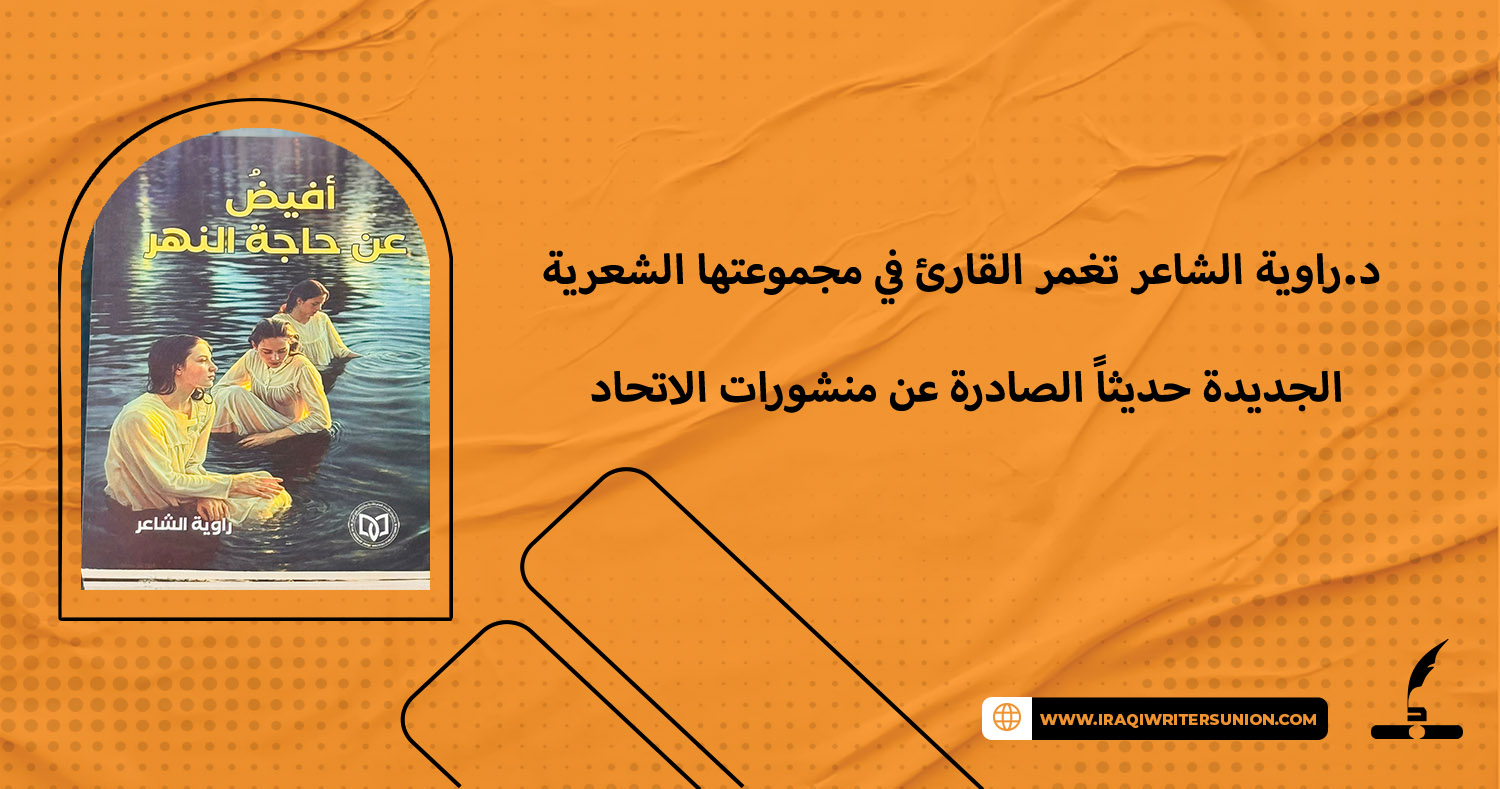ذاكرة النّقد الأدبيّ: الجمال أمرٌ حتميّ وتركه هروب من التّخصّص
أ. د إياد عبد الودود عثمان
يعدّ البحث في الجمال والجماليّ مفهومًا إشكاليًّا على أساس أنّه يرتبط بمجموعة من المشكلات التي لا يمكن حلّها إلّا برؤية شموليّة. وقد مثّل الجمال قيمة واضحة طويلة الأمد في دراسة الأدب لظروف تاريخيّة لها علاقة بفلسفات العصور وارتباطه بالأحاسيس ؛ وقد ظهر علم الْجمال Aesthetics بوصفه اتّجاهًا جدليًّا في دراسة الأدب على أساس إمكانيّة تعلّمه أو تقييمه أو الوصول إليه ، ومعرفة ماهيّته ومعاييره ، وتناغمت هذه الْجدليّة مع ثنائيّة المثاليّ والواقعيّ، فمنذ أفلاطون الذي يجد أنّ الجمال فعلٌ خارجيّ ، لا يحصل في ذاته ، رابطًا بين نسبيّة الجمال في الشّيء ، والخزين الجمعيّ الذي تحمله الحضارات وما يتعالق معها من قيم ثقافيّة وإنسانيّة تقود إلى الأخلاقيّ Ethics الذي به حاجة إلى عناية أكبر في دراساتنا النقديّة العربيّة. وقد ارتبط مفهوم الْجمال بالنّفع عند أستاذ أرسطو (سقراط) الذي وجد في جحوظ عينيه جمالًا على أساس الوظيفة النّفعيّة التي تتحقّق ، وأيّده في ذلك آخَرون ، ومن هؤلاء جورج سانتيانا صاحب كتاب (الإحساس بالْجمال).
وكان أرسطو قد ربط الْجمال بمفهوم الانسجام والتّناسب والتّوافق ، فالعين جميلة إذا كانت تناسب الوجه ، وهكذا ، وفي الوقت نفسه كان يعتني بما يحقّقه الفنّ من تطهير Catharsis بوصفه المرتبط بالتّنفيس الوجدانيّ وتهذيب النّفس ، عند دراسته لفنّ الشّعر والبلاغة والمسرح وغيرها، والتطهير قرين الرّسالة التي ينقلها العمل الفنّي نفسه. أمّا الرّمزيّون فوجدوا في الغموض جمالًا ، ويقال إنّ سرّ الإثارة في (ألف ليلة وليلة) يكمن في غموض ما تسرده شهرزاد وما يرافقه من تشويق ، وتحقيق اللذّة الْجماليّة Aesthetic Pleasure ، ولا يمكن إغفال النّزاع بين الموضوعيّ والنّسبيّ في دراسة الجمال طوال حقب التّاريخ.
لقد كانت فكرة الْجمال واحدة من مداخل دراسة الفنون في الفلسفة الحديثة ، وقد مثّل كانط وهيغل وسارتر أبرز هذه المداخل ، والحديث يطول في ذلك ، وأركّز – هنا – على مقولة كانط الذي يجد في مَلَكة الحُكم الْجماليّ ما يُعرف بحكم الذّوق بوصفه مَلَكة مستقلّة عن العقل الخالص والعقل العمَليّ ، وهي نتاج التّفكير الفلسفيّ للوصول إلى الفَهم والمخيَّلة ؛ وأنَّ الْجمال وحدَه ليس فنًّا ، لكنّ الفنّ يمكن أن يُصنَع لأجل الأشياء الْجميلة ، وما يرتبط بها.
إنّ ارتباط الْجماليّ بالفلسفة يذكّرنا بالبلاغة الأرسطيّة حين كانت تدرَّس مع الفلسفة ، وكذا الحِجّاج والْجدل وما إلى ذلك ؛ فالأمر ليس غريبًا لارتباط الجماليّ بالطبيعة ، والفنّ ، والتّذوّق، والمتعلّقات الحسيّة ، والقيم العاطفيّة ، والشّعور، ويبدو واضحًا أنّ ثورة المناهج الحديثة وخلفيّاتها الفلسفيّة كانت سببًا في إعادة التّفكير بالْجماليّ بطريقة جديدة بعد أن هيمن على دراسة الأدب منذ عقود ، وقد كان لثورة الإنتاج الإبداعيّ في الأدب في الثمانينيّات والتسعينيّات تأثير في التفكير النّقديّ ،؛ إذ اختلط الفلسفيّ بالْجماليّ بوضوح ، وقد قاد هذا الاختلاط إلى ظهور اتّجاه جماليّ تعدّى حدود اللغة الإبداعيّة المنطوقة إلى ما عُرِفَ بلغة الأدب المقارَن المستندة إلى الفحص الْجماليّ ، وقد شجّع ذلك ظهور فلسفة (العَولَمة) وهيمنتها على التّفكير الفلسفيّ ومن ثمّ التفكير النّقديّ حتّى بات من المُسلَّمات القول : إنّ الأدبيّ قرين الجماليّ على أساس أنّ الأدب يعتمد الْجمال بل هو فرعٌ من فروعه الفاعلة.
إنّ الْجمال قيمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة والشّعور الإيجابيّ ، والأديب حامل رسالة ، والبحث عن الْجمال ميدان الفضيلة المادّيّ والمعنويّ الذي يبحثُ فيه النّقّاد ؛ فهو متأصّل في مسارات النّقد على مرّ التأريخ ، والْجمال هو العنصر المشترك الأوّل بين أنواع النّقودات في الشّعر أو السّرد ومتعلّقاتهما الفنيّة ، وكذا الفنون التّشكيليّة أو المعمار أو الموسيقى أو السينما أو المسرح وغيرها.
يقول ابن سينا إنّ الرّغبة في خوض الْجمال أمرٌ فطريّ في الكائنات الذّكيّة ، وإنّ مصدره جمال الخالق المطلق، وهو بذلك يعبّر عن النفس الإنسانيّة وسموّها ، ويذكّرنا هذا الرّأي بموقف المتصوّفة من الجماليّ. أمّا الفنّانون فيحاولون تجسيد الجمال بتوظيف أدواتهم في الرّسم أو النّحت أو الموسيقى أو الشّعر أو الفنون البَصَريّة الأخرى ، ومن الواضح جدًّا ارتباط الفنون ومنها الأدب بالجوانب النّفسيّة التي يحقّقها الجمال ، وبسبب ذلك ظهر (علم النّفس الْجماليّ) وكذا ما يُعرَف بـ (علم نفس الأدب). استنادًا إلى ذلك يمكن القول إنّ رصد الْجماليّ فطرة ، والإجراء النّقديّ يمثّلُ إسقاطًا وسلوكًا نفسيًّا بديهيًّا ، والبحث عن الْجماليّ إنّما هو هُويّة النّقد الأدبيّ؛ وليس اعتباطًا حضور الاتّجاه الْجماليّ في النّقد القديم ، ولاسيّما النّقد العربي الّذي نشأ في ظروف فلسفيّة خاصّة جعلتْهُ يعتني بالنّصوص من الدّاخل مُبكّرًا، وهو يبحث في الْجماليّ والْجمال مستفيدًا من ظروف تعليم المسلمين الأعاجم والعرب ما عُرِفَ بـ (الإعجاز) الذي يقوم على كشف الْجماليّ في القرآن الكريم ، وهو صورة متقدّمة من صور الكشف عن شعريّة التّعبير وأسلوبيّة النّصّ، ومن البديهيّ القول إنّ القرآن جميل في رسالته الإنسانيّة وقيمه الثّقافيّة أيضًا.
إنّ الجمال سمة وجوديّة ، والتّعامل معه ضرورة نفسيّة ، والْجدل في علاقته بالأدب لا يوصل إلى نتيجة ؛ لأنّ البحث في مزالق الاتّجاه الْجماليّ في التنظير أو التطبيق عقيم ؛ لأنّ التّاريخ النّقديّ الْجمالي الطّويل ، وعمر النّقد الرّاسخ في ذاكرة الأمّة يجعلنا نقرّ بضرورة التمسّك بالْجماليّ بوصفِهِ عنصرًا أساسيًّا في رصد الشّعريّ أو السّرديّ وقبلهما القرآنـيّ. وهذا لا يعني أن نحوّل الأدب إلى ألاعيب مجرَّدة من الرّسالة الإنسانيّة الثّقافيّة التي يحملها.
تمثّل مواجهة الْجماليّ والتّصدّي له هروبًا واضحًا من التخصّص، وسلوكًا تأويليًّا مَرَضيًّا يقوم على عدم تقبّل الأشياء مثلما هي حاضرة وفاعلة وممتدّة في عمق الأصالة ، والابتعاد عن الجماليّ مثّل اليوم ملاذًا لعدد من الهاربين من مسؤوليّة الضّبط المنهجي، باستثناءات معروفة مثّلها جامعيّون فاعلون. ويبدو أنّ التأثّر بالفلسفة الظّاهراتيّة وفلسفة التّفكيك التي يهمّها كثيرًا إظهار التناقضات ، ومقولات ما بعد الحداثة وما رافقه من حريّات في تقبّل الأشياء على طريقة (دعْهُ يَمرّ)، كانت من المُمَهّدات الموهِمة التي قادتْ إلى ذلك السّلوك. ومن ذلك تأثّر الوسط الثقافيّ العربيّ بأفكار غربيّة منذ تفكيكيّة دريدا ، و رولان بارت في نقد الثقافة البرجوازيّة وأمبرتو إيكو في نقد العنصريّة في أوروبا، وكذا بعض طروحات بارت وفوكو. فضلًا عن ما كتبه الدكتور كمال أبو ديب في دراسة النّسق الثّقافيّ بوصفه المتواري خلف النّصوص والخطابات، وكذا أدورد سعيد في دراسته للاستشراق، وهذه الأفكار الفلسفيّة برأيي تغرّب واقعنا النّقديّ وتسلبُه الكثير من أصالتِه.
إنَّ أمّة العرب تمتلك موروثًا نقديًّا وبلاغيًّا وجماليًّا هائلًا ، يقابله منجزٌ قرآنـيّ و إنشائيّ نجده حاضرًا في ذائقتنا بوضوح ، عمرُهُ يتجاوز الألف سنة بكثير، ولاسيّما في القرنَين الثالث والرّابع للهجرة. وإذا كان هناك ثمّة تقصير فهو في حدود عدم التّوسّع في دراسة الْجمال المعنويّ وما يحقّقه من شعريّة وأصالة فكريّة ، وقيم نبيلة ، وعلينا إعادة قراءة المُنجَز الإبداعيّ العربيّ بعيدًا عن بعض إفرازات ما بعد الحداثة وجوانب من مآلات العَولَمة التي تحاول استلاب هُويّة الأمم وأصالة منجزها.
وهنا أقول إنّني أدعو إلى دراسة الْجماليّ في النّقد مع الانفتاح على عوالم المعنويّ والأصالة بطريقة أوضح وأرسخ بالإفادة من المنجز الإبداعيّ والنّقديّ بدلًا من تغذية النّقد بالدراسات الثقافيّة بصورتها الانتقاديّة للموروث التي تواجه الْجمال على طريقة الرّافض والمُعادي ، وإذا كانت هناك ضرورة فلسفيّة و واقعيّة ، فظهور (النّاقد المزدوج) الذي يحيي الجماليّ بتوظيف الثقافيّ بعيدًا عن فرضيّة المضمرات الانتقاديّة هو الحلّ التوفيقيّ الذي يمكن الاستناد إليه بطريقة تعترف بخصوصيّة اللغة الإبداعيّة العربيّة ، وخصوصيّة النّقد الأدبيّ العربيّ. وهنا تجب الإشادة بما قدّمه الدكتور عبد العظيم السلطاني في كتابه (نقد النقد الثقافيّ) بهذا الاتّجاه الذي بحث فيه في عدد من مزالق لعبة الدّوال التي طرحها الدكتور عبد الله الغذّامي التي وفّرت لي مساحة من التّفكير بطريقة جديدة .
إنّ مقولات الناّقد عبد الله الغذّامي في النّقد الثقافي مؤثّرة ومهمّة جدًّا ، لولا حدّتها في مواجهة النّقد الأدبيّ ، والإعلان عن (موته) ، وإثارتها للجدل ، وهذه المقولات تلفِتُ انتباهَنا إلى أهميّة دراسة المضمون وتأمّله ذهنيًّا ، لكنّها تنسى العمر النّقديّ الجماليّ العربيّ الطويل الذي تقع عند قمّتُه دراسات - قلّ نظيرها- اعتنت بالإعجاز القرآنيّ ، والإبداع الشعريّ والنثريّ ، أظهرُها كتب الجاحظ (ت 255 هـ) وعبد القاهر( ت 471هـ) و أبي يعقوب السكاكي (ت 626 هـ) وحازم القرطاجني (ت 684 هـ) وغيرهم كثير، ولا وجود له في الأمم الأخرى بسبب عمر لغتنا الطويل ، ولا يمكننا إهمال منجز هائل يستدعي دراسات جماليّة بدأ بالمعلّقات وسَجْع الكُهّان وشعر الواحدة ومرّ بالخطابة الإسلاميّة والرّسائل والغزل العذريّ والحماسات والحجازيّات والكافوريّات والمقامات والموشّحات والمدائح النّبويّة ورثائيات آل البيت ، والسّرديّات الكبرى ، ومئات الدواوين المحقّقة ، وهي جميعًا مرتبطة بأمّتنا ولغتنا الإبداعيّة ، وما تحملُه من قيم جماليّة معنويّة ذات رسائل نبيلة بها حاجة إلى متابعة وتأثيث وإعادة قراءة بوعي نقديّ فلسفيّ جديد ، ويمكن أيضًا تطوير إجراءات التحليل البديعيّ المعنويّ – وهي شُبه مهملة - بهذا الاتّجاه الذي يقع ضمن حدود المستوى الدّلاليّ الذي يبحث فيه علم البيان أيضًا في الدّرس البلاغيّ العربيّ ، فالبحث في إمكان تأدية المعنى الواحد بطرائق متعدّدة ميدان علم البيان ، ويحيل على التوظيف الْجماليّ للعبارة التي تستدعي عناية أكبر بالمعنى على أساس مفهوم مقتضى الحال الذي يستهدفه النّقد البلاغيّ المعياريّ ، وفي تأمّل اللغة الكنائيّة في موروثنا الشعريّ والسّرديّ نجد أن لها الأصل الأوّل في تحقيق الشّعريّة بسبب ذاكرة اللغة الطويلة جدًّا ، والميدان يُشجّع اليوم للتفكير النّقديّ الفلسفيّ بطريقة جديدة انسجامًا مع ثورة المناهج وتوجّهات البلاغة الجديدة التي ترحّب بتطّوير أنويّة ثقافيّة تعترف بأن المنهج كائن حيّ له أبوّة ونَسَب. وفي هذا ردّ ضمنيّ على مقولة (شيخوخة البلاغة العربيّة ورجعيّتها) التي ردّدها أستاذنا الدكتور عبد الله الغذّامي ، وترحيب مطلق بالقراءات الثقافيّة والانفتاح على المعارف الأخرى ، ورفض للنّقد الثقافيّ وإجراءاته الانتقاديّة المُفتَرَضة ، واتّهام النقد العربيّ بالعمى الثّقافيّ على أساس أن النّقد الأدبيّ العربيّ يمتلك ثروة نقديّة وإنشائيّة متسلسلة ومتحوّلة بطريقة قلّ نظيرها في العالم.












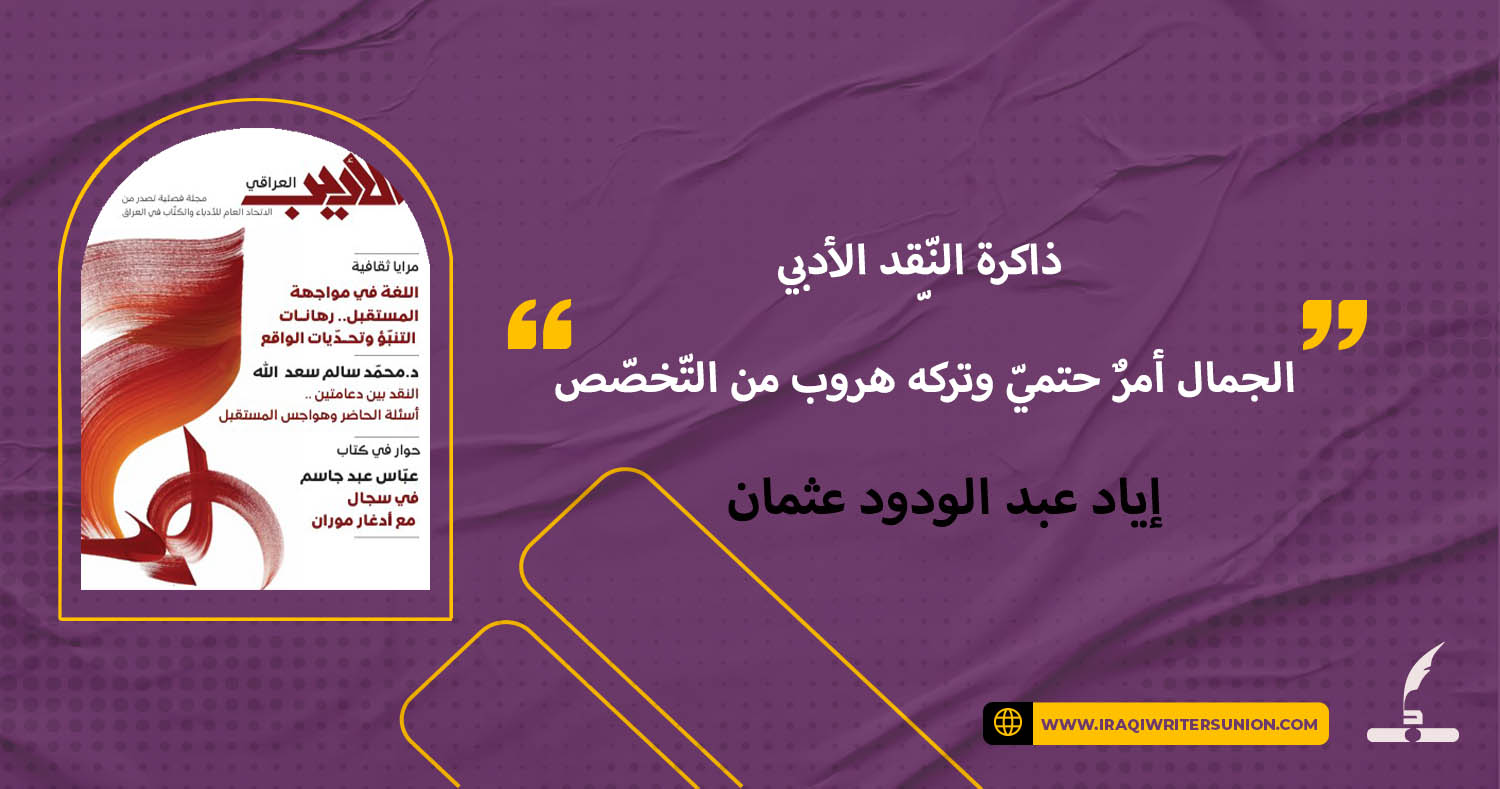
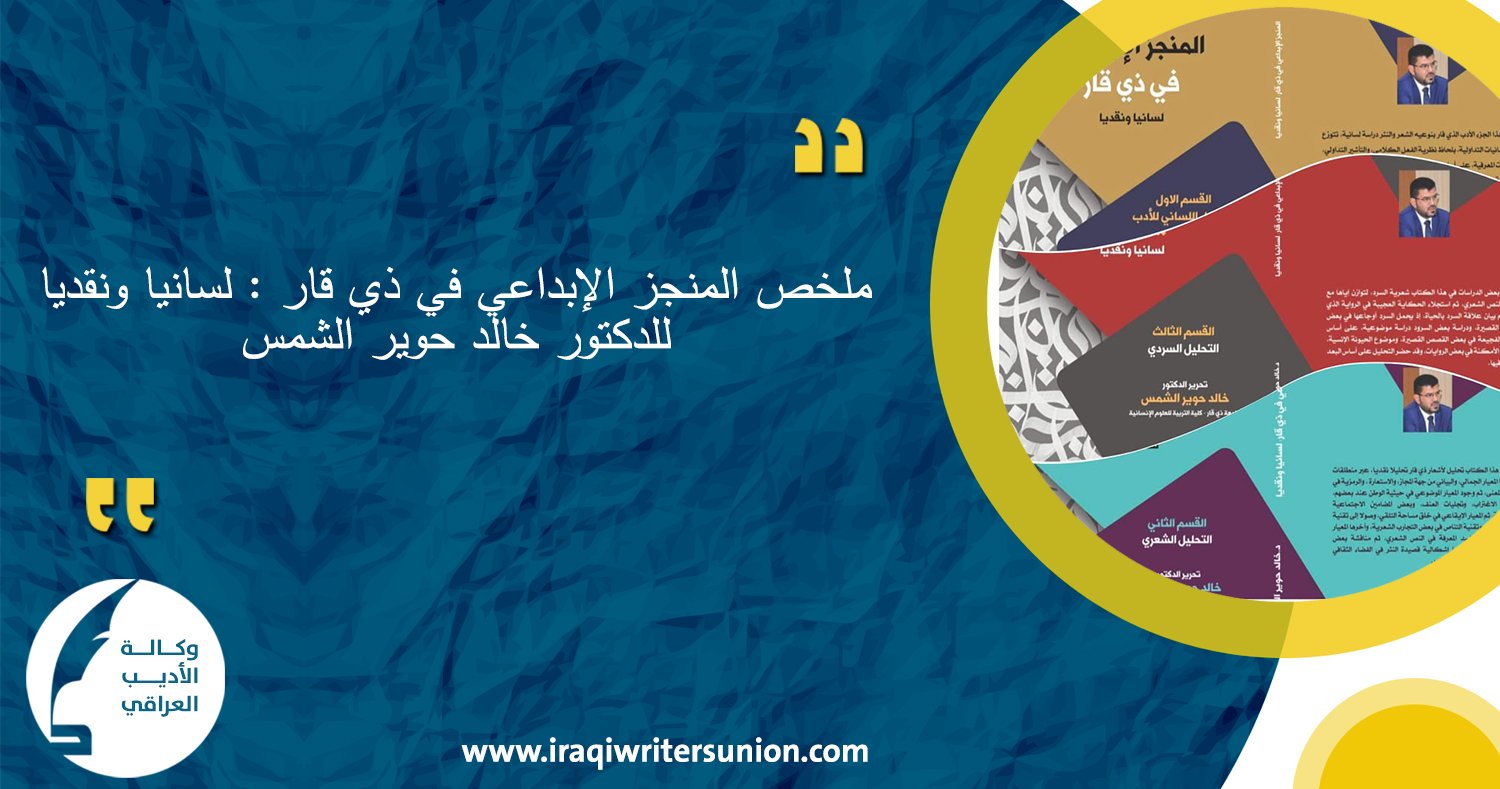
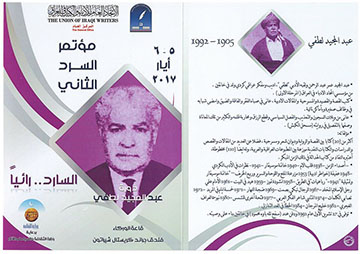
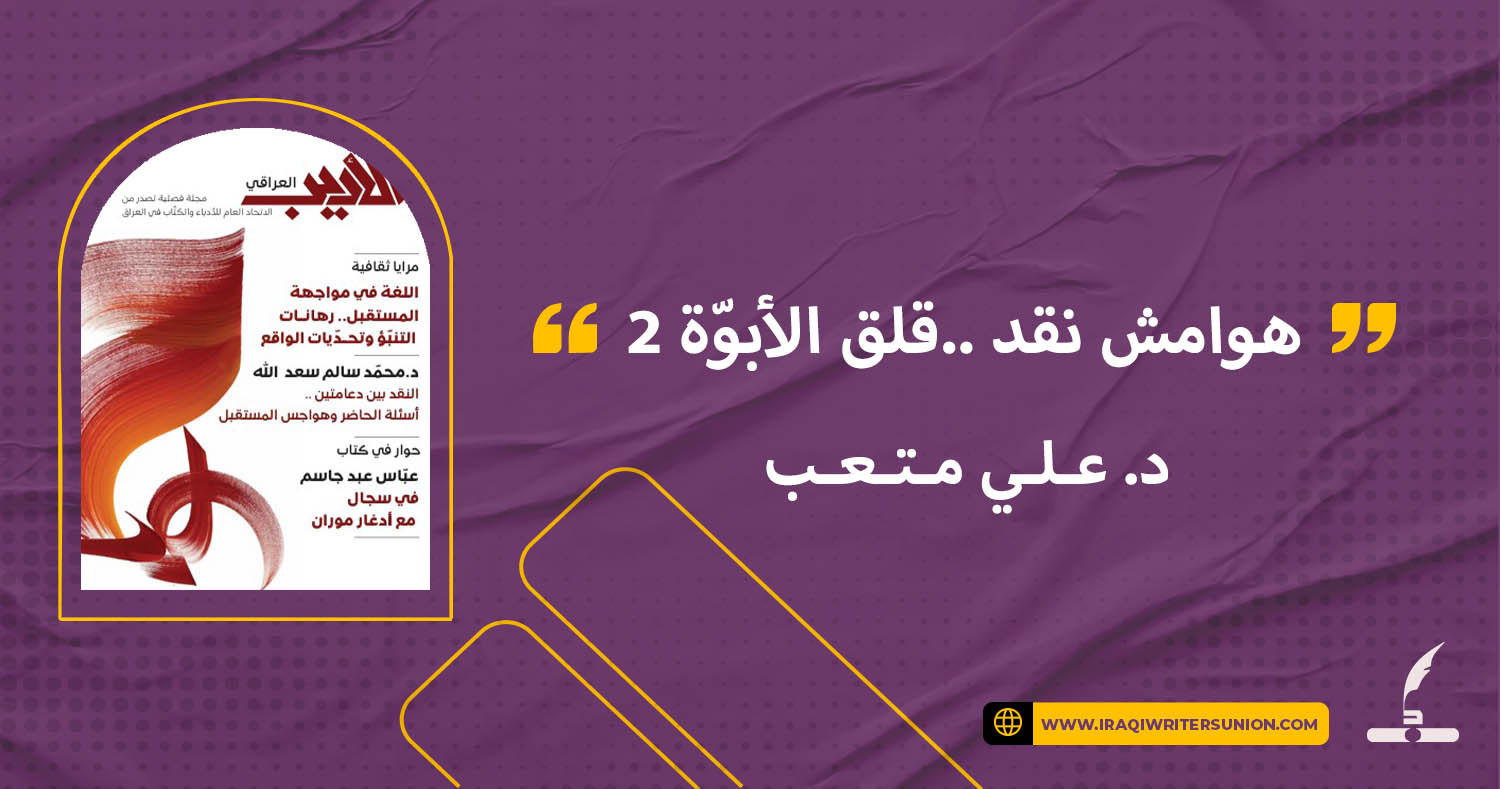
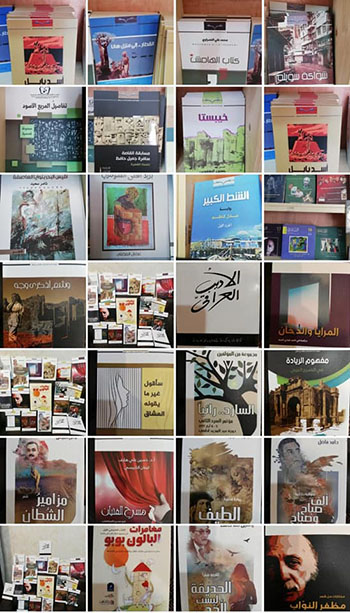
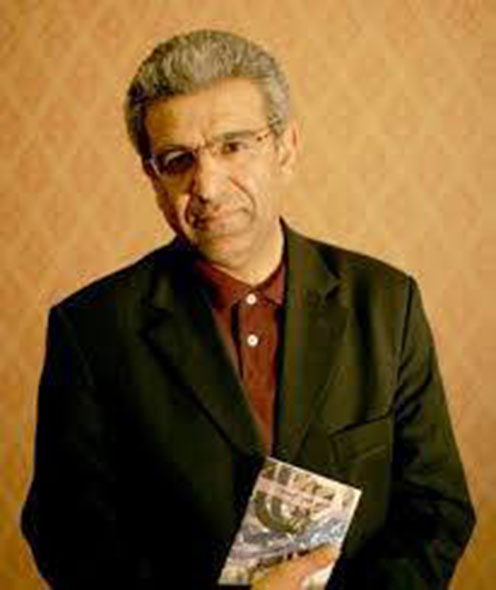

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي