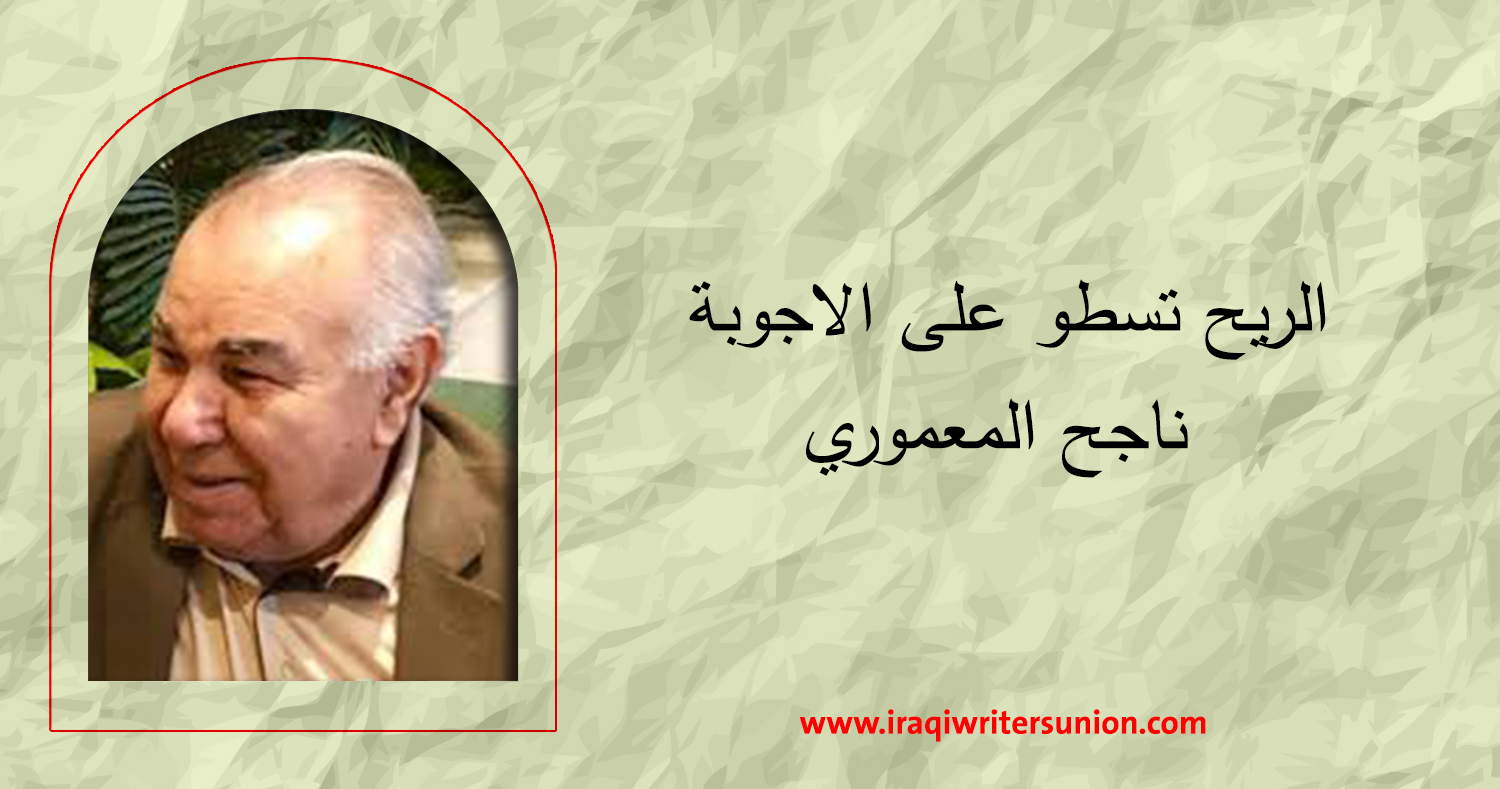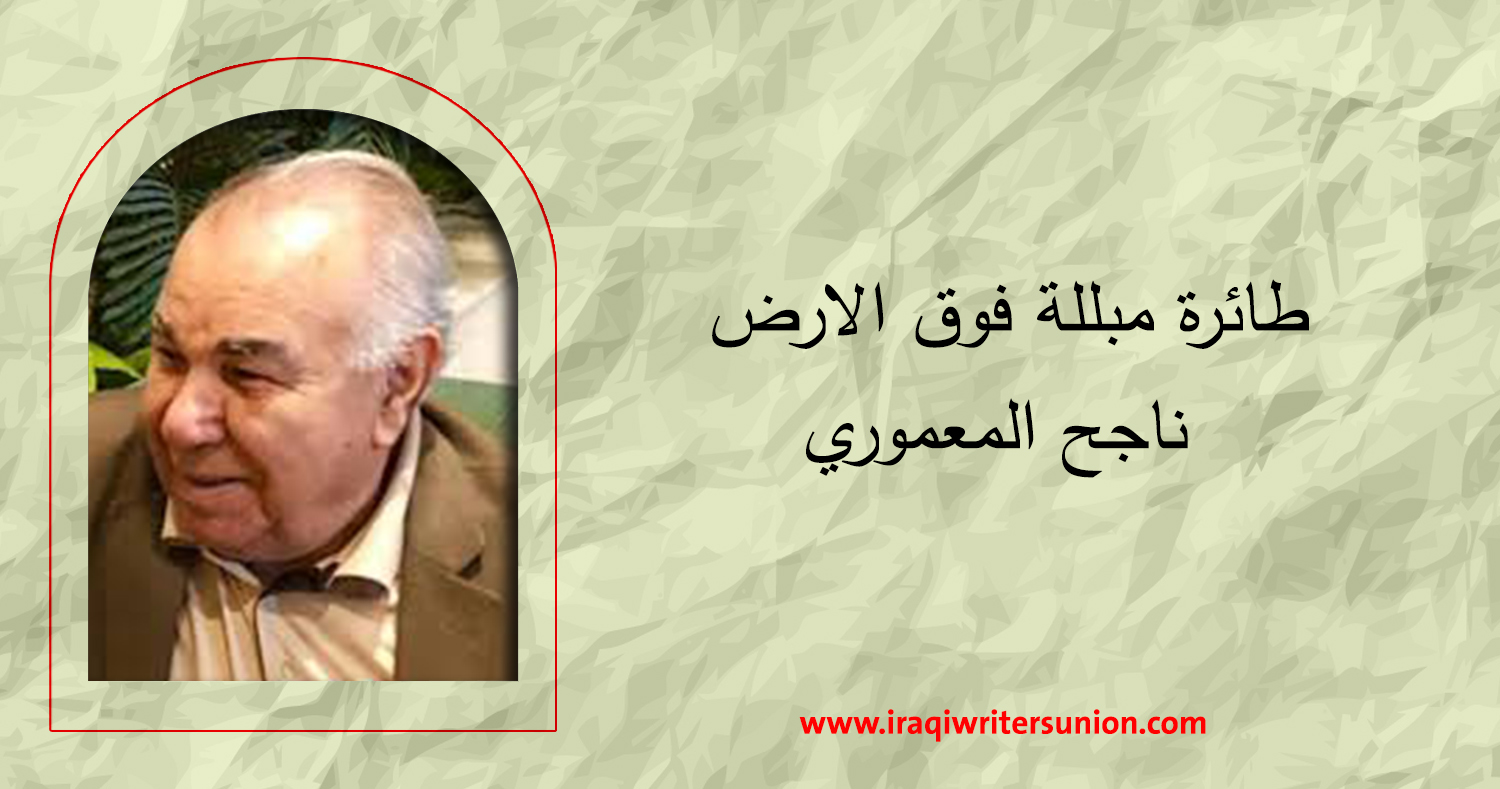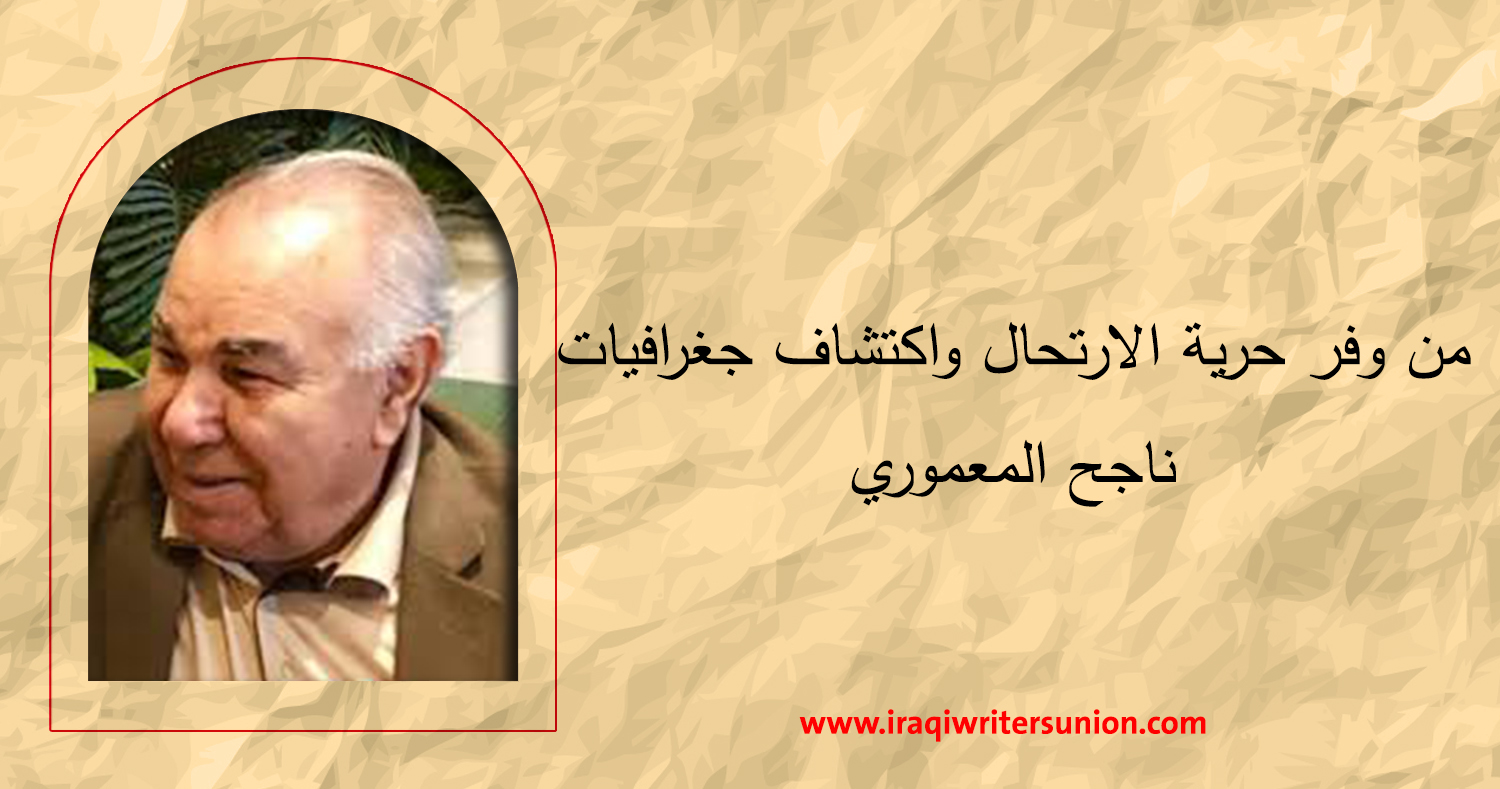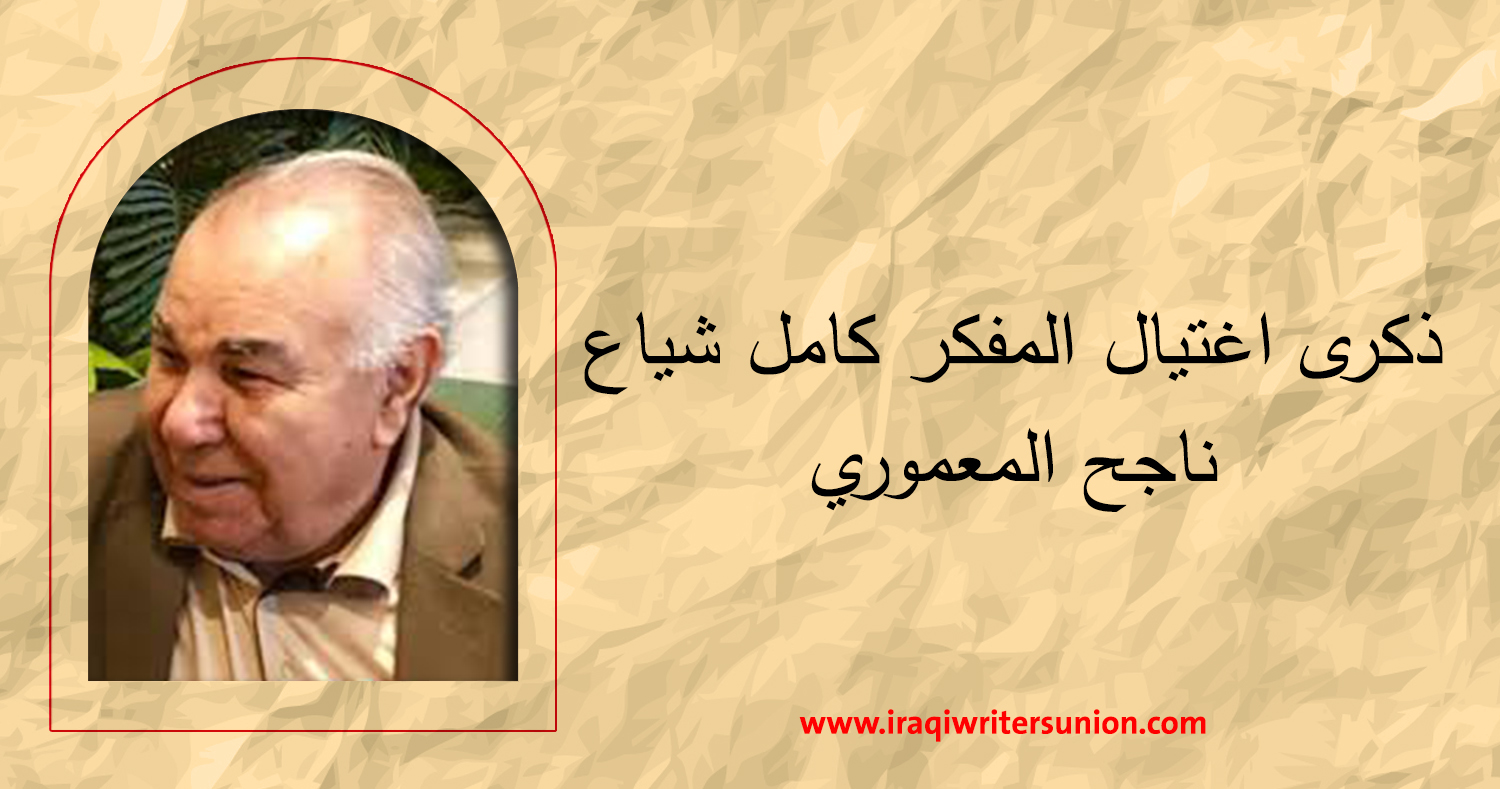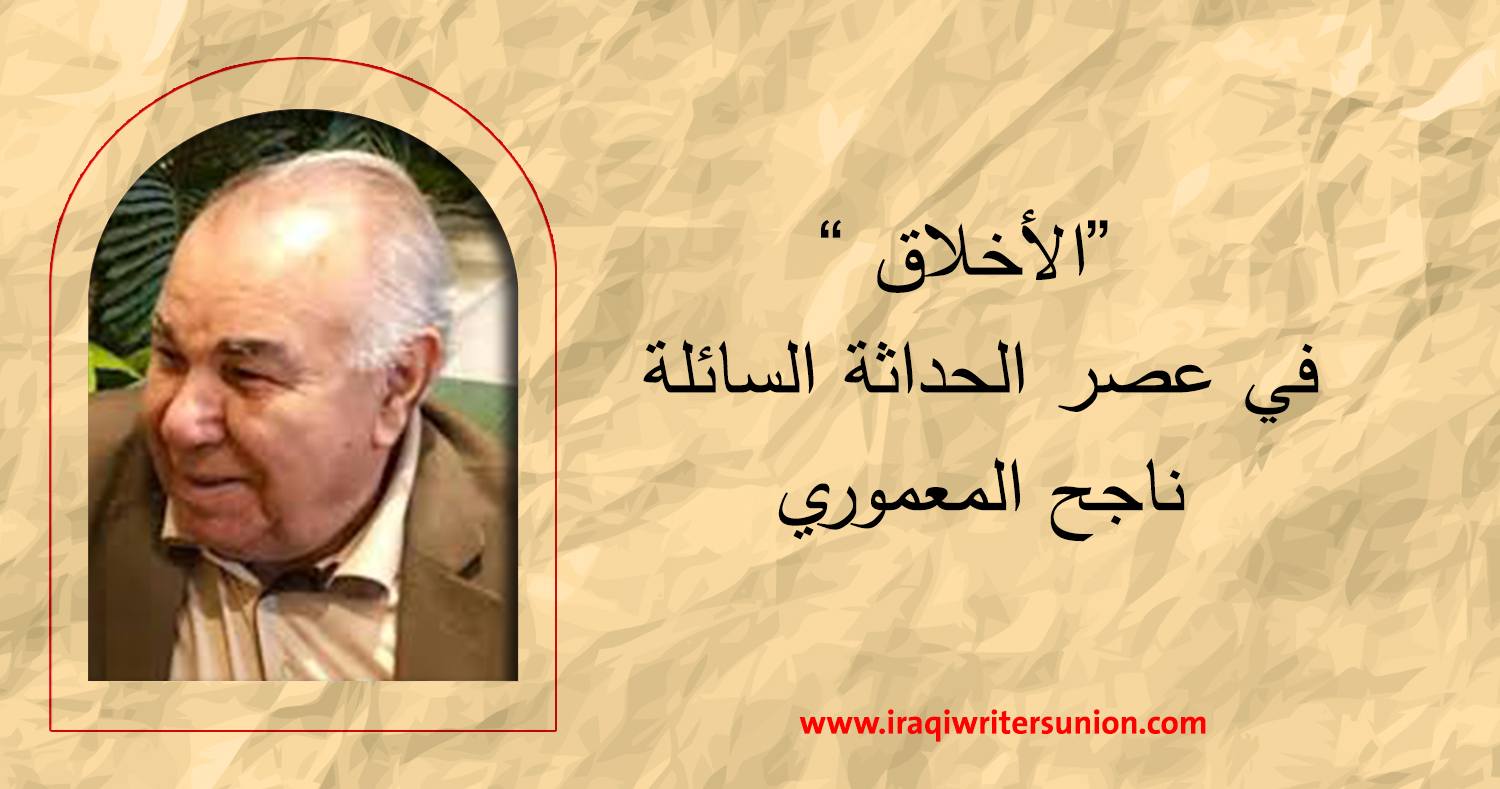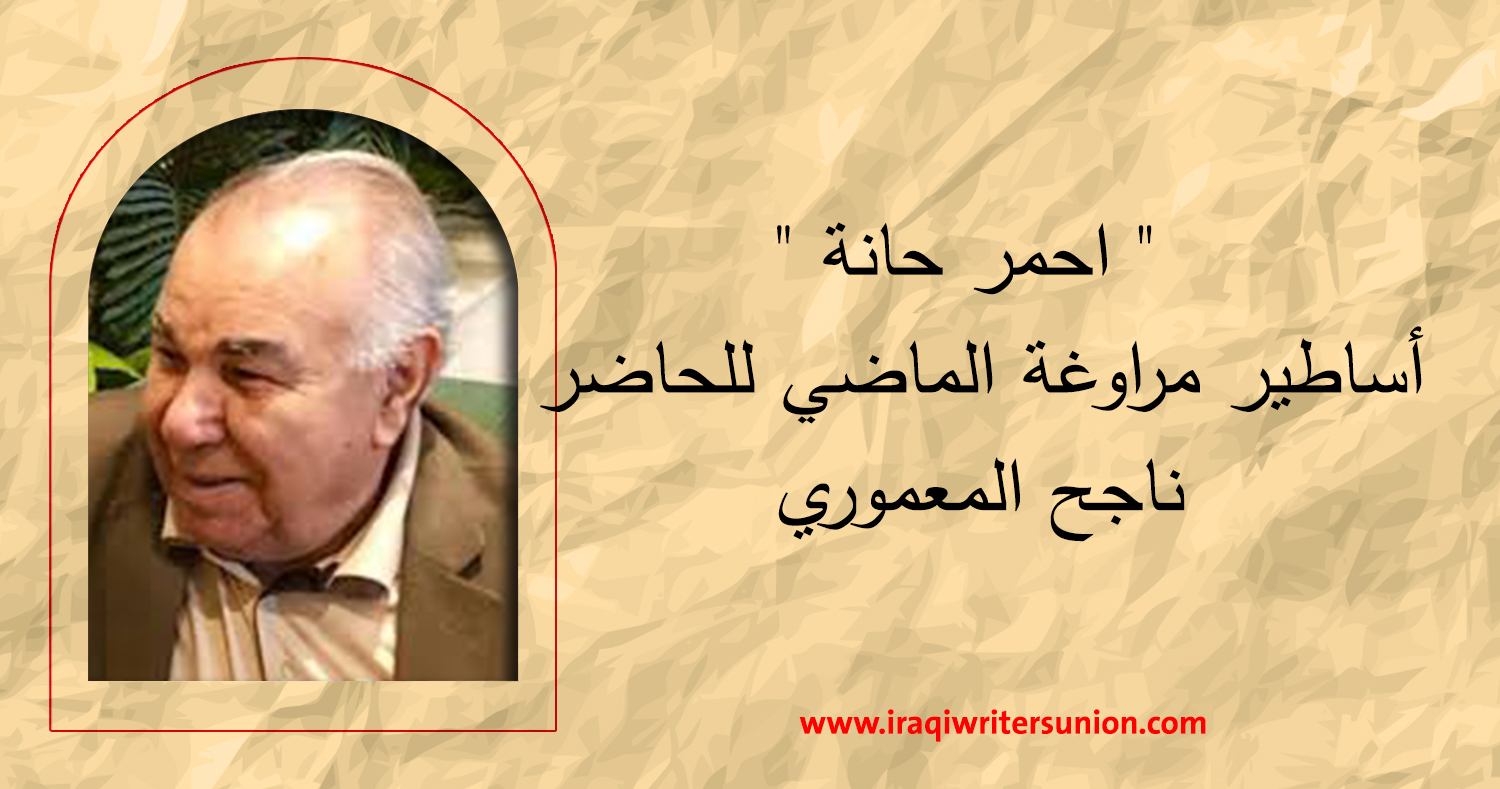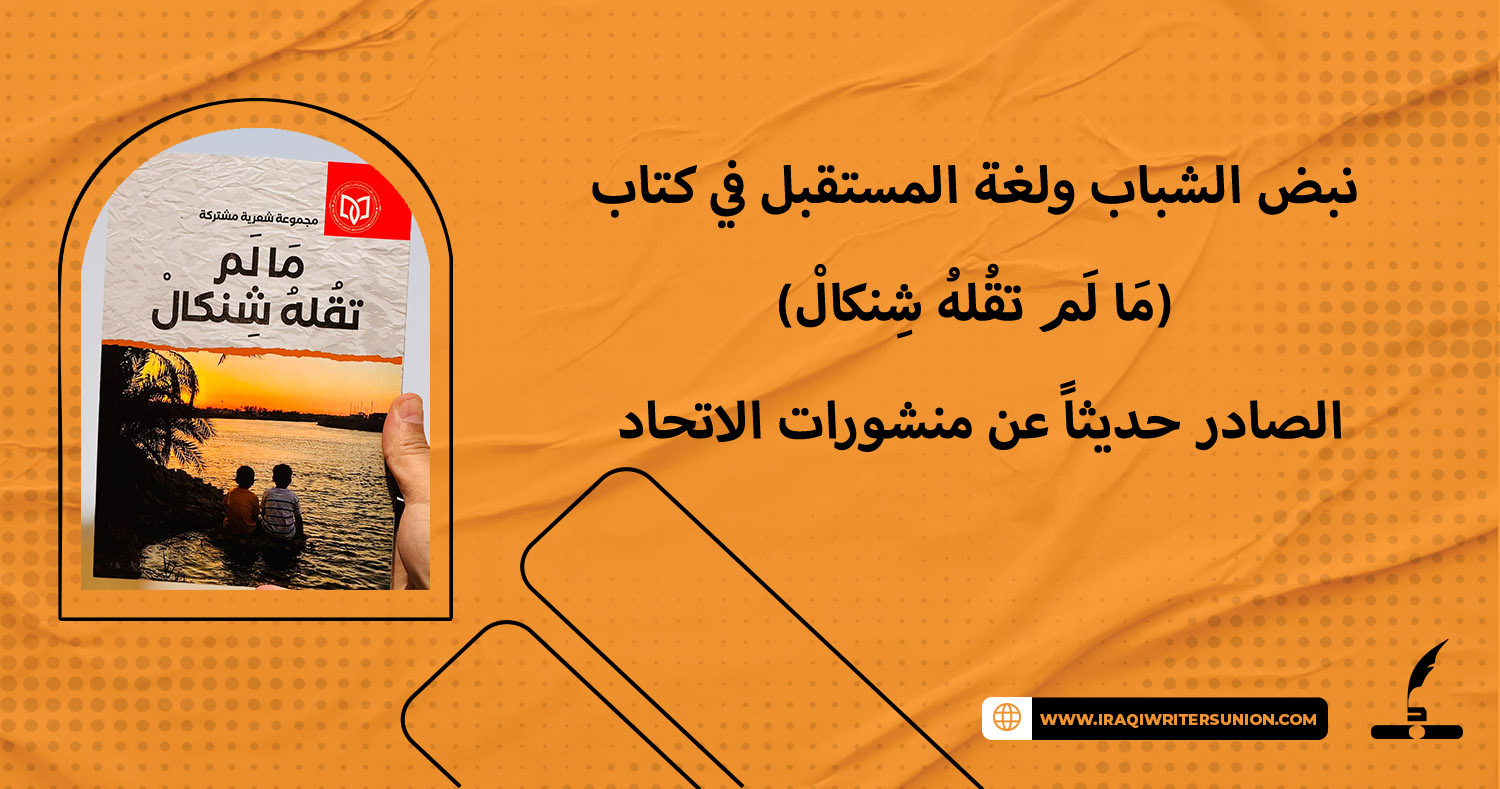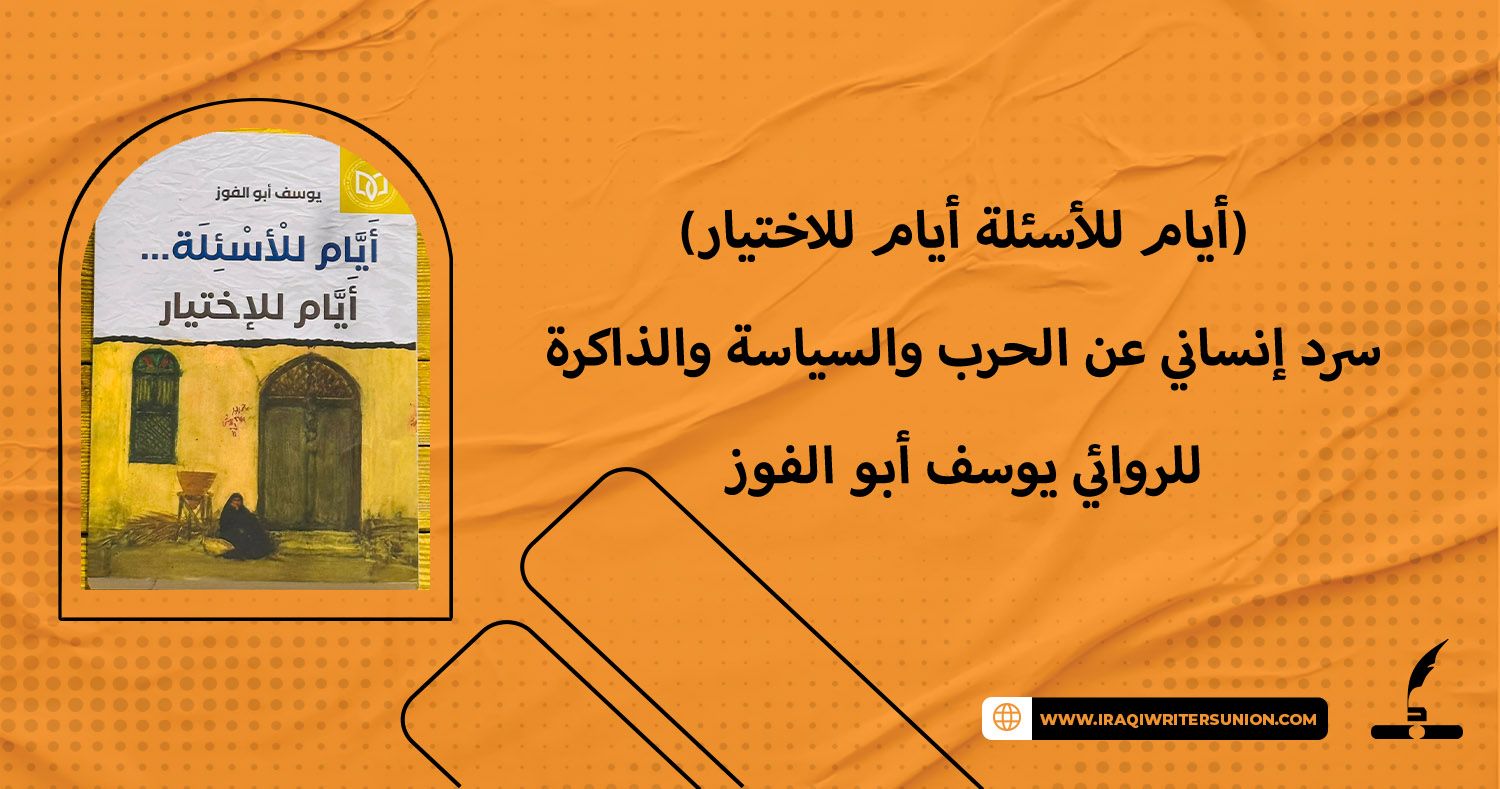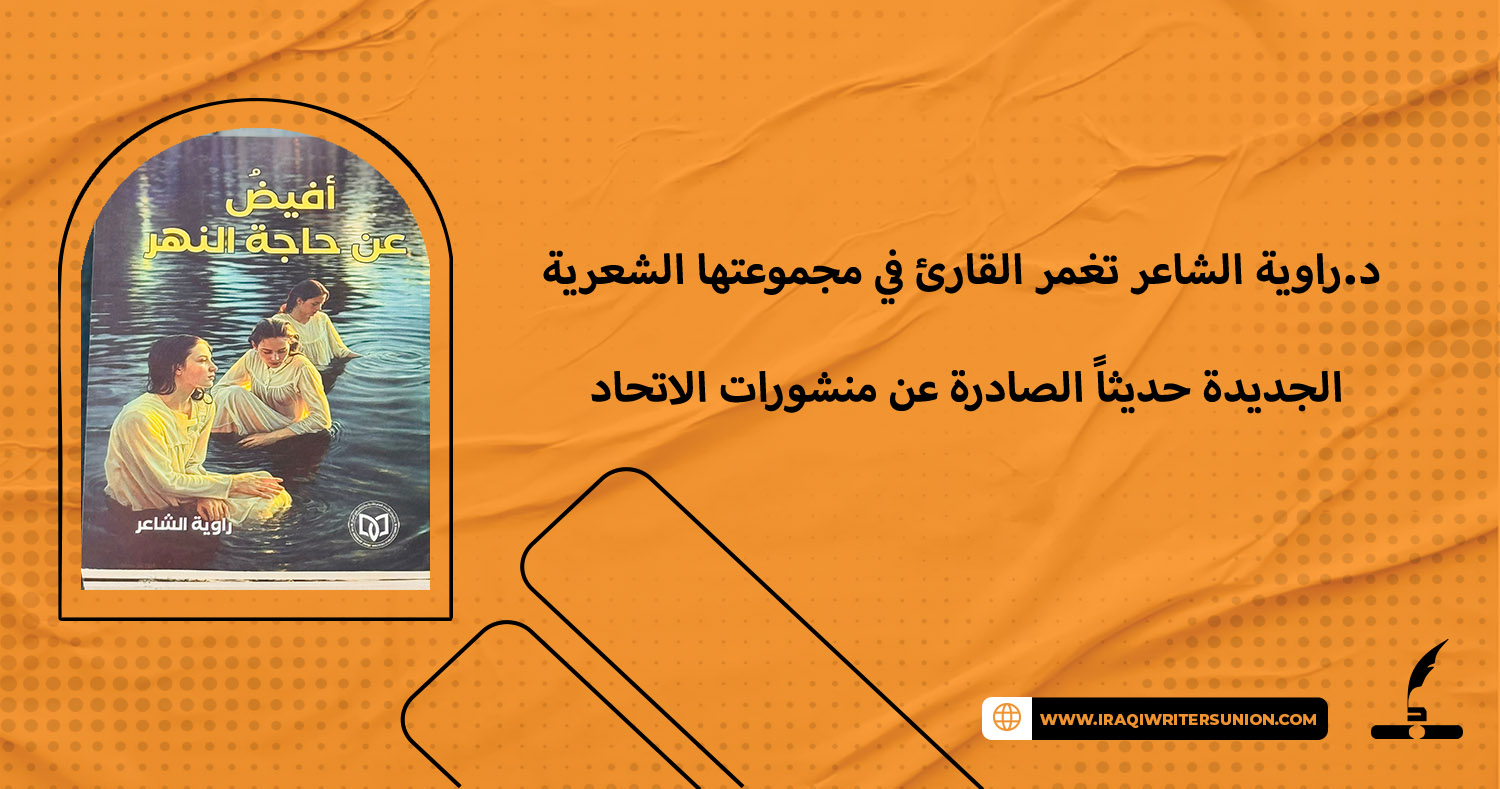التخييل المستقبليّ
الرواية العراقيّة المعاصرة / أسئلة الذات والوجود.
أ. د. فيصل غازي النعيمي
لو ابتعدنا قليلًا عن التصنيفات الببلوغرافيّة والرؤى التاريخيّة، لوجدنا الرواية العراقيّة مرّت بثلاث مراحل فنيّة وجماليّة كبرى متتالية عن بعضها أحيانًا، أو متداخلة في أحيان أخرى.
تبدأ المرحلة الأولى ( التأسيسيّة ) مع الميلاد الحقيقيّ للدولة العراقيّة عام (١٩٢١) وتتماهى مع ما قبلها من روايات، أشبه بالحكايات، وتمتزج فيها الرؤى الرومانسيّة والأخلاقيّة وحتّى التعليميّة.
ثمّ تلتها المرحلة الثانية (الأيديولوجيّة)، وهي تمتدّ إلى ما يقارب ستّة عقود من نهاية الثلاثينات حتّى مفتتح الألفيّة الجديدة، وهي ليست لونًا واحدًا وإن غلبت عليها الأيديولوجيا بأشكالها المتعدّدة: الماركسيّة ، القوميّة ، الإسلاميّة ، البعثيّة ، وقد ارتبطت الرواية العراقيّة في هذه المدّة الزمنيّة الطويلة برؤى وأفكار سياسيّة وحضاريّة وجماليّة، وأفكار حزبيّة ضيّقة، وفلسفات معاصرة لعلَّ أهمّها الماركسيّة والوجوديّة، ومثّلت التعبير الأوّل عن الوعي المدينيّ والتحوّل السوسيوثقافيّ الذي مرّ به المجتمع العراقيّ ، لذا لم تنفصل الرؤية السّرديّة لدى الكثير من المبدعين العراقيّين عن الرؤية الفكريّة والحضاريّة التي انطوت على نوع من الاهتمام بالقضايا المعاصرة الآنيّة.
أمّا المرحلة الثالثة فقد جاءت بعد عام ( 2003) وهي مختلفة تمامًا عن المرحلتين السابقتين ، إذ شهدت الثقافة العراقيّة مساحة من الحريّة لم تكن متاحة في السنوات السابقة مّما أتاح للمبدع / الروائيّ العراقيّ أن يقتحم عوالم جديدة كانت تعدّ لديه من التابوهات المحرّمة ، ولهذا شهدت الرواية العراقيّة بعد عام ( 2003) انطلاقة حقيقيّة على المستويين: الفنّي (الجماليّ) والفكريّ.
وقد ركّزت الرواية العراقيّة في مرحلة ما بعد (2003) على الواقع العراقيّ وهو يواجه تحدّيات كبيرة وتحوّلات مصيريّة حيث الاحتلال الأجنبيّ، والحرب الطائفيّة المقيتة، واحتلال بعض المدن وأجواء الدمار والفساد بأشكاله المختلفة، فضلًا عن تصوير قضايا راهنة لعلّ أهمّها أزمة الهُويّة الوطنيّة وإشكاليّة الانتماء، كلّ هذا جاء وفق آليّات تعبير سرديّة جديدة لم تألفها الرواية العراقيّة فيما سبق.
إلّا أن المتابع لمسارات هذا التحوّل في الصيغ السّرديّة سيواجه بمسألة غريبة وهي قلّة أو انعدام الروايات التي تشير إلى المستقبل العراقيّ، إذ هيمنت الرؤية الماضويّة والآنيّة على مجمل السّرد العراقيّ وانشغل الكاتب العراقيّ بالمشكلات العظيمة التي يواجهها الفرد العراقيّ والأمّة العراقيّة بعد ذلك، مع وجود استثناءات قليلة جدًّا ، حاول مبدعوها أن يتكلّموا عن القادم في المستقبل العراقيّ، وكما هو معروف فإن روايات الخيال العلميّ أو الروايات المستقبليّة ليست جديدة في مجال الإبداع العالميّ ، فهي حالة أدبيّة / فكريّة عبّرت عن تطوّرات مستقبليّة للوجود البشريّ. إنّ هذه النوعيّة من الروايات " تتحدّث عن الحاضر والمستقبل القريب والبعيد ولا تلتفت إلى الماضي، وهي، في الأعمّ الأغلب، تتحدّث عن المستقبل من أجل تحفيز إرادة المتلقّي إلى التقدّم العلميّ، وتكفي هنا الاشارة إلى أن الخيال حرّ في الزمان، يتناول الماضي والحاضر والمستقبل، لكنّه في روايات الخيال العلميّ يكاد يكون مقتصراً على المستقبل "(1)
إن فاعليّة التخييل الروائيّ ليست مجرّد طاقة إبداعيّة تعيد تشكيل الماضي والحاضر على اعتبار أنّ الرواية نصّ نثريّ تخييليّ سرديّ واقعيّ، غالبًا ما يدور حول شخصيّات متورّطة في حدث مهمّ، وهي تمثيل للحياة والتجربة والمعرفة "(2). بل إنَّ التخييل الروائيّ قد يتّجه إلى المستقبل ككلّ، أي يتحوّل المستقبل إلى هدف سرديّ، وليس مجرّد تفاصيل صغيرة في البناء الروائيّ العامّ، وهذا ما جعل من الروايات التي تُعدّ حول المستقبل تكتب بزمن الفعل الماضي وتنتقل سريعًا إلى زمن الفعل الحاضر وهذا ما نجده في رواية (1984) لـ (أورويل) الذي كان حين " يكتب الرواية كان يتخيّل المستقبل، وكيما يتفهّمها القارئ، عليه أن يطلعها بوصفها رواية تنبّؤيّة وليست تاريخيّة، وقد استخدم المؤلّف صيغة الزمن الماضي في السّرد كي يخلع على صورته عن المستقبل وهمًا روائيًّا بالحقيقة "(3)
إنَّ الرواية بوصفها نصًّا تخييليًّا تميل إلى الزمنين: الماضي والحاضر وحتّى عندما تصوّر المستقبل فهي تجعل منه إمّا ماضيًا أو حاضرًا عبر منطقها السّرديّ القائم على بديهة الحكي عمّا جرى.
وقد تعدّدت أنماط الرواية المستقبليّة تحديدًا بعد التطوّر الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعيّ وظهور الروايات التفاعليّة القائمة على الحوسبة والرقمنة، وكذلك الروايات التنبّؤيّة مثل روايات الخيال العلميّ والتطوّر التكنلوجيّ، وروايات الخيال التأمّليّ، وروايات المدينة الفاضلة، وروايات المدن الفاسدة، وروايات السفر عبر الزمن، وروايات المغامرات الفضائيّة، وروايات الخيال العلميّ ما بعد المستقبليّة، وروايات ما بعد الإنسانيّة، وروايات الكون الموازي وغيرها.
لكن ماذا عن الرواية العراقيّة المعاصرة وهي تعيش مرحلة ما بعد الحداثة في تجلّياتها الفلسفيّة والفكريّة والثقافيّة حيث فلسفات السيولة والنسبيّة والتقويض؟
حاول الروائيّون العراقيّون أن يتمثّلوا إلى حدٍّ بعيد مقولات فلسفة ما بعد الحداثة في النصوص السّرديّة بما يتوافق مع طبيعة التحوّلات التي مرّ بها المجتمع العراقيّ في مطلع الألفيّة الثالثة ، ولكن بقيت مسألة تخيّل وتخييل وتمثيل المستقبل شبه غائبة عن هذه الجهود لاعتبارات عديدة، لعلّ أبرزها انشغال الكاتب العراقيّ بهذا الواقع الذي يعاني من أزمات وجوديّة وأخلاقيّة كبرى، وجاءت رواية (مشروع أومّا)(4) للروائيّة العراقيّة لطفيّة الدليمي لتقدّم مشروعًا سرديًّا ضمن رؤية استشرافيّة للمستقبل العراقيّ القريب، ولا يمكن لنا أن نعدّ هذه الرواية تنتمي إلى نمط روائيّ واضح المعالم، باستثناء الرواية المستقبليّة، فهي مزيج من الخيال العلميّ وروايات ما بعد الكوارث وروايات المدن الفاسدة وإلى حدٍّ ما روايات المدينة الفاضلة، وكلّ هذا التداخل منح نصّ لطفيّة الدليمي حيويّة لا محدودة؛ لأنّه يقارب الواقع العراقيّ برؤية استشراقيّة فضلًا عن اعتماد مرجعيّات عراقيّة حضاريّة للخلاص من أزمة هذا الواقع ، وبهذا يتحوّل الماضي في نصّ الرواية عبر (مشروع أومّا) إلى قوّة مهيمنة لاستمراريّة الحياة في بلاد ما بين النهرين.
" – حسنًا، لقد دوّنت أفكاري كلّها ها هنا، وما عليكم سوى مناقشتها والتأكيد على ما يجب تنفيذه قبل سواه. أطلقتُ على مشروع إنقاذ بلدة الصافية اسم (مشروع أومّا). تساءل عادل :
- اسم جميل ؟ ولكن لماذا أومّا ؟
الفضل يعود إلى فلاح الذي ذكر في أحد النقاشات اسم مدينة (أومّا) السومريّة التي اتّسم عهد ملكها لوكال زاكيسي ملك بلاد سومر بالسلام والازدهار. وجدت لاسم (أومّا) رنّةً موسيقيّة ولفظًا يماثل كلمة الأمّ في معظم اللغات الرافدينيّة القديمة.
قال فيصل : أوما ، أمّنا ، الأمّ الكبرى الحاضنة ، المعطاء، والواهبة : هكذا تخيّلت الأمر وإنّي مستبشر به .
- حسنًا، قال عادل، ليكنْ إذن (مشروع أوْمّا).
- نحاول وصل ما انقطع بين جذورنا في نحو 2327 قبل الميلاد و 2027 بعده، كلّنا يعاني من حكم اللصوص اللذين استولوا على مقادير البلاد وأعادوها إلى قاع التخلّف، معضلتنا الأولى موضوع الطاقة، والوقود ، ثمّ المياه والغذاء "(5)
إذن الرواية تسرد واقعًا / مستقبلًا عراقيًّا يبدأ من عام 2027صعودًا إلى عام 2030 وهذا المستقبل يحاول الخلاص من الواقع الفاسد، وهنا ماضٍ حيث سيطرة الجماعات العسكريّة على كلّ تفاصيل الحياة مع كارثة طبيعيّة حلّت على البلاد ونضوب النفط وجفاف الأنهار الكبرى وعودة البلاد إلى زمن ما قبل الكهرباء وصعود الجماعات الدينيّة المتشدّدة، والفضاء هنا قرية الصافية القريبة من العاصمة بغداد والتي تعاني من تمزّق اجتماعيّ، طبقيّ، وهجمات متكرّرة من الجماعات المسلّحة، فضلًا عن الفساد المستشري في كلّ مفاصل البلاد، وتكاد الرواية هنا إن تشابه في ثيمتها المركزيّة رواية ( ١٩٨٤) لـ جورج أورويل .
تقوم الرواية على مقولات عدّة تتواشج فيما بينها لتشكّل البعد الاستشرافيّ، أولى هذه المقولات وهي المحرّك الحقيقيّ لأحداث الرواية المتتابعة السّرد الديستوبيّ أو (المدينة الفاسدة) إذ يؤكّد السّرد على لسان الشخصيّات أنّ الكارثة الكبرى التي وصلت إليها البلاد كانت بسبب استشراء الفساد وهيمنته على المفاصل السياسيّة والاجتماعيّة والعسكريّة، و(الديستوبيا Dystopia) أو المدينة الفاسدة هي عالم تخيليّ يتحوّل فيه هذا الحلم إلى كابوس والديستوبيا والتي يطلق عليها أيضًا اليوتوبيا المضادّة anti utopia تهدف في خططها الروائيّة إلى نقد التبعات السلبيّة الكامنة وراء الانصياع لصيغ بعينها من الأفكار المثاليّة، وعلى كلّ حال تميل الروايات الخياليّة عن المدينة الفاسدة إلى تضمين بعد نقديّ لاذع يرمي إلى التحذير من العواقب المحتملة لتوجّهات معيّنة في عالم الواقع الراهن "(6).
وهذا ما نجده مبثوثًا على طول الرواية التي تتعامل مع الماضي وفق مسارين متغايرين الأوّل يحيل إلى الماضي البعيد، حيث الحضارة السومريّة والازدهار الحاصل فيها، والثاني يحيل إلى الماضي القريب، حيث زمن المدينة الفاسدة التي أوصلت العراق إلى مرحلة الخراب بدءًا من عام 2027، وهو زمن مستقبليّ افتراضيّ يمثّل نقطة الشروع لانطلاق السّرد بصيغتي الحاضر والمستقبل: "ذات لقاء صاخب بعد عودة إبراهيم من (الصافية ) حين التقى زهيرة احتدم الجدال حول مأساة واقعهم المزري في بلاد ممزّقة تمضي نحو التفسّخ ما لم تحصل معجزة ، أقرّوا بعجز جيلهم عن فعل شيء مؤثّر ما خلا المظاهرات التي التهمت خيرة الشباب ولم تغيّر شيئًا، بل ضاعفت تغوّل السلطة ، ولم يتبقَ لهم سوى الثرثرة البائسة (...).
لنحسم هذه المراوحة الفاشلة، البلاد تتآكل بالفساد والتخلّف وتواجه انهيارًا كاملًا وإفلاسًا غير مسبوق، أخشى أنّ القادم ينذر بمخاطر مروّعة لا يمكن تجنّبها "(7)
تحاول المؤلّفة أن تطرح إشكاليّة الصراع بين الديستوبيا واليوتوبيا عبر شخصيّاتها المتباينة في الأفكار والمرجعيّات، فالديستوبيا واقع يمكن الخلاص منه، واليوتوبيا مجرّد حلم تفاؤليّ ورؤية مستقبليّة؛ لأن الواقع بائس وفقد أبسط مقوّمات الحياة.
" قال عادل : إذن ما الذي ترونه ؟ شخصيًّا أرى أننا لا نبحث عن فردوس متخيّل ولا نعمل على إيجاد جنّة أرضيّة أو يوتوبيا، لقد ضيّقوا علينا الخناق، نحن في ضائقة، والسلطة عاجزة تمامًا ولم تعد تقدّم الخدمات الأساسيّة، مشكلتنا الأولى هي توفير الطاقة والماء والغذاء الكافي.
عقّب إبراهيم :
- حسب علمي، هناك تجارب حقيقيّة على الأرض يمكننا الاستفادة منها، ولكنّني لا أرى خيرًا أن يؤمن الشباب في مرحلة معيّنة بمثاليّات كبرى، وأعلم أنّنا سرعان ما سنتخلّى عن معظمها حين نختبرها عمليًّا، لدينا فسحة للتجريب "(8).
وهذا ما دفع الشخصيّات إلى محاولة تغيير الواقع الفاسد ولكن بشكل عمليّ / واقعيّ وليس طوباويًّا / مثاليًّا، فالطريق الأمثل لمغادرة كلّ تجلّيات المدينة الفاسدة يبدأ من فكرة ذات جذور حضاريّة تمزج بين الأزمنة الثلاثة " قال فلاح أتخيّلكم وكأنّكم قادة الفيالق السومريّة من مدينة (أومّا) تخطّطون تحت أمرة الملك (...).
قاطعه إبراهيم:
- أوّلًا شكرًا لك لأنك ذكّرتني بمدينة (أومّا)، وكأنّك أطلقت برقًا أضاء مخيّلتي، وثانيًا دعونا نغادر هذا الهراء: من يؤمن بمغادرة الكلام إلى الفعل بوسعه الالتحاق بي لخوض تجربة واقعيّة على الأرض في حدود إمكاناتنا لضمان البقاء أحياء ولتغيير أنفسنا لا لتغيير العالم "(9).
يمكن أن تكون هذه الفكرة هي الخطوة العمليّة الأولى لبداية مشروع أومّا المؤطّر بأفكار مثاليّة في بعض الأحيان، ولكنّ المنطق العمليّ / الوطنيّ ينتصر فيما بعد، وبهذا تتأرجح عمليّة البناء السّرديّ التي توازي في إيقاعها وتجلّياتها الواقع العراقيّ - بين العالم الكابوس الديستوبيّ المتحوّل في كلّ مفاصل الدولة العراقيّة وبين الحلم بالفردوس حيث المدينة (الواقعيّة) " وقعت أحداث لا تحصى صيف 2028 : فوضى اعتصامات، انتخابات فاسدة، اضطرابات مسلّحة في المدن ، استيلاد المتنفّذين على معظم مراكز المدن شرق البلاد وجنوبها ، اشتداد أزمة المياه والصراع القبليّ حوله والتقاتل على موارد النفط الذي تهدّد أسعاره بانخفاض غير مسبوق ينذر بإفلاس نهائيّ مروّع "(10).
كلّ هذه الأجواء لم تمنع شخصيّات (الصافية) من العمل بجدّ في مشروع (أومّا) وعدّه الطريق للخلاص، وكلّ هذا يأتي وفق برامج عمليّة وعلميّة بعيدًا عن المثاليّات " وظهرت ملامح المشروع الأوليّة خلال ثمانية شهور ، ازدهرت مزارع افترسها الجفاف وجار عليها الإهمال ، سوّرت المزارع لردع المواشي والحيوانات البرّيّة بصبّار التين الشوكيّ المثمر بديل الأسلاك الشائكة "(11).
إن الرؤية الاستشرافيّة التي تقدّمها (لطفيّة الدليمي) تأخذ شكلين الأوّل مطبوع بالرؤية المأساويّة، حيث الخراب قادم في السنوات القريبة (ما بعد 2026) وهذا الخراب متأسّس على فضاء كلّ ما فيه فاسد ، والثاني يشتغل وفق الروح الوطنيّة ومنطق العلم، حيث التكاتف والتعاون والانتصار لكلّ ما هو وطنيّ، والبحث عن الطاقة البديلة للكهرباء واستصلاح الأراضي وردع العدوان والإيمان بالمستقبل الزاهي لهذا الوطن ، وهذا ما جعل الرؤية التفاؤليّة تنتصر على الرؤية المأساويّة ، وهذا الانتصار لم يتحقّق إلّا بالعلم ( الهندسة الوراثيّة والعمارة البيئيّة ، وتطوير المناهج الدراسيّة ، وإعادة الفنون إلى مكانتها الطبيعيّة ) وهذا التواشج السّرديّ مع المعرفيّ عمّق من مقولات الرواية وأن لا تصبح مجرّد حكاية تنبّؤيّة مستقبليّة عن المصير المجهول للبلاد، بل تطرح الرواية عبر شخصيّاتها الواعية الحلول الناجحة للتغيير والاستمرار ، وهذا ما تكشّف بوضوح في عنوان الفصل الثالث من الرواية ( الأجنحة لمن يحلّق )
" - ما هذا الجمال ؟ من صنع كلّ هذا ؟ أرى سحرًا يحصل اللحظة أمامي ؟ .
قالت زهيرة وهي تتحسّسُ دُرَف النوافذ المصنوعة من الحديد
من صاحب الفكرة ومن صمّم المبنى ؟ ومن نفّذه ؟
قال فيصل : أخي المعماري فراس وهو عاطل بسبب فلسفته في العودة إلى العمارة البيئيّة ، وهي العمارة التي تراعي المناخ المحلّيّ وتستخدم موادًا من البيئة ذاتها : الطين واللبن الطينيّ وجريد النخل ، لم تقنع أفكاره أحدًا عندنا ؛ فالكلّ يريد تقليد مبانٍ من الإسمنت والرخام والنوافذ الواسعة ، ضحك الناس من فكرة العمارة البيئيّة (...) ولم يطبّق من مشروعه سوى مبانٍ قليلة لأشخاص راقت لهم الفكرة "(12) وكلّ هذه الخطوات العمليّة في واقع الرواية ( الزمن المستقبليّ القادم ) هي ما ستؤسّس لبناء مجمّع جديد ، مدينة - ربّما فاضلة – على أنقاض هذه المدن الفاسدة " ربّما بعد سنوات أو عقود ، أو ربّما عندما سيولد مجتمع جديد ، ربّما سيحصل شيء ، البعض ربّما حلموا به رغم أنّه لا أحد متيقّن إن كان ذلك سيحصل حقًّا ؛ لكنّه الأمل حسب: سيكون أبناؤهم أو أحفادهم هم الذين يقرّرون قانون الحياة إن نجا (روّاد مشروع أوما وتزوّجوا وأنجبوا) سيغدو الروّاد تلك الجياد الهرمة ، الخيول المهيّأة للموت ، وربّما في الغد بعدما يولد مجتمع مختلف سيكونون محض رفات في قبور مهجورة ، سيضحكون هم الجياد العاجزة من تهوّر أبنائهم وأحلامهم المحدودة واهتماماتهم "(13).
أمّا المقولة الثانية التي تحرّك أحداث الرواية وتصنع عالمها المتخيّل وتعبّر عن أفكارها الرئيسة فهي ( الأنثويّة ) ، فالفلسفة الأنثويّة - وليست النسويّة – هي المتحكّمة في فضاء الرواية والشخصيّات الفاعلة ويبدو أن لطفيّة الدليمي تستكمل مشروعها الروائيّ مع هذه الرواية وتقدّم لنا شخصيّات أنثويّة متعدّدة في الرواية لكن ضمن خطّ سرديّ / أيديولوجيّ يضمن لهن مكان الصدارة ، وهذه فلسفة لا يمكن إنكارها في مدوّنة لطفيّة الدليمي السّرديّة ، والأنوثة " تعبّر عن موقف محدّد عقائديّ ينبع من التعلّق بما تعتقده صاحبته بأنّه سمة من سمات الأنثى ورؤيتها للعالم وموقفها منه "(14) .
وهذا ما تذهب إليه الكاتبة نفسها إذ تعتقد أن الشخصيّة الأنثويّة من دون أن يكون لها غطاء ثقافيّ ما هي إلّا قيمة سلبيّة مفتقرة إلى الجوهر وتمثّل التشويش والظلمة وكلّ الصفات السلبيّة(15).
لذا نجد أن المرأة الأنثى المتميّزة بالجمال والقوّة والثقافة مقترنة بتعديل الواقع ورسم ملامح المستقبل والمشاركة في بنائه.
تتحرّك في فضاء الرواية أكثر من شخصيّة أنثويّة إلّا أنّ الصراع بين الجدّة والحفيدة، بين فوزيّة وزهيرة هو المنطلق الأساس لتشكيل انتصار الرؤية المستقبليّة بين الروح الإقطاعيّة المتأصّلة عند الجدّة وعواطف الإيثار والمحبّة عند زهيرة " كشفت تناقضات شخصيّة الجدّة عن سيرة الزمان الذي عاشته بين فقدانات الأسرة وفواجع البلاد ؛ فهي بقدر ثقافتها وفطنتها الفطريّة وقراءتها الكتب واهتمامها بالأملاك والأشجار والخيول التي تحبّها كأبنائها وعملها على نقل أساليب العيش الحضريّ للبلدة كانت توسّع مطامعها لسبب غامض وكأنّه تعويض عن ظمأ يكتنف سنواتها ، وهي أحيانًا تفيض رحمة وضوءًا، وكأنّها ليست تلك الذئبة الشرسة التي تتسبّب ببؤس الآخرين وتتلذّذ كلّما ارتفع منسوب الجشع لديها "(16).
هذه الصفات نجد نقيضًا لها في (زهيرة الصافي) الأنثى الجميلة القويّة المحبّة للآخرين والتي تمثّل أصل مشروع أومّا لإنقاذ الصافية / الوطن، وهي في الرواية امرأة عاشقة مندمجة مع الطبيعة تمامًا وكأنها جزء منها، حتّى تحوّلت إلى كائن أسطوريّ قادر على التنبّؤ بالمستقبل "يذكر منذ صباهما البعيد أنّها كانت تدهشه وتثير عجب من حولها بتوقّعاتها المذهلة ، كانت تتنبّأ بالمطر، وتنذر بالعاصفة وتحذّر من حدث قد يجيء مفضيًا إلى كوارث محتملة ، نسي أن زهيرة تمتلك بصيرة العرّافات ساكنات البراري المتواجدات مع الريح وحركة الأفلاك ، كاشفات البشائر والنذر ، فكيف يتساءل بسذاجة صبيّ أخرق عن إدراكها لقربه منها "(17).
تتوحّد شخصيّة المؤلّفة مع شخصيّة زهيرة، توحّد الحقيقيّ مع المتخيّل، وتصبح الأنثى المستشرفة للمستقبل في سرديّتها ( نقيض شهرزاد في الحكايات العربيّة القديمة ) متماهية مع بطلة روايتها التي ترى بعيون العرّافات الدمار القادم، ولكنها لا تقف مستسلمة لواقعها بل تعمل جاهدة على تغييره.
ولا تستخدم (زهيرة / لطفيّة) مذهب الانشقاق النسائيّ (18) حيث ينفصل الرجال عن النساء في يوتوبيا تقضي بأفضليّة المرأة بل تؤكّد مقولات إنسانيّة عميقة عن ضرورة الاندماج البشريّ لمواجهة الخراب.
" قالت الجدّة:
- لم يكن عادل ليرفض لي أمرًا أو مطلبًا، أنتِ الوحيدة في عائلتنا مَن تعارض وترفض ، ماذا ستكونين بعد موتي ؟
ردّت زهيرة بنفاد صبر !
- سأكون زهيرة الصافي كما تعرفينني، وسترين ما أفعله، فلديّ من الخبرة ما يكفي لتسيير حياتي.
- أردتك أن تكوني بمستوى أختك.
- ردّت زهيرة بنبرة احتجاج !
- بل أريد لأختي أن ترتقي لمستواي، زهور شخصيّة هشّة تنازلت عن أحلامها لتحقّق لخالتي وزوجها أحلامهما ( ........).
- كفّي ثرثرة ، ستصبح الدكتورة زهور.
- وسأكون زهيرة الصافي، هل تذكرين ما لقّنتني إيّاه؟ لنساء عائلة الصافي لا تستسلم، قلت هذا، وقلت أيضًا لا يقف بوجهنا شيء حتّى نبلغ مرادنا .
- لكنّك تتراجعين وترفضين إكمال دراستك.
- ما أقتنع به لن أتراجع عنه
- لا تخيّبي أملي فيك
- يبدو أن طرقنا تتقاطع يا جدّتي " (19).
لا تتقاطع الشخصيّتان إلا لتلتقيا من جديد سواء في الماضي أو الحاضر (حاضر السرد) أو المستقبل، ويختلف حبّ زهيرة عن حبّ جدّتها، فالثانية تتعامل مع الأشخاص والأشياء وفق مبدأ التملّك ، أمّا الحفيدة فتتعامل مع الجميع وفق مبدأ العطاء مثل (الطبيعة) تمامًا " بلغها صوت اصطفاف أمواج الزهر ، النهر يناديها وهي تسمع حفيف أشجار الصفصاف على الجرف مشبكًا بشجيرات الطرفاء ، أيقنت منذ صغرها أن الطبيعة اختارتها لتكون ابنة النهر والتراب والشمس والجذور والشذى ، لبثت تصغي لنداءات الطبيعة التي تحتها وتفهمها وتحتفي بها ، تترجّل عن فرسها وتربطها بشجرة ، تهبط الجرف الرمليّ – الفرنيّ الأحمر المتيبّس يتكسّر بملامسة الريح كرغيف خبز محمّص ويتهشّم تحت قدمها (...) تعلّمت زهيرة من الطبيعة أن كلّ ما يفنى ويتحطّم لا يرتسم بأقواس أبدًا ( ٠٠٠٠٠٠٠) آمنت زهيرة أن الطبيعة اختارتها منذ طفولتها دون توأمها زهور لتغدق عليها نعمتها وتهبها مفاتيح وعيها بالحياة ، وها هي تضيء عقلها وتكشف لها عمّا ينبغي عمله قبل فوات الأوان "(20).
إذًا، الطبقة شأن أنثويّ، وهذا الشأن يتأرجح بين الانتماء (والاندماج) إلى الطبيعة واللجوء إليها والمحافظة عليها، ويُعدّ ذلك الانطلاق منها لتحقيق المشروع الكبير الذي سيعيد الصافية/ الوطن إلى مساره الصحيح ، وهذا ما حدث لزهيرة إذ أن وعيها الأنثويّ الحادّ هو الذي دفعها إلى اللجوء إلى الطبيعة خصوصًا عندما انعدمت الخيارات مع تغوّل طروحات المدينة الفاسدة ، لتتحوّل زهيرة بعد ذلك إلى رمز للخلاص المرتجى ، إذًا، الأنثى الواعية المثقّفة القويّة هي من تتحمّل مسؤوليّة الخلاص في عراق ما بعد الكارثة " لم تفكّر زهيرة أبدًا فيما سيفضي إليه هذا الحبّ ، لم تناقش مع نفسها فكرة الزواج أبدًا وهي المشغولة بمشاريعها المستقبليّة حول إدارة البلد بعد الاضطراب الشامل الذي تشظّت إثره جغرافيّة البلاد، يكفيها أن تحبّ وتُحبّ ، لماذا لا تبتكر نمطًا غير مألوف لعلاقتها بإبراهيم ؟ كانت سعيدة بحياتها كما هي لا تحبّ أن تمتلك شيئًا أو أن يمتلكها أحد أو تتعلّق : بالممتلكات أو المقتنيات ، الامتلاك هوس الناس العاجزين عن كلّ حلم"(21).
إن التخييل المستقبليّ عبر الوسائط السّرديّة في رواية (مشروع أومّا) للعراقيّة لطفيّة الدليمي جاء ليعبّر عن حاجة حقيقيّة لسرد تعبيريّ لا يتوقّف عند ثوابت الواقع، بل يرتقي إلى مصاف الأدب التنبّؤيّ الذي يعالج مشاكل مجتمعات ما بعد الكارثة ، وكيف يمكن للوعي الفرديّ والجماعيّ أن يصوغ أفكارًا ليست مثاليّة، وإنّما علميّة وعمليّة قادرة على إعادة الحياة إلى البلاد بعد أن عانت كثيرًا من الفساد والإفساد المقصود، لذا نرى أن أسئلة الذات لا تتشكّل لوحدها وإنّما تنفذ إلى منطقة الوجود الجماعيّ وهذه فلسفة - متشعّبة آمنت بها الكاتبة أوّلًا والشخصيّات المتخيّلة ثانيًا.
هوامش الدراسة:
- مصطلحات الرواية (من التعريفات إلى المفهومات) ، سمر روحي الفيصل ، الهيئة العامة السورية للكتاب ، دمشق ، ٢٠٠٣ ، ص ١٦٣ .
- معجم مصطلحات نقد الرواية ، لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون ، دار النهار للنشر، بيروت، ط1، ٢0٠٢، ص ۹۹.
- الفن الروائي ، ديفيد لودج ، ت : ماهر البطوطي ، المجلس الأعلى للثقافة ، القاهرة ، ٢0٠٢، ص ١٥٤.
- مشروع أومّا ، لطفيّة الدليمي، دار المدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد، دمشق، ط 1، ٢٠٢١.
- الرواية ، ص ۱۰۸ و ۱۰۹.
- المرجع في روايات الخيال العلمي، كيث بوكر و آن ماري توماس، ت: عاطف يوسف محمود، المركز القومي للترجمة ، القاهرة ، ط 1، ٢٠١٠ ، هي ١٢٧ .
- الرواية ، ص 51.
- م . ن ، ص 107.
- م . ن ، ص 52.
- م . ن ، ص 131.
- م . ن ، ص 134.
- م . ن ، ص 166.
- م . ن ، ص 214.
- الثقافة والامبرياليّة ، إدوارد سعيد ، ت: كمال ابو ديب ، دار الآداب للنشر والتوزيع، بيروت، ط4، ٢٠١٤ ، ص ٥٣.
- خبرة الحريّة في الأدب وخبرة الأدب في الحريّة ، لطفيّة الدليمي ، مجلّة الأقلام ، بغداد ، العدد24، لسنة ١٩٩٩ ، ص ١٠.
- الرواية ، ص ٧3.
- م . ن ، ص 11.
- المرجع في روايات الخيال العلمي ، ص ١٧١
- الرواية ، ص ٧3.
- م . ن ، ص 86.
- م . ن ، ص 101.












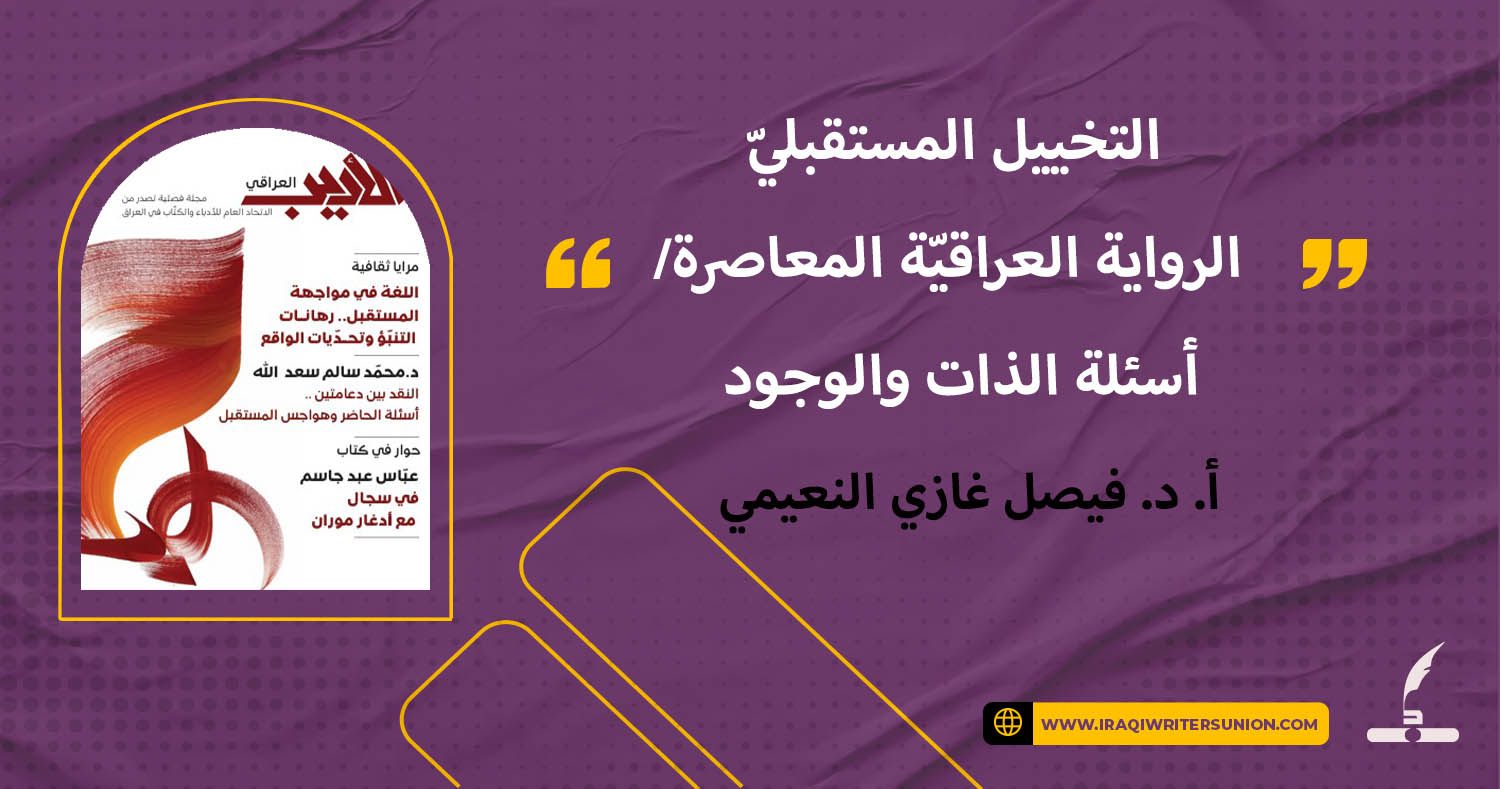
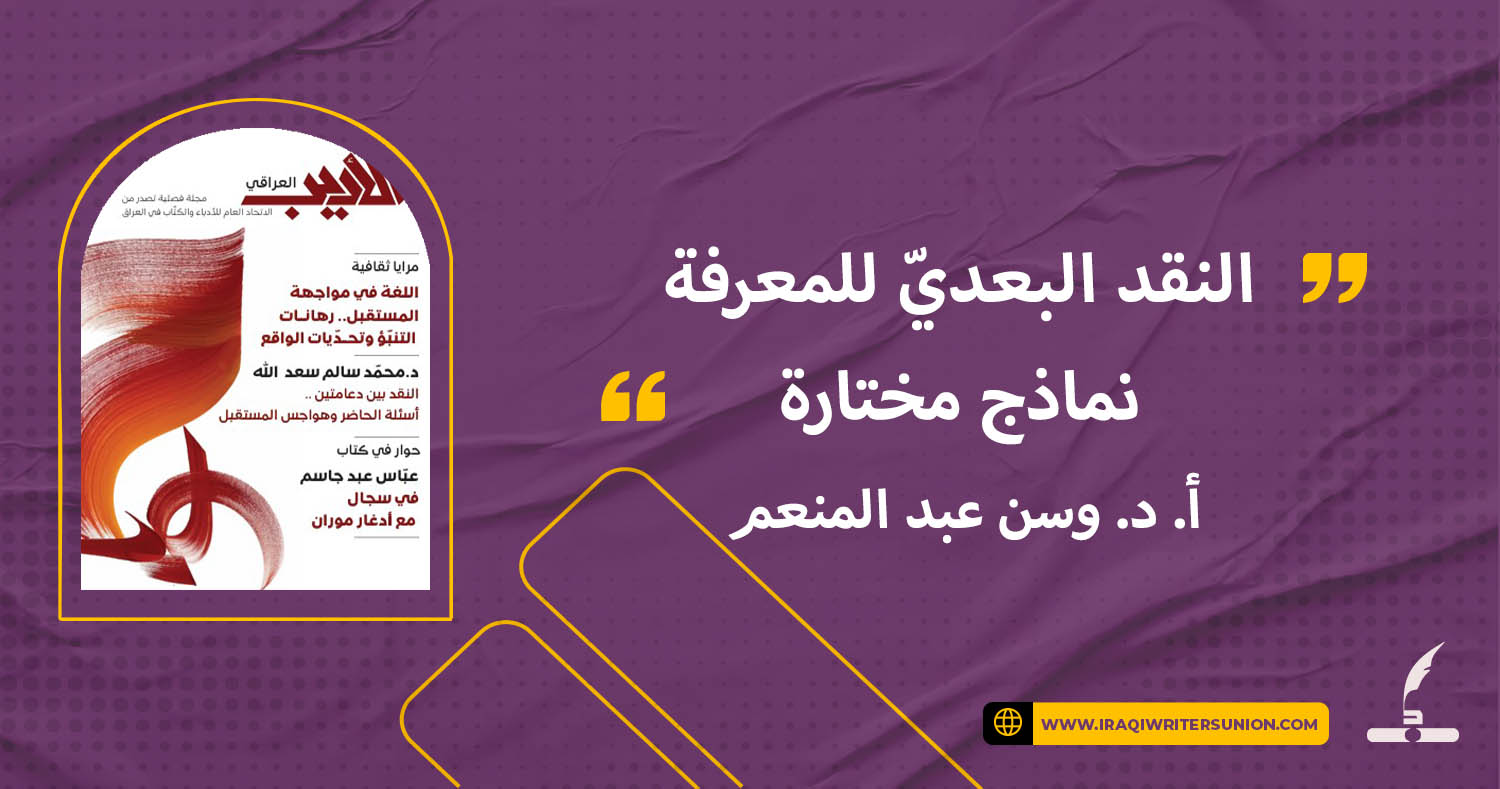
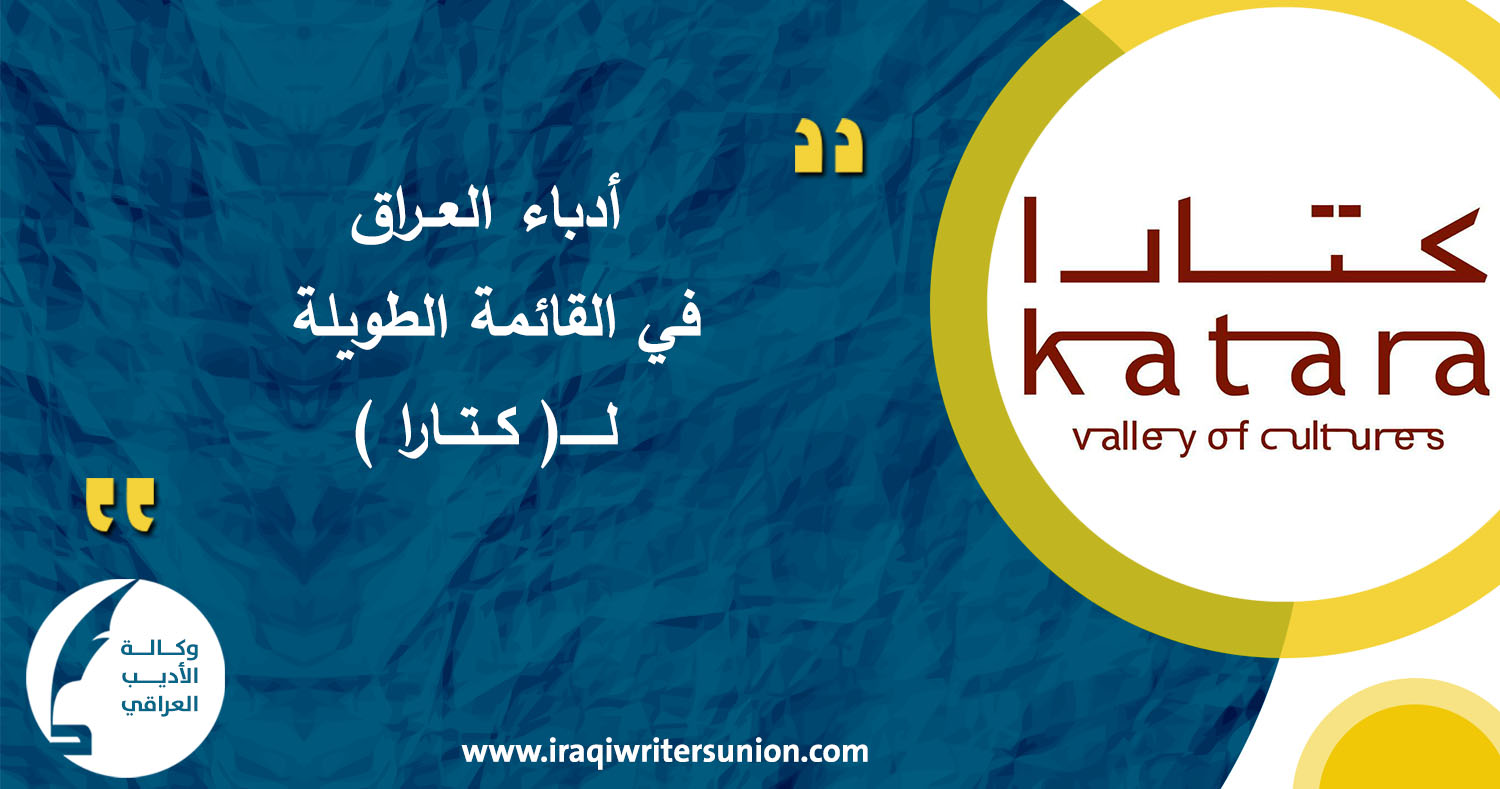
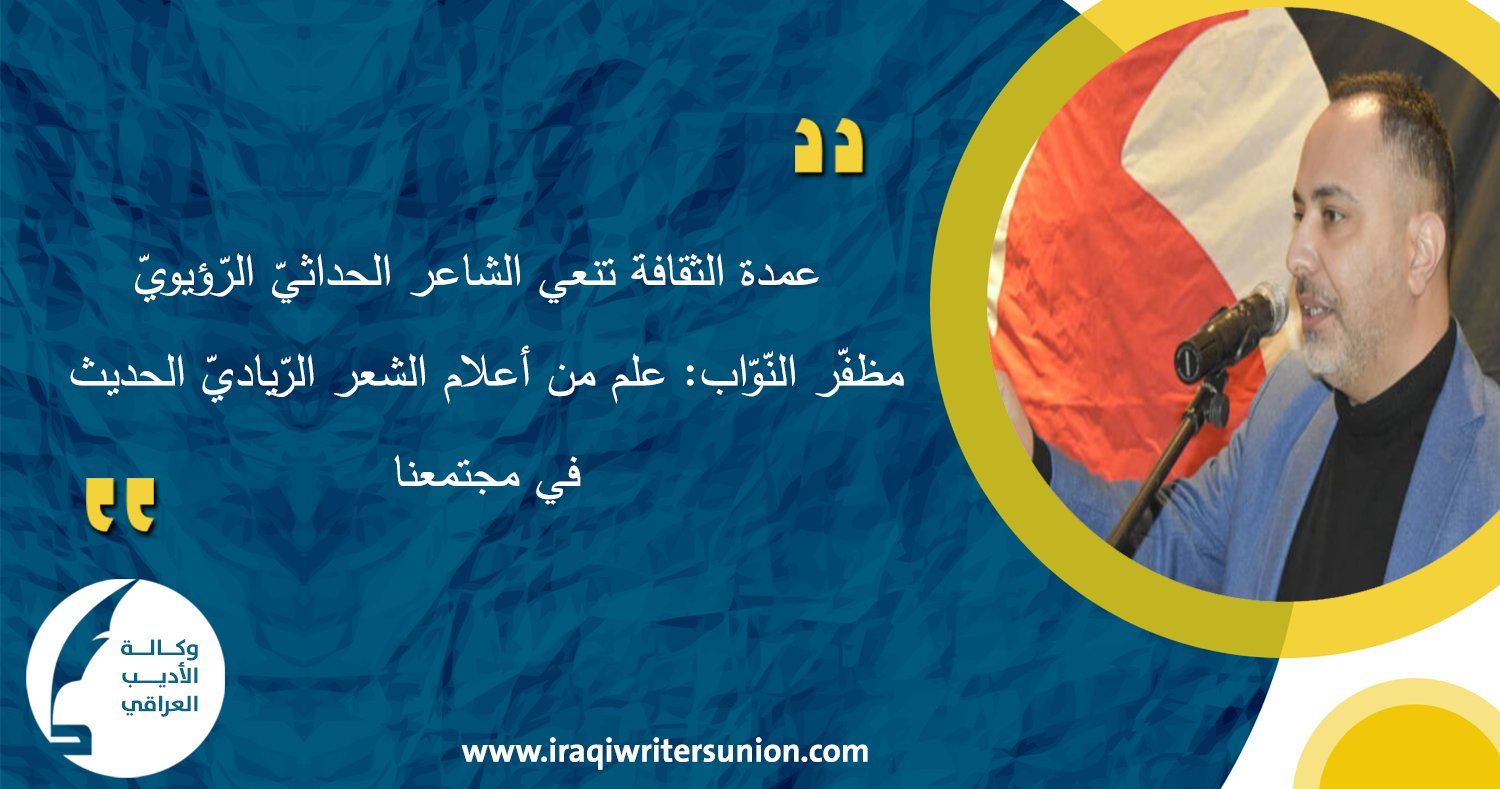



 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي