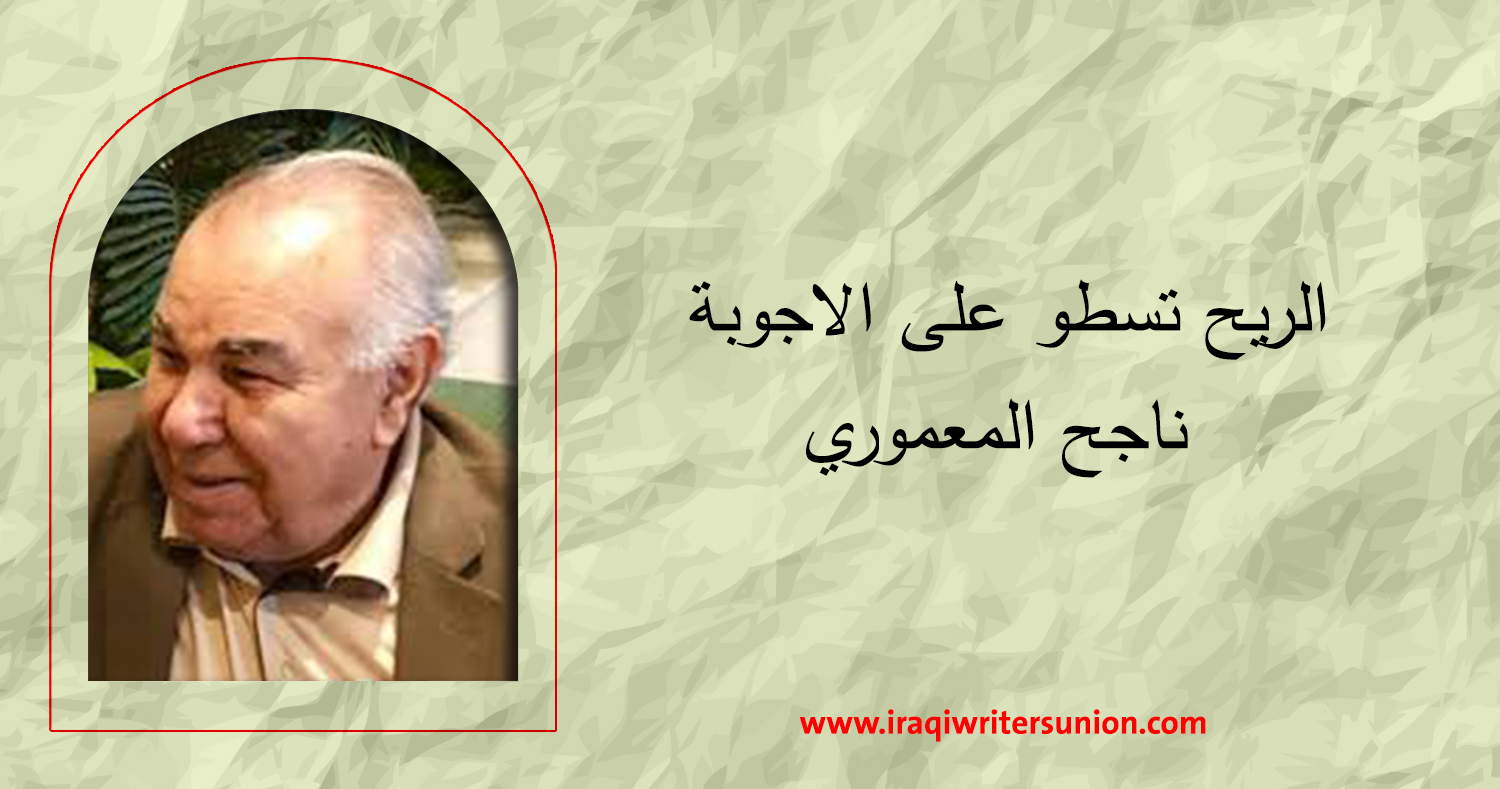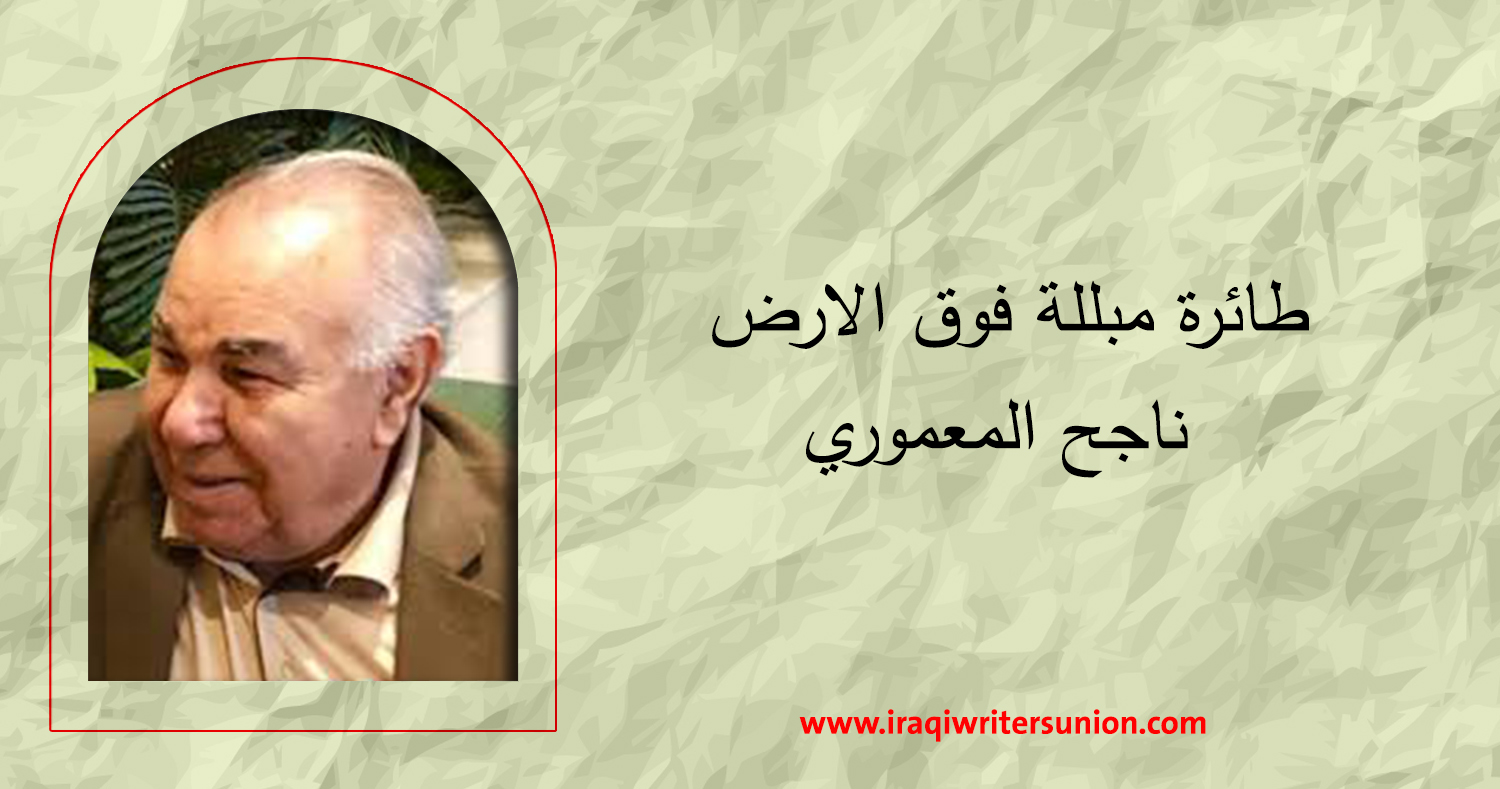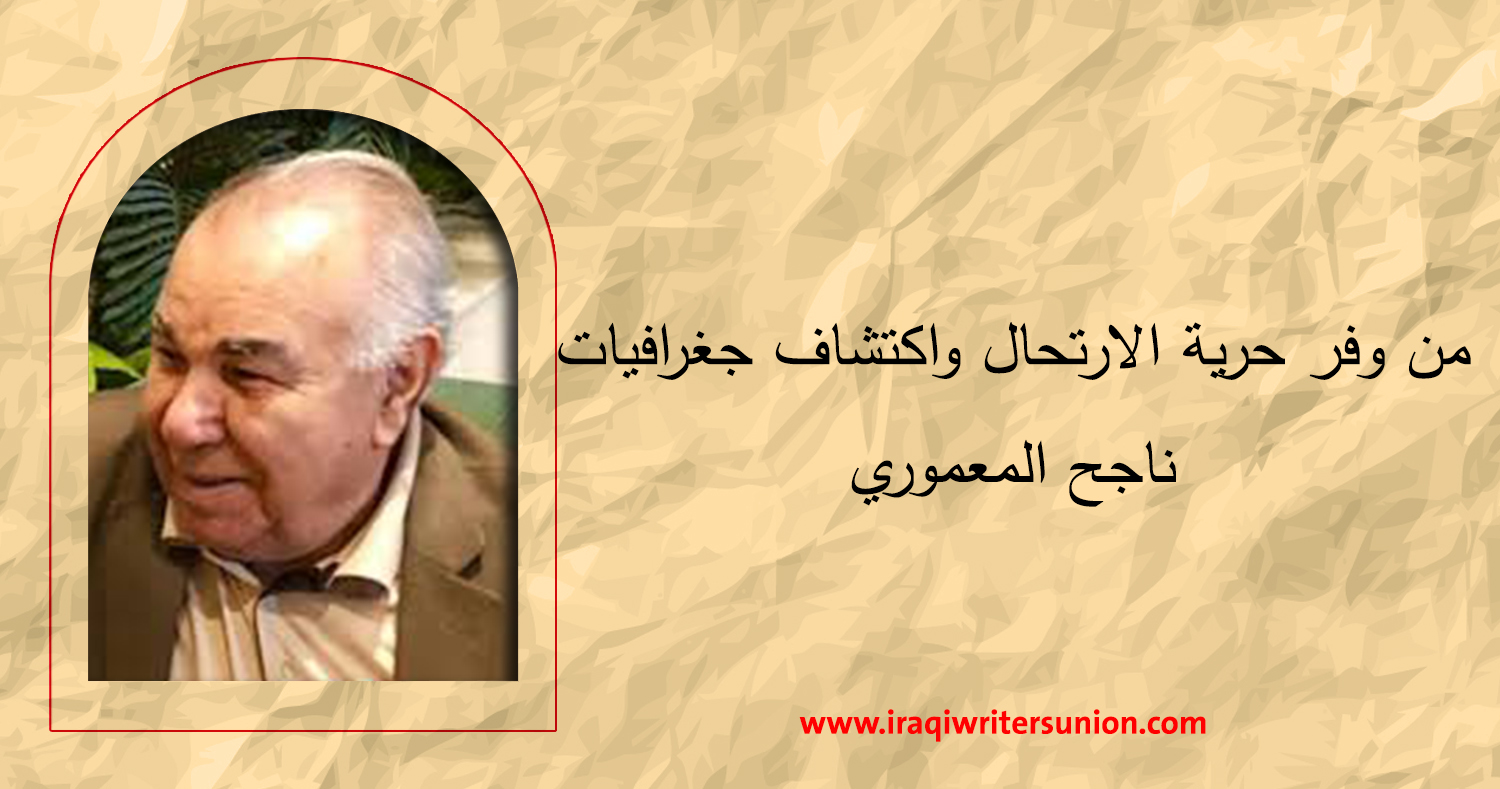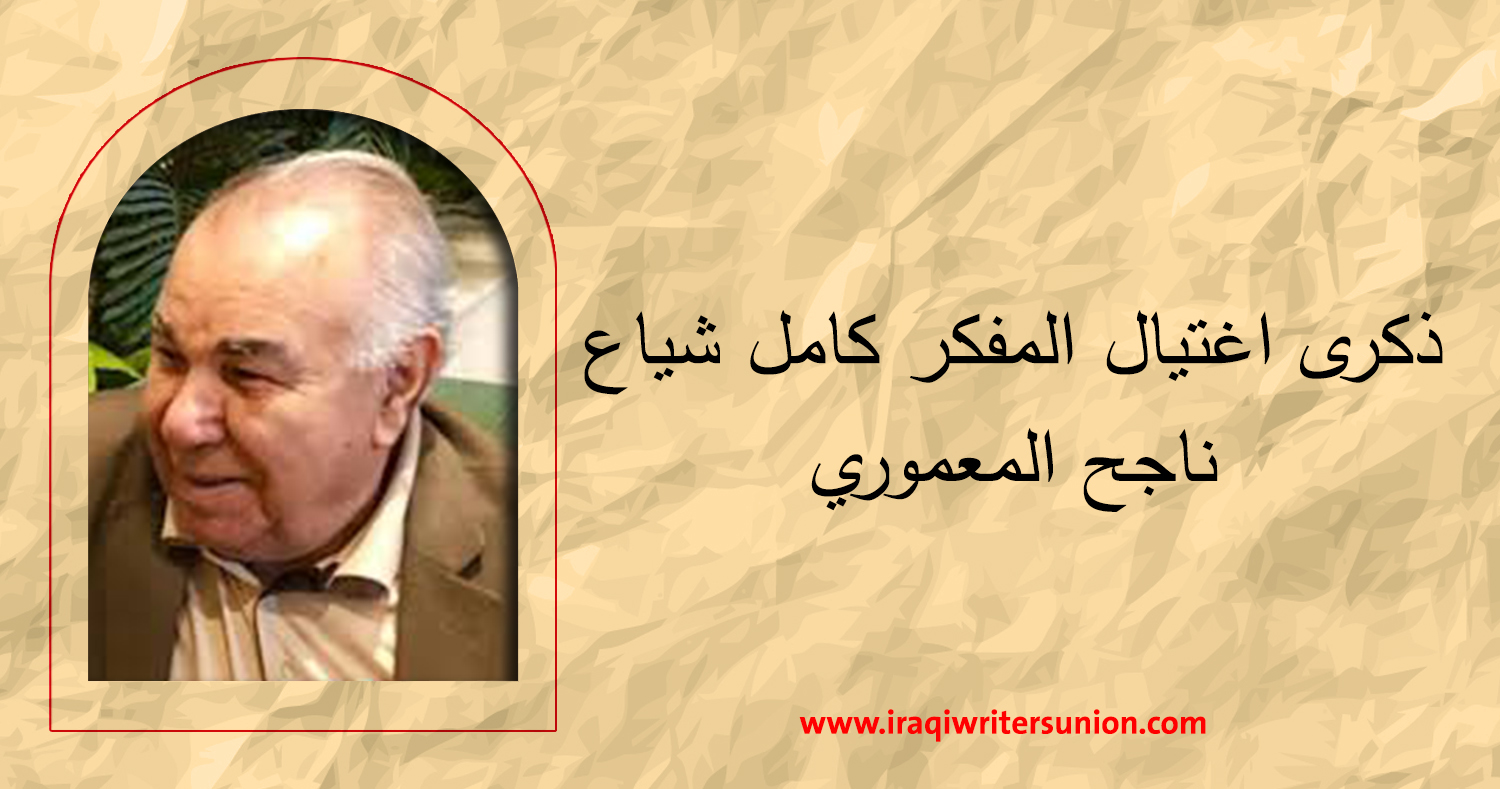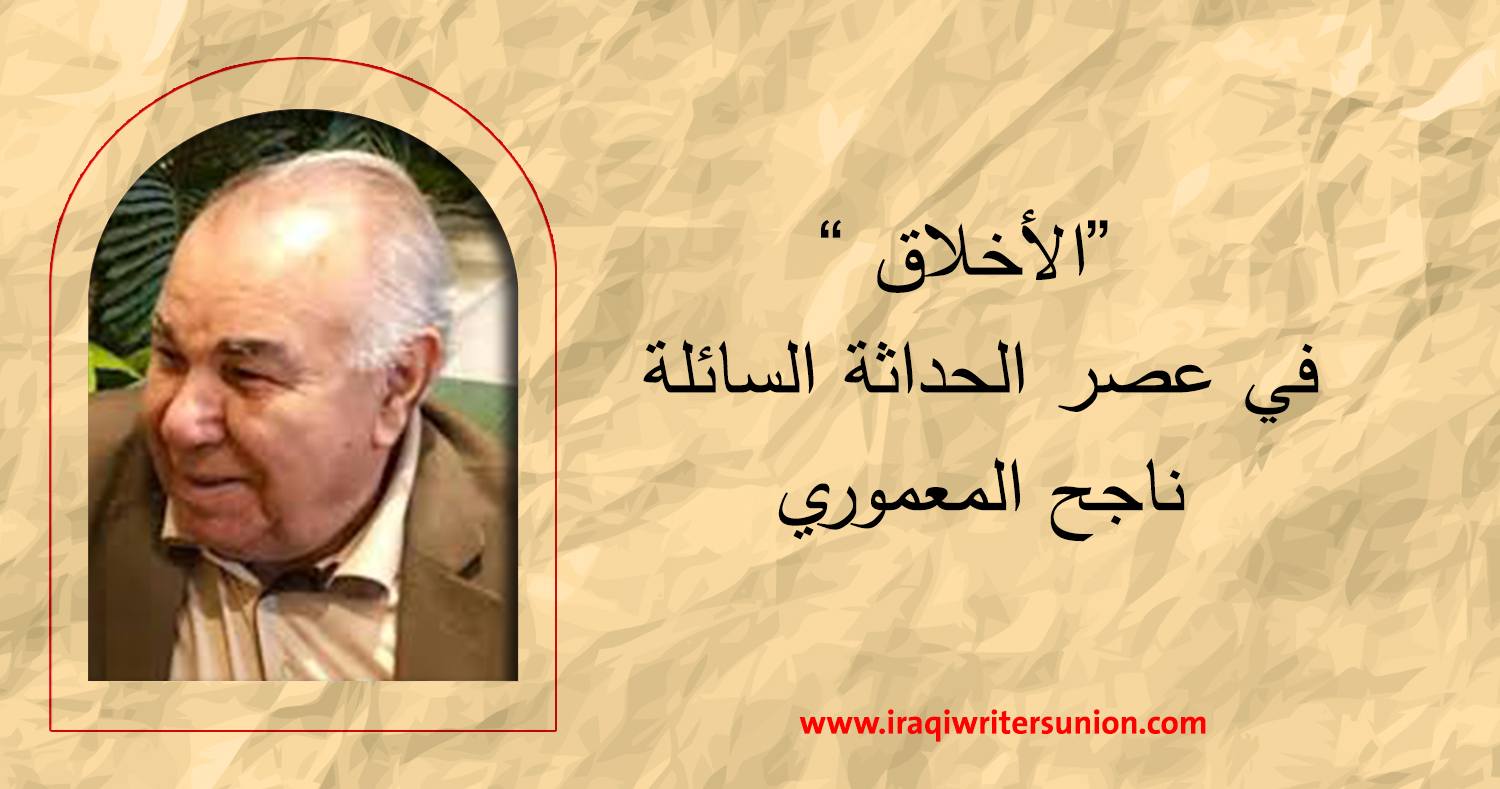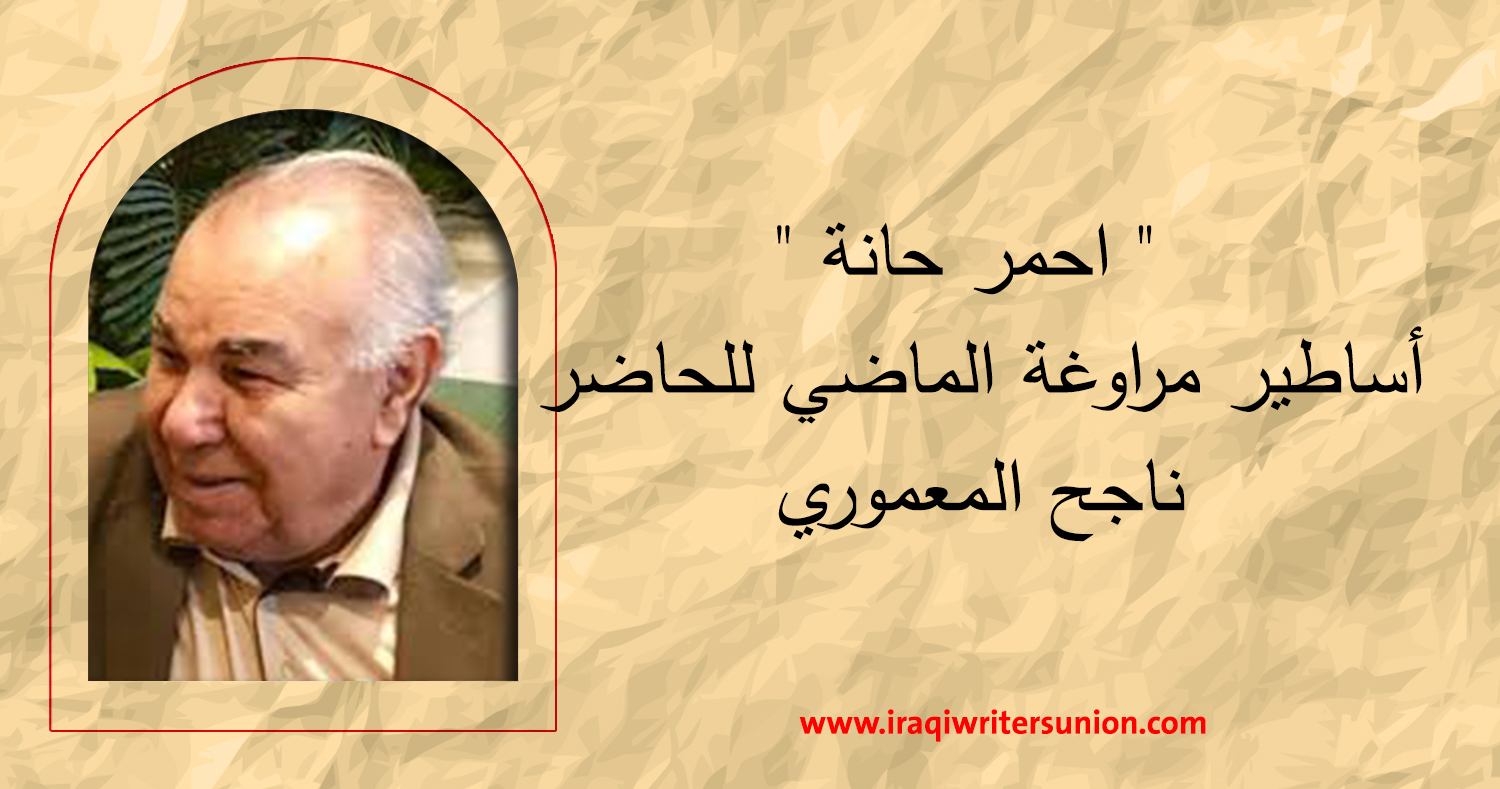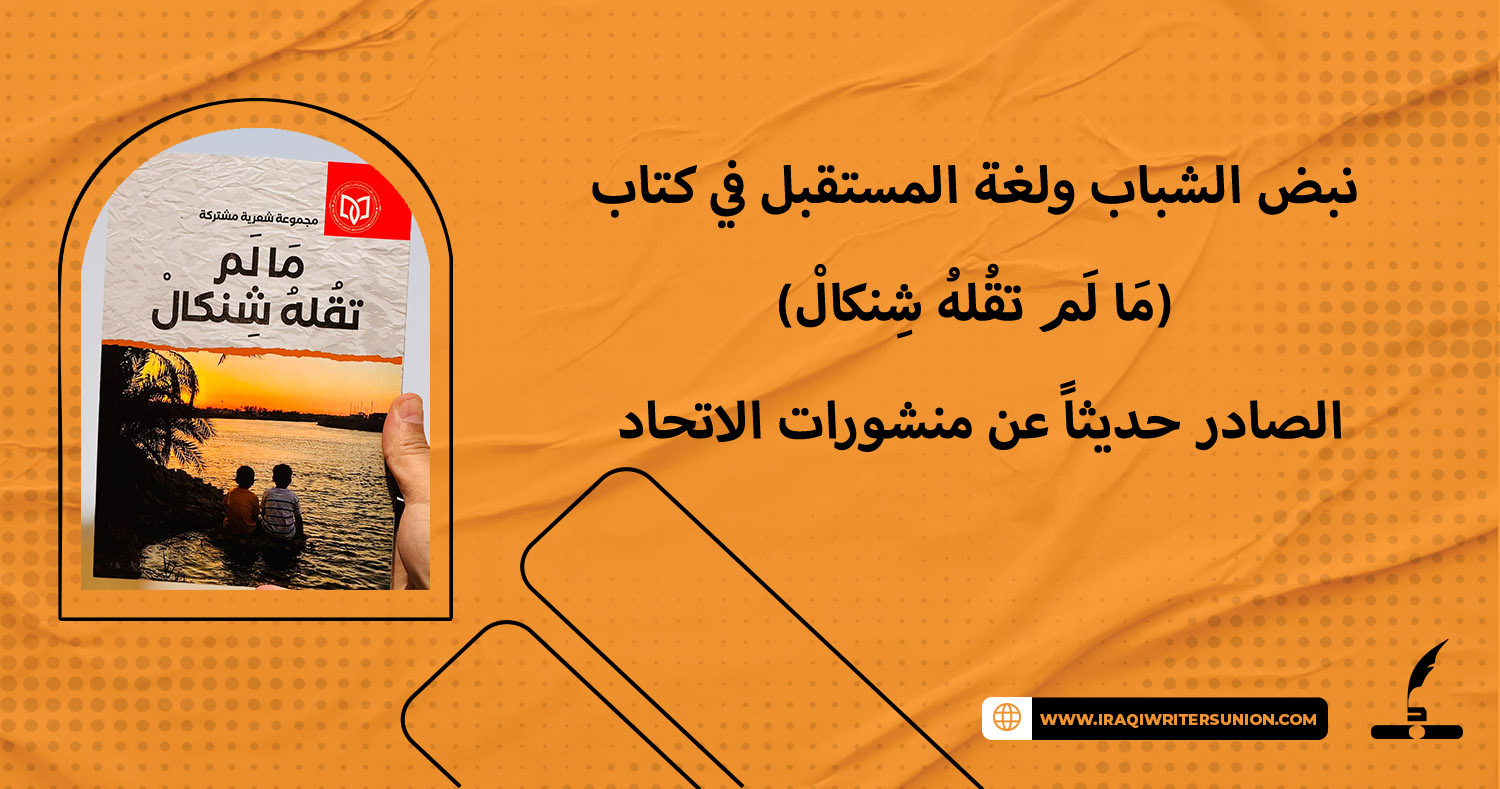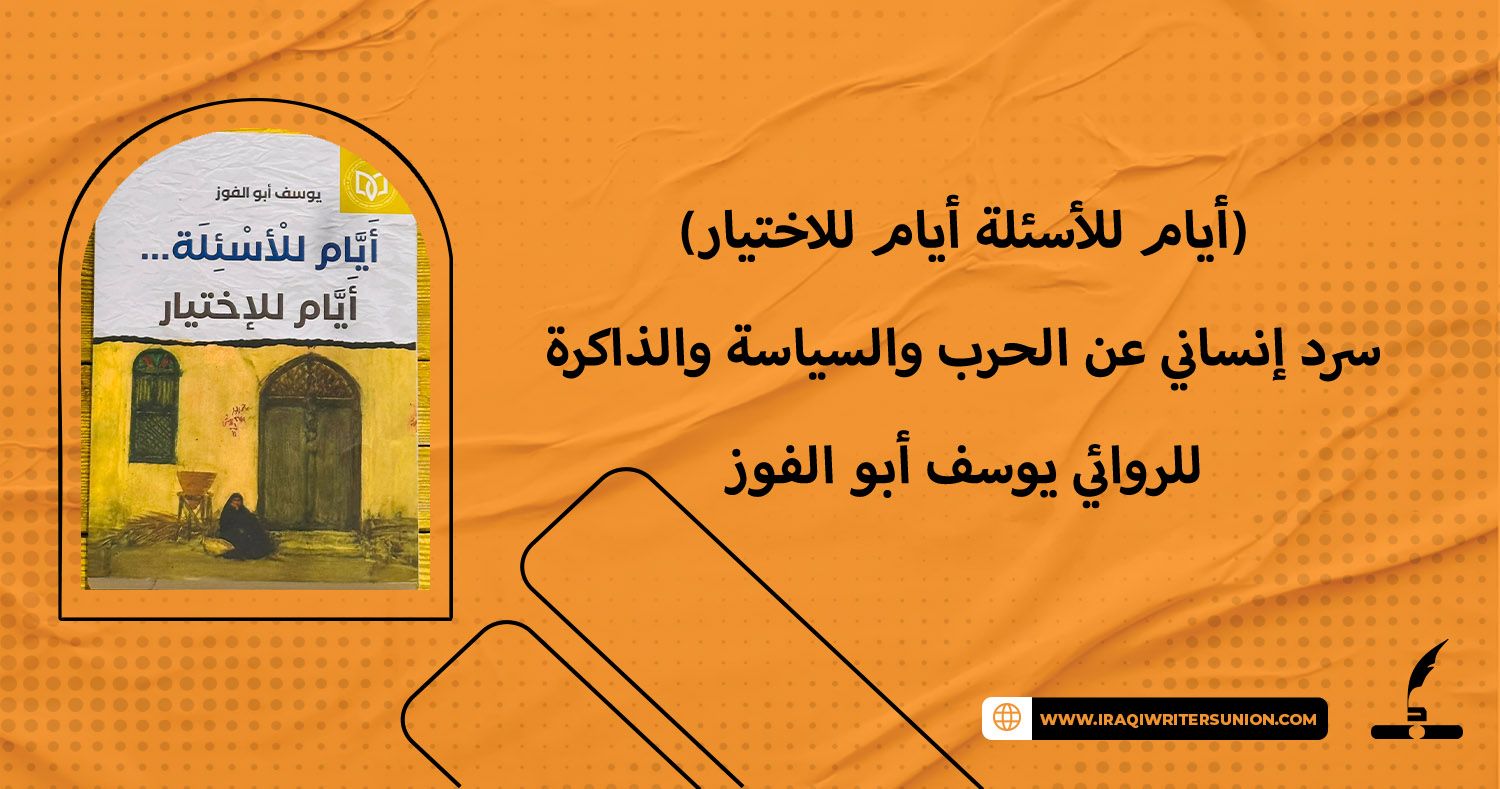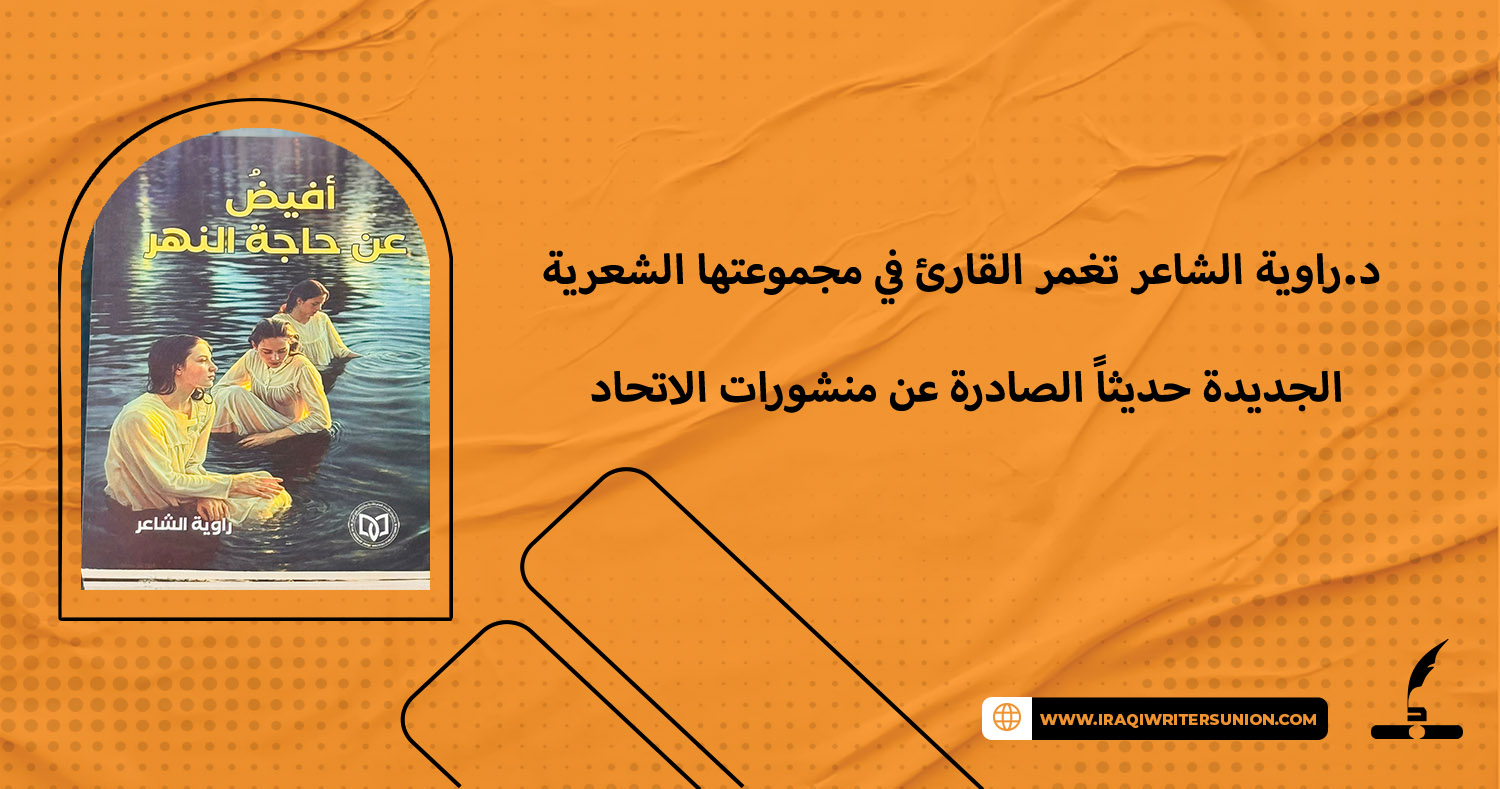اللغة في مواجهة المستقبل.. رهانات التنبّؤ وتحدّيات الواقع
مقدّمة
اللغة ليست مجرّد أداة للتواصل، إنها كائن حيّ يحمل في طيّاته تاريخًا من التطوّر والتحوّل، ويعكس رؤية الإنسان للعالم من حوله. وفي الوقت ذاته ليست مجرّد مرآة للواقع بل هي نافذة على المستقبل. ففي بنياتها الدلاليّة والتركيبيّة، تحمل بذور التوقّع والتنبّؤ، وكأنها تفكّر في المستقبل بطريقتها الخاصّة من خلال مفرداتها التي تّتسع لاستيعاب مفاهيم جديدة، وتراكيبها القادرة على التكيّف مع التحوّلات الاجتماعيّة والتكنولوجيّة. تظهر اللغة كيانًا ديناميكيًّا يتفاعل مع الزمن بكلّ أبعاده لكنّ هذا التفاعل محاط بمخاطر جسيمة ، ربّما تكون أقلّها ، السياسة والاقتصاد وما تفرزه من عوامل مؤثّرة تهدّد مستقبلها كما يشير لويس جان كالفي .
في مرايا هذا العدد من مجلّة الأديب العراقيّ المتخصّص في الأدب والمستقبل والمعنونة باللغة في مواجهة المستقبل: رهانات التنبّؤ وتحدّيات الواقع نحاول أن نستكشف كيف تفكّر اللغة في المستقبل من داخلها. هل تحمل الكلمات في دلالاتها إمكانيّة التطوّر؟ هل يمكن للتراكيب اللغويّة أن تتكيّف مع مفاهيم لم توجد بعد؟ وكيف تعبّر اللغة عن رؤيتها للمستقبل من خلال قدرتها على خلق استعارات جديدة، وصياغة مفاهيم معقّدة، واستيعاب التغيّرات الثقافيّة والتكنولوجيّة؟
فمثلاً قبل مئة عام من اليوم لم تكن كلمات مثل الرقمنة والعولمة والذكاء الاصطناعيّ لها حضور داخل نسيج اللغة العربيّة فكانت اللغة غير عاجزة عن التأقلم مع متغيّرات الواقع وطوّعت نفسها لها. الأمر الذي يفسّر قدرة اللغة على التعايش مع تحدّيات الواقع. لكنّنا هنا لن نناقش اللغة كأداة للتواصل، بل بوصفها كيانًا قادرًا على التوقّع والتنبّؤ. من تأثير الذكاء الاصطناعيّ على دلالات الكلمات، إلى قدرة اللغة على استيعاب مفاهيم مستقبليّة مثل الواقع الافتراضيّ والفضاء الرقميّ، إلى ما نتوقّع من مستقبلها . نحن أمام تحوّلات عميقة تتطلّب منّا أن نعيد النظر في دور اللغة وسيطًا بين الإنسان والعالم.
ومن جانب آخر نريد أن نتعرّف على طبيعة تفكير اللغة بالمستقبل وكيف تعاملت داخل بنيتها مع القادم، فلكلّ لغة خصوصيّتها النحويّة والدلاليّة والاشتقاقيّة . اللغة العربيّة – على سبيل التمثيل- تعاملت مع المستقبل بحرفي( سين وسوف) ولكلّ منهما دلالاته الخاصّة، وعندما نستعمل ال (سين) للمستقبل تكون للقريب بينما (سوف) للمستقبل البعيد وتعطي إحساسًا أقوى بالتأكيد، هذان الحرفان يعكسان قدرة اللغة العربيّة على التعبير الدقيق عن الزمن بينما في اللغة الانجليزيّة توجد ثمانية صيغ للتعامل مع المستقبل! بدءًا من will/shall/be going to/ إلى آخره وهناك تقسيم المستقبل إلى المجرّد والبسيط والمستمرّ والتامّ المستمرّ وفي اللغة الألمانيّة خمس صيغ للتعامل مع المستقبل. إلى مَ يُعزى هذا الاختلاف التقنيّ بين اللغات بالتعامل مع المستقبل؟ ثمّ هل توجد إمكانيّة أن تكتشف اللغة صيغًا جديدة وتضيفها لبنيتها؟ ثمّ أنّه في مواجهة هذه التحوّلات، تبرز تحدّيات كبيرة تتعلّق بنا بوصفنا ممارسين للغة حين نقلق بخصوص كيفيّة الحفاظ على الهُويّة الثقافيّة؟ كيف يمكن للغة أن تظلّ وفيّة لجذورها بينما تتكيّف مع متطلّبات المستقبل؟
ومجلّة الأديب العراقيّ في هذا الملفّ إذ تطرح هذه الأسئلة على نخبة من المهتمّين بالشأن الثقافيّ إنّما تريد تحريك الوعي تجاه اللغة والمستقبل فمع الدكتورة بشرى البستانيّ نبدأ الملفّ حين قالت:
"اللغةُ بيتُ الوجود" هكذا اختصر الفيلسوف الألمانيّ هيدجر قضيّة أخطر ممارسة إنسانيّة عرفها الإنسان عبر مراحل حياته ، ولا بد من الإشارة بدءًا إلى أنّ اللغة لا تمتلك شخصيّتها الوجوديّة إلّا بالكتابة التي ظلّت تنمو وتتطوّر عبر تطوّره الحضاريّ، كما ظلّت تغيّر الوسائل التي صحبت دراسة تقدّمه العلميّ والمعرفيّ وتعقيدات وعيه الإنسانيّ التي تطلّبت اليوم الوقوف لتأمّل هذه المتغيّرات الهائلة التي طرأت على حياته عمومًا والتي تحتاج اللغة القادرة على الكشف والتعبير عن منجزاتها العلميّة والحضاريّة الضخمة وعن الإشكاليّات المعقّدة التي اكتنفت البحث فيها كالهُويّة والتراث والتاريخ وعلوم اللغة وما تمخّض عن كلّ ذلك من تطوّر وعقبات معًا، تحوّلت عبر سكونيّة الزمن العربيّ الحديث إلى ما يشبه القوالب المقيّدة للانفتاح والتطوّر بدل مساعدتها على إثراء القاموس العربيّ بالجديد الحيويّ القادر على مواكبة التطوّر العلميّ الذي يفاجئ الإنسانيّة بتسارع هائل كلّ يوم ويطالب الإنسان بالتفهّم والتجدّد والإضافة.
ولمّا كانت اللغة نتاج الإنسان فإنّها تتعلّق بمجمل رؤاه ومراحل تطوّره المستقبليّ ومجمل حالاته الإنسانيّة، فكلّ ما نكتبه وكلّ تقوّلاتنا عن الحياة وما فيها هو تعبير عن رؤانا الوجوديّة للعالم، وكلّما تطوّرت مفردات الحياة ومنجزاتها النوعيّة علينا أن نسارع لضرورة فحص قدرة لغتنا على المواكبة، ولمّا كنّا نمتلك لغة من أثرى لغات العالم بشهادة العلماء المختصّين بشؤون اللغات، فعلينا أن نحرص على هذه الثروة الوجوديّة التي تمتلك فضلًا عن ثرائها كنزَ إسنادٍ سماويًّا عظيمًا هو القرآن الكريم، ومع ذلك فمن الموضوعيّة القول إن اللغة العربيّة اليوم قد أصابها و يصيبها كلّ ما أصاب الأمّة العربيّة من كيد ووهن جرّاء الحروب وعوامل الإفقار. وهذا يتطلّب مواجهة قصوى ومواقف حاسمة لحمايتها من سلبيّات هذه المرحلة التي بلغت فيها عوامل السلب على الأمّة أقصاها، ذلك أن قضيّة اللغة لا تنفصل عن قضيّة وجود الأمّة الذي يختصر حيويّة الحضور السياسيّ والاجتماعيّ والعلميّ برمّته، ولا بدّ من القول أن لغتنا التي سادت زمنًا طويلًا وازدهرت وأعطت الإنسانيّة الكثير من ثمار منجزاتها في الميادين كافّة إلّا أنها اليوم بحاجة إلى إنعاش ومعالجات شتّى تستحقّها في أكثر من ميدان: الإعلاميّ والسياسيّ، والثقافيّ والعلميّ، وإن تطلّب ذلك خارطة عملٍ متكاملة لا تعكس بل تتفاعل وتحاور منجز الحضارات الأخرى متثاقفة ومستفيدة ومُفيدة في الوقت ذاته، وهي في كلّ ذلك تطلّ على المستقبل برؤىً إيجابيّة منتجة، ولعلّ لغتنا في تشكيلها التركيبيّ والدلاليّ واحدة من أذكى اللغات في قدرتها على الاستشراف والتنبّؤ وفي ثرائها التأويليّ، يتجلّى هذا الثراء والبعد العميق الذي تستمدّه من تعايشها مع الحياة ومع التراث والثقافة والتحضّر، فاللغة الأصيلة هي التي تبعد أمّتها عن الصنميّة والتعصّب لأنها صانعة الثقافة المتحضّرة التي تؤمن بالانفتاح والحواريّة والعطاء فيأتي شجرها بثمر معطاء وقد قيل من قبل : كلّما كبرت شجرة الثقافة أغدقت بثمرها على الجيران، هكذا تكون المثاقفة سمة إنسانيّة لتشكيل علاقات إيجابيّة خيّرة تتحاور ولا تتصارع، تتجاور ولا تسعى للإزاحة كما يحدث بين الدول اليوم، تعطي ولا تُغيّر وتستحوذ وتنهب كما تفعل أمريكا وإسرائيل وهما يحاولان بالعدوان الأثيم إبادة شعب فلسطين قتلًا وحرقًا وتجويعًا وهدم مساكن ومدن..
إن استيعاب لغتنا العربيّة للقيم الراقية منذ القدم وقدرتها على النبض بمكرمات الأمّة التي تكلّمت بها هو الذي أنتج ثقافةً مازالت تنبض بروح ذلك العصر المنتج وإيجابيّات ناسه حتى اليوم وسيظلّ ذلك الأثرُ مادام الخير ملازمًا للإنسان.
إن ما يعوزنا في ميدان الدرس اللغويّ هو الجرأة التي تقترب من الشجاعة في التعامل مع لغتنا وهذا التعامل لا يتحقّق في الأغلب إلّا مع الشعراء والأدباء ومع علماء ودارسي اللغة وراصدي حركتها وملاحظة صيرورتها في الاستعمال وما ينتقيه العلماء من تداول العامّة، فأحيانًا يستعمل عامّة الناس مفردات محرّفة عن أصولها، أو مبتكرة في الاشتقاق لكنّها قادرة على التعبير بكفاءة تفوق مفردات القاموس بقواعدها المدوّنة في الكتب المقرّرة، فالكتب النحويّة واللغويّة مثلاً تؤكّد أن السين وسوف هما حرفا الدلالة على المستقبل قريبًا (السين وبعيدًا سوف) لكنّنا قد نعبّر بأكثر من وسيلة عن المستقبل ولنتأمّل هنا إذا الشرطيّة الظرفيّة لما يستقبل من الزمان مثلاً :
إذا كنت في كلّ الأمور معاتبًا صديقك لم تلقَ الذي لا تعاتبه
ففي هذا البيت إمكانيّات تنفتح على تداخل المعنى فقد مزج التشكيل بين الماضي والمستقبل (إذا، ظرف لما يستقبل من الزمن، وكنت لزمن ماضٍ، بحيث منحنا بعدًا آخر لمقدرة اللغة العربيّة على البثّ والثراء الدلاليّ. فليس من العسير أن تكون (لم) هنا بمعنى (لن) المستقبليّة حتّى في ملاءمة وزن البحر الطويل، يؤازر هذه الدلالة حضور الفعل المضارع الذي تلاها في (تعاتب) مّما يؤكّد قدرة كمون الدلالات في تشكّلات لغتنا، هذه التشكّلات التي مازال الكثير منها بحاجة للتأشير والدراسة.
إن الدارس المتأنّي للغة العربيّة ولشعرها القديم ونثر مبدعيها القدامى الموهوبين تتأكّد له قدرة هذه اللغة المبهرة على تخطّي الزمن بحواريّة تمنح دارسيها الثقة على أن الإمكانيّات الكامنة فيها قادرة على مواكبة التطوّرات العلميّة والتقنيّة التي يأتي بها المستقبل، فلغتنا اليوم تعبّر عن مخترعات العصر الجديدة والتي صارت مألوفة لدينا بتسمياتها فنحن نتداول بأسماء الكومبيوتر والذكاء الاصطناعيّ والفضاء الرقميّ والعولمة والواقع الافتراضيّ وغيرها من مفردات سادت وتقبّلها الذوق العربيّ مّما يؤكّد مرونة اللغة العربيّة وانفتاح الإنسان العربيّ في حواريّة حضاريّة ترفض الانغلاق وتقبل التطوّر. إنّ بقاء اللغة في الدور السلبيّ المنفعل سيبقينا عاجزين عن مواجهة التحدّيات الحضاريّة الكبرى المحيطة بنا.. وأخيرًا لا بدّ من الإشارة إلى أن اللغة حلقة من مجموعة حلقات يشدّ بعضها بعضًا للتطوّر عبر تماسك القيم بفكر موضوعيّ وإعلام رصين وثقافة توحّدُ الكلمة ولا تفرّق، ودينٍ يجمع بكتابه وسنّته وسيرة أمّته، كلّ ذلك يدعو لتوحيد الكلمة وتعزيز دور اللغة وإيجابيّة الفعل. ويطول الكلام في الحديث عن دور الغرب في تفسير وتوظيف أدبنا العربيّ أخبث توظيف والانحراف به لخدمة مشروعهم الغربيّ الاستعماريّ ضدّ تراثنا وإبداعنا وتاريخنا كما أكّد المفكّر أدوارد سعيد ولاسيّما في مشروعهم الاستشراقيّ العدوانيّ.
وكان للدكتورة ناهضة ستّار رأي يتعلّق بمفهوم الأزمة حين وضعت اللغة العربيّة وتحدّيات العالم الرقميّ في الممكنات فيما إذا كانت لغويّة أم أزمة ثقافة وتنمية قائلة:
نتّفق هنا على مدى أهميّة البحث ومزاولة الحوار في هذا الشأن الثقافيّ المهمّ تمهيدًا لحلول ومعالجات تخصّ هذا الحقل الحضاريّ والتعليميّ والتنمويّ المهمّ ،لأنّ اللغة جزء مهمّ من التنمية الحضاريّة والإنسانيّة ، بل إن التغاضي و إشاحة النظر و تقليص حجم الأزمة سيزيد من فوضى الحال ونسلّم القياد لبرنامج word ليصحّح أخطاء الكتابة.. ولن يجدي إبداء الأسف وتداول إلقاء عبء المسؤوليّة على الآخر ، بينما تجتهد قوى(الآخر) في العالم بشكل واقعيّ مدروس للهيمنة على صورة عالم قادم يكون لصالحهم فقط ، ولعلّ في هذه المصلحة أذىً جوهريّ يطال سائر اللغات والثقافات والأمم الأخرى ومنها أمّة اللغة العربيّة.
سؤال بجناحين صدّرنا به هذا المقال لأعرب عن أسباب الوضع الذي تواجهه وستواجهه (العربيّة) بوصفها كيانًا حضاريًّا عميق الجذور، وارف الفضاءات وليس مجرّد قواعد يكره حفظها الطلبة ومتعلّمو اللغة لظنّهم أنّها من الماضي البعيد الذي لا وجود ولا فائدة له في عصرهم الإلكترونيّ... وسترى عزيزي القارئ كثرة الأسئلة في تضاعيف هذا المقال لأنّ الأسئلة بوّابة انفتاح الوعي الخلّاق على أفق المعالجة ، كما تنبّهنا الأسئلة على أزماتنا حين (نسمّيها) ، فالتسمية تحديد للأزمة، وتعيين لماهيّتها، و فرز وتشخيص لحدودها، وتقييم لمدى خطورتها من عدمه .. من هنا لزم رسم جغرافيا الأزمة وتأشير بؤر التوتّر بحسب الرؤية التي يتبنّاها كلّ راءٍ ومنظّر وناقد ..التي هي بدورها تفتح أفقًا للمعالجة ينهض به المثقّف الحقيقيّ والأستاذ و الأديب ولن أنسى هنا الإداريّ الذي يحوّل توصيات المثقّف والعالِم والأديب إلى مشاريع قوانين نافذة تخصّ سلامة اللغة و الإفادة من ممكناتها و الحثّ على الارتقاء الدائم بمكانتها في جميع منافذ الاستعمال اللغويّ في كلّ حقل و مجال ..
لذا لن أرهق مقالتي بأيّ تنظير يمكن للقارئ الكريم استيفاءه من مصادره إنّما سأخصّص جهدي هنا في تشخيص بعض من الأزمات بحسب رؤيتي أراها هي الركائز التي تقوم عليها فرضيّة ( اللغة و المستقبل)..
واللغة منظومة تواصليّة وحضاريّة بين أبناء الثقافة الواحدة مع بعضهم بعضًا ومع الثقافات الأخرى ، أخذت بعدًا تمجيديًّا لا يخلو من تقديس في نشأتها وأهميّتها ، وليست ببعيدة عنّا أولى النظريّات المتكهّنة بنشأة اللغة وهي النظريّة التوقيفيّة التي ترى أن اللغة إلهامٌ ، وإذا ما ذهبنا أعمق من ذلك إلى ثقافة بلاد الرافدين القديمة إذ عُدّ مصدر اللغة إلهيّ النشوء ، منحتها الآلهة للبشر لتسيير أمورهم ، و تخصّص آلهة معيّنون منهم الإله(نابو) والإلهة (نيسابا) (ينظر الكاتب في بلاد الرافدين، عامر الجميلي، 117) لذلك ارتبطت كينونة اللغة بالتمجيد والقداسة وصعوبة الخروج على مواضعاتها وقوانينها الحتميّة الصارمة وينبغي احاطتها بالرعاية والمحافظة فلا يجوز إضافة حرف أو حذف حرف أو أيّ تعديل ما على بناها وقواعدها ، من هنا نحاور الأزمة مع فحوى هذه الصرامة التي فيها وجه إيجابيّ هو الحفاظ على اللغة لأن كلّ لغة معرّضة لتغيّرات و استقطابات بفعل تغيّر الزمن و الأجيال وطبيعة الاستعمال و تغيّر أنماط الحياة ، هل تعاملنا مع اللغة من زاوية قواعديّتها الصارمة فقط ؟ هل نظرنا إلى المتاح الكثير من اجتهادات علماء اللغة والنحو والصرف وغيرهم في تقليب الأوجه والاحتمالات و أوجه الوجوب والجواز و غير ذلك من ممكنات تزخر بها قواعد اللغة والنحو والبلاغة وغيرها ...
كما يشكّل الماضي ركيزة انطلاق راسخة ومتينة و بليغة لا يمكن أن نتقدّم مع الزمن إلّا ونحن متسلّحون بهذا الدعم الرصين نقف بفضله واثقين مطمئنّين أننا داخل عجلة التطوّر و ضمن حركيّة الجدّة والابتكار والتميّز في كلّ زمان و مكان.. فاللغة ليست وليدة اليوم و هي مستمرّة معنا مع كلّ مرحلة .. و أيّ فكرة تطرأ على الحياة أو مشكلة اجتماعيّة أو صحيّة أو سياسيّة أو نفسيّة .. أو غير ذلك ننشغل بعد الصدمة بها بتفكيك ( التسمية) والمصطلح و تحليل مرجعيّتها وصلاحيّة إطلاق المصطلح و محاولة تعشيق (الفكرة الجديدة المعاصرة الراهنة) مع (ماضويّة التركيب اللغويّ و الصرفيّ والدلاليّ المعهود في المعجم ) لذلك انشغلنا زمنًا بمصطلحات ( العولمة، المكننة، الأتمتة .. وغيرها كثير ) وهو سعي يدلّ على (عتمة) الثقافة العربيّة أي متانتها فهي ليست(شفّافة) يخترقها كلّ طارئ بسهولة ، وهذا شأن اللغات الحيّة العريقة في العالم ..
والسؤال الثقافيّ هنا .. هل انشغلت الذهنيّة الغربيّة بالتجديد والابتكار و بقي الشرق يقلّب في المعجم ليرى صحّة المصطلح من خطئه.. ؟ حينما نفتّش في ثقافة (العصر العباسيّ )في تاريخنا مثلًا نجد أن الجهد الابتكاريّ و التأليفيّ و التجديديّ والتدوين في علوم الفلسفة والمنطق والطبّ والفلك والآداب وغيرها .. كانت تسير بنحو متوازٍ نسقيّ مع اللغة والمصطلحات و الاشتقاق و حريّة ابتداع الملفوظات الدالّة على الأفكار الجديدة المستحدثة في عصرهم .. فالفكرة تخلق مصطلحها الدالّ عليها ، والعلم ينتج مع فكره لغته الدالّة على تفاصيله و جزئيّاته .. لذلك نحن أمام دهشتين حضاريّتين لافتتين في طرفي هذا الإشكاليّة (الإبداع واللغة ) ، هما :
أولًا : الحضارة العراقيّة القديمة (الأكاديّة والبابليّة والآشوريّة) و ثانيًا: الحضارة العربيّة الإسلاميّة في العصر العباسيّ
لقد كانت فيهما اللغة تسير متوازية النسق مع التطوّر العقليّ والعلميّ والأدبيّ وكانت (اللغة) في الحضارتين المشار إليهما في أعلاه تشكّل أهميّة لافتة وجوهريّة نحن إلى يومنا هذا نتفحّص ملامح إبداعها و سبقها الزمنيّ والعبقريّ لأوانها ، فهي لغة (مستقبل) كما هي لغة (حاضرهم) آنذاك مع كلّ جديد تكشفه التنقيبات و قراءة النصوص والألواح والمخطوطات .. فالعراقيّون القدماء قدّموا للعالم في وقتهم وإلى يومنا هذا إدهاشات عظيمة برغم قلّة المستَكشف من الآثار وأنتجوا لغةً مُعْربة اشتقاقيّة متميّزة ولا ننسى تلك الظاهرة الازدواجيّة الغريبة التي أدهشت علماء الآثار واللغات في العالم وهي استعمال العراقيّين القدماء لّلغتين (الأكاديّة والسومريّة) معًا في الكتابة ، وابتكروا النظم الشعريّ الموزون (الأمر الذي غفل عنه عالم المسماريّات (صموئيل نوح كريمر) في كتابه الشهير(السومريّون) إذ قال إن الأعمال الأدبيّة السومريّة لم يستخدم فيها الوزن الشعريّ/ ص 232) بينما أكّد العلّامة الآثاريّ الكبير (طه باقر) في كتابه المهمّ ( مقدّمة في أدب العراق القديم على وجود أوزان الشعر في الشعر العراقيّ القديم كملحمة كلكامش وغيرها ، ثمّ الجهود العلميّة الكبيرة للعلّامة الآثاريّ( د. نائل حنون) في ترجماته المهمّة للملحمة و سائر الأعمال الأدبيّة المسماريّة الخالدة. و ماذا لو تمّت تنقيبات أكثر وأكثر فمن المؤكّد ظهور نصيّات هائلة تدلّ على تفوّق وجدنا ملامحه في المقروء من النصوص المكتشفة والمقروءة والمطبوعة ،علمًا أن الحضارتين عانتا من صراعات ليست هيّنة لكنّهما استمرّتا في اتحاف البشريّة بمؤشّرات على عظمة الشرق ، و توازى مؤشّر النماء السياسيّ والمعرفيّ و العقليّ مع الجانب اللغويّ والتعبيريّ في الحضارتين ، فالحضارة البابليّة ملكتْ الجهات الأربع من العالم القديم ، و الحضارة العبّاسيّة وصلت إلى أوربا ومركزها بغداد، بمعنى أن الحضارتين وصلتا إلى المستقبل ومازلنا نحلّل إبداعاتهما في أكثر من حقل معرفيّ . من هنا تأتي وجاهة رؤية (ابن خلدون) في قوله الشهير محلّلًا طرفي معادلة (اللغة والقوّة): ( إن غلبة اللغة بغلبة أهلها وإن منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم) /مقدّمة ابن خلدون
وأظنّ أن من أهداف هذه المرايا النظر في ممكنات اللغة وقدرتها على استيعاب حداثات العالم المعاصر والقادم ، وبعد النظر فيما قدّمناه من إطلالة على نموذجين حضاريّين مهمّين شرحناهما في الفقرة السابقة ، نجد أن اللغة مهيّأة لتطوّرات العصر الرقميّ الحاليّ .. لأن فيها مكامن و إمكانات لا نهائيّة لاشتقاق الجديد من الصيغ والتراكيب والمشتقّات لتساوق الدارج من المخترعات الحديثة وبخاصّة الإلكترونيّة منها التي تحكم حياتنا اليوم بشكل طاغٍ ..فلعلّك حين تقلب معجمًا من المعاجم اللغويّة لأيّ لفظة تشاء ستجد تقليبات متعدّدة واشتقاقات و مواقع واستعمالات مختلفة في القرآن والشعر و النثر وكلام العرب وغير ذلك لكنّنا لا نجد إلّا صيغة أو اثنتين منها متداولات في الاستعمال اللفظيّ والكتابيّ ، فيشيع النزر القليل و يُنسى الكثير ويبقى حبيس الكتب والمجلّدات ولا يذكره إلّا الدراسون وأساتذة اللغات ، فتهيمن (الشهرة و الألفة و الاعتياد ) على واقع لغويّ ثريّ و منسيّ ، والثراء مزيّة مائزة في اللغات الحيّة المتطوّرة التي تمنح للمتكلّم والكاتب مائدة عامرة سخيّة لكنّ المأكول منها نزر يسير ، أرى في هذه المزيّة فسحة ضوء للمستقبل عند مستعملي اللغة في الإفادة من هذه الإمكانات الموجودة في اللغة بـ (القوّة) لكنّها محدودة في (الفعل ) – حسب مصطلحات أهل الفلسفة ..
وسنكتفي باشتقاق واحد للجموع مثلًا بينما توجد أنواع من (الجموع) في اللغة لا نعلمها في الاستعمال ..
ونكتفي ببحور قليلة من أوزان الشعر وأعاريضه علمًا انّها ا 16 بحرًا من خمس دوائر عروضيّة استنبطها العبقريّ العراقيّ (الخليل الفراهيديّ 255 هـ) و في تضاعيف كلّ دائرة عروضيّة بحور مستعملة وأخرى يسمّيها (مهملة) مع أنها ضمن التشكيل الموسيقيّ داخل الدائرة العروضيّة .. والأمثلة كثيرة كثيرة .. تثبت أن مستعمل اللغة لا يدرك أبعادها المترامية و ثراءها المبهر فيحدّدها بقدرٍ استعماليّ يسير . و علّة ذلك استسهال الدارج من الاستعمالات ، والخشية من الوقوع في الخطأ اللغويّ ..
فضلًا عن ملاحظة مهمّة تتعلّق بمناهج تعليم اللغة للأجيال .. وهذا لوحده شأن غاية في الأهميّة في ضرورة تجديد مناهج الدراسة للغات في جميع المراحل الدراسيّة و التحسّب لمستحدثات المستقبل و منح الطلبة ومتعلّمي اللغة مفاتيح تمكّنهم من تحقيق التوازن بين التطوّر والتعبير ..
فيما قال الدكتور هادي نظري منظّم من جامعة تريبت في طهران رأيًا متعلّقًا باللغة في ظلّ العولمة والتحدّيات المعاصرة:
اللغة أداة للتعبير، والتواصل، والتفکير، بها نعبّر عن عواطفنا ومشاعرنا، عن آمالنا وآلامنا وهواجسنا، کما أنها خيرُ أداة لتحقيق التواصل مع الآخر، والتفاهم معه. ومن وظائفها أيضًا أنّنا نفکّر بها و نُنمّي أفکارنا ونطوّرها، فاللغة تصنع الفکر مثلما أن الفکر يصنع اللغة.
واللغة العربيّة، کما هو معروف، من أقدم اللغات وأغناها ظلّت وما تزال تحتفظ بإنجازات کثير من المفكّرين والمثقّفين والأدباء والعلماء من العرب المسلمين وغيرهم مّمن خدموها منذ أکثر من ألف وخمسمائة سنة وما يزالون يخدمونها عن حبّ وإخلاص، لکنّ هذه اللغة اليوم خائفة متوجّسة، لأنها تُجابه عددًا لا يستهان به من تحدّيات نتجت في الأکثر الأعمّ عن الثورة المعلوماتيّة والتطوّرات التکنولوجيّة المعاصرة في العالم ؛ فالثورة العلميّة والتکنولوجيّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ ساعدت في نشر العربيّة والارتقاء بها إلی مصاف اللغات العالميّة الحيّة کالانکليزيّة والفرنسيّة، وهي من جهة أخری، أثارت الرعب في قلوب أنصار العربيّة والمتعصّبين لها، مثلما أثارت القلق في قلوب المتحمّسين لباقي اللغات والمتکلّمين بها؛ ولکلّ من هؤلاء حججهم وبراهينهم لکن يضيق البحث الحاليّ عن الدخول في تفاصيلها.
والإنصاف يقتضينا الإشارة إلی أنّ العربيّة ليست هي وحدها اللغة التي تواجه هذه التحدّيات. ففي ظلّ العولمة والثورة التقنيّة والتکنولوجيّة، وفي عصر القرية الکونيّة باتت جميع اللغات العالميّة بما فيها الفرنسيّة(المنافسة الأقوی للانکليزيّة) في حالة الانحدار والتراجع ناهيك عن اللغات التي لا يتکلّم بها سوی أمم وشعوب غارقة في التخلّف الاقتصاديّ والتقنيّ والثقافيّ. فالعالَم عالَم الأقوياء علميًّا ومعرفيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا، والذي یمتلك العلم والمعرفة ومصادر التقنيات ويستغلّها خير استغلال من شأنه أن يتصرّف کما يشاء ويتحکّم بأفکار الناس وعقولهم وآرائهم في مختلف المجالات وأن يشکّل حتّی تفکيرهم ووعيهم بالقضايا والمستجدّات.
ولمّا کان الغرب يمتلك المعرفة وأدواتها ومصادرها ویمتلك ما ینتج عنها من سلطان وقوّة وهيمنة، فمن الطبيعيّ أن يستخدم کلّ ما لديه من تکنولوجيا ووسائل الإعلام والتواصل في تشکيل وعي العرب بغية تعزيز هيمنته عليهم، فلا عجب إذا ما رأينا أنّنا نحن العرب والمسلمين نفکّر بالطريقة نفسها التي یرسمها الغرب لنا، وعلی النحو الذي هو يفضّله، فنصبح ،والحالة هذه، تابعين ومقلِّدين وخادمين ومنبهرين ومغتربين عن الذات ومتجرّدين عن کلّ قيمنا الدينيّة والإسلاميّة والثقافيّة ، ويصبح الغرب بالتالي هو السائد والمتبوع والقدوة الحسنی والمثل الأعلی والنموذج الناجح ، الذي یمارس سحره وتأثيره في الآخر المسکين المستکين ليل نهار. واللغة إذا باتت ضعيفة تابعة فهي تطبع أهلها والمتکلّمين بها بطابع الضعف والذلّ والتبعيّة والاستکانة والعکس أيضًا هو صحيح ، حيث إن أهل اللغة والمتکلّمين بها إذا باتوا مصدر قوّة وإشعاع وإبداع واختراع يطبعون لغتهم بطابع القوّة والانتشار عالميًّا، مثلما نری اليوم بالنسبة للإنکليزيّة التي صارت لغة العلم والتکنولوجيا دون منازع ، أمّا إذا ضعفوا وجبنوا فلغتهم أيضًا تضعف وتنهار اللهمّ إلّا في حالات نادرة.
من هنا يری کاتب هذه السطور أنّه من واجب کلّ عربيّ غيور علی لغته وثقافته وقيمه الإسلاميّة والدينيّة أن تکون لديه فکرة کاملة عن التحدّيات التي تهدّد لغته وثقافته وقیمه الدينيّة، کما أنّه من واجبه أن يتسلّح بسلاح المعرفة والعلم لأنّ العلم والمعرفة هو ما یحقّق له السلطان. فاللغة العربيّة والأدب العربيّ المتمثّل في هذه اللغة هما آخِر ما تبقَّی للإنسان العربيّ الذي تعصف به عواصف العولمة وتهدّده أشدّ التهديد في قرية کونيّة لا بد منها.
کما یجب علی العرب وعلی هواة العربيّة من غير العرب أن یهتمّوا بإعداد المحتوی الرقميّ بالعربيّة الفصيحة والتزوّد بالمعارف والعلوم العصريّة والعناية القصوی بالتعريب وتشجيع تعلّم العربيّة الفصحی وأن یرکّزوا علی تحسين المهارات اللغويّة عند الأطفال والشباب وتعزيز الوعي لديهم. علیهم أن یتّخذوا العربيّة الفصيحة هي اللغة السائدة في الجامعات ولغة العلم ولغة الاقتصاد ولغة التواصل والفکر وأن يقفوا أنفسهم علی نشر هذه اللغة محليًّا ودوليًّا وعالميًّا، کما یجب عليهم أن يُعنَوا بالترجمة لإغناء اللغة العربيّة بالجوانب الفکريّة والمضمونيّة والفلسفيّة وبالأجناس العالميّة الجديدة وألّا يغفلوا عن نقد هذه الترجمات ومساءلة المترجمين الغافلين وتشجيع الواعين منهم ، إذ إن القوی الکبری بقيادة أمريکا والصهيونيّة العالميّة مازالت لهم بالمرصاد و إنها لم ولن تتخلّی عن ممارسة التحکّم بعقول الشعوب العربيّة والمسلمة، وهي تری في نشر اللغة التابعة والضعيفة خير أداة لها، تّتخذها وعاءً لإضفاء وإسقاط مفاهيمها علی الآخر العربيّ في محاولة منها لاحتواء هذا الآخر والإبقاء عليه علی حاله من الضعف والتخلّف والتبعيّة.
إنّ اللغة التابعة والمقلّدة التي تعجز عن مواکبة التطوّرات المذهلة الراهنة مآلها الزوال أو التهميش والانعزال، أمّا اللغة القوّيّة التي تستوعب العلوم والمعارف وتقتبس المفردات و المصطلحات وتعمل علی تدجينها وتأصيلها، وتنفتح علی الآخر ومعارفه وعلومه وتقنیاته فهي لها أقوی سلطان؛ تمارس من خلاله تأثیرها، وتجد طريقها إلی العقول والأذهان، فهي ملهِمة أکثر مّما هي مستلهِمة، وهي مؤثّرة أکثر مّما هي متأثّرة ، ولا بقاء في هذا العالم غير المتوازن ، والمأزوم سوی للأصلح والأقوی.
العربيّة کانت وما تزال قويّة، لکنّها اليوم في وضع يختلف عن سابق عهدها أشدّ الاختلاف، ومن هنا فهي في حاجة ماسة إلی من يساعدونها عن حبّ وإخلاص ويسهّلون الطريق لتعليمها وتعلّمها ونشرها والإقبال عليها کي تجد طريقها إلی العالميّة وتفرض سلطانها علی متلقّيها.
والمعروف أنّ المحليّة طريق للعالميّة، فإذا فرّطنا في حقّ العربيّة وأهملناها علی صعيد الأقطار العربيّة فهي تُفرِّط فينا وتهملنا وتُمثّلنا أسوأ تمثيل علی الصعيد العالميّ وتطبعنا بطابع الضعف والاستسلام والخنوع.
وعلى صعيد متّصل تقول الدكتورة رنا فرمان من جامعة القادسية بأن تزامن التحوّل الهائل الذي يشهده الفكر الإنسانيّ في فضاء التكنولوجيا متجدّد وتأثيره على مستقبل اللغة بحاجة إلى رصد عبر:
السؤال أوّلاً عن "الذات" وطبيعة الإنسان أو الفكر الإنسانيّ، لأنَّ النظر إلى اللغة ضمن هذا الاتّجاه قائم من منظور طابعها الماديّ أو حضورها في المشروع الإنسانيّ بوصفها "علاقة" أو "ممارسة"، بالنظر للفرق بين تصوّر اللغة على مستوى التقعيد وبين تصوّرها نشاطًا قابلًا –بالضرورة- لمواكبة تطوّرات الفكر والعالم، وربّما ذلك ما دعا الدارسين الأوائل لعلاقة اللغة بالتكنولوجيا على مستوى الترجمة والاشتقاق؛ الإشارة إلى إمكانيّة مناورة النحو والصرف انطلاقًا من تصوّر اللغة "لباسًا خارجيًّا وطارئًا" للبنية الفكريّة تماهيًا مع تغيّرات التجربة الإنسانيّة وتطوّر العقل، وقد أشار كثير من الباحثين إلى أزمة اللغة العربيّة مع العولمة، وعن إمكانيّات تجاوزها أكّد "د. غسان مراد" على القدرات الذاتيّة للغة ، وتقنيات مجتمع المعرفة، والدعوة إلى دراسة حقل "الإنسانيّات الرقميّة Digital Humanities" من أجل بحث العلاقة التبادليّة بين المعلوماتيّة والثقافة عامّة، والعلوم الإنسانيّة خاصّة، فحقل اللسانيّات المعلوماتيّة يشكّل الجانب التطبيقيّ للمعالجة الآليّة للغات.
لإدراك أهميّة معالجة اللغة توافقًا مع طبيعة العصر، يقتضي ذلك إدراكًا فعليًّا لطبيعة التحوّلات على مستوى "الذات" تماهيًا، إذ يرافق التغيّرات الفكريّة تغيّر شامل في الخطابات بأشكالها المختلفة؛ السياسيّة، والثقافيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، ذلك يعني تغيّرًا جذريًّا في "الذات" ومن ثمَّ طبيعة الوعي، وشروط التفكير وإنتاج المعرفة، لذلك يعدّ التطوّر التكنولوجيّ انعطافة بشريّة غيَّرت الوعي الإنسانيّ بفارق ابستمولوجيّ كبير، يمكن ملاحظتها تتكشّف مع ظهور نظريّات ودراسات "ما بعد الإنسانيّة post human" التي قوّضت مركزيّة الإنسان وأعادت موضعته خلافًا لمنظور العقلانيّة الحديثة، وذلك تجلّى عن طريق نبذ التسلسلات الهرميّة والثنائيّات المتمايزة مثل: الإنسان/ غير الإنسان؛ واستبدالها بموقف علائقيّ جامع يتألّف على وفق ما حدَّدته "روزي بريدوتي" من ـثلاثة مصطلحات "الزوي، والبايوس، والتكنولوجيا" على مستوى توزيع الوعي انطولوجيًّا، فـمصطلح: الزوي zoe يعني: "حياة كلّ الكائنات الحيّة"، ومصطلح البايوس bios يعني "حياة البشر المنظّمة في المجتمع"، أمّا التكنولوجيا techno فمن جهة التأثير، هذا الموقف الجامع ينطوي ضمنيًّا على: إقرار بالتعدديّة والبنية التشاركيّة للعالم، ومن ثمَّ تحديد موضعة جديدة للمعرفة أي المعرفة "من موقع" ذات أخرى "ذات جماعيّ" لا تمتّ بصلة للذات المتمركزة في سرديّات التنوير، فتغيّرات موقع "الذات" كفيلة بإحداث تأثيرات بنيويّة كبرى في طبيعة العقل؛ فالعقل متغيّر بحسب ليوتار بوصفه ليس مبدأ أو كليّة بشريّة كونيّة غير قابلة للتغيير ولكنّه إنتاج بشريّ محدّد ومتغيّر، الأمر الذي يظهر جليًّا في تبدّل سمات الإنسان المعاصر واكتسابه خصائص جديدة لتشكيل رؤى ومنظورات مغايرة للعالم والمعرفة واللغة، تلائم الطابع الجماعيّ الذي تتميّز به "الإنسانيّات الرقميّة" تعبيرًا عن الحاجة إلى تفاعل العلوم المختلفة بحثًا عن لغة مشتركة أو صناعتها دعمًا لعمليّة إنتاج المعرفة المشتركة، فضلاً عن إيجاد طرائق لتعليم المعلوماتيّة وإدخالها في مجال العلوم الإنسانيّة مثل الإعلام الرقميّ، والأرشفة الإلكترونيّة، والمعالجة الآليّة لّلغات، ونصوص المدوّنات، وعلوم الإدراك وفلسفة الذهن، والذكاء الاصطناعيّ، لتمكين اللغة العربيّة من تجاوز أزمة ركودها مقابل تحدّيات مجتمع المعرفة التكنولوجيّة.
إذ لم يعد إنسان الألفيّة الثالثة هو الإنسان الذي عرفته البشريّة من قبل، إنسان التكنولوجيا الذي أطلقت عليه "دونا هاراوي" مصطلح "السايبورغ cyborg" ضمن إعلانها الصادر عام 1989، الذي تقصد به الكائن السايبرنيتيكيّ المعرفيّ الهجين الذي يجمع بين الآلة والكائن الحيّ على المستوى العضويّ ، فضلاً عن مستوى تشكّل الوعي وطبيعة إنتاج المعرفة، بوصفه ذاتًا مختلطة ناتجة عن عمليّات معقّدة من تداخل خطابات السلطة بأشكالها المختلفة بما تتضمّن سلطة خيال العالم أي التكنولوجيا؛ التي تمكّنت جميعها من إعادة إنتاج الذات، التي تسعى –بالضرورة- إلى تأسيس عالمها ضمن سمات متوافقة مع سياق التغيّر والتركيب والصيرورة التي تسم الفضاء الجديد، إذ خلقت التكنولوجيا عالمًا اكتسب فيه الانفتاح ، وذوبان الحدود شرعيّتهما ضدّ البنى الثابتة، عالم التحوّل والافتراض وإعادة التنظيم المستمرّ الذي شكَّل سياسات وجماليّات السايبورغ على مستوى الإبداع الثقافيّ والفنّيّ والأدبيّ ، وإذا كانت "الذات" إحدى متغيّرات التجريب لعصر ما بعد الإنسان، فضلًا عن تقمّصها التغيّر والتجدّد والابتكار، فهي قادرة على موضعة نفسها في مواجهة تحدّيات الواقع لّلغة سواء على مستوى الاشتقاق والتوليد أم بوصفها منظومة إنتاج دلاليّ في سيرورة منفتحة، وهنا تعلو أصوات الباحثين نحو ضرورة التنبّه إلى تجاوز التعليم الكلاسيكيّ من خلال اعتماد الوسائل الحديثة إقرارًا بفضاء السايبورغ وما يستلزمه من معرفة مناسبة، ويؤكد د. غسان مراد على أهميّة وعي الإنسان العربيّ بضرورة أن يكون فاعلاً في مجال المعلوماتيّة توافقًا مع شرط وجوده، لمواجهة التحدّيات وإشكالات المعالجة الآليّة لّلغة ، مقترحًا التركيز على علوم التواصل ولغات البرمجة.. وإذا كانت اللغة كما يقول كاسيرر أداة الإنسان إلى التفكير العقليّ، فهي إذًا؛ تستمدّ قدراتها من شرط وجودها..
ربّما لذلك افترضت "دونا هاراوي" أنّ اللغة هي تكنولوجيا المعلومات الأولى، وأنّ البشريّة كانت سايبورغيّة منذ الكلمة الأولى، وأن الإنسان لم يصبح إنسانًا إلّا حينما اكتسب "تكنولوجيا معلوماته: اللغة" وأثبت براءته من خطيئته الأولى؛ لقد كان نضال الإنسان من أجل اللغة ...
أمّا الدكتور نشأة فائق عبد الحسن من جامعة الإمام الكاظم فقد أثرى المرايا حين وضع اللغة بين التنبّؤ والتحدّي قائلًا:
لا شكّ أن اللغة تستوعب أفكارًا وأدوات جديدة ، وتتكيّف مع كلّ زمان ، وتعاين أحداثه وما يفرزه من مصطلحات ومفاهيم جديدة ، فلم نجد هناك فجوة بين اللغة والمصطلحات المستحدثة ، بل هناك تعايش حميم بينهما، لأنّ الكيفيّة التي تفكّر فيها اللغة بالمستقبل تبدأ من المجتمع وانعكاساته، لا سيّما أن التحوّل الاجتماعيّ قد يحدث تحوّلًا لغويًّا موازيًا من جهة، وتؤثّر اللغة أيضًا في طريقة تفكيرنا الاستشرافيّ من جهة أخرى؛ فينتج من ذلك استكشاف دلالات وصيغ واستعارات جديدة ، تحلّ محلّ المصطلحات القديمة التي تكون الأخيرة جذرها اللغويّ، فعلى سبيل المثال ظهر مصطلح ( السخرية ) جليًّا في العصر العباسيّ وتحوّل هذا المصطلح في عصرنا الحديث إلى مفهوم التنمّر، وأخذت اللغة تواكب هذه المصطلحات وتستعملها ضمن أدواتها، بيد أن التغيير والتطوّر ورؤية المستقبل واستشرافه هي مبعث الحياة لهذه اللغة ، فلولا التجدّد والاستشراف لأصبح كلّ شيء راكدًا ، ولا حياة مع الركود. لذا أفرز لنا تراثنا العظيم فكرًا لغويًّا وعلميًّا خلاّقًا ، نعدّه زادًا ثريًّا منح تاريخنا اللغويّ موقعًا متقدّمًا في المسيرة الحضاريّة والإنسانيّة، إذ واكب هذا الفكر اللغويّ التطوّر الذي تشهده البشريّة ، وانفتح على آفاقها الجديدة مرحّبًا بكلّ ما يفرزه العصر من معارف ومعلومات ومصطلحات تخدم الإنسان وترتقي به نحو التقدّم والإبداع.
لا يستطيع الإنسان أن يعيش ويتواصل مع الآخر دون اللغة، فإن الابتكارات والرؤى المستقبليّة التي ينتجها عقل الإنسان ناتجة بالأساس من الحصيلة والانجازات الهائلة التي أفرزها عقله بوساطة اللغة، وأقصد في ذلك لغة التفكير والتنبّؤ بما يحمله لنا المستقبل من مفاجأة؛ لأنّ التنبّؤ مسألة محفوفة بتلك المفاجأة المستقبليّة التي تنمو وتتفرّع ثمارها عبر اللغة ومصطلحاتها الجديدة ، فقد أخذت اللغة تفكّر بالمستقبل بطريقة متفرّدة تختلف عن التفكير الذاتيّ للإنسان، فهي تفكّر بطريقة التفكير الجمعيّ نحو المستقبل ، إذ تلجأ إلى إدخال بعض المفردات الرقميّة، والترجمة الآنيّة التي كشفها الذكاء الاصطناعيّ بأعجوبة.
تعبّر اللغة عن الفكر كما يقول ( فوكو)، بل تُشكّل طريقة تفكيرنا نحو المستقبل، باعتمادها على مصطلحات ومفاهيم أكثر فاعليّة وسرعة، إذ أن أيّ لغة لا تنمو ولا تزدهر بعيدًا عن المجتمع وما يجري فيه من أحداث، فهي البيئة الفكريّة التي نحيا فيها، وحلقة الوصل التي تربط الماضي بالحاضر بالمستقبل ، لذا بنت اللغة لنفسها مشروعًا لغويًّا للألفيّة القادمة، بوصفها وعاءً حضاريًّا قادرًا على الاستيعاب من جهة، ومواكبة المستقبل والتعبير عنه ، وإعادة إنتاجه بما يلائم ما هو جديد من جهة أخرى.
لن تتراجع اللغة إلى الوراء، بل وقفت بوجه جميع التحدّيات الثقافيّة والفكريّة والاجتماعيّة، المتمثّلة بالغزو الثقافيّ وطوفان التغريب ، الذي فرض هيمنته على اللغة، لكنّ اللغة بأصالتها، وقوّة ألفاظها، ورصانة معانيها، وتشعّب دلالتها، بقيت صامدة أمام سلسلة من الابتلاءات التي تعرّضت لها الأمّة من غزو وحقد من قبل بعض المستشرقين الذين رموا تلك اللغة بعيوب وقصور، متناسيًا أن لغتنا من أكثر اللغات وفرة للمعاني والألفاظ ، إذ تنحت من جذورها ما يعبّر عن مفاهيم المعارف والعلوم الجديدة، وتهب لغيرها من اللغات ما تحتاجه، فهي لغة متطوّرة ومتجدّدة، تحمل في طيّاتها سرّ بقائها، وتتماشى مع الألفاظ والمصطلحات التي ألفنا النطق بها واستعمالها مجاراة لمعطيات العصر ومستجدّاته، مستوعبة علومه ، ومستشرفة آفاقه المستقبليّة.
وكان لا بد من اللجوء إلى الشعراء بغية فتح نافذة السؤال على مقاربة خارج الأكاديميّة للوقوف على سؤال اللغة والمستقبل حين تكلّم في مضمونه الشاعر زاهر موسى قائلاً:
في مناسبة تتكرّر، يقف الشاعر بموهبته الفطريّة أمام اللغة الرسميّة للأدب وبينهما نهر التلفّظ (بفهم باختين)، وبرغم أنّهما على ضفّتين متقابلتين ويشربان من النهر نفسه، إلّا أن ما بينهما يُعدّ اغترابًا ووحشة.
الشعر من جانب يقود كلماته أو تقوده الكلمات نحو الخطاب الأحاديّ؛ لكنّ واقع التلقّي والوعي باللغة يريد تعدّدًا يماثل الرواية وينافسها في عصريّتها وحداثتها. يبدو المشهد بهذا الشكل في الشعريّة العربيّة خلال القرن الماضي وربّما في هذا القرن أيضًا، خصوصًا وأن اللغة الرسميّة للأدب ما زالت أجنبيّة على فطرة الشاعر العربيّ يتعلّمها كما يتعلّم الحساب ، أي أنّه ينظر لها من ضفّته متجاهلًا النهر (نهر التلفّظ) الذي يفصله عنها؛ إلّا ما ندر.
لقد تمركزت الرواية بمكان الشعر في الزمن الذي نصادفه، حدث ذلك من خلال أمور عدّة من بينها تعدّد الأصوات، ومنذ ذلك الوقت سعى المحدّثون من الشعراء العرب إلى البكاء على طلل التقنيات المستوردة من السرد، لقد حاولوا طويلًا أن يعالجوا فقرهم اللغويّ عبر مراقبة نهر التلفّظ السرديّ الواقعيّ وتتبّع موجاته الهادرة في محاولة لاستنساخها؛ الأمر الذي لم ينجح من وجهة نظري؛ إذ إنّ هناك فرقًا كبيرًا بين أن تكون نهرًا له قاع ومجرى ومياه متعدّدة الألوان والأفكار والحيوات وبين من يحمل نهرًا خياليًّا على كتفه في رحلة عبر الصحراء.
هل نقول: فشل الجميع في تحديث الشعر العربيّ وإنتاج تلفّظ شعريّ حافل بالتهجين والأسلبة والمحاكاة الساخرة، يبدو هذا تطرّفًا، خصوصًا وأنّ مفهوم الانزياح (بفهم كوهين) أنقذ الموقف ومنح الشعراء نهرهم الخاصّ، لق












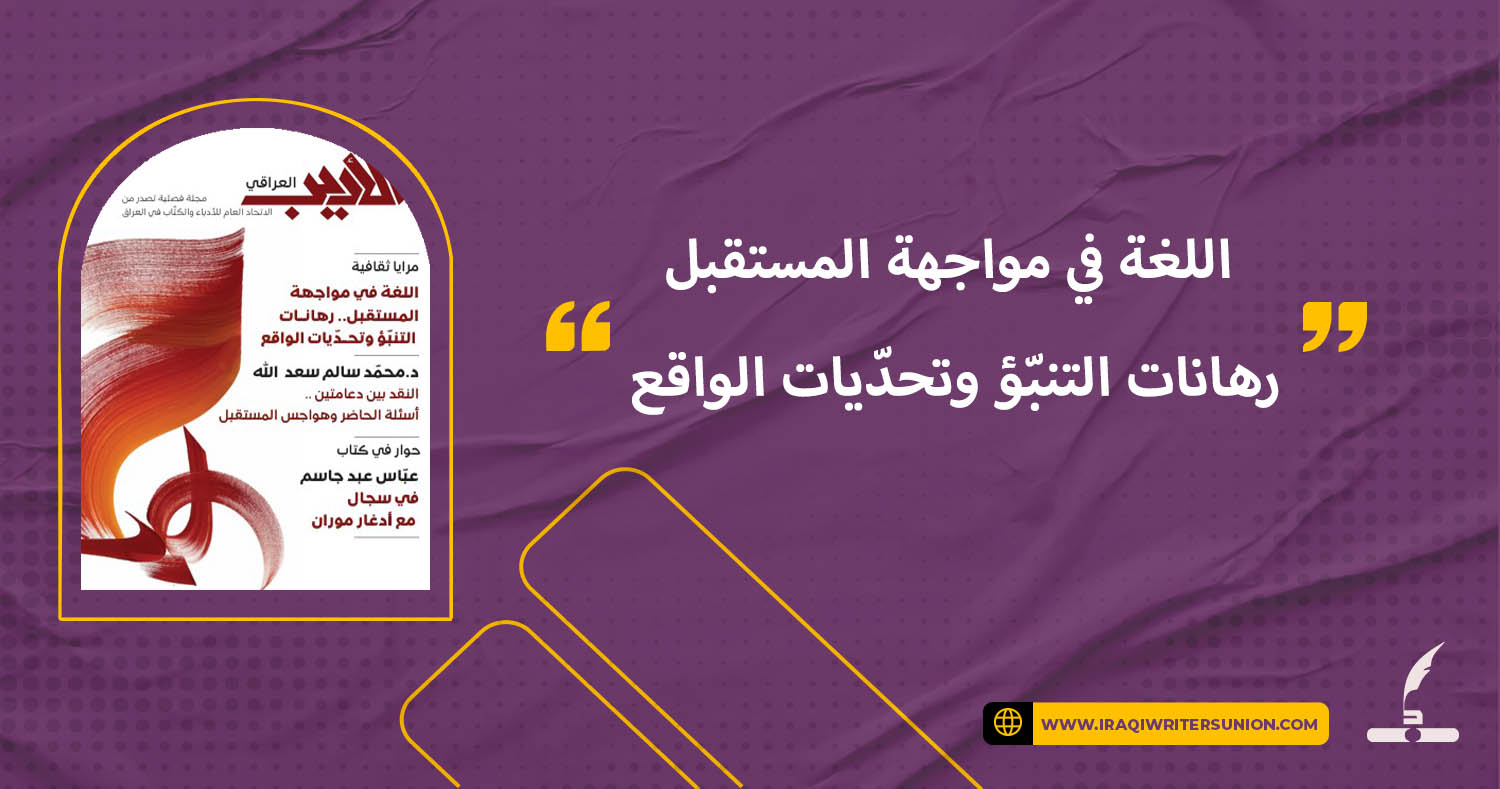
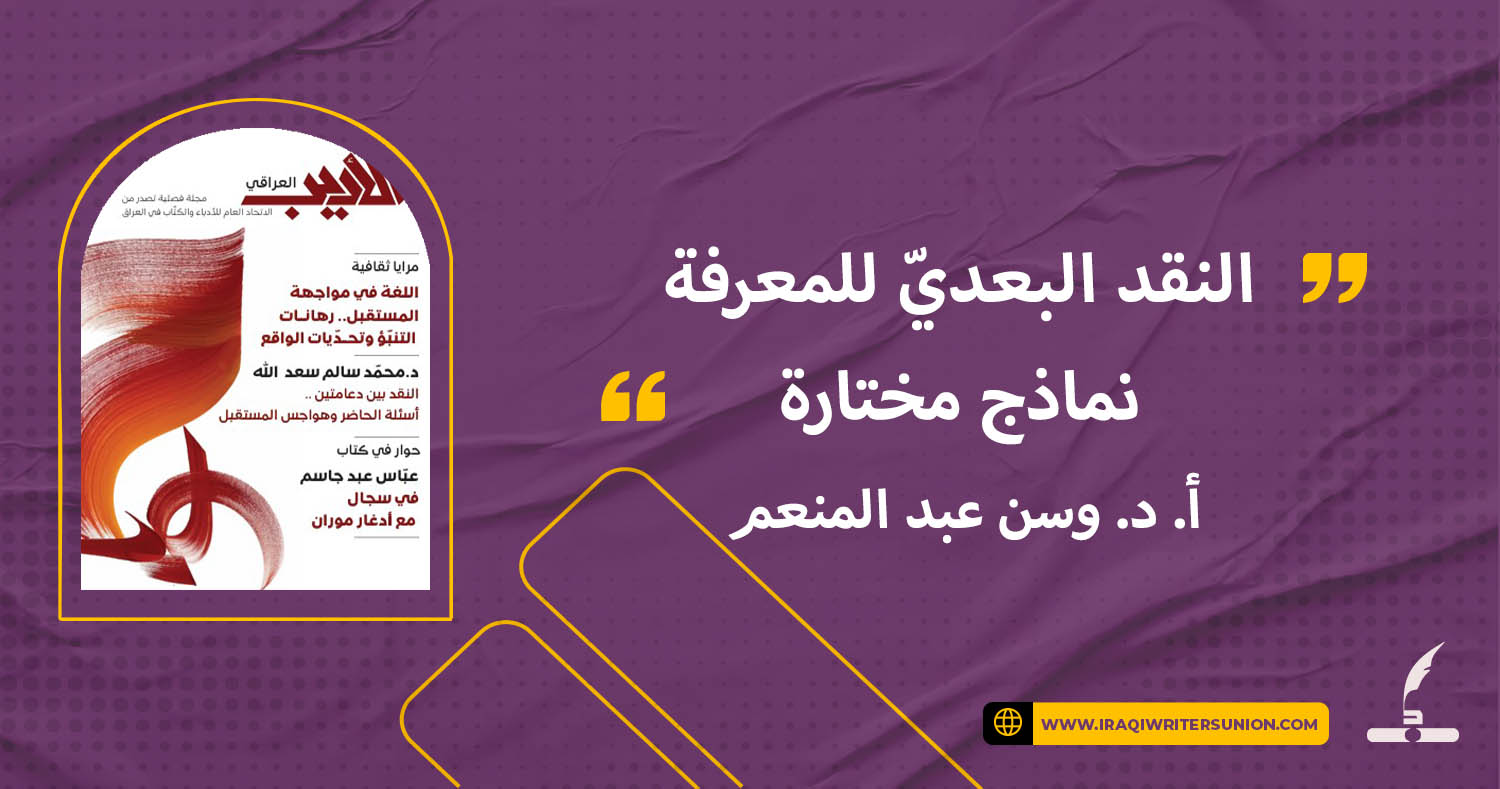
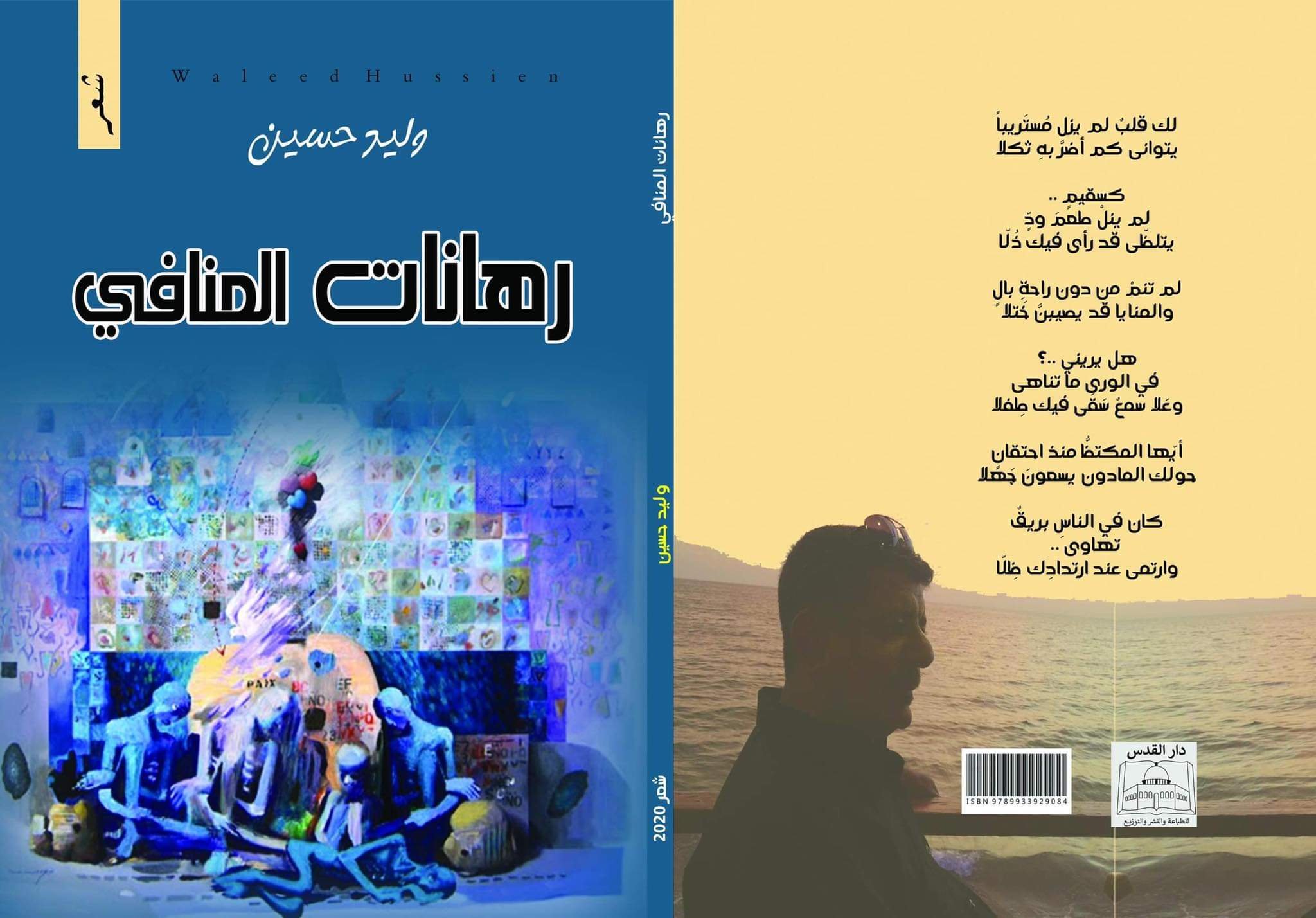

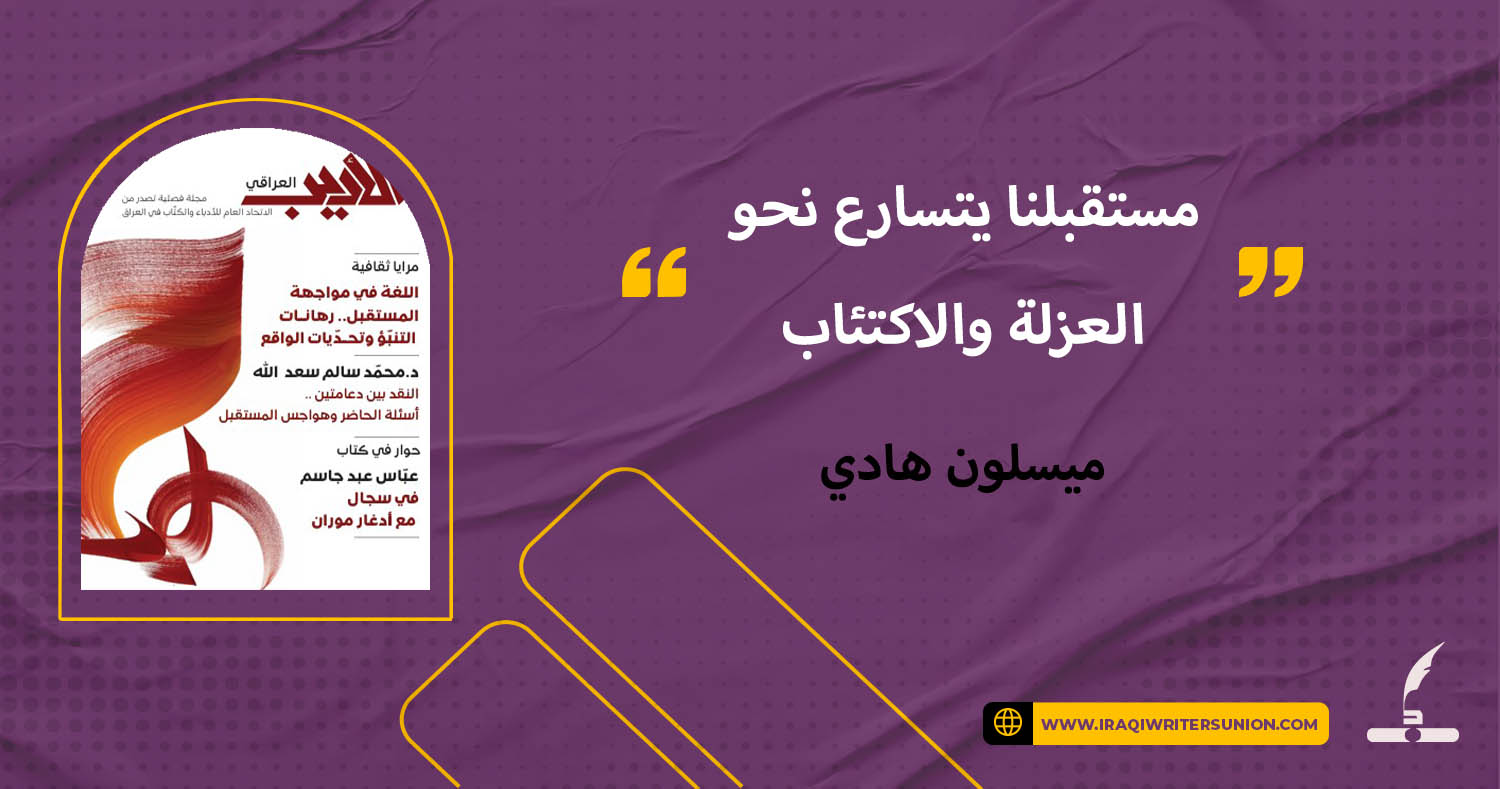
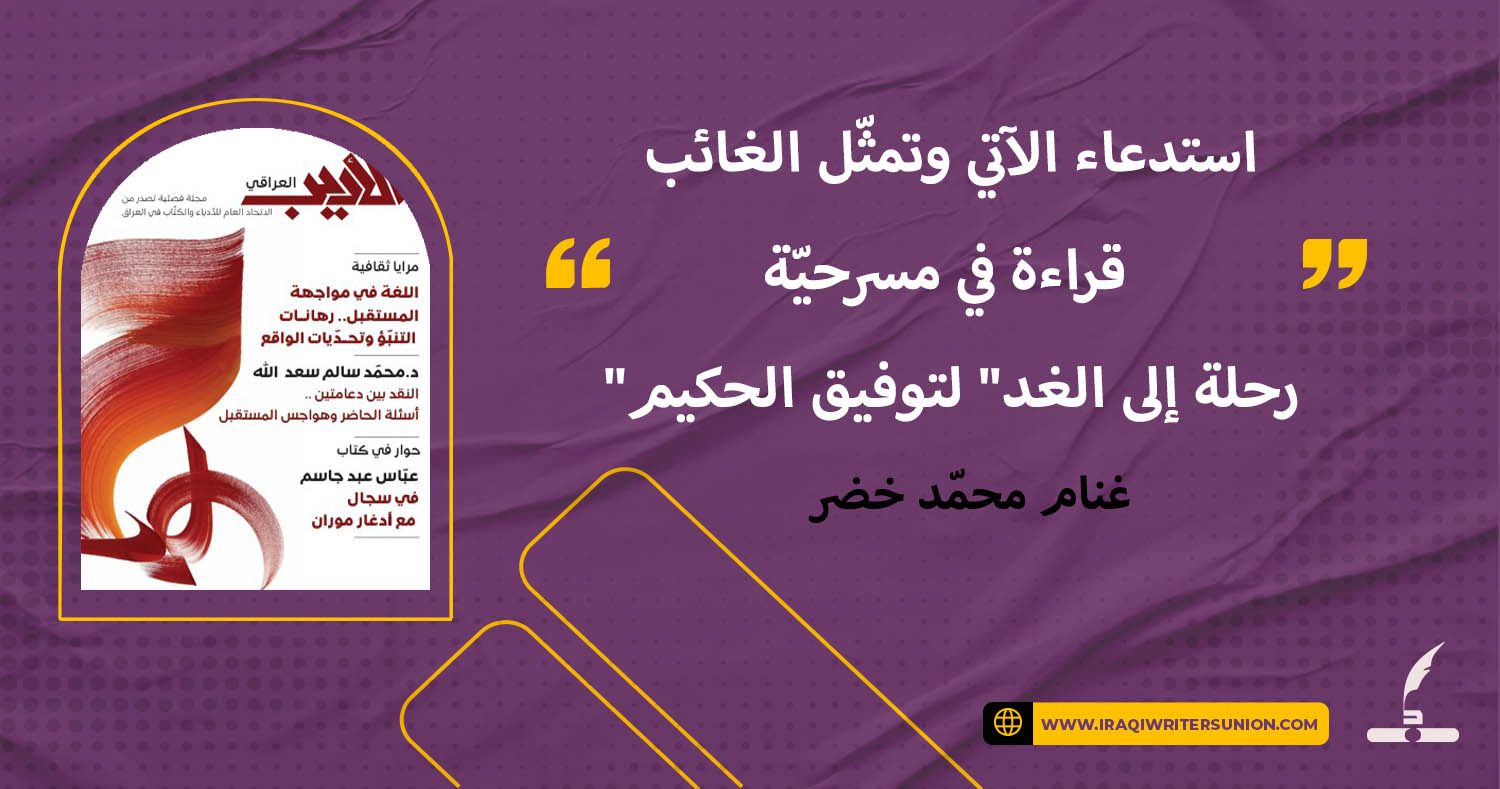

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي