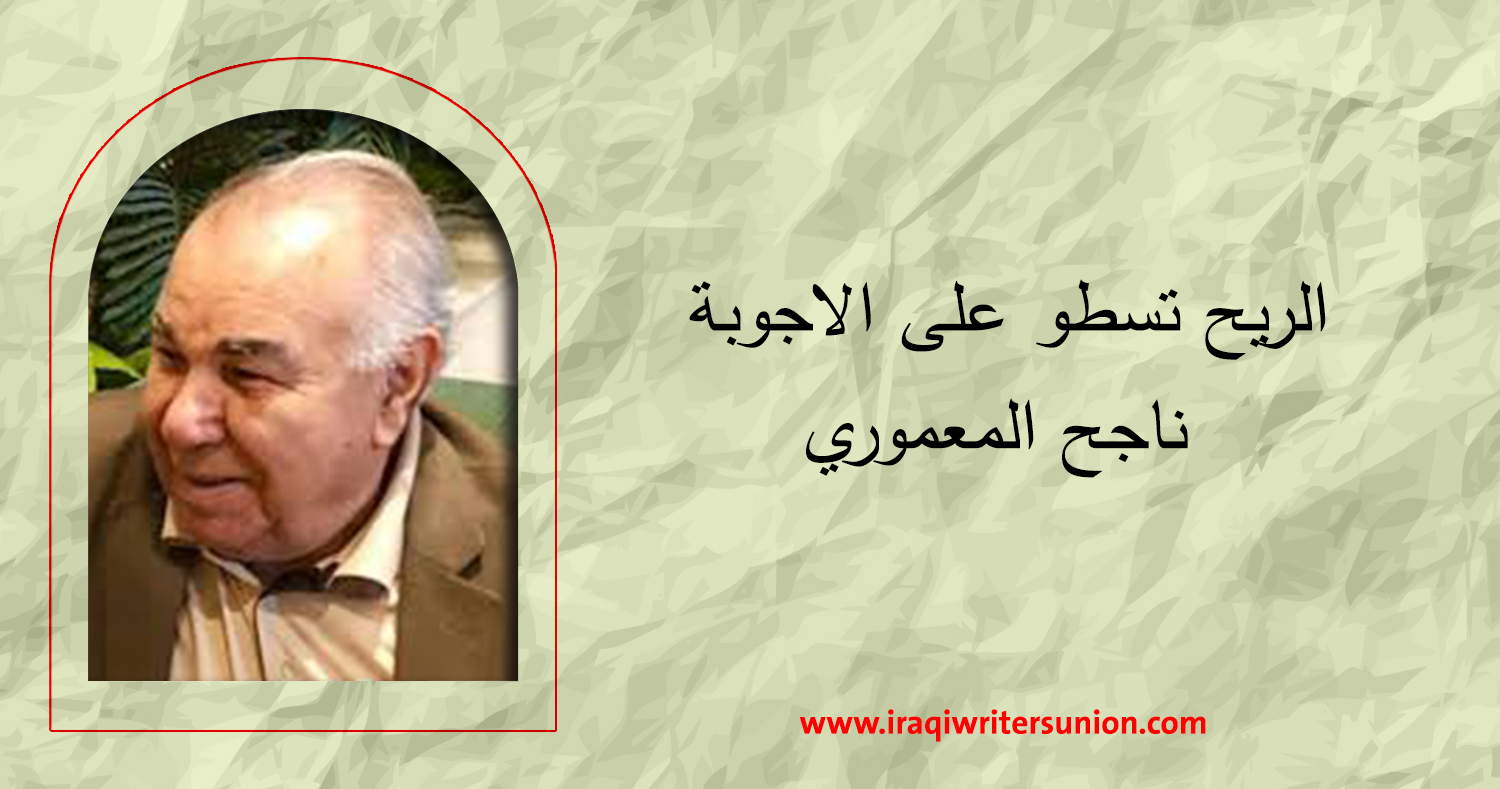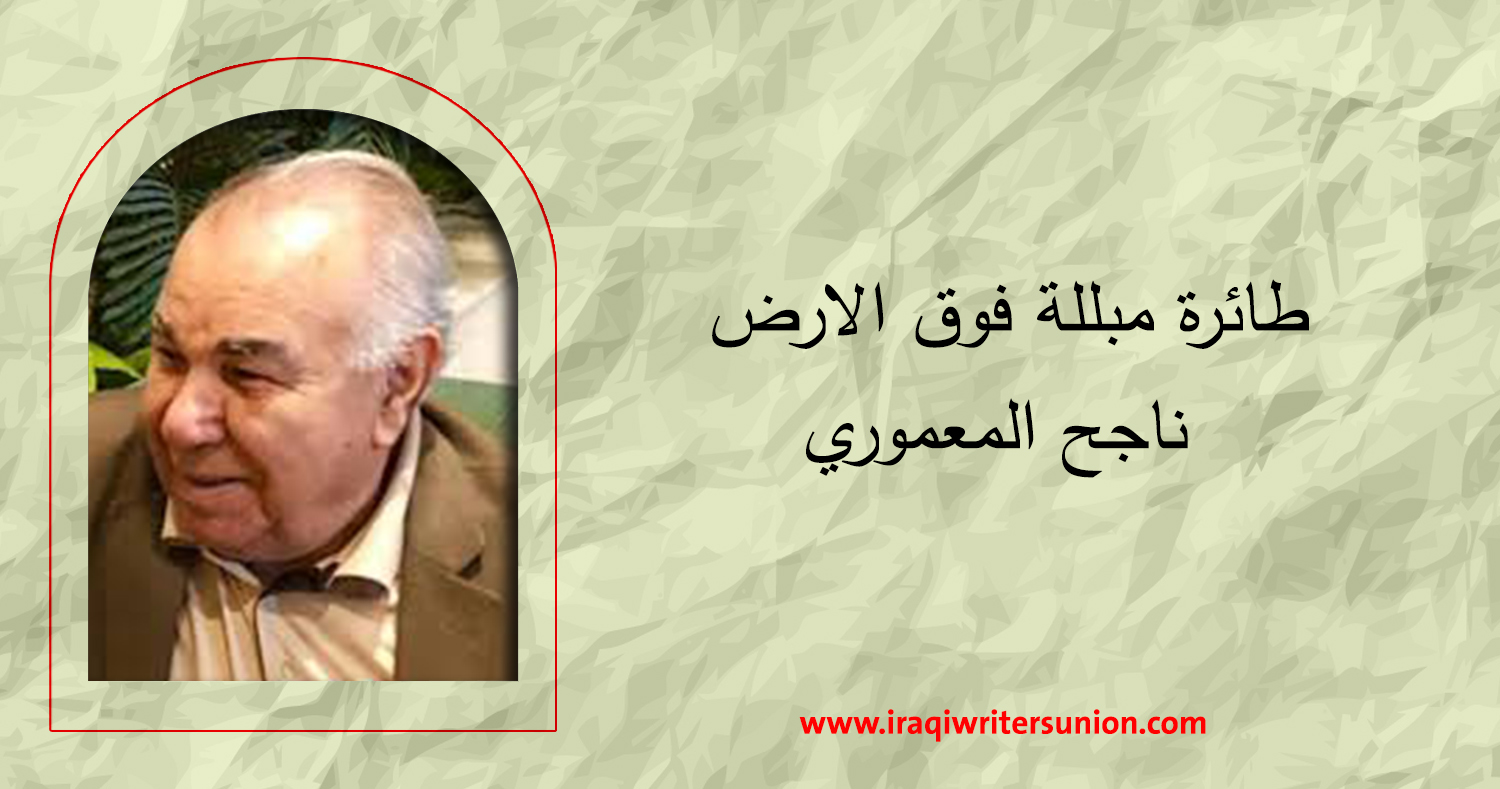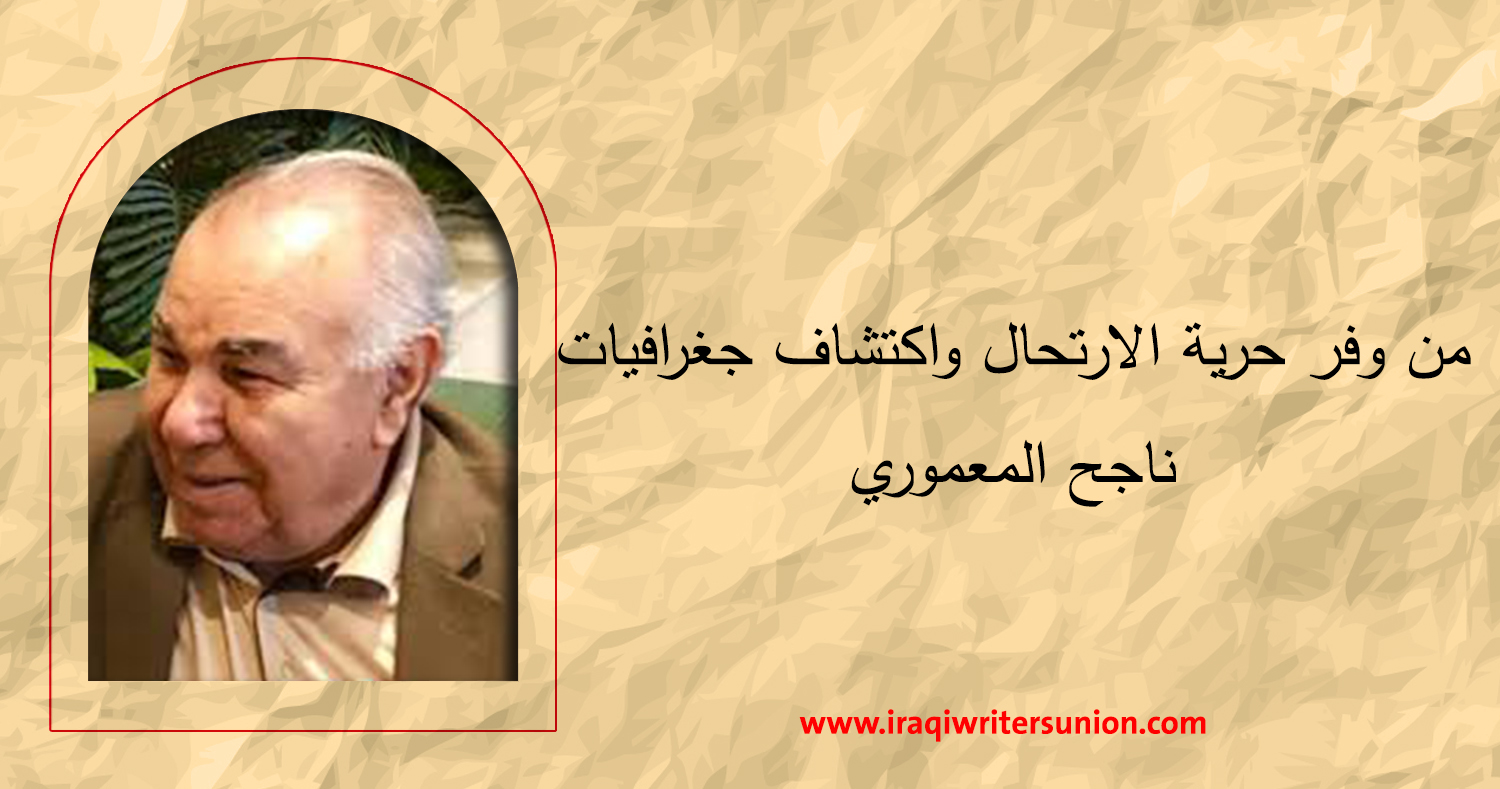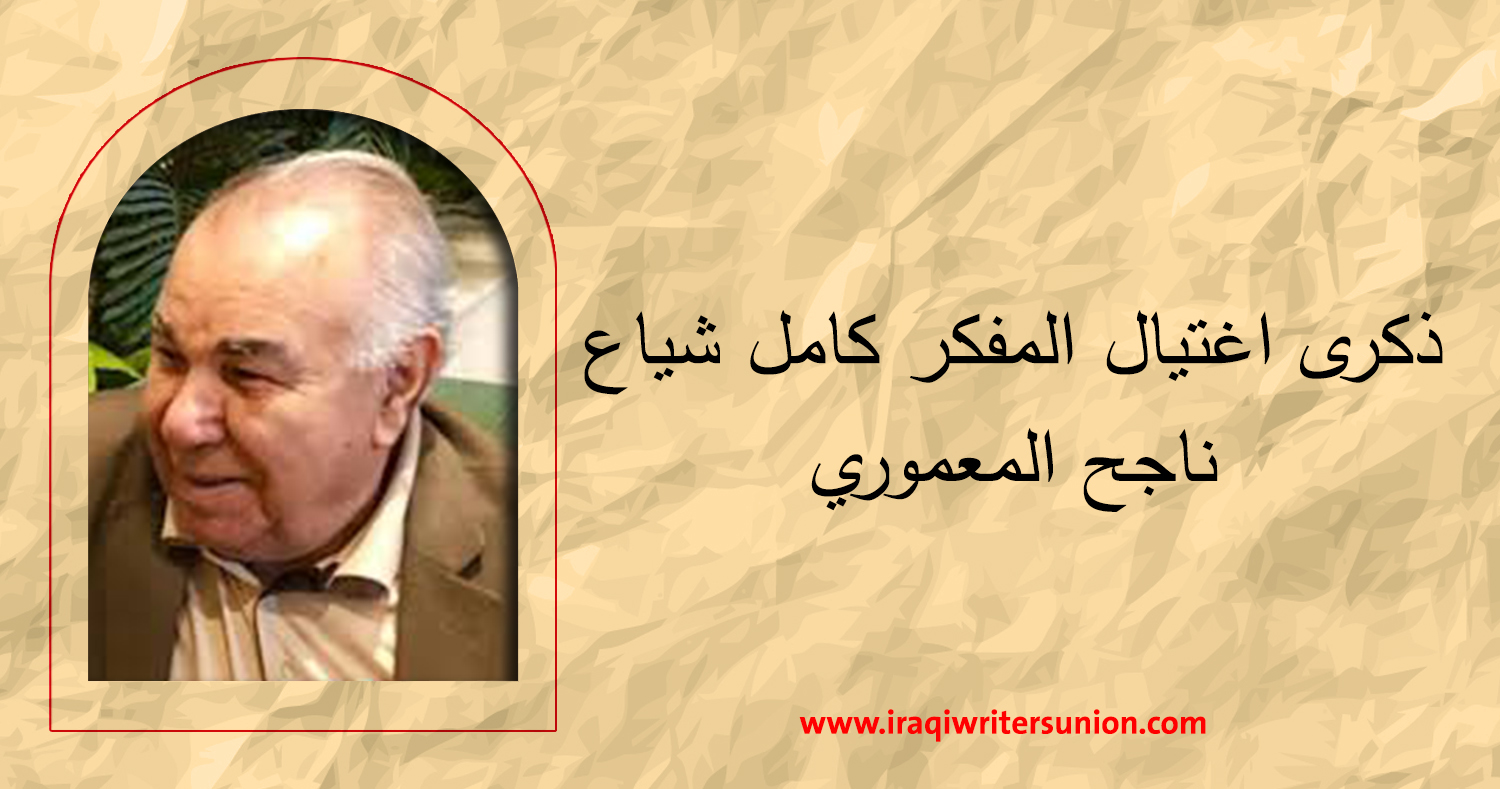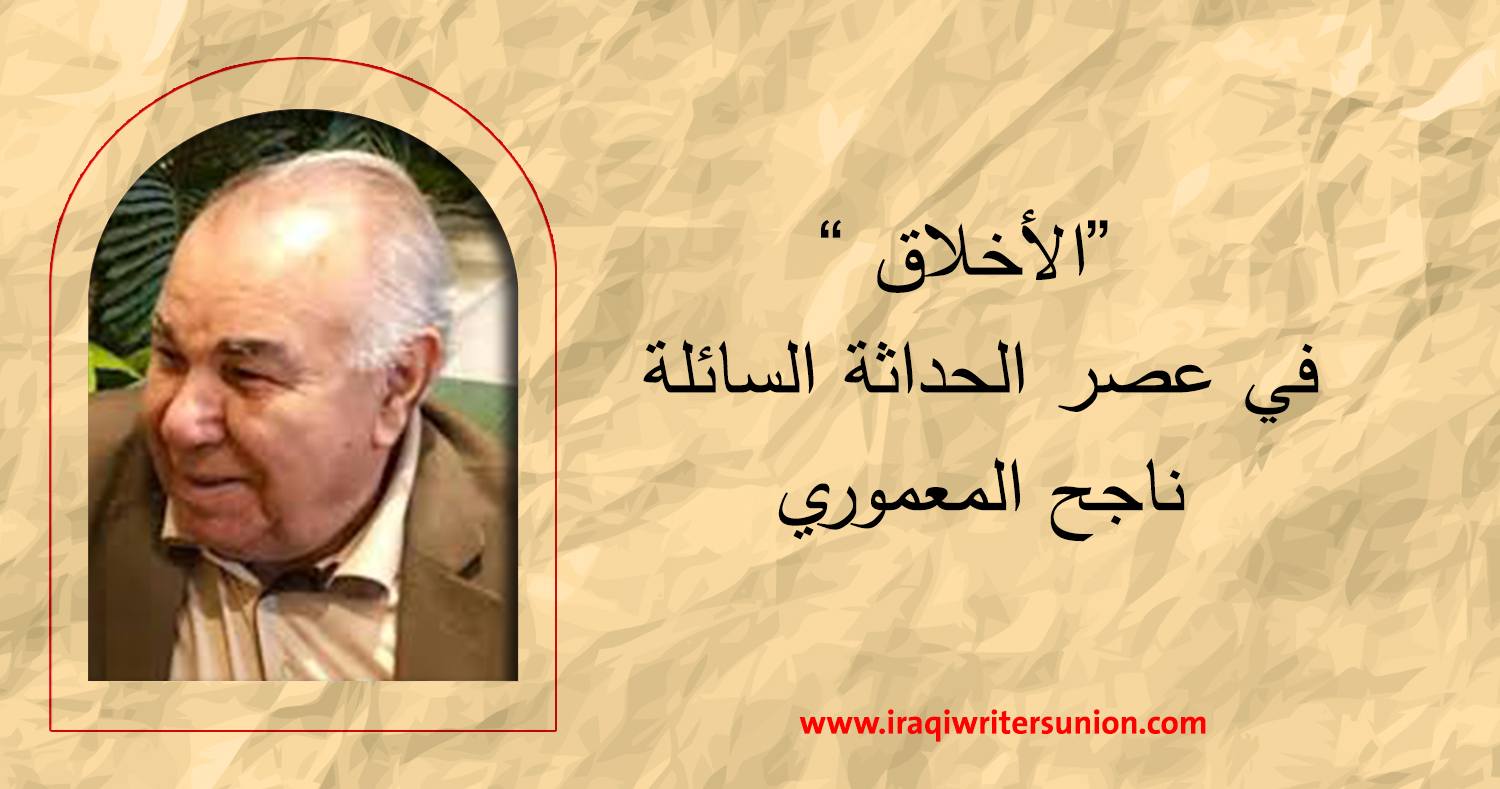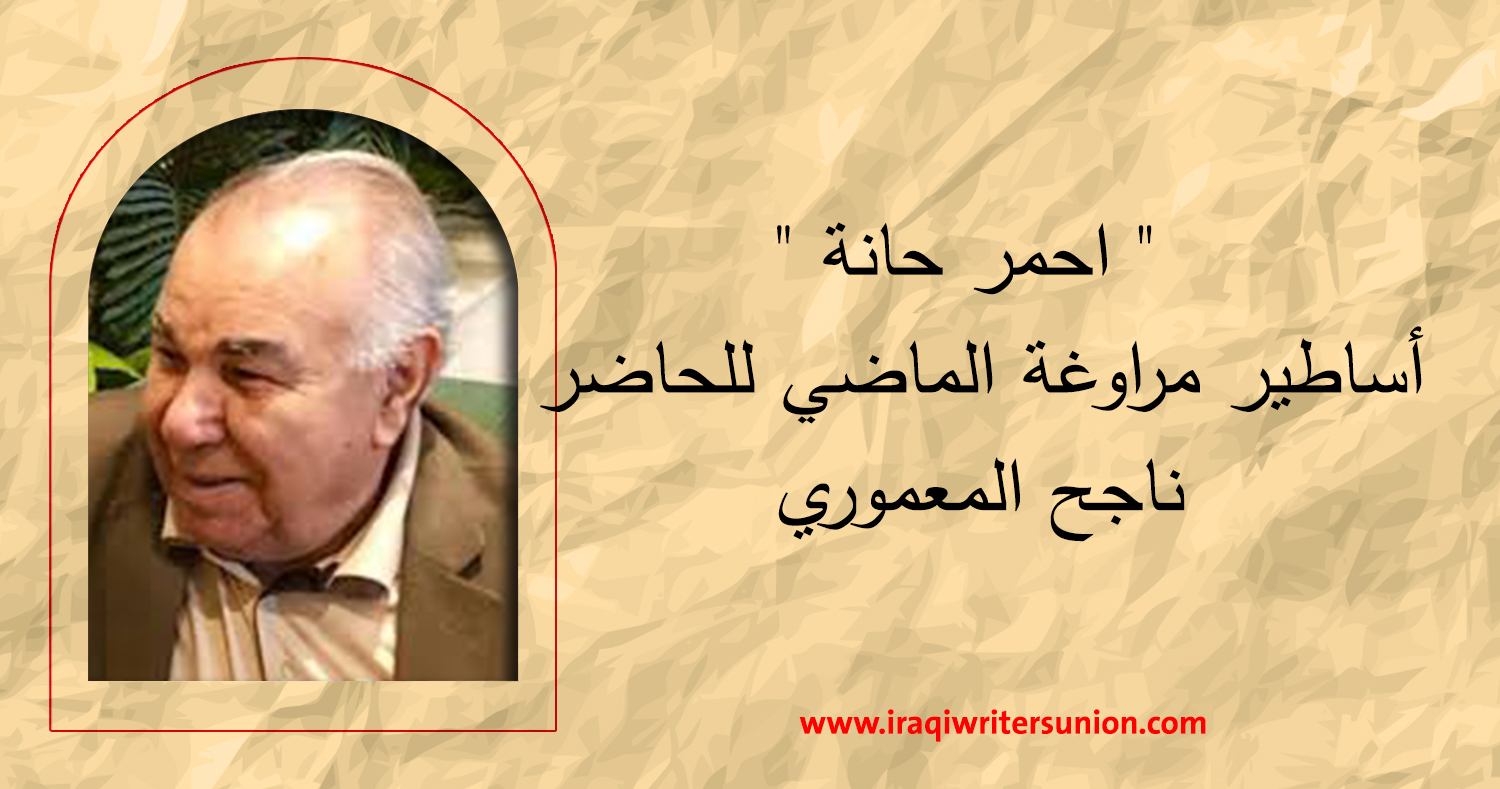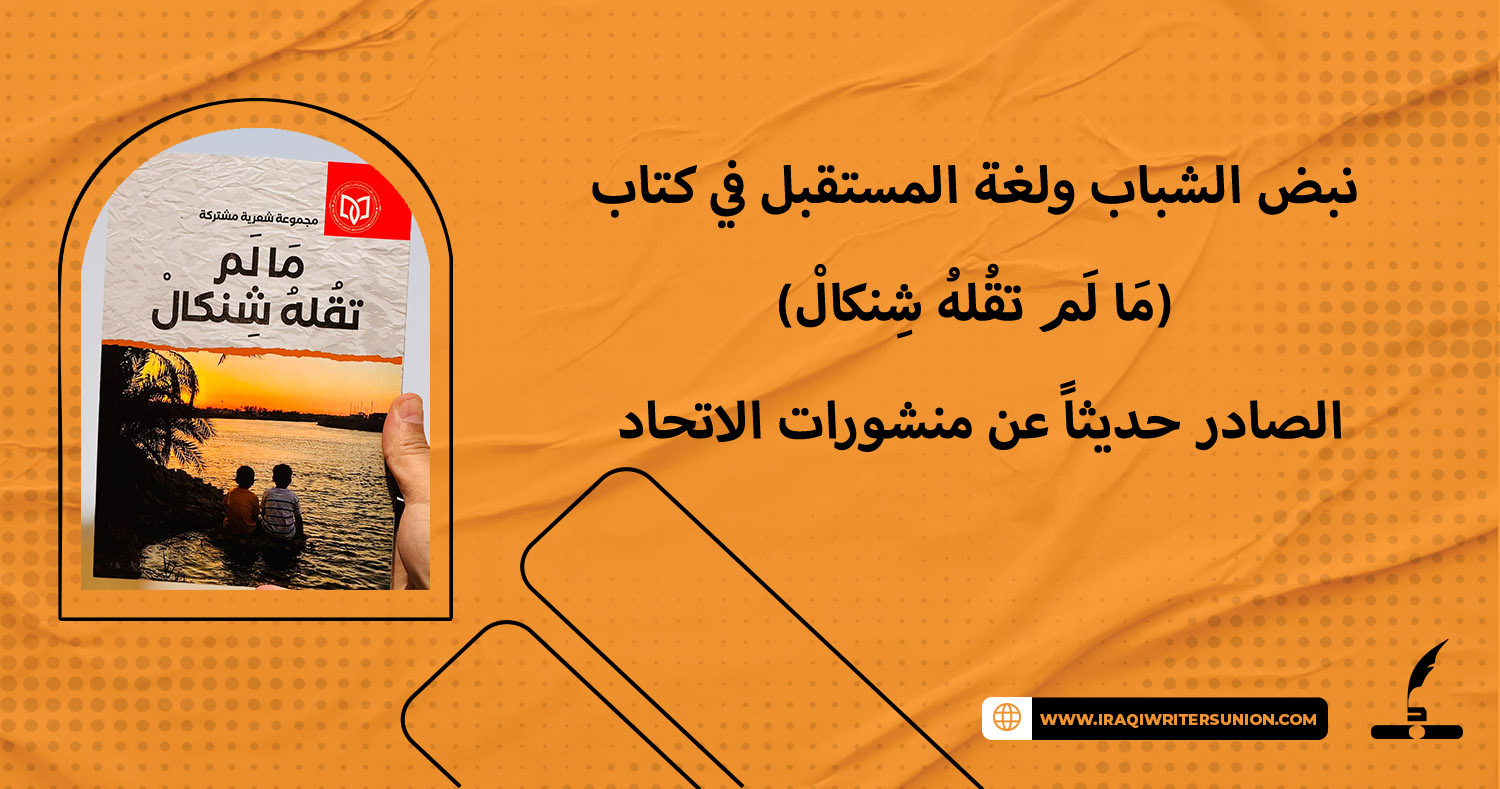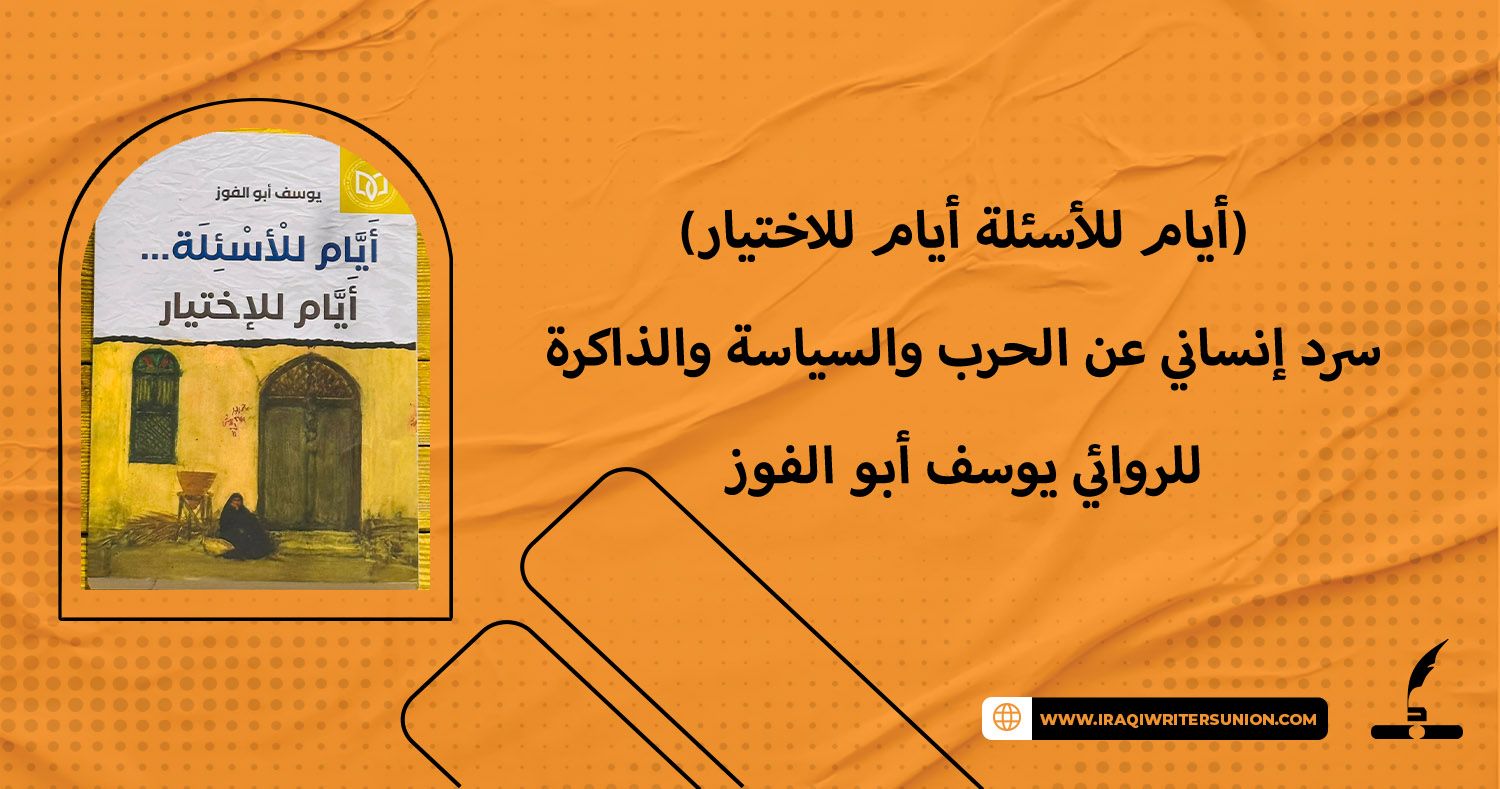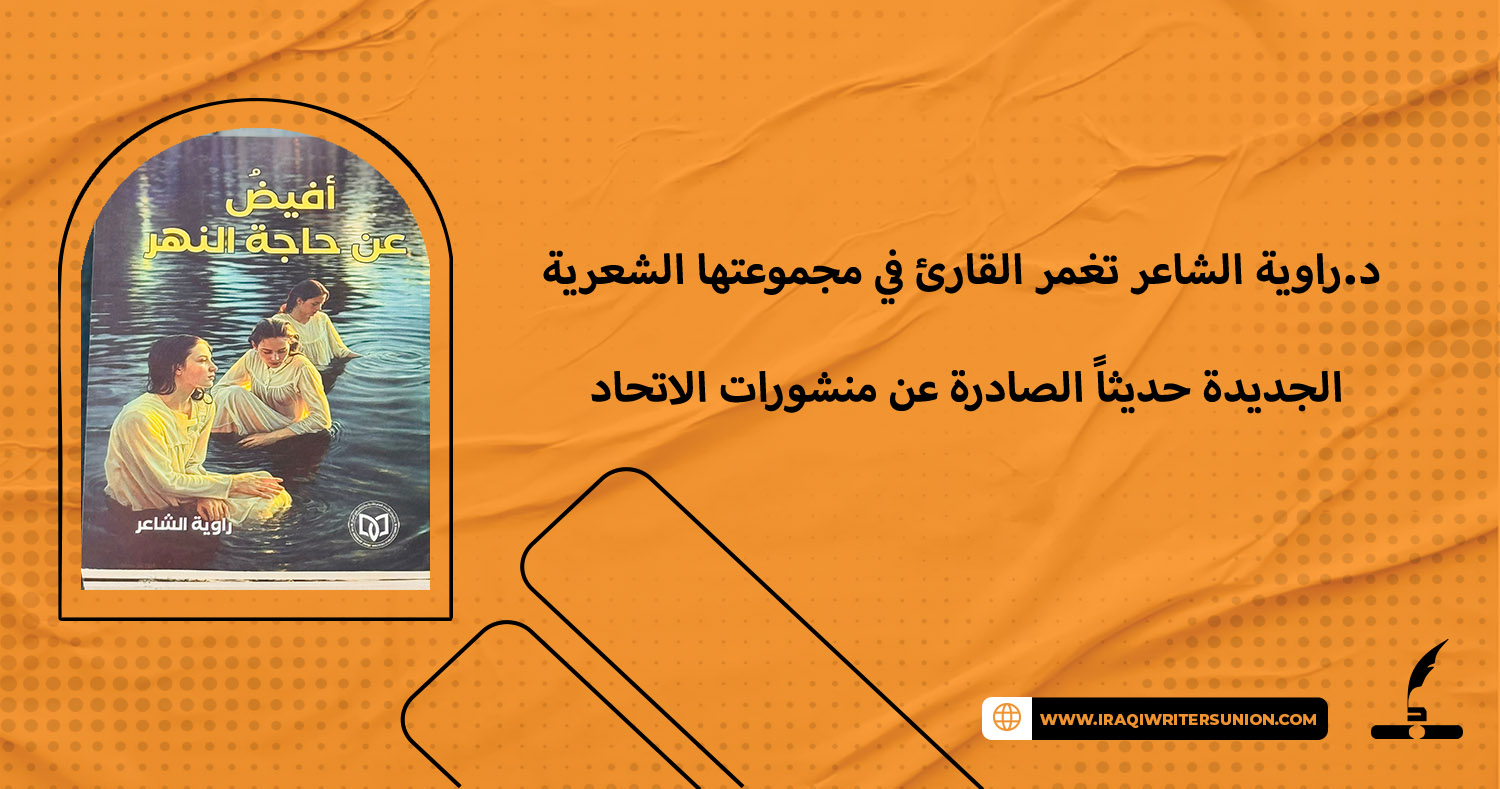الشِّعر الصوفيّ اليوم!
عبد الله قره داغي
هل يمكن الحديث عن وجود شعرٍ صوفيّ في الأدب العربيّ اليوم ؟. هذا سؤالٌ أصعب مّما يبدو في الوهلة الأولى ، لأن حكمًا كهذا يستلزم ، إن توخَّينا الأمانة ، الاطِّلاع على ما هو منشور، أو ما يُنشَر يوميًّا من قصائد وقطع شعريّة في مجمل المطبوعات العربيّة الصادرة داخل الأقطار العربيّة أو خارجها. وهذا أمرٌ لا يمكن الوفاء به رغم أن الانترنت قد يَسَّر عمليّة الوصول إلى أكثريّتها. فضلاً عن إمكانيّة وجود شعراء لا ينشرون قصائدهم ، كما كان الشاعر البصريّ محمود البريكان يفعل. ولئن لم يكن البريكان صوفيًّا ، فإن الشعراء الصوفيّين الحقيقيّين يردعهم عن النشر خوفُهم من أن يكون ذلك سبيلًا إلى الشهرة التي يعتبرونها من مظاهر حبّ الدنيا المذمومة التي ينبغي عليهم تجنّبها بحرص شديد. وقد ذهب بعض شيوخ الطائفة إلى أن آفة الآفات هي الشهرة . يعود ذلك إلى أنها التي تشكّل في نظرهم نوعًا خفيًّا من المراءاة لأنها تتوخّى الجاه بين الناس ، وتُبعِدُ طالبَها عن حبّ الله الذي هو الغاية النهائيّة للتجربة الصوفيّة.
غير أن حقيقة اُخرى تقف بالضدّ من هذه الحقيقة تمامًا . فقد خلَّفت رابعة العدويّة (أمّ عمرو، 100 – 180 هـ ) ، كما خلَّفَ الحلّاج ( أبُو عبدِ الله وأبُو المُغيث الحُسَين بن منصُور الحلَّاجُ التُستَري البيضاويُّ 244 – 309 هـ ) ، ابن عربيّ (مُحيِي الدين محمّد بن عليّ بن محمّد بن عربيّ الحاتميّ الطائيّ الأندلسيّ ، 554 – 638 هـ ) ، ابن الفارض ( أبو حفص شرف الدين عمر بن عليّ بن مرشد الحمويّ ، 576 – 632 هـ ) ، وغيرهم أبياتًا متفرّقة ودواوين شعر، لكنها لا تقاس بما نراه في الأدب الفارسيّ ، رغم أن رابعة العدويّة والحلّاج أقدم بكثير من الشعراء الذين كتبوا بالفارسيّة. فالشاعر الإيرانيّ الروميّ (مولانا جلال الدين محمّد البلخيّ ، 604 – 672 هـ ، 1207 – 1273 م ) ، الذي تتقطّر شعره عذوبة ورقّة ، يمتلك ثلاث مجاميع كتب كبيرة ، اثنان منهما ديوانان شعريّان هما (مثنويّ معنويّ ، بالفارسيّة ، المثنويّ المعنويّ بالعربيّة) ، ( ديوان شمس ، البالغ تعداد أبياته 39,903 بيتًا فارسيًّا، 436 بيتًا عربيًّا، وثلاثة أبيات تركيّة ) ، وكتاب (فيه ما فيه) المنثور، غير أنه يتضمّن عدّة أبيات ، منها 32 بيتًا فارسيًّا و6 أبيات عربيّة. ولكن رغم أبياته القليلة ، فقد استخدم فيها أبحر (المضارع ، الخفيف ، المنسرح ، الهزج بأنواعه ، المتقارب ، الرمل بأنواعه ، ووزن الرباعي مفعول مفاعيل مفاعيل فعل). إلاَّ أن بقيّة الشعراء الإيرانيّين ليسوا كذلك. فالشاعر أبو سعيد أبو الخير النيسابوريّ ، أبو سعيد بن أبي الخير فضل الله بن أحمد بم محمّد بن إبراهيم المِيْهَني، 375 – 440 ه ـ، عالم القرنين الرابع والخامس الهجريين، وصديق الكثير من الشخصيّات الفكريّة المؤثّرة ، ومنهم ابن سينا ، الذي يعتبره أكثر الباحثين واضع أسس التصوّف الإيرانيّ ، فلم يُخَلِّف ، كما أحصت المؤسّسات المهتمّة بالأمر، سوى 1588 بيتًا فارسيًّا، و4 أبيات عربيّة. أمّا الشاعر فريد الدين العطّار (أبو حامد ، وأبو طالب ، محمّد بن إبراهيم بن مصطفى بن شعبان ، 540 – 618 هـ ) ، وهو صاحب منظومة (منطق الطير) الأكثر شهرة من بين جميع المنظومات الصوفيّة ، فقد فاق حتّى الروميّ كثيرًا في غزارة إنتاجه ، إذ ترك ما لا يقل عن 21 مُؤَلَّفًا ضمَّ بين دفّتيه 95,015 بيتًا استخدم فيها من بحور (الهزج ، الرمل ، الخفيف ، المضارع ، الرمل ، المجتث ، السريع المطويّ ، المنسرح ، المتقارب ، المقتضب ، البسيط ، ووزن الرباعي أيضًا ). فما الذي يُفَسِّر هذا الانتاج الهائل من الشعر الصوفيّ لهؤلاء وللعديد من عمالقة الشعر الصوفيّ الفارسيّ في عصر السلاجقة : شهاب الدين أديب صابر، المتوفّى سنة 542 هـ ، أوحد الدين كرماني 559 – 635) ، الذي كان معروفًا بصلته القويّة بمحيي الدين ابن عربيّ ونقل أفكاره إلى الفارسيّة ، أنوري ( أوحد الدين عليّ بن محمّد الخافاراني)، السنائي الغزنزي (أبو المجد بن مجدود بن آدم ، 467 – 529 هـ ) وهو من الشعراء غزيري الإنتاج ، كما أنّه مبتكر فنّ الغزل ( وليس غرض الغزل) في الشعر الفارسيّ ، والذي طغى على كلّ الشعر الصوفيّ بعده ، سوزني سمرقنديّ ، المتوفّى 562 أو 569 هـ، عمعق البخاريّ المتوفّى إّما في 1542 أو 543، الفلكيّ الشيروانيّ ، المتوفّى بين 577 و587، القوامي الرازي ، من القرن السادس الهجري أيضًا ، مجير الدين البيلقاني ، المتوفّى 586 ، مسعود سعد سلمان ، 438 – 518 هـ ، مهسَتي گَنجوي ، المولودة بمدينة گنجه شمال غرب آذربايجان ، ومن مدن القفقاز التاريخيّة ، المتوفّاة عام 539 هـ ، التي تعتبر الشاعرة التالية لعمر الخيّام في الرباعيّات ، رغم أنها تركت ، حسب أكثر المصادر موثوقيّة ، 61 رباعيّة فقط ، ولم تكن صوفيّة ، لكنّها كانت على اطِّلاع جيّد بالتصوّف ، وابن مدينتها نظامي گنجوي المتوفّى سنة 587 هـ ، وغيرهم كثير.
فيما بعد ، في القرن السابع الهجري ، برز عمالقة التصوّف سعدي الشيرازيّ ، المُختَلَف على ولادته ووفاته بين 585 – و690 ، و615 – 695 هـ ، رغم أن التاريخ الأقرب إلى الصواب لأن كتّاب سِيَرِه يذهبون إلى أنه عاش ما يقرب من المائة عام أو أكثر، وكان من منسوبي الطريقة السهرورديّة وشيخه شهاب الدين عمر السهرورديّ. يعتبر سعدي في الأوساط العالميّة شاعر القمّة دون منازع ، كما ذهب إليه المستشرق (آرثر جون آربري Arthur John Arberry 1905 – 1969 م) ، شمس تبريزي ، 582 – 645 ه ـ، الذي أثّر ذلك التأثير الكبير في جلال الدين الروميّ وجعل منه ذلك الشاعر الفذّ ، الروميّ نفسه ، وغيرهم كثير.
في القرن الثامن الهجري اعتلى حافظ الشيرازي 727 – 792 هـ ، المعروف لدى الإيرانيّين حتّى اليوم بألقاب عديدة منها، لسان الغيب ، ترجمان الأسرار، ناظم الأولياء ، ولسان العُرَفاء ، أي لسان الصوفيّة ، لأن التصوّف يُعرَفُ في إيران بـ "العرفان" ، كما كان صاحب التأثير الأكبر في الشعر الفارسيّ بعده حتّى اليوم ، وفي الشاعر والفيلسوف الألمانيّ يوهان يوهان ڤولفگانگ گوته Goethe Johann Wolfgang von 1749 – 1832) الذي أصدر ديوانًا بالكامل تحت تأثير حافظ سمّاه بـ (الديوان الشرقيّ لشاعر غربيّ) ، المترجم إلى الإنگليزيّة من قبل إدوارد دُودن Edward Dowden تحت عنوان West-Easter Divan، على الأقل في عام 1913. والقائمة تطول.
ما كان ينبغي قوله هو أن هذه الحقائق من شأنها أن تُقَوِّضَ الفرضيّة التي سبق ذكرها ، أي أن نعتبر حرص الصوفيّة على تحاشي الشهرة يؤدّي إلى الامتناع عن نشر قصائدهم. غير أن هذا الأمر حقيقيّ لدى الصوفيّة ، فما الذي يمكن أن يُفَسِّر وجود هذا الكمّ الهائل من الموروث الصوفيّ ، شعرًا ونثرًا ، الممتدّ على عدّة قرون ، والشاغِلِ مئات المجلّدات القيّمة ؟. شخصيًّا أميلُ إلى أن رسالةً ما كان يحرصُ الصوفيّةُ الايرانيّون إيصالَها كانت وراء تلك الروحيّة المُبدِعة ، والتي تتجسّد في أنَّها حملت معاني إنسانيّة لم تكن مطروقة في الآداب السابقة ، المعاصِرة ، بل وحتّى اللاحقة لها. فالحكايات التي ضمَّتها تلك النتاجات ، ومنها المطروحة في (منطق الطير) مثلًا ، تبحث عن مخارج تُنقِذُ الإنسان من مآزِقَ أوقعته فيها ظروفه الخاصَّة. كالرجل الذي يقوده جلاّدٌ ليضرِبَ عنقه ، لكنّ زوجة الجلّاد ترأفُ به ، في غفلة من الجلّاد ، وتعطيه كسرة خبز، وحين يرى الجلّاد كسرة الخبز في يده ، يسأله من أين أتى بها، يُجيبُهُ بأنَّ زوجته هي التي أعطته إيّاها ، فُيبادِرُ الجلّادُ إلى القول : "ما دمت قد أكلت من زادِنا ، فقد أصبح دَمُكَ حرامًا علينا. كما تضمّ تلك الحكايات والقصائد نصائِح للملوك ومن يمتلكون زمام أُمور الناس في كيفيّة التعامل مع الرعيّة. ثمّة بيت للشاعر سعدي الشيرازيّ يمتلك مغزى خاصًّا، يقول فيه:
به مردی که ملک سراسرْ زمین
نیرزد که خونی چکد بر زمین
أي "قَسَمًا، فإن امتلاك أملاك الأرض كُلّها لا تستحقُّ أن تُراقَ في سبيلِها قطرة دم واحدة". وهذه النقطة هي من أكثر المسائل جوهريّة ، ذلك لأن الدُّنيا ، مُغرياتها ، مفاتِنَها، وبالتالي المنافسةَ عليها هي أصل الفتنة ، ولذلك يحرص الصوفيّةُ على إظهار مخاطرها. وقديمًا قال الشاعر عن الصوفيّة:
إن لله عبــادًا فـِطَنا طلّقوا الدّنيا وخافـوا الفِتَنا
نظروا فيها فلمّا علموا أنها ليـست لـحَيٍّ وطنا
جعلوها لجّة واتّخذوا صالح الأعمال فيها سَفَنا
ورغم أن هذه الأبيات تُنسَبُ في مصادر عديدة ، ومنها ديوانه المجموع ، إلى الإمام الشافعيّ (محمّد بن إدريس، 150 – 204 هـ) ، إلاّ أنها تُنسَبُ إلى عديدين غيره أيضًا. وفي كلّ الأحوال ، فإنها تُمَثِّلُ جوهر النظرة الصوفيّة إلى الدنيا. وفي الحقيقة ، فقد ندر في التاريخ الإسلاميّ من أدار ظهره للدنيا بحقّ من غير الصوفيّة ، إلاّ الزّهاد ، من أمثال الحسن البصريّ (الحسن بن يسار 21 – 110 هـ) ، أو الوكيع ابن الجرّاح ، شيخ الشافعي الذي كان معجبًا أشدّ الإعجاب بالفضيل بن عياض ، وقد قال يوم وفاته: "ذهَبَ الحزن عن الأرض" ، وأئمّة الفقه ، ونفر قليل مّمن استطاعوا أن يلجموا الدافع الداخليّ نحو الاستزادة من ملذّات الدنيا.
والآن ، هل يمكن أن نتوقّع أدبًا صوفيًّا ، والمقصود هنا باللغة العربيّة ، يمكن أن يكون له شأن مستقبلًا ؟. رغم أن الإجابة سلبًا أو إيجابًا على هذا السؤال قد تُجانب الواقع ، لأننا لا يمكن أن نرى في الحقيقة أمثلة فعليّة تؤكّد على وجود أرضيّة صلبة لها من ناحية ، وأننا قاصرون في مطالعة جميع النصوص المنشورة في هذا المجال من الناحية الأُخرى. وبالمقابل ، ثمّة لغط كبير وزخم من مؤلّفات عديدة ، بعضها ملبوسٌ بلباس الأكاديميّة للأسف ، ويُصدِر أحكامًا قطعيّة لا يجد نفسه معنيًّا بإثباتها بنصوص دامغة. ولأنني لا أُريد أن تكون مقالتي هذه بحثيّة ، سأتحاشى الإشارة إلى الكثير من المصادر، لكنني لست قادرًا على تجاوز مسائل مهمّة فيها. على سبيل المثال ، نجد في بحث التخرّج من الجامعة ، المعنون (الرمز الصوفيّ في شعر عبدالوهاب البياتي: قصيدة عذابات الحلّاج نموذجًا) ما يلي: "تنقسم تجربة البياتي الشعريّة إلى مرحلتين ، وتنقسم المرحلة الأولى إلى ثلاثة أقسام:
– البيان الثوريّ اللا منتمي: في دواوينه "أباريق مهشّمة" و"مسافر بلا حقائب"....
البيان الثوريّ المنتمي: في دواوينه "المجد للأطفال والزيتون" و"أشعار في المنفى" و"عشرون قصيدة من برلين"، لأن قصائد هذه الدواوين هي أشعار تتعلّق بتيّار الواقعيّة الاشتراكيّة.
- تيّار المتصوّف الثائر: حيث خرج من مرحلة القناع التي سيطر عليها الحلّاج في التصوّف العقليّ ، ودخل في مرحلة وحدة الوجود التي طبعها ابن عربيّ بطابعه ومفرداته ، حيث نجد توتّرًا بَيِّنًا بين الظاهر والباطن في التصوّف القلبيّ ، وتتجسّد هذه المرحلة من خلال دواوينه: "كتاب البحر" و"سيرة ذاتيّة لسارق النار" و"قمر شيراز".
المرحلة الثانية هي مرحلة البياتي الصوفيّ العاشق، وهي مرحلة الفناء، فقد توفّيت نادية ابنته الكبرى ، وتهدّم العراق وطنه ، وألفى نفسه وحيدًا بلا أمل ولا مال ولا أهل ، ومن دواوينه في هذه المرحلة "بستان عائشة"، و"كتاب المراثي": وتحوّلات عائشة ، يوسف 2012 – 2013 م ، 26. ويبدو أن كاتبتها (جقاوة يوسف) لم تهمل مصادر التصوّف الأساسيّة ولغته الخاصَّة ومفرداته وأُسُسَه فحسب ، بل وتجاوزت حتّى أبسط مقوّمات الدراسة العلميّة التي ينبغي أن يكون التلميذ في المرحلة الجامعيّة مُلِمًّا بها.
سوف أتفحّص هنا، أوّلًا ، مسألةً اعتبرتها الكاتبة أحد أسباب ما أسمته بـ "مرحلة البياتي الصوفيّ العاشق" وهي موت ابنته نادية ، وسأختار من قصيدة "مصباح علاء الدين" مخاطبته لابنته الكبيرة نادية التي تُوفّيت ، والتي يفترض أن وفاتَها قد تركت تأثيرًا كبيرًا عليه ، وسوف أمتنع عن التعليق عليها ، تاركًا ذلك للقارئ الكريم ، لكنني أتبعها بأبيات من قصيدة ، تُعتبر نثريّة ، كتبها نزار قباني في رثاء ابنه. يقول البياتي:
صغيرتي .. نادية
رأيت في سماء عينيك
رأيتُ الله والإنسان
وجدت مصباح علاء الدين
والجزائر المرجان
قُلتُ لشِعري كُن!
فلبّى عبده
وكان
طفولتي رأيتُها تبحر في عينيك
في شِراع هذا الأبد السكران
أبحرت، فالرياح لا تنتظر الربّان
أبحرت فالوداع يا سماء عينيها
و يا طفولة الإنسان
غدًا بمصباح علاء الدين من جزائر المرجان
أعود يا صغيرتي ، إليكِ ، بالأزهار
من نهاية البستان
ويقول نزار قباني:
مُكَسَّرةٌ كجفون أبيك هي الكلمات
ومقصوصةٌ كجناح أبيك هي المُفردات
فكيف يُغَنِّي المُغَنِّي؟ ، وقد ملأ الدمعُ كُلَّ الدواة
وماذا سأكتب يا بُنَيّ ؟ وموتُكَ ألغى جميع اللُّغات!
ولا بأس أيضًا بذكر أبيات من قصيدته التي كتبها في رثاء زوجته:
شكرًا لكم..
شكرًا لكم..
فحبيبتي قُتِلت.. وصار بوُسعِكم
أن تشربوا كأسًا على قبر الشهيدة
وقَصيدتي اغتيلت..
وهل من أُمَّةٍ في الأرض..
إلاّ نحنُ، تغتالُ القصيدة؟
للتذكير فقط ، لم يكن نزار يومًا شاعِرًا صوفيًّا ، لم يَقُلْ ذلك عن نفسه ، ولم يذكُر أحدٌ شيئًا من هذا القبيل، حسب عِلمي.
أيًّا كان ، ولكي لا يكون الأمر من قِبَلي تجنّيًا عليها وعلى غيرها أيضًا ، فإنني أختار من ديوانه "بستان عائشة" ما يُفتَرَضُ أن يكون إلهامًا من الشاعر جلال الدين الروميّ:
النايُ يبكي: إنها الغابات تبحث ، سيدي ،
عن قوتها في باطن الأرض العميق.
الناي يَبكي: إنها ريح الخريف.
النايُ يبكي: إنها الأبراج داهمها الحريق
الناي: إنسان يُقاوم موته
موت الطبيعة والفصول ، ص 12
ولكي تكتمل الصورة سأقتبس من ديوان (المثنويّ المعنويّ) أبياتًا بنصوصها الفارسيّة وأُترجمها إلى العربيّة فيما بعد:
سِرِّ مَنْ أز نالهْ ِ مَنْ دور نيست
ليك چشم وگوش را آن نور نیست
آتش أست إین بانگ نای ونیست باد
هر کە آن آتش ندارد نیست باد
آتش عشق أست کاندر نی فتاد
جوشش عشق است کە اندر می فتاد
ليسَ سِرّي مُنفَصِلًا عن أنيني غيرَ أنَّ الأبصار تفتقر إلى النور اللازم لرؤيته
ليسَ الجسد منفصلًا عن الروح ، ولا الروح منفصلة عن الجسد غير أن رؤية الروح ليست مُتاحة لأحد.
نارُ العشق – المحبّة – هي المُضرَمة في الناي وليست نفخة هواء مجرّدة
فَليَكُن معدومًا – غير موجود – من لا يمتلك مثل تلك النار.. أو أن من لا يمتلك مثل تلك النار أشبه بالمعدومات منه بالموجودات.
ولا ضير من إيراد بيت لحافظ الشيرازيّ عن تصويره للحبيب ، إذ يقول:
تو خود چه لعبتي أي شِهسَوار شيرين كار
كه در برابر چشمى وغايب أز نظرى
أي "أيّ لُغزٍ تُجَسّده ، أنت بالذات ، يا بديع الصنع وآسِر الألباب إذ تكون تُقابِل عَينيَّ مُباشَرةً، غيرَ أنهما لا تريانك
هذه تراجم لنصوص رائعة لا يمكن أن أفيها حقَّها ، فالشعر يفقد الكثير من جماليّته حين يُتَرجَم. يقينًا ، لا يمكن الجزم ، نفيًا أو إثباتًا ، بإمكانيّة نهضة شعريّة صوفيّة في الأدب العربيّ. إلاّ أنني لا أعتقد بأن أيّة نهضة كتلك ، إن كانت ممكنة ، يمكن أن تكون من القوّة ما يؤهّلها لأن تتبّوأ مقعدًا حقيقيًّا لها في العالم. حتّى في إيران التي تمتلك ذلك الموروث الغنيّ الهائل ، لم يستطع شعراؤها المعاصرون ، بل وأكثرهم حضورًا ، من أمثال مهدي أخوان ثالث هوشنگ ابتهاج ، سهراف سپهري ، بل وحتّى محمّد رضا شفيعى كدكنى الذي يُعتبر باحثًا جيّدًا في الشعر الصوفيّ الكلاسيكيّ الإيرانيّ ، من طرح رؤية صوفيّة أصيلة مستندة إلى التجربة المعاشة. ولذلك ، فإنني أميل إلى أن نهضة كتلك ، في كلّ اللغات الشرقيّة ، تتطلّب وجود أرضيّة عمليّة صادقة وجيّدة ، وهي أرضيّة تتطلّب من أصحابها نذر أنفسهم بالكامل لها ، وهي ليست عسيرة في أيّامنا هذه فحسب ، بل ولا يمكن التأكّد من حقيقة وجودها أيضًا.












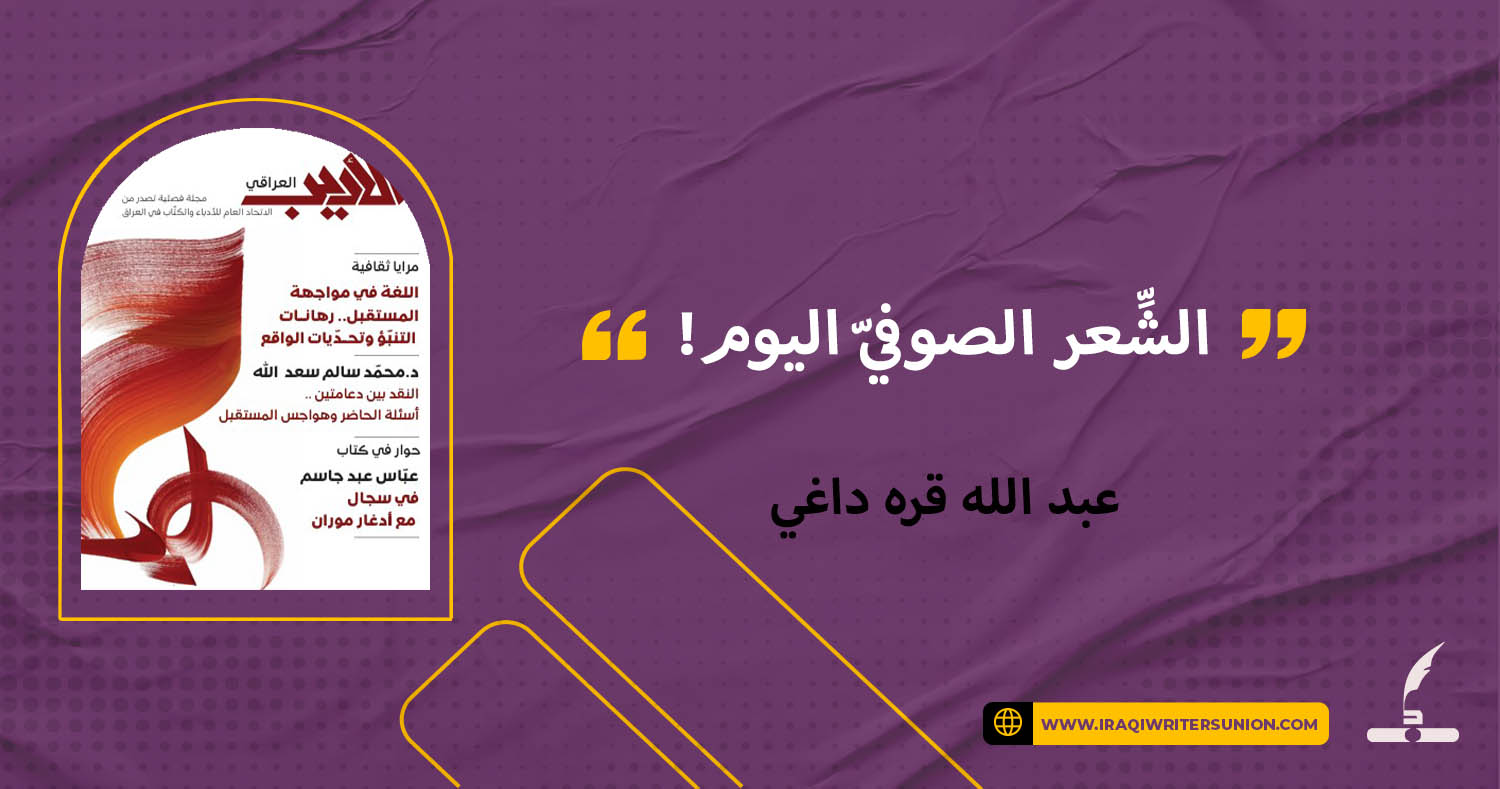



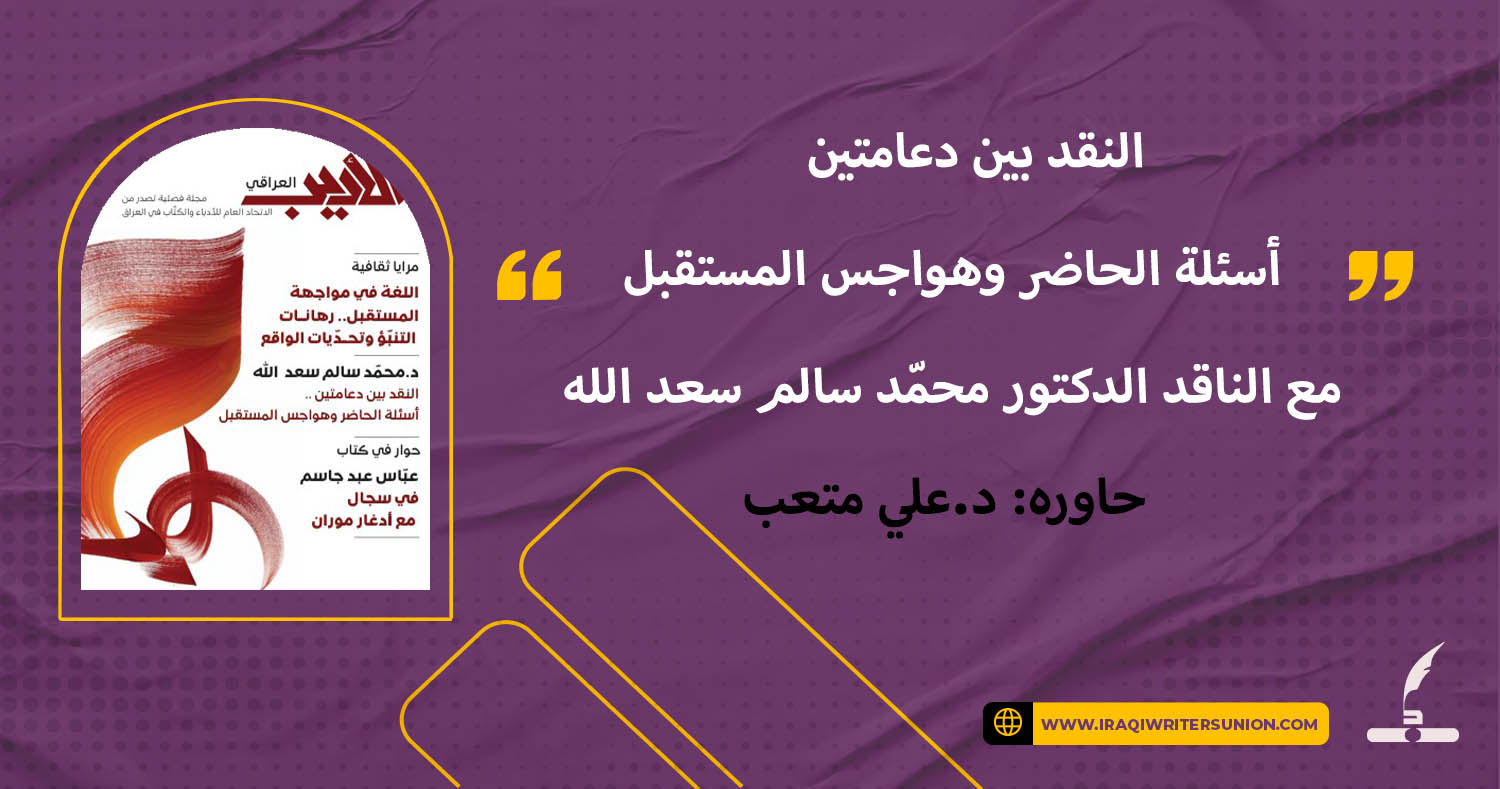
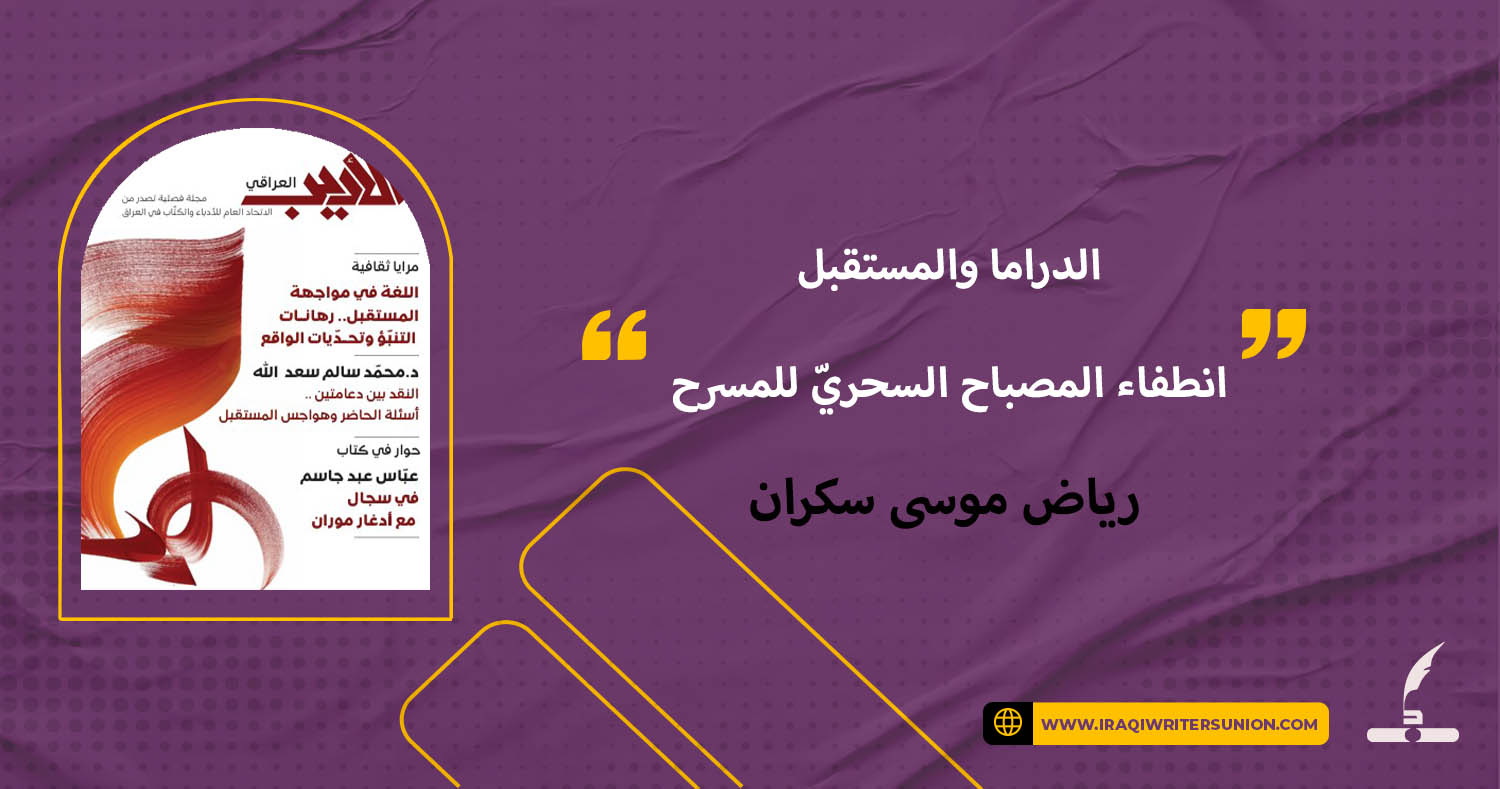

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي