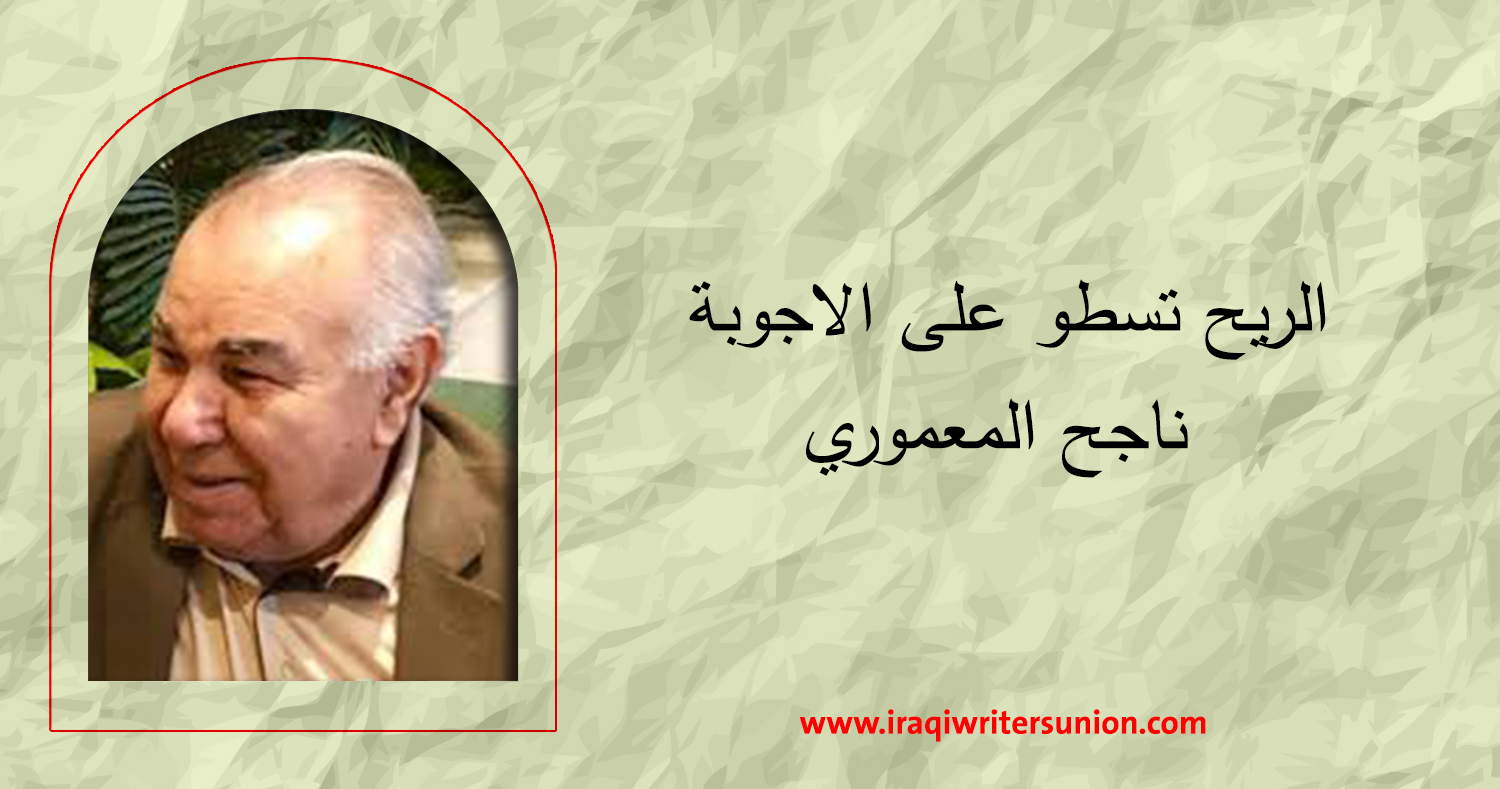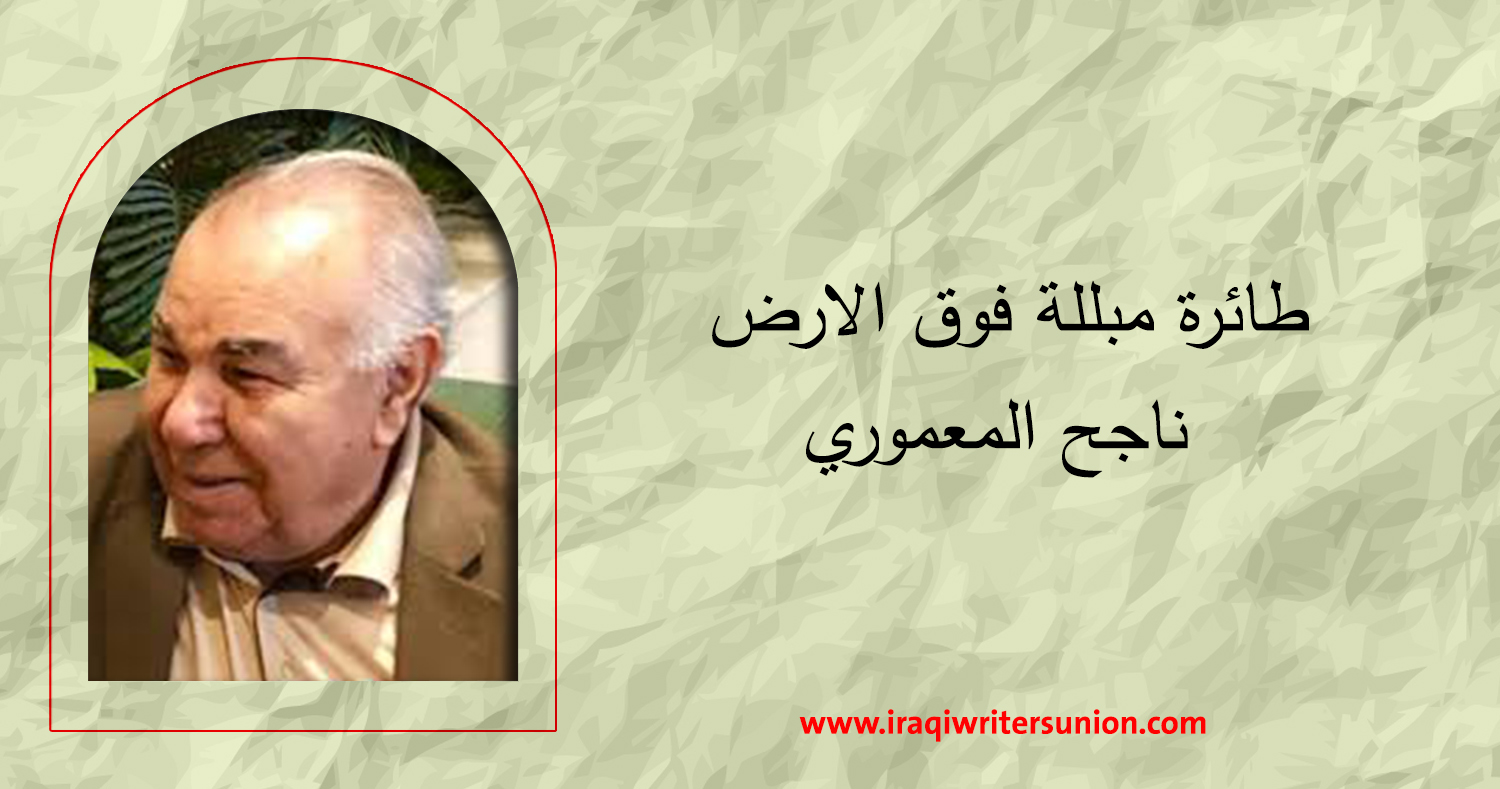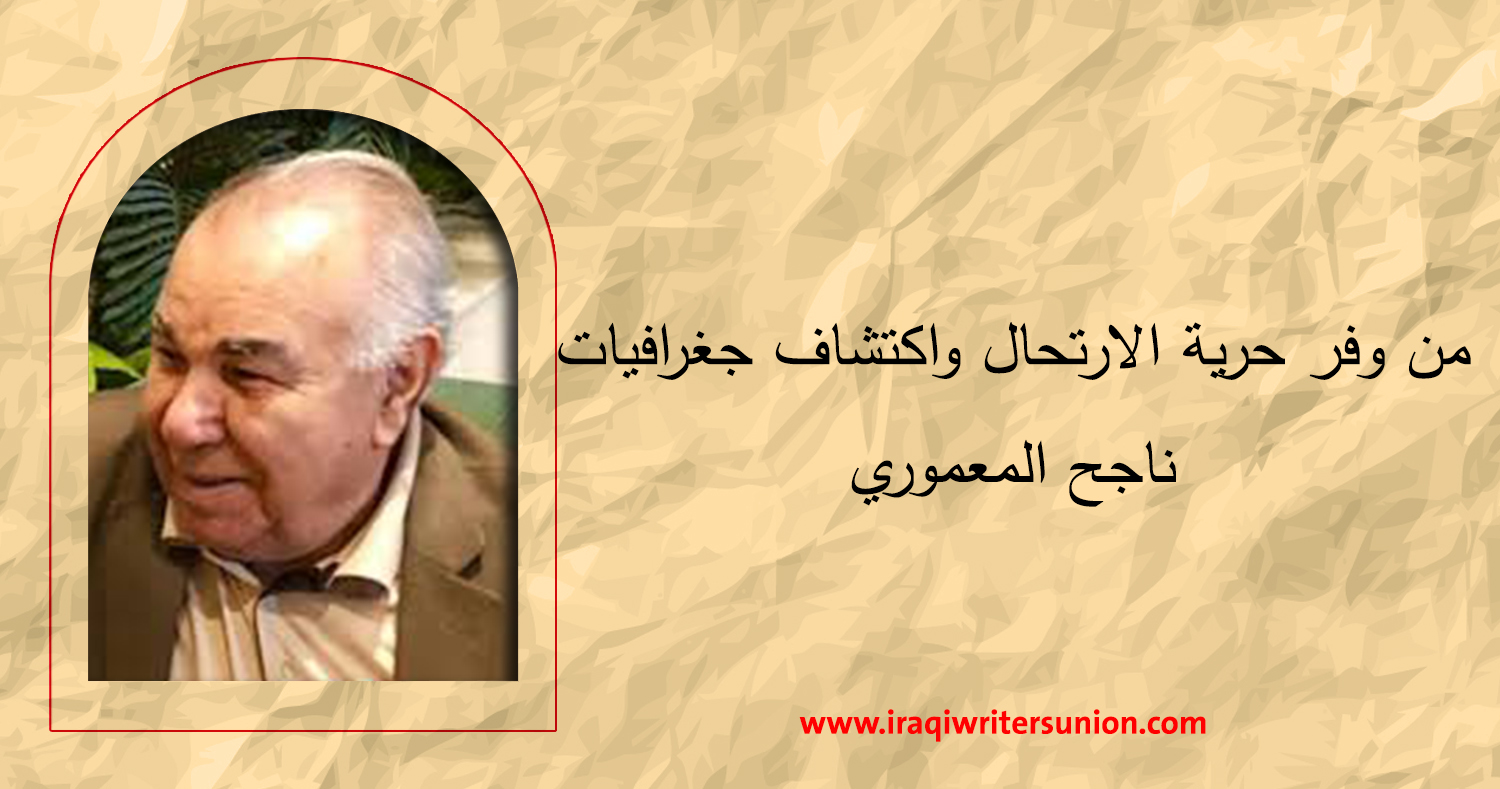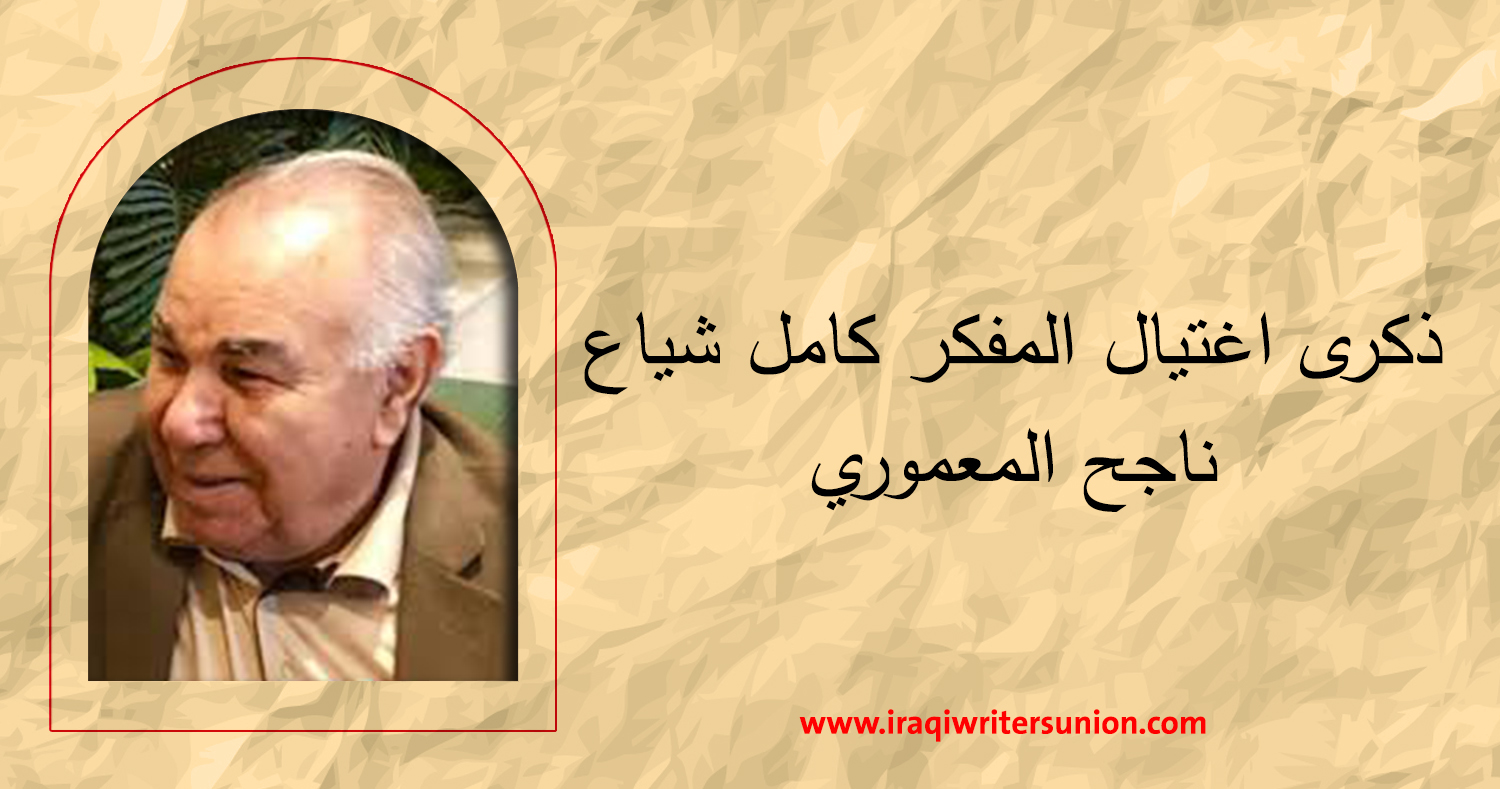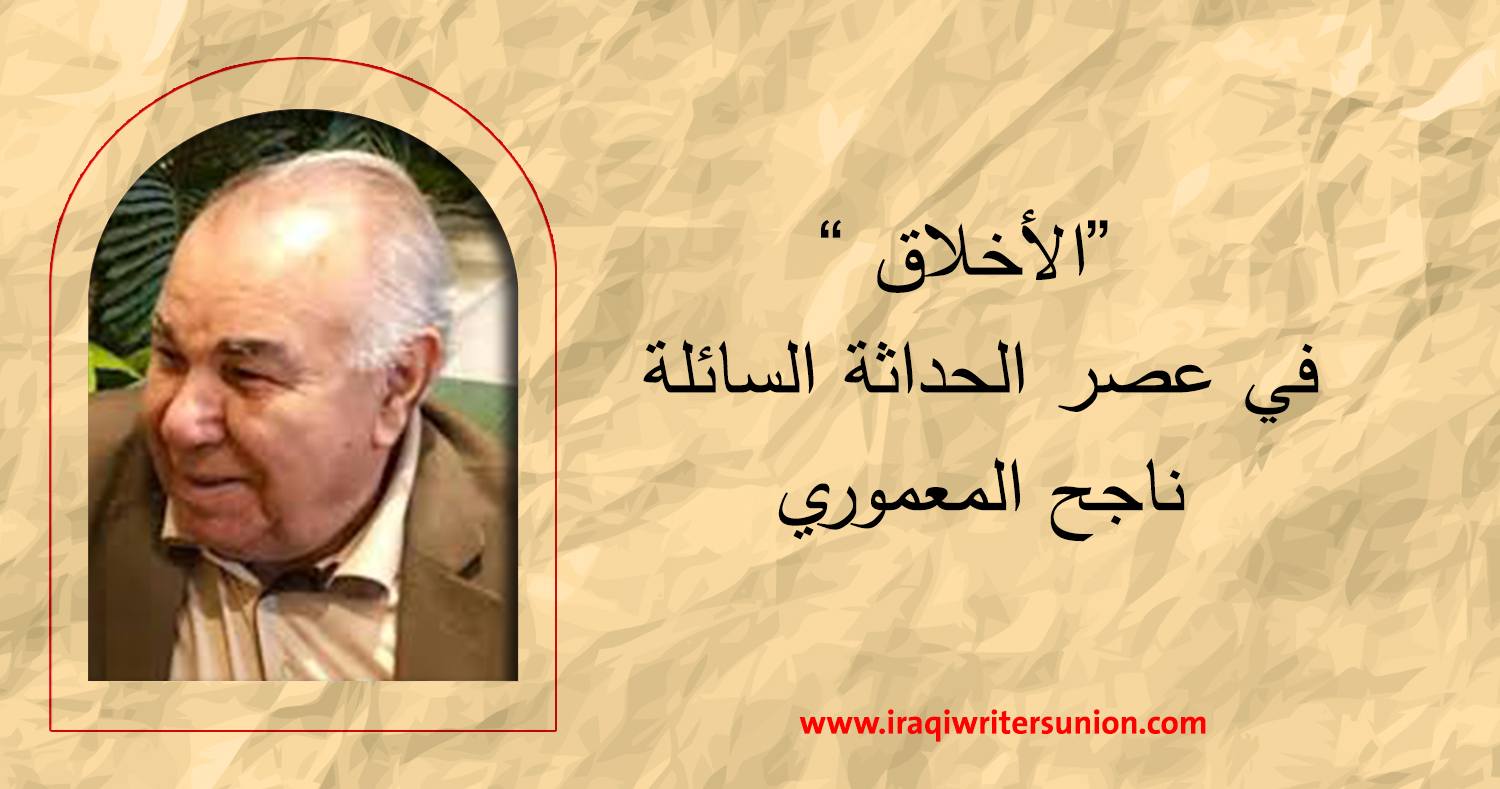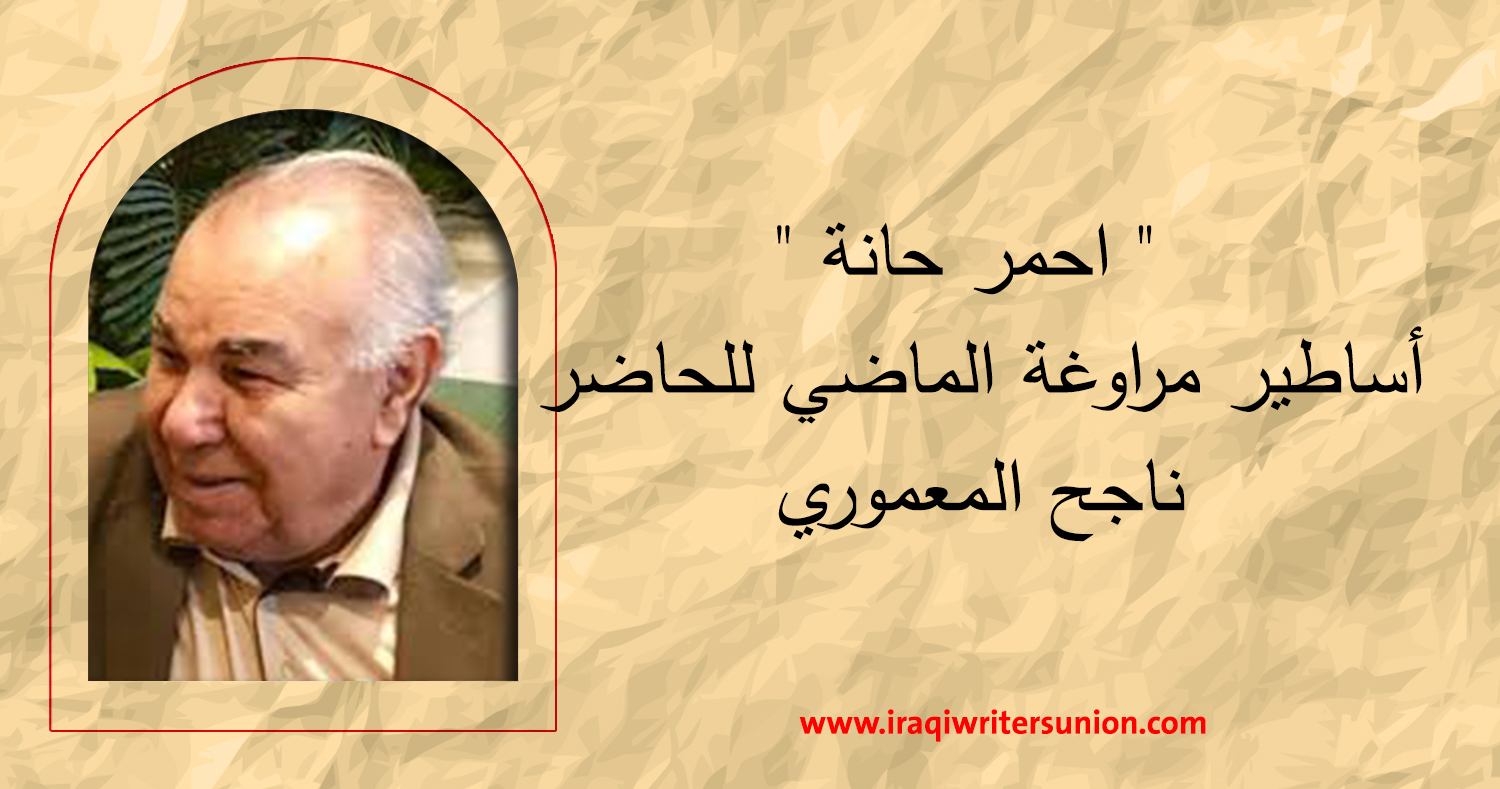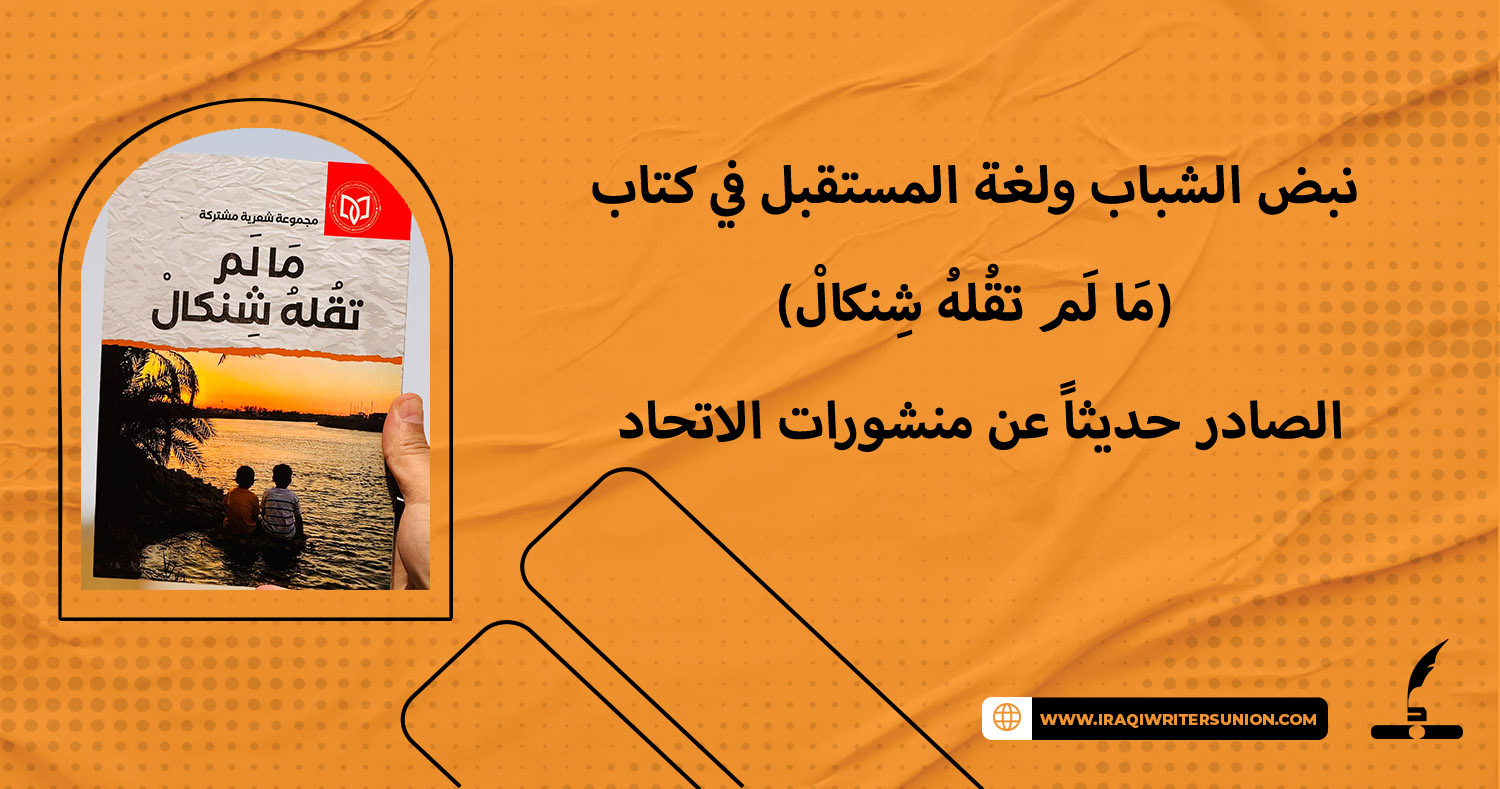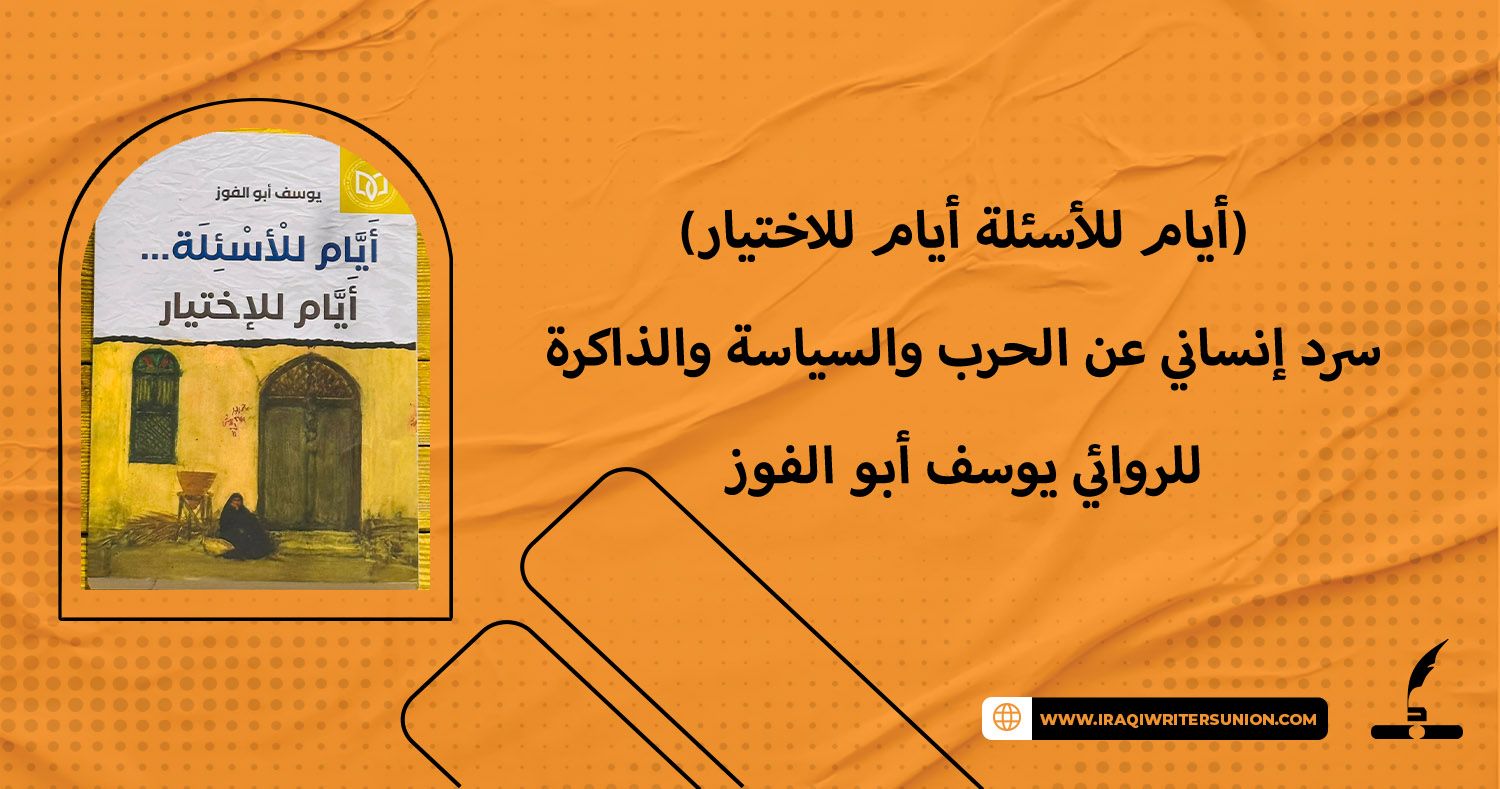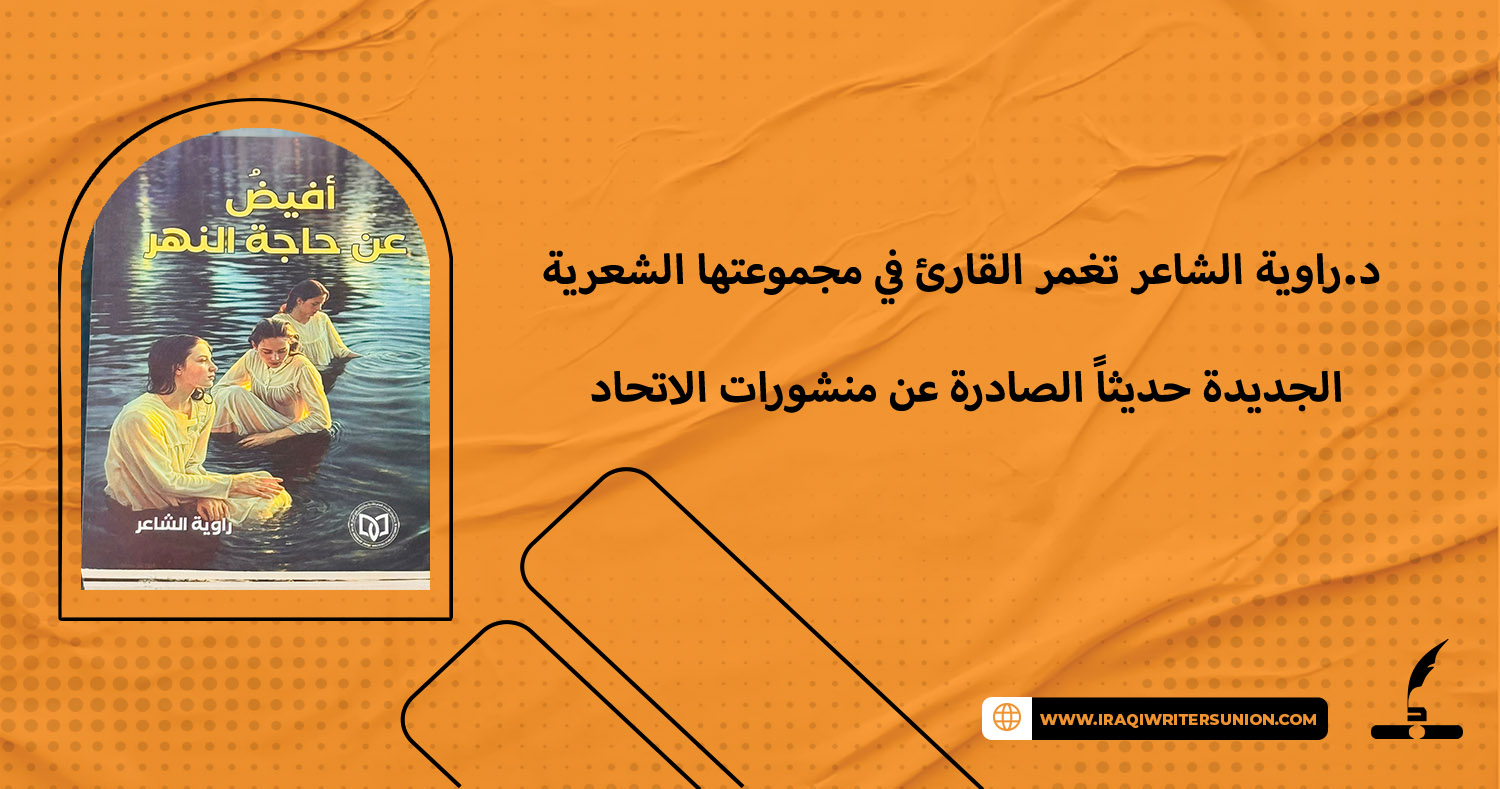الدراما والمستقبل..
انطفاء المصباح السحريّ للمسرح
أ. د. رياض موسى سكران
تقديم:
لابدّ من الوقوف بداية، على الخارطة المعرفيّة والفكريّة التي حدّدت الخطوط الرئيسيّة لعنوان هذا المحور، بجرأة وعلميّة ووعي بما يحدث من مشكلات جوهريّة في الثقافة اليوم ، وهي تعيش في ظلّ الأزمات الإنسانيّة الراهنة ، فالعنوان ، يضع تحت المجهر واحدة من أهمّ الإشكاليّات الأساسيّة ، والمسكوت عنها في عمليّة صناعة الخطاب الثقافيّ ، فالبحث في الأدب ومستقبله والثقافة ومستقبلها، يكشف عن رؤية بعيدة المدى وأهداف مخطّط لتحقيقها بعناية ، وهي تسعى للخروج بنتائج علميّة وعمليّة لمعالجة إحدى أخطر الظواهر الوجوديّة للأدب والفنّ والثقافة..
فعنوان المحور الرئيس (الأدب والمستقبل) يكشف عن رؤية منفتحة لما حدث ويحدث في واقعنا الثقافي الراهن ، حيث بدأ الأدب والفنّ يفقدان دوريهما التنويري ويعانيان العزلة ، في ظلّ الإكراهات العديدة المتداخلة الناتجة عن الأزمات الإنسانيّة المتلاحقة والمتصاعدة ، من أزمة اقتصادية إلى اجتماعيّة إلى سياسيّة إلى حصار وحروب وكوارث ، أدّت بالنتيجة إلى خلخلة القناعات الراسخة والمستقرّات السائدة عند المتلقّي وعلى قدرة الخطاب الثقافي والفني عمومًا ، ومنه الخطاب الأدبيّ ، والخطاب المسرحيّ ، على مقاومة ومواجهة هذه الإكراهات والتحدّيات والأزمات المتصاعدة..
ـ إيقاع العصر وتحوّلاته المتسارعة:
أسهمت حركيّة إيقاع العصر والتطوّر التكنولوجيّ المصاحب ونظم الاتّصال التي نعيش اليوم على وقعها في عالم متسارع ومضطرب ، في إطفاء وهج مصباح المسرح السحريّ ، واجتاحت الظلمة فضاء التواصل الروحي مع الجمهور، حيث أصبحت نظرة الجمهور وطبيعة تعامله مع العرض المسرحيّ ، تعاملاً هامشيًّا ، أو كماليًّا وترويحيًّا في أفضل حالاته ، فبعد أن كان جمهور المسرح في السنوات الماضية متفاعلاً مع مجمل الحركات الفنيّة والتيّارات الطليعيّة ، والتي كانت تشكّل إحدى أهمّ موجّهات الحياة ، فإنه لم تعد اليوم هناك حاجة أساسيّة في بناء المنظومة القيميّة والذوقيّة للفرد والمجتمع.
وفي التساؤل عن مدى تحقّق اكتمال الفعل المسرحيّ والحال هذه ، نجد أنفسنا نبحث في طبيعة الموضوعات التي كان يتصدّى لها الكاتب المسرحيّ ، وكانت جزءًا أساسيًّا من حاجة الجمهور الباحث عن وجوده ، ومن خلالها كان يكتمل الفعل المسرحيّ ، أمّا اليوم فالعالم الذي أصبح قرية صغيرة وسُلبت كلّ خصوصيّات المجتمعات ، فضلاً عن تنامي الشعور الجمعي باللا جدوى واليأس من هذا العالم الذي فقد قيمه الروحيّة ، وصار الإنسان مجرّد رقم في مضاربات الاقتصاد العالميّ وسوق المال وحركة التجارة ، وتضاءل أمام عجلة التكنولوجيا التي سحقت كيانه ووجوده الذي كان مؤسّسًا على تلك القيم الروحيّة والمبادئ الأخلاقيّة ، ومع هذا الشعور الذي تولّد لدى الفرد ، لم يعد المسرح قادرًا على أن يقنع الجمهور بأن (اللعبة) المسرحيّة ستؤثّر في تغيير أو تعديل مسارات هذا الواقع أو تعيد إنتاجه أو تصحّح أخطاءه ، فالمشكلة لا تكمن في نقص أو خلل في قدرة المسرح ، وإنّما في (تسونامي) المتغيّرات السياسيّة المباغتة والأزمات الملتهبة والمتصاعدة التي رافقها الانفجار التكنولوجيّ الهائل ، فضلاً عن حجم المآسي وما خلّفته الحروب من آثار وحشيّة وويلات على مجمل مفاصل الحياة ، فصار المجتمع يرى أن مآسيه أكبر وأعمق مّما يقدّمه المسرح عبر لعبة وهم وإيهام ومحاكاة ، وهكذا ارتبكت قناعات الجمهور وثقافة التلقّي التي تستلزم مراجعات وصياغات جديدة ومبتكرة.
إن طبيعة التطوّر التكنولوجي ونظم الاتصال الحديثة ، جعلت نظرة المجتمع وطبيعة تعامله مع مجمل حقول الثقافة والفنون ، ومنها فنّ المسرح ، تعاملاً هامشيًّا لا يتعدّى التسلية والترفيه ، وبالتالي فإن الجمهور لم يعد بحاجة حتّى إلى كلّ هذه المفردات ، بعد أن اكتسحت تقنيات الاتصال الحديثة كلّ تفاصيل حياته.
وعِبرَ أدواته الأساسيّة ، التي تكمن في وجود الإنسان ، والمتمثّلة بالجسد والروح والفكر، يكمن السّرّ الذي جعل (بيتر بروك) يؤمن بأن (المسرح قائم على الفطرة ، وله عيون تنظر إلى الغد) ، فهو وسيلتنا للاتصال بالعالم ، وتعميق الشعور بالحياة الإنسانيّة وخلق الإحساس بأننا جزء من الحياة ، فالأساس في التجربة المسرحيّة ، أنها تساعد على تعميق الشعور بالحياة ، حيث أن المسرح مكوّن أساسيّ في حياة الإنسان منذ نشأته ، فهو الذي كان يحرّر أدواته المتمثّلة بـأسرار الجسد وهواجس الروح وتجلّيات الفكر، هكذا أشبه بتفاعل كيميائيّ حثيث ومتواصل، ينتج عنه ، أمّا ذلك التوهّج الجميل ، أو انطفاء ذلك المصباح السحريّ للعرض المسرحيّ.
وتعدّ احتفالات ( ديونسيوس ) ، وجميع الطقوس ، مجالاً للتفاعل المؤدّي مع المتلقّي هنا في طقس الاحتفال ، ولتفاعل الطبيعة وتقاليدها في النماء والزراعة ، وتعاقب الفصول والليل والنهار والولادة والموت بأسلوب مسرحيّ لتعميق الشعور بالتجربة الحياتيّة ، وتوفير البيئة لتطوير أجهزة الإنسان الجسديّة والروحيّة والفكريّة ليكون أكثر توازنًا وتأهيلاً لمواجهة ظروف الحياة.
فأهميّة المسرح في حياتنا، هو أن نتعلّم كيف نشرك طبيعتنا الروحيّة والجسديّة والفكريّة في نشاطنا اليوميّ وممارساتنا الحياتيّة ، والمسرح قائم على هذه الفرضيّة التي دعت (ستانسلافسكي) أن يبحث عن عناصر تنشيط المزاج الروحيّ بوساطة الخيال والتخيّل لخلق الصورة عبر (الذاكرة الانفعاليّة ) ، لمعالجة معلومات الذاكرة و(الظروف المعطاة) ، و(لو السحريّة) على إنها ( إيهام بالواقع ) ، ولهذا سمّيت هذه العناصر ( تنشيط المزاج الروحيّ ) لأن عملها كان يستهدف تكييف الإنسان للمعايشة وتعميق الشعور بالحياة.
فظهور كاتب مثل (يوسف العاني) ومخرج مثل (سامي عبد الحميد) مع بداية تأثير الحركات الفنّيّة والتيّارات الفكريّة سجّل حراكًا جماهيريًّا لافتًا ، فكان الجمهور يأتي من المدن والمحافظات العراقيّة بباصات لمشاهدة عروض فرقة ( المسرح الفني الحديث ) ، لأن الموضوعات التي كان يتصدّى لها المسرح كانت تعبيرًا عن حاجة المجتمع الباحث عن وجوده ، الآن وسط هذا العالم الذي أصبح قرية صغيرة ، فضلاً عن الشعور الجمعيّ باللا جدوى واليأس من عالم فقد قيمه الروحيّة ، لا يمكن للمسرحيّ أن يؤثّر في وعي المتلقّي بسهولة ، وأن (وهم) المسرح ما عاد يؤثّر في هذا الواقع أو يعيد تصحيح أخطائه ، فالمشكلة إذن لا تكمن في عدم قدرة المسرحيّين ، بل في سرعة وحجم المتغيّرات التي خلخلت قناعات المتلقّي وشعوره بالإيقاع المضطرب للواقع الذي يستوجب منّا قراءات جديدة وصياغات محدّثة . فليس المسرح موضوعًا ولا مفهومًا ولا فكرة ، بل إنه صيغة من صيغ الحياة ، وهو اليوم بأمسّ الحاجة إلى التعزيز بأساليب معاصرة قادرة على التماهي مع ثقافة التلقّي المعاصر، والعودة إلى الحقيقة التي تمثّل جوهر التجربة المسرحيّة..
يُعدّ فنّ العرض المسرحيّ فنّ الاتصال الأرقى بين الفنون ، وله فرضيّات ومقاربات لا نهائيّة من أجل إعادة إنتاج الحياة والتعبير عن مشكلات الإنسان ، وعن تلك الأحلام والطموحات والمخاوف والهواجس والأمنيات التي تراوده ، فالمسرح عبر وسائله المختلفة يهيئ للأفكار والأحاسيس القدرة على خلق التفاعل والتواصل مع المتلقّي ، وعبر أدواته الأساسيّة ، التي تكمن في وجود الإنسان والمتمثّلة بالجسد والروح والفكر، الذي يرى نفسه ويكتشف عالمه ، ولعلّ هذا هو السبب الذي جعل (بيتر بروك) يؤمن بأن المسرح قائم على الفطرة ، و له عيون تنظر إلى الغد ، فهو وسيلتنا للاتصال بالعالم ، ليس فقط على المسرح وإنّما حتّى في حياتنا اليوميّة لأنه يساعد على تعميق الشعور بالحياة الإنسانيّة.
فالأساس في التجربة المسرحيّة أنها تساعد على تعميق الشعور بالحياة الإنسانيّة ، حيث أن المسرح مكوّن أساسيّ في حياة الإنسان منذ القدم ، حيث كان قائمًا في ذاته وفي سؤاله عن وجوده ، حيث كان يحثّه على التفكير والمناقشة والاتّصال والتواصل ، فهو الذي كان يحرّر أدواته المتمثّلة بـالجسد والروح والفكر، وقد كانت المجتمعات القديمة تعتبر الاحتفالات السنويّة والطقوس والمراسيم مواسم مهمّة لتحرير أدوات الإنسان ، جسده وروحه وفكره ، من الطرق التقليديّة في التعامل مع متغيّرات الحياة ، وكانت هذه الاحتفالات تطرح التحفّظ جانبًا للاختبار الحرّ في التعامل بدون إكراه ٍ، حيث تكون البهجة والمتعة أمورًا جوهريّة ، وتعتبر احتفالات ديونسيوس ، وجميع الطقوس والمناسبات في المجتمعات ، مجالاً لتفاعل المؤدّي مع الجمهور في وحدة واحدة هنا في طقس الاحتفال ، ولتفاعل الطبيعة وتقاليدها في النماء والزراعة ، وتعاقب الفصول والليل والنهار والولادة والموت بأسلوب مسرحيّ لتعميق الشعور بالتجربة الحياتيّة ، حيث كانت هذه المجتمعات توفّر البيئة لتطوير أجهزة الإنسان الجسديّة والروحيّة والفكريّة ليكون أكثر توازنًا وتأهيلاً لمواجهة ظروف الحياة المتغيّرة.
الدروس المستمدّة من أهميّة المسرح في حياة الإنسان ، هو أن نتعلّم كيف نشرك طبيعتنا الروحيّة والجسديّة والفكريّة في نشاطنا اليوميّ وممارساتنا الحياتيّة ، فالمسرح قائم على هذه الفرضيّة التي دعت (ستانسلافسكي) أن يبحث بشكل منهجيّ في أسس التمثيل والأداء المسرحيّ ، عن عناصر تنشيط (المزاج الروحيّ) بواسطة الخيال والتخيّل لخلق الصورة عبر الذاكرة الانفعاليّة ، لمعالجة معلومات الذاكرة والظروف المعطاة لقراءة وتشخيص رسائل البيئة ، و (لو السحريّة) على أنها إيهام بالواقع لمعالجة البيئة ، ولهذا سمّيت هذه العناصر تنشيط (المزاج الروحيّ) ، لأن عملها كان يستهدف تكييف الإنسان للمعايشة وتعميق الشعور بالحياة الإنسانيّة.
وأمام مجهر الجمهور، وفي ظلّ تعدّد القراءات وتنوّع الرؤى واختلاف الأساليب وتباين الجذور وتجدّد الثقافات ، فإن تَمثُّل الوقائع والأحداث في صيغة مسرحيّة يشكّل جوهر العمليّات الاتصاليّة ، وهو الفرضيّة السائدة في تشكيل هُويّة ومفهومات الخطاب المسرحيّ الحديث.
إن حاجة العالم المعاصر للمسرح ، تأتي من قدرته على الإقناع وتحقيق أهدافه في تبنّي الوقائع والأحداث والعلاقات والاتصالات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي وصناعة البرامجيّات بصيغة دراميّة ، هي جزء من إعادة النظر في المعاني وفي الرؤية اللا تقليديّة للدراما والأداء التمثيليّ ولمواقف حياتنا الواقعيّة ، وذلك بالرجوع إلى الأشياء في حالة بداهتها الأولى والأصيلة.
فالمسرح ليس موضوعًا تقليديًّا ولا مفهومًا متداولاً ولا فكرة مجرّدة ، بل إنه صيغة حياة ، وصورة حيّة لها ، وقد أدركت المجتمعات المعاصرة تلك الصيغة وأهميّتها وآثار استخدامها بشكل متعاظم ، وأجمعت على ضرورة تعزيزها بأساليب متطوّرة من تكنولوجيا الاتصالات والتقنيات الرقميّة ، لغرض تفعيل وإعادة تنظيم رسالة المسرح ودوره في بناء المجتمع المعاصر، وذلك لأن من مميّزات هذه الأساليب هي قدرتها على التماهي مع ثقافة التلقّي المعاصرة ، فضلاً عن تحقيق عناصر التسلية والمتعة والإثارة والدهشة وتحقيق الإقناع والإيهام بالواقع على وفق فرضيّة الضرورة والاحتمال ، وهذه الحقيقة تمثّل جوهر التجربة المسرحيّة..
لقد أدّى تفشّي الوباء الكونيّ (كورونا) إلى عزلة البشريّة عن بعضها وعن العالم المحيط ، فيما كشفت عن إصرار بعض المسرحيّين للتواصل فيما بينهم وتوظيف شتّى الوسائل المتاحة لذلك ، مستعينين بإمكانيّات وقدرات ومعارف شخصيّة في الأساليب التقنيّة وتوظيف شتّى وسائل الاتصال لتحقيق التواصل الاجتماعيّ ، تأكيدًا لرسالة المسرح الهادفة إلى إعادة إنتاج الحياة كما ينبغي أن تكون وليست كما هي كائنة ، وصارت تلك المحاولات تمنح المسرحيّين ولو الحدّ الأدنى ، من حالة الشعور بالرضا عن أداء واجبهم الأخلاقيّ وتلبية النداء الإنسانيّ من خلال إصرارهم على خلق وابتكار وتأسيس منصّات بديلة عن منصّة المسرح المعروفة ، ومجمل هذه المحاولات تمثّل استجابة لرغبتهم في كسر العزلة ، وإبقاء جذوة الحياة متّقدة ، مع إدراك الفنّان بأن هذه المنصّات الإلكترونيّة هي حالة مؤقّتة فرضها الظرف الراهن ، ولا يمكن أن تكون هي البديل الدائم عن حالة التجلّي التي تخلقها طقسيّة الاتصال الروحيّ التي يتفرّد بها فنّ العرض المسرحيّ عن سائر الفنون ، فالتفاعل الحيّ والمباشر للمسرح بكلّ عناصره الفنيّة والجماليّة مع الجمهور في لحظات العرض ، هي التي تمنح العرض المسرحيّ (روحه) وتمنحه دفقة الحياة ، وتمنحه صدقيّته التي تتحقّق عبر عمليّة الاتصال الوجدانيّ ، فالمسرحيّ بمحاولته توظيف المنصّات الإلكترونيّة ، يريد أن يؤكّد إنه لن يبقى مكتوف اليدين إزاء هذا المتغيّر الطارئ وليؤكّد انتصاره الدائم لإرادة الحياة تحت شتّى الظروف.
وراح البعض من المسرحيّين العرب المشغولين بقضايا الحداثة والتجديد في الفكر الجماليّ والنقديّ النظريّ أو التطبيقيّ ، يحاولون تقديم رؤاهم وأفكارهم عبر هذه المنصّات الإلكترونيّة لمواكبة هذا التطوّر من خلال مشاركتهم الفاعلة في مؤتمرات وندوات وحلقات فكريّة ومهرجانات عربيّة ودوليّة ونقل تجاربهم الشخصيّة عبر منصات إلكترونيّة عديدة، الهدف الأساسيّ منها هو تحقيق حالة التواصل والتفاعل وتحريك الساكن وكسر حالة العزلة والمحافظة على جوهر العمليّة المسرحيّة..
وبما أن العرض المسرحيّ يعكس مجمل ما يحدث في الواقع ، بكلّ متغيّراته وانعطافاته وتأثيراته المتباينة على المجتمع والفرد ، وبالتالي فإن جوهر العرض المسرحيّ هي محاكاة هذا الواقع وإعادة تشكيله كما ينبغي أن يكون ، على وفق رؤية وأسلوب خاصّ.. ولمّا كانت طبيعة الأحداث وحركة الشارع ومتغيّرات الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة تمثّل محور ارتباط واتّصال الجمهور بالعرض المسرحيّ ، إلا أن طبيعة التطوّر التكنولوجيّ ونظم الاتّصال ، ونحن نعيش في عالم متسارع ، أطفأ وهج مصباح المسرح السحريّ ، حيث أصبحت نظرة المجتمع وطبيعة تعامله مع فنّ المسرح ، تعاملاً هامشيًّا، أو كماليًّا وترويحيًّا في أفضل حالاته ، فبعد أن كان جمهور المسرح في السنوات الماضية متفاعلاً مع مجمل الحركات الفنيّة والتيّارات الطليعيّة والمتغيّرات الأيديولوجيّة، التي كانت تشكّل إحدى أهمّ موجّهات الحياة ومتغيّرات الواقع، أمّا اليوم فلم يعد ينظر إلى المسرح تلك النظرة التي ترى فيه حاجة أساسيّة في بناء المنظومة الأيديولوجيّة والاجتماعيّة والذوقيّة للمجتمع والفرد
فالموضوعات التي كان يتصدّى لها الكاتب المسرحيّ كانت جزءًا أساسيًّا من حاجة المجتمع الباحث عن وجوده ، أمّا اليوم فإن العالم الذي أصبح قرية صغيرة وسلبت فيه كلّ خصوصيّات المجتمعات ، فضلاً عن الشعور الجمعيّ لأغلب المجتمعات باللا جدوى واليأس من هذا العالم الذي فقد قيمه الروحيّة ، وصار الإنسان مجرّد رقم في معادلات الاقتصاد العالميّ وسوق المال ، وتضاءل أمام عجلة التكنولوجيا التي سحقت كيانه ووجوده الذي كان مؤسّسًا على قيم روحيّة ، وهو يرى ويلمس أن هذه القيم قد اضمحلّت وانطفأ وهجها ، ومع هذا الشعور الذي تولّد وتعاظم لدى الفرد ، لا يمكن للمسرحيّ بعد ذلك أن يقنع الجمهور بأن ( لعبة المسرح ) و( لعبة الوهم ) المسرحيّ ستؤثّر في هذا الواقع وتصحح أخطاءه أو تعيد إنتاجه كما ينبغي أن يكون على حدّ قول (أرسطو) ، فالمشكلة تكمن في (كيفيّات) التعاطي مع حجم المتغيّرات الكونيّة الهائلة والمتسارعة التي أربكت قناعات المجتمع وجمهور المسرح وثقافة التلقّي التي تستلزم منا مراجعات جريئة وفرضيّات جديدة وقراءات محدّثة وصياغات مبتكرة ، ورؤى تهضم الواقع وتتماهى مع متغيّراته المتسارعة وما يجري من تقلّبات متواصلة .
فالمشكلة لا تكمن في نقص أو خلل في قدرة المسرح ، وإنّما في حجم (طوفان) المتغيّرات والأزمات الراهنة والمتسارعة ، فضلاً عن حجم المآسي وما خلّفته الحروب من آثار وحشيّة وويلات على مجمل مفاصل الحياة التي صار الإنسان يعاني قسوتها ومرارتها اليوميّة ، وصار الجمهور يرى أن مآسيه أكبر وأعمق مّما يقدّمه له المسرح ، وهكذا ارتبكت واشتبكت وتراجعت قناعات الجمهور وثقافة التلقّي التي تستلزم مراجعات وصياغات ومقاربات جديدة في صناعة العرض المسرحيّ.
لا شكّ في أن لكلّ مخرج مسرحيّ رؤيته الخاصّة ومقارباته الفنيّة وفرضيّاته الجماليّة التي تتشكّل على وفق مجسّاته الإبداعيّة ، وهذه المجسّات ربّما لامست جوهر هذا النصّ أو ذاك ، وتشابكت وتعالقت مع منطلقات تشكّلاته الأسلوبيّة وتمفصلاته الجماليّة ، بوصفه نصًّا يتوافق مع إيقاع الحياة والواقع الراهن من وجهة نظر المخرج ، والذي سينتج عنه تفاعل الجمهور.. ولا يمكن لأحد أن يفرض على المخرج قناعات غير التي آمن بها ، وبالتالي فإن جميع النصوص ستكون مهيّأة لتداخل واشتباك مع رؤية أيّ مخرج مسرحيّ ، ربّما الآن أو ربّما مستقبلاً ، وليس هناك ما يحول دون دخول أيّ نصّ إلى فضاءات العرض المسرحيّ..
السؤال الذي يرافقنا دائمًا هو: ما الذي ينقص المسرحيّين الآن ليقدّموا عروضًا أو نصوصًا مسرحيّة على غرار ما كان يقدّمه جيل الروّاد في المسرح العربيّ من مؤلّفين ومخرجين ، مثل توفيق الحكيم وصلاح عبد الصبور وسعد الله ونّوس ويوسف العاني وسامي عبد الحميد وغيرهم من روّاد المسرح في العراق والوطن العربيّ..؟
المسرح هو انعكاس لما يحدث في الواقع، بكلّ متغيّراته وانعطافاته وتأثيراته المتباينة على المجتمع والفرد ، وبالتالي فإن الفنّان المسرحيّ يسعى جاهدًا لمحاكاة هذا الواقع وإعادة تشكيله ، على وفق رؤية ناتجة عن قناعات خاصّة.. من هنا فإن طبيعة الأحداث ومتغيّرات الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة سيكون لها صدى في صوت الفنّان المسرحيّ ، فضلاً عن ذلك فإن طبيعة تطوّر التكنولوجيا ونظم الاتصال في عالم متسارع ، جعل نظرة المجتمع وطبيعة تعامله مع مجمل حقول الثقافة والفنون ، ومنها فنّ المسرح ، تعاملاً هامشيًّا أو كماليًّا وترويحيًّا في أفضل حالاته ، فبعد أن كان جمهور المسرح في السنوات الماضية متفاعلاً مع مجمل الحركات الفنيّة والتيّارات الطليعيّة والمتغيّرات الأيديولوجيّة ، التي كانت تشكّل إحدى أهمّ موجّهات الحياة ومتغيّرات الواقع ، فإن قناعاته اليوم قد تغيّرت وتبدّلت ، فلم يعد ينظر إلى المسرح بوصفه حاجة أساسيّة في بناء المنظومة الأيديولوجيّة والاجتماعيّة والذوقيّة للمجتمع والفرد.. فمثلاً ظهور كاتب مثل (توفيق الحكيم) في مطلع القرن العشرين جاء متزامنًا مع مرحلة نهوض المجتمع المصريّ والثورة المصريّة سنة 1919 التي ألهبت مشاعر الشعب المصريّ وعواطفه ، وبدأ بالخروج من حالة الركود والاستسلام إلى مواجهة الظلم والاستعباد ، فتولّدت لدى الحكيم تلك الروح الوطنيّة الجديدة والحسّ القوميّ الذي نتج عنه دعوة الحكيم ، من خلال مجمل نصوصه المسرحيّة إلى حريّة الفكر والانفتاح على الآخر، مع طرحه لفكرته المؤثّرة في المجتمع في تلك الفترة: ((إن الدين لا يتقاطع مع الانفتاح الإنسانيّ)) وهو يؤكّد على أن : (( الدين والفنّ يرفعان الإنسان إلى العالم العلويّ ، فالأنبياء والفنّانون رسُل الحقيقة في الوجود..)) ومثل هذه الدعوات وجدت تفاعلاً من قبل أغلب طبقات المجتمع المتعطّش لذلك الانفتاح ، فالموضوعات التي كان يتصدّى لها الكاتب المسرحيّ كانت جزءًا أساسيًّا من حاجة المجتمع الباحث عن وجوده..
وفقًا لما تقدّم فإنّ الفنّان المسرحيّ اليوم ، بوصفه شاهد عصره ، فإنه يقرأ الواقع ويتفاعل فيه ومعه ، ويتحسّس إشكاليّاته وقضاياه وهمومه ، ويعيد صياغتها بإمكانات وقدرات وقناعات وممكنات تتفاوت من مسرحيّ إلى آخر، وهذه القناعات تختلف وتتباين حتمًا حتّى في ثقافة المجتمع الواحد ، فثقافة زمن الستينيّات تختلف عن إشكاليّات زمن السبعينيّات ، وتحوّلات التسعينيّات هي ليست أزمات الألفيّة الجديدة المتلاحقة.. فالمسرح اليوم هو استمرار لحقيقة كونه انعكاسًا للواقع الراهن المتحوّل والمتسارع ، وإعادة إنتاج هذا الواقع كما ينبغي أن يكون ، وهو يحاول جاهدًا توجيه بوصلة الحياة الاجتماعيّة ، أو على الأقلّ إنه يحاول الاستجابة لحاجات الجمهور المتسارعة وإشكاليّاته المستمرّة وقناعاته المتحوّلة وثقافته المتجدّدة ، ومتغيّراته التي لن تتوقّف عند نقطة محدّدة..












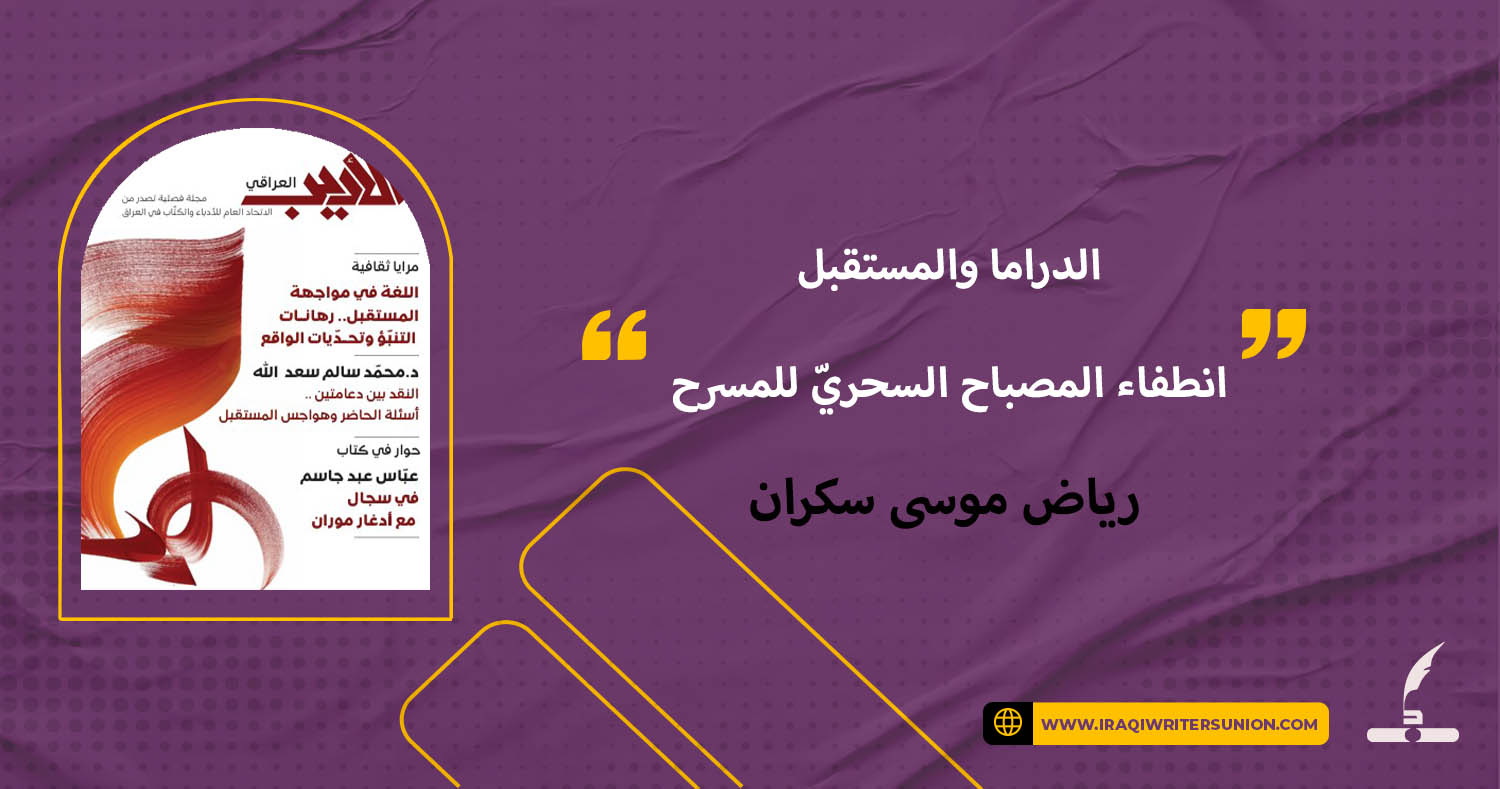
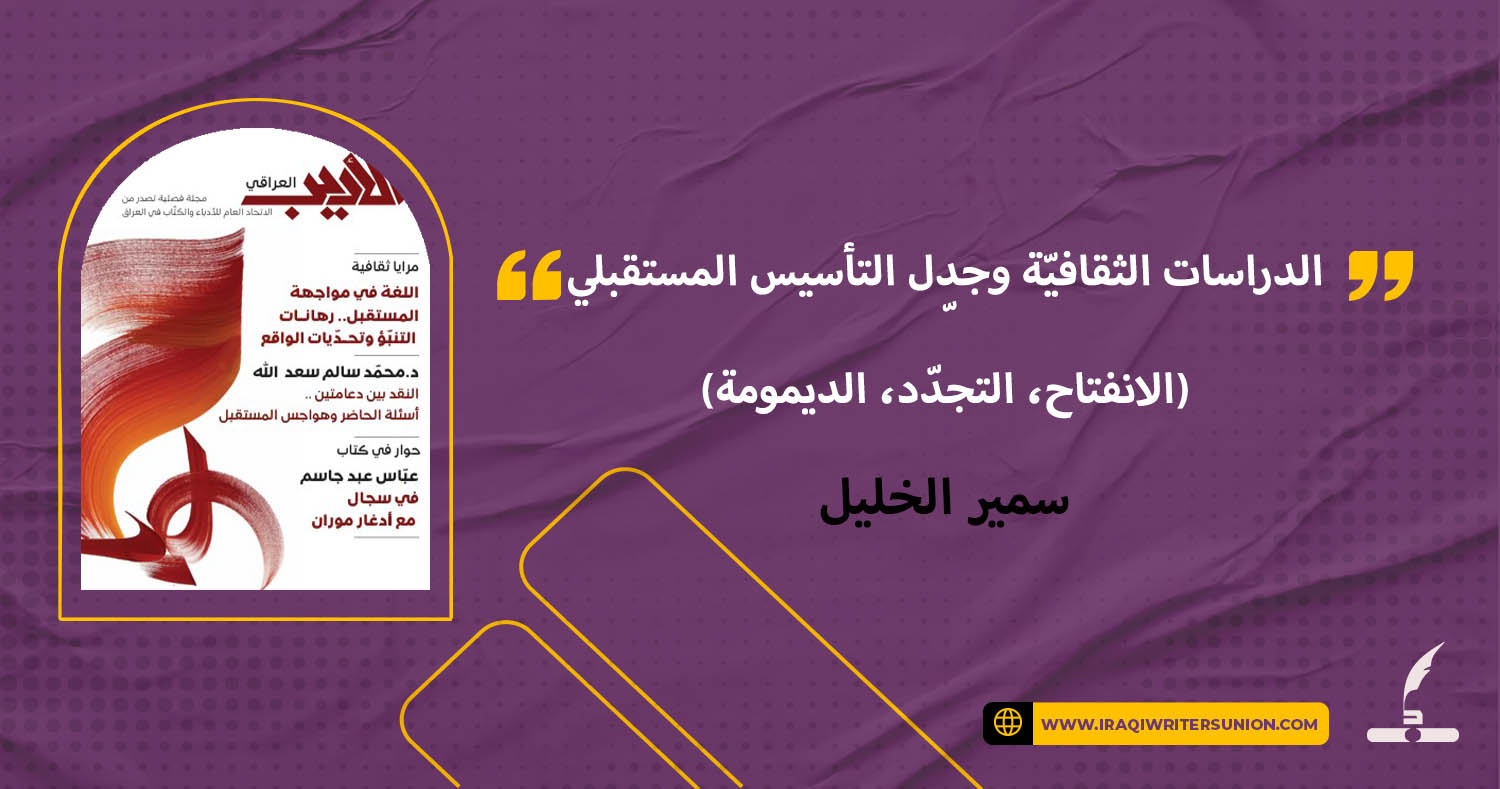


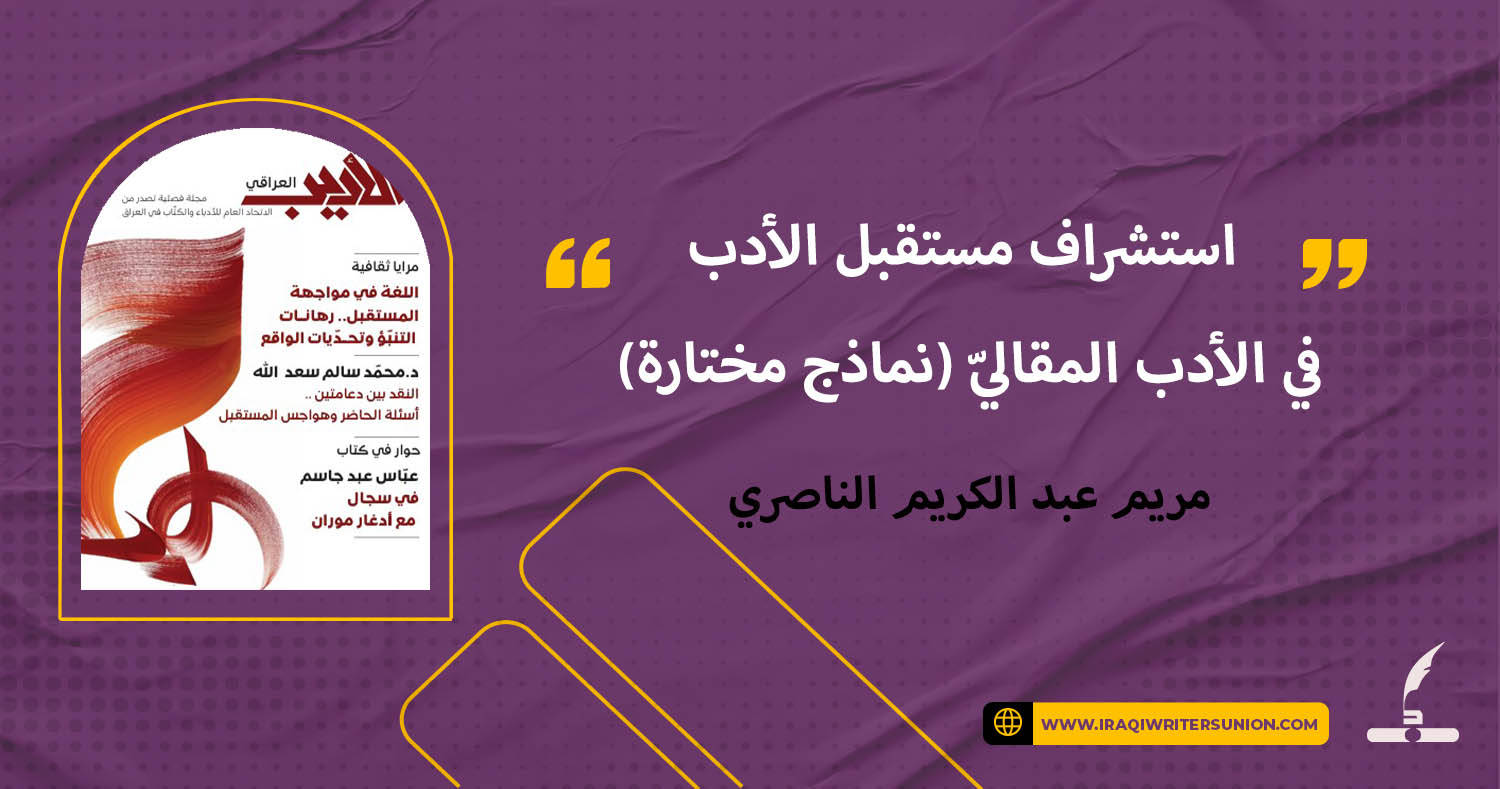


 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي