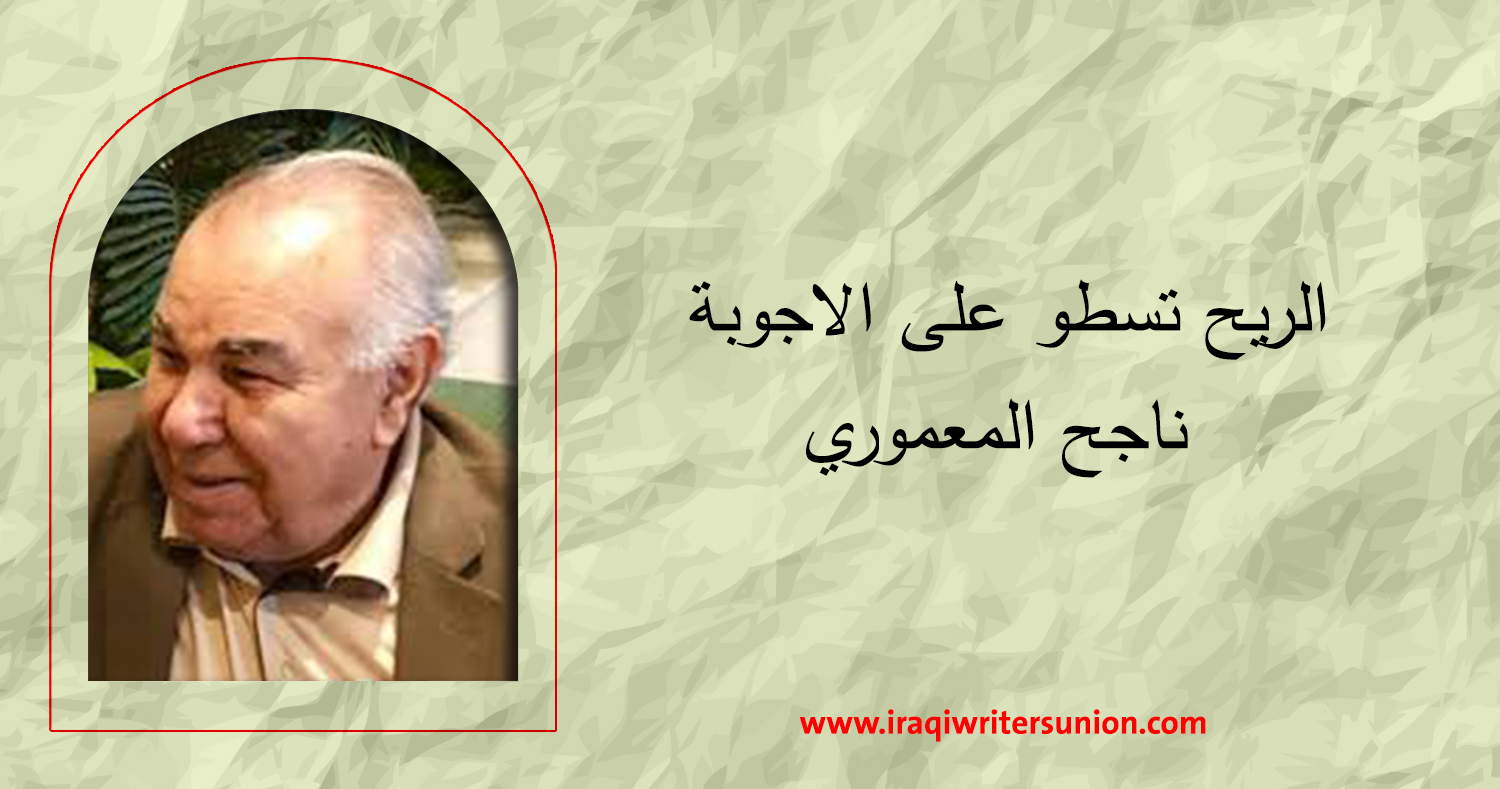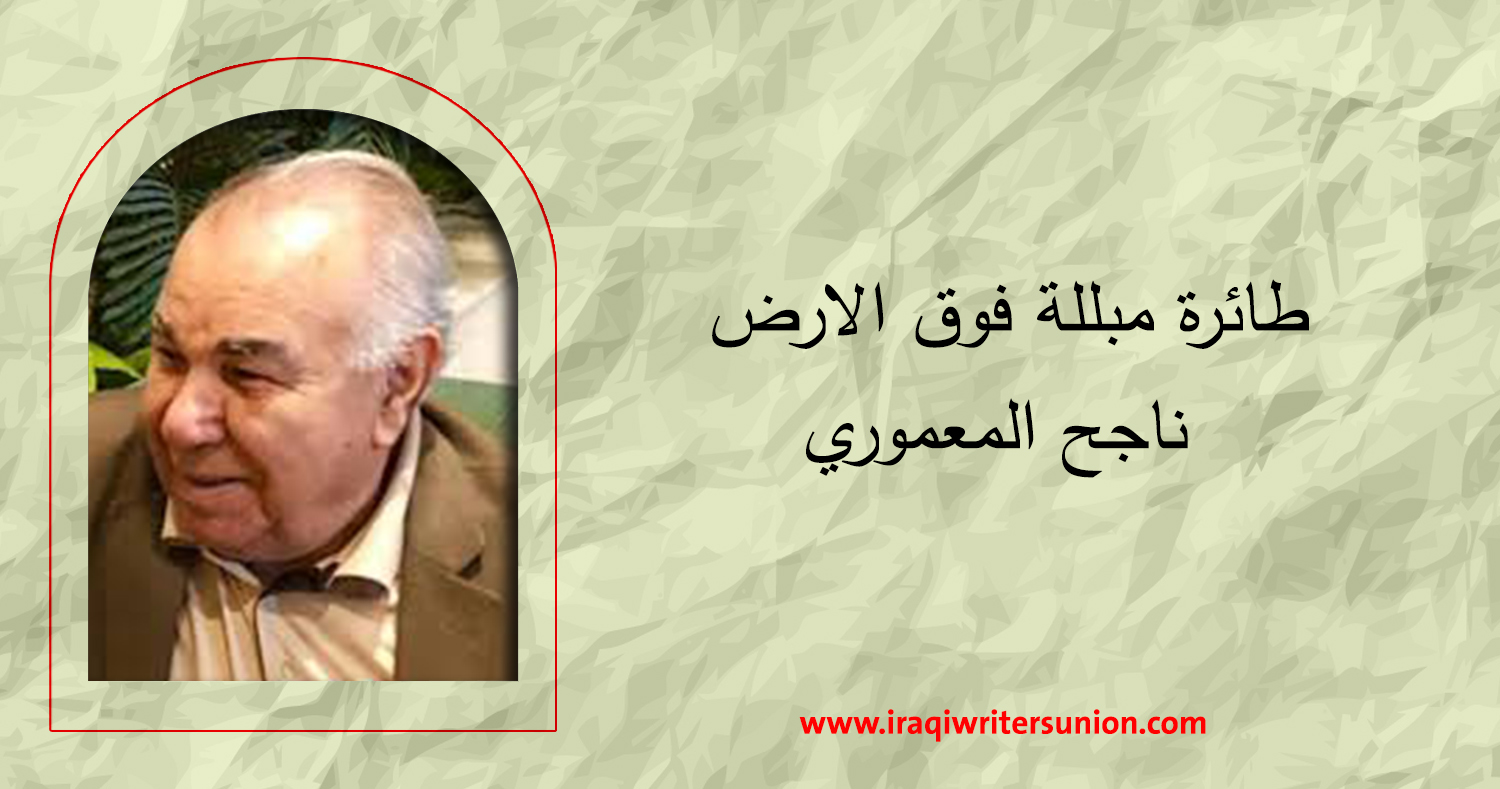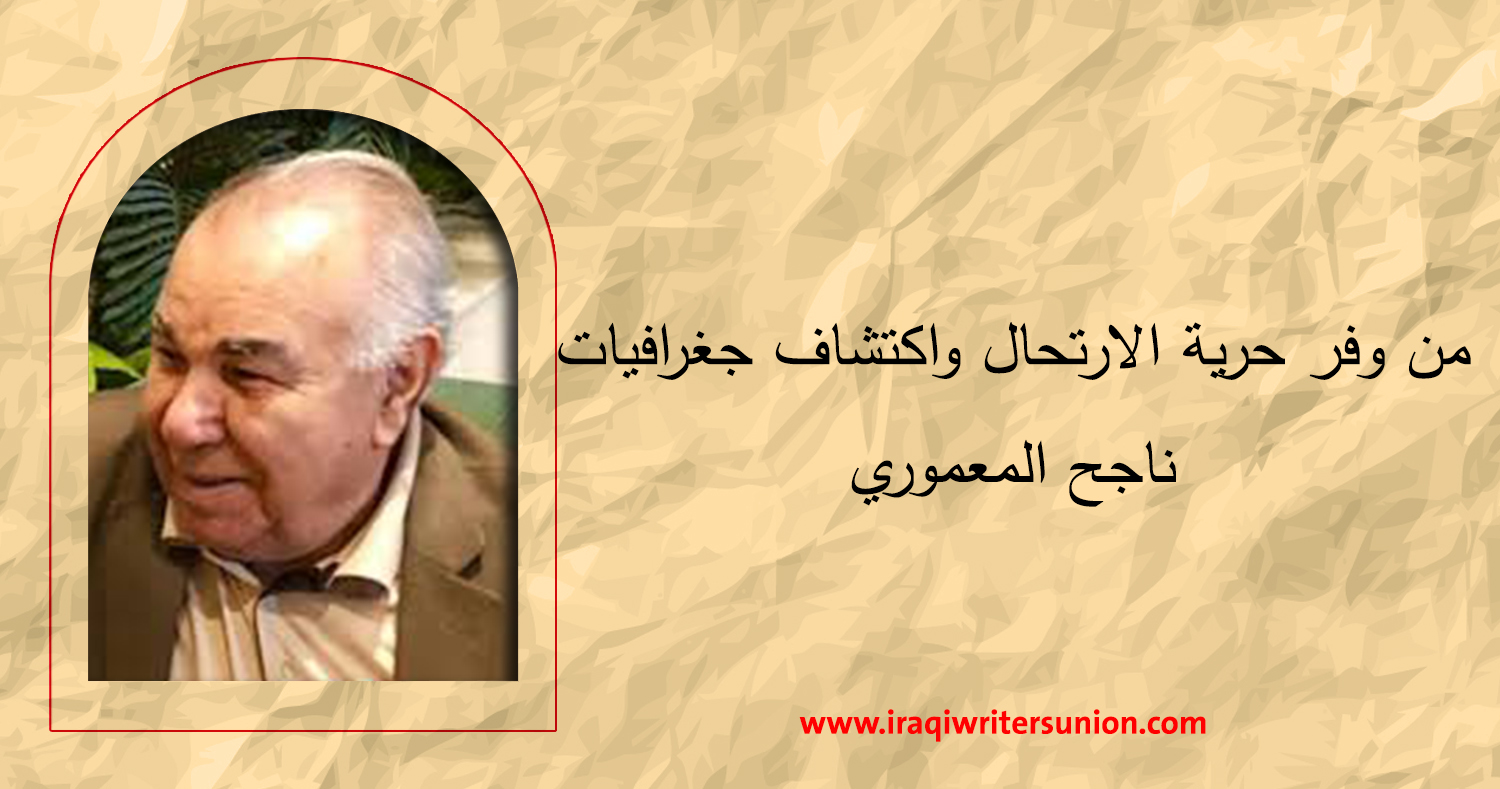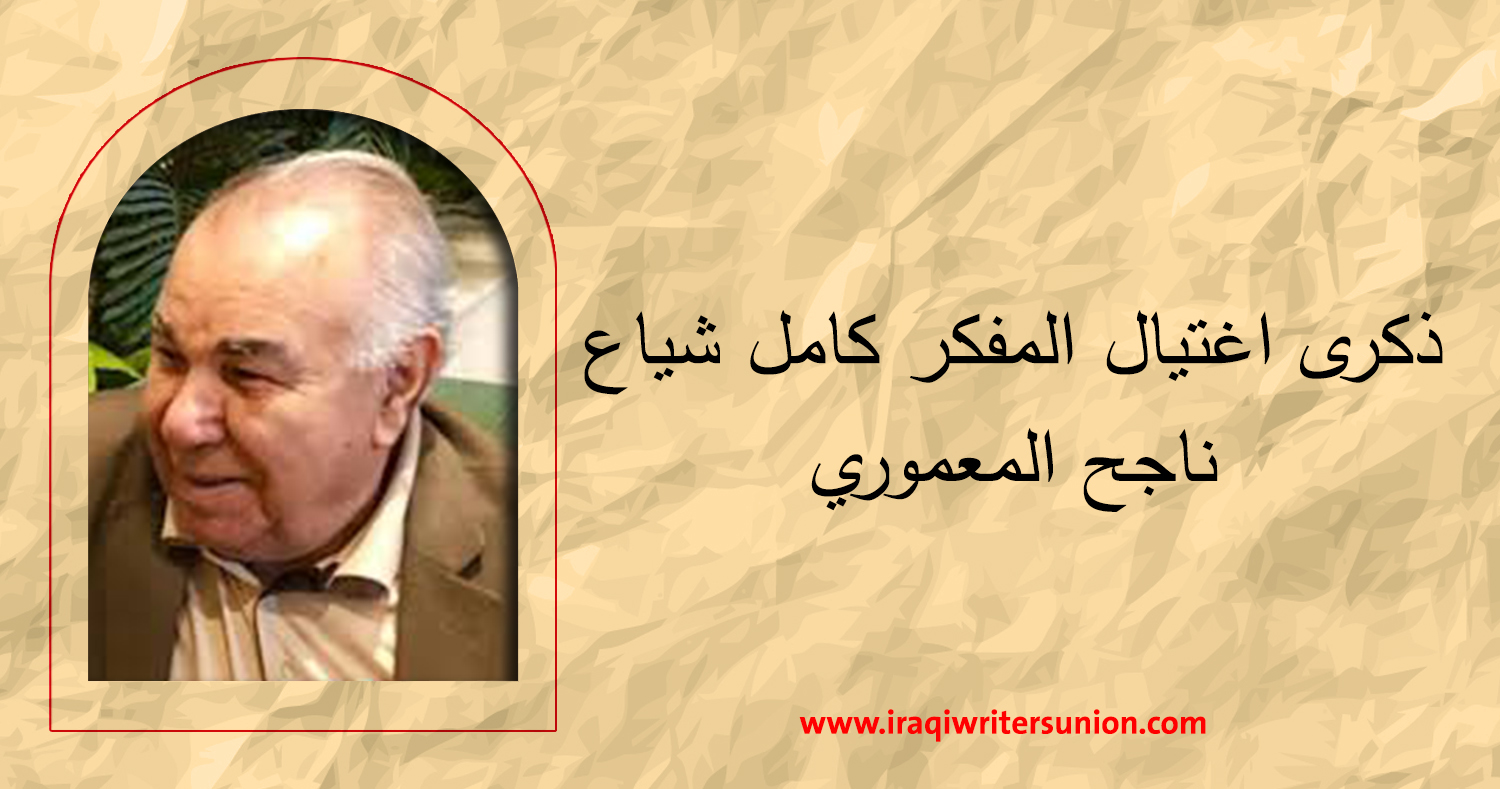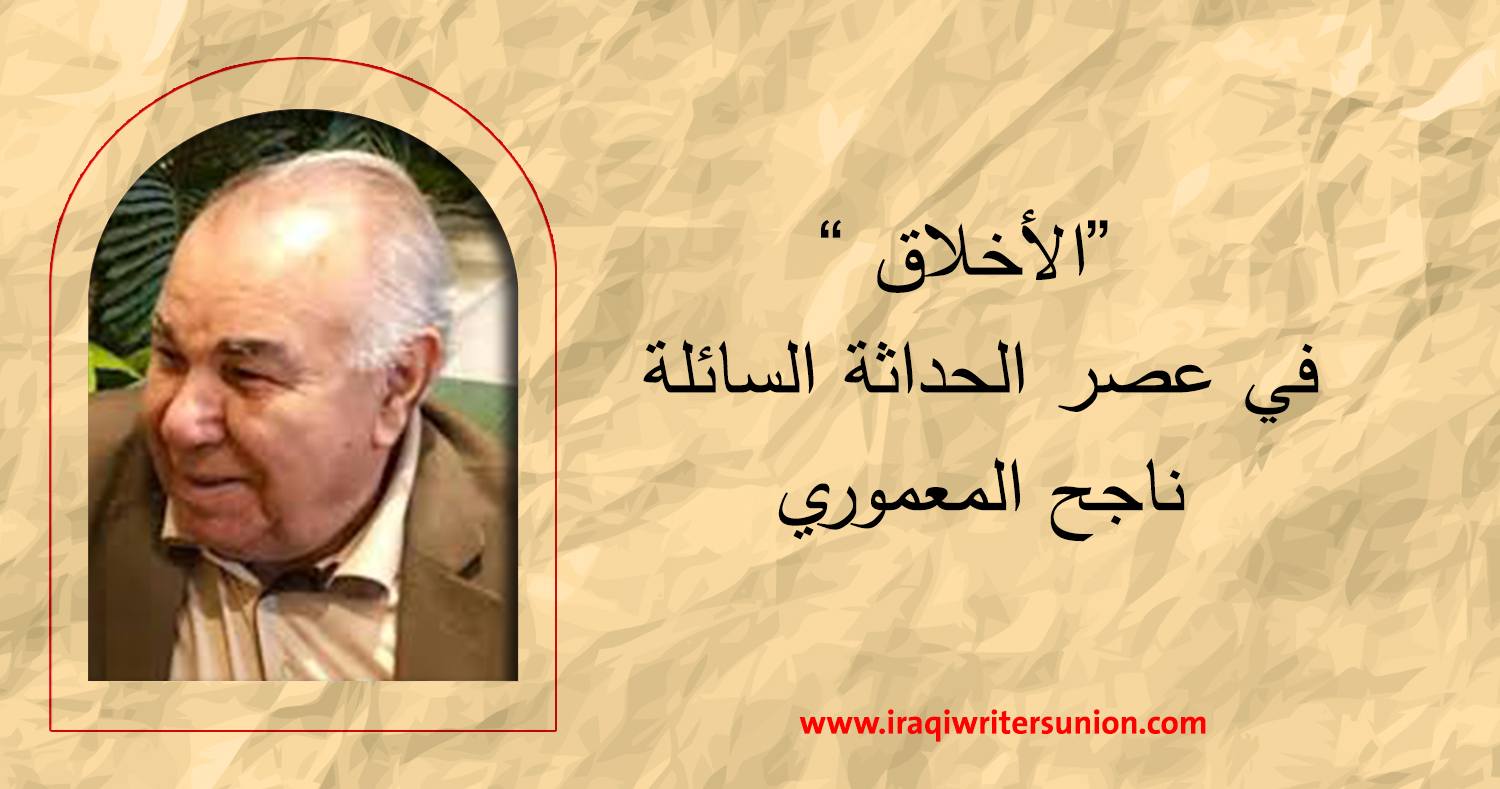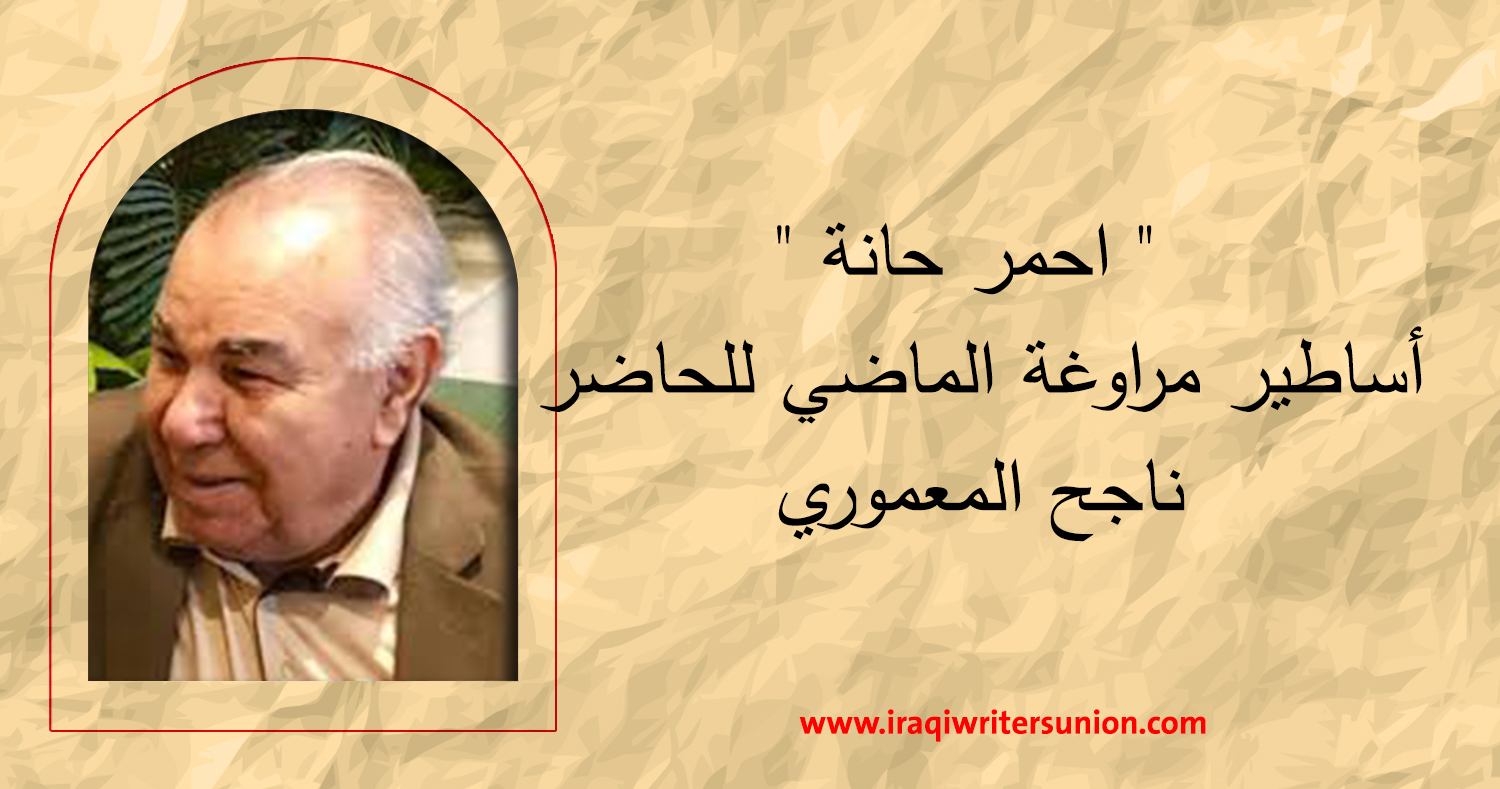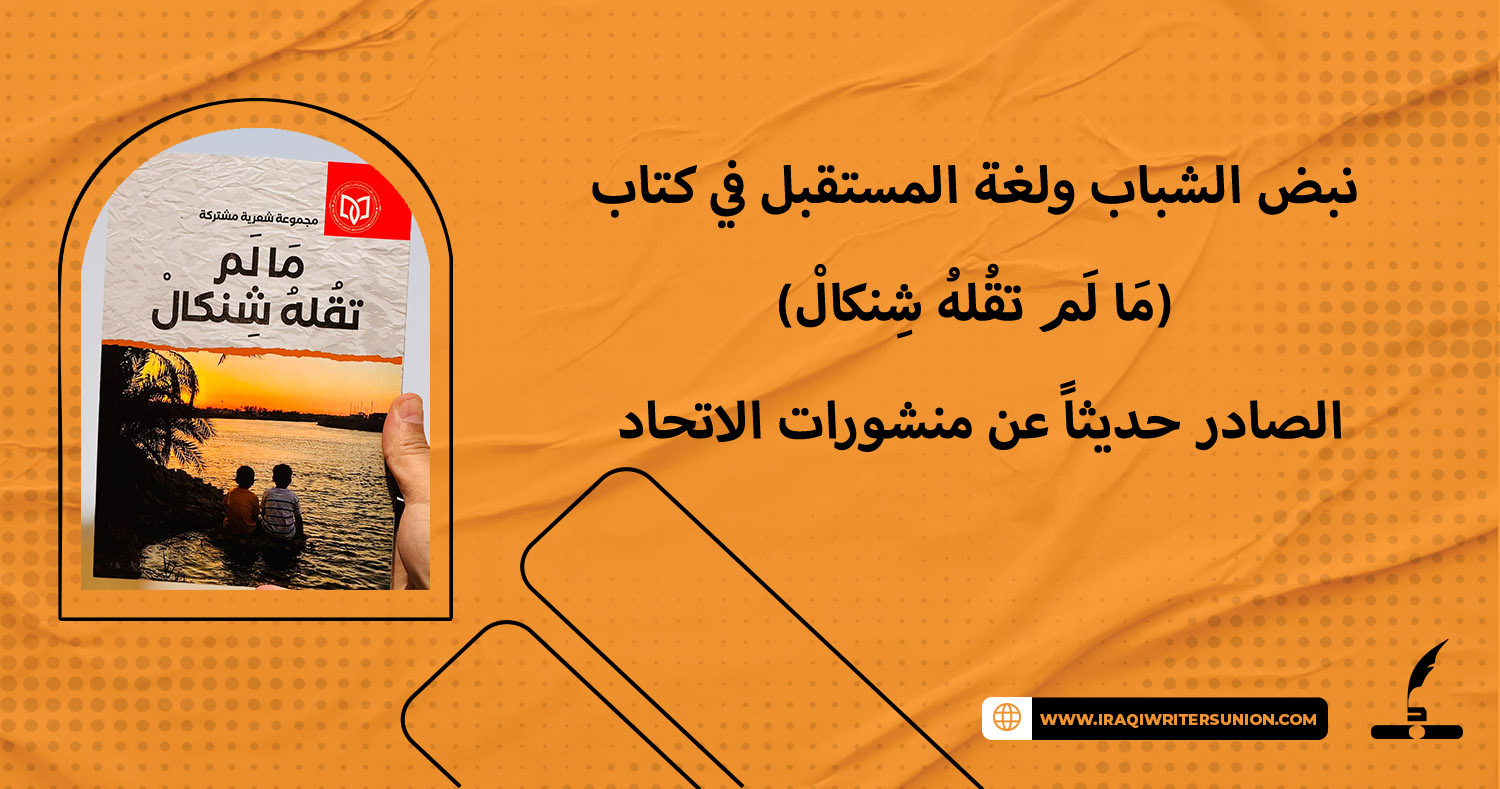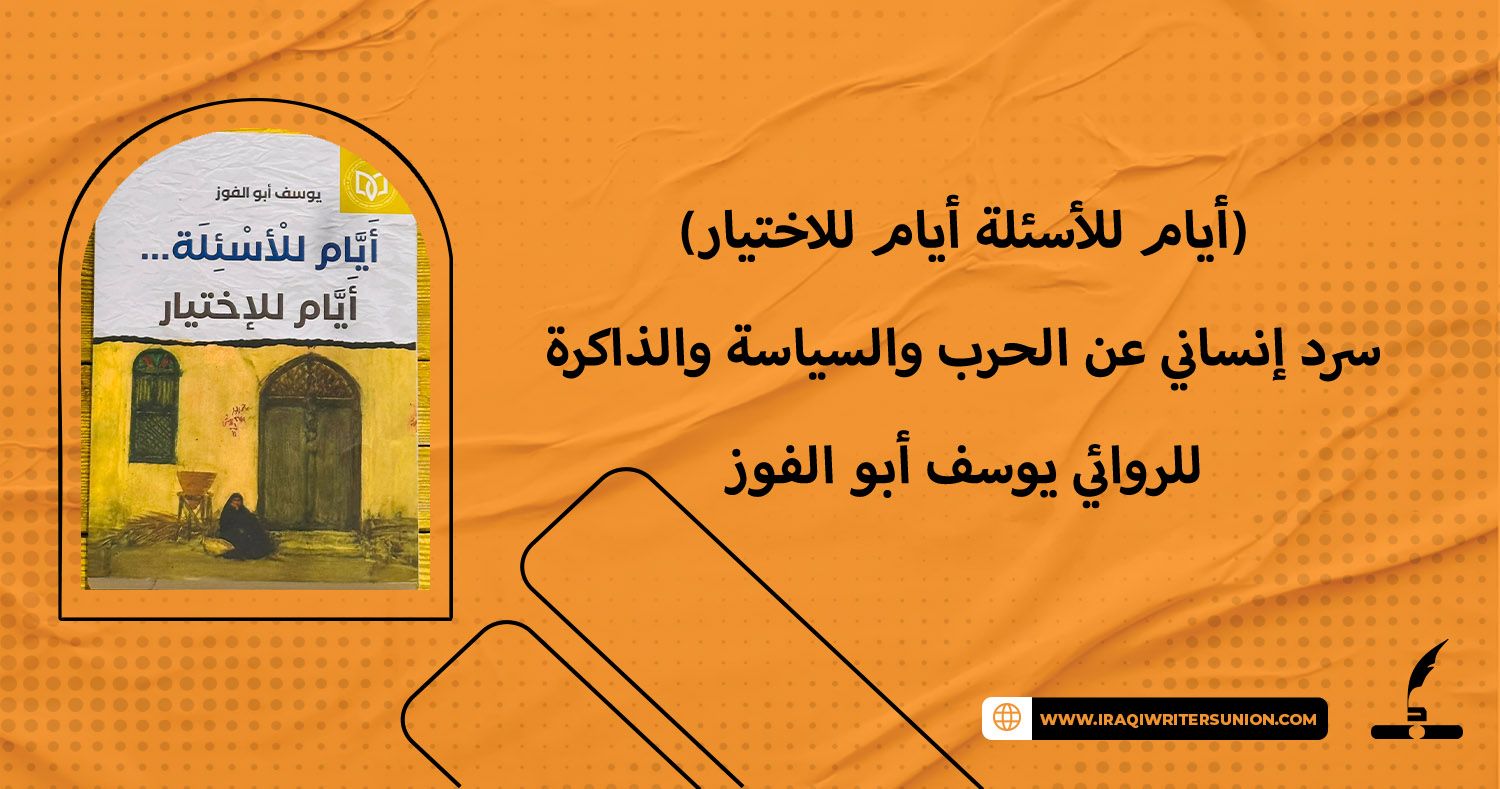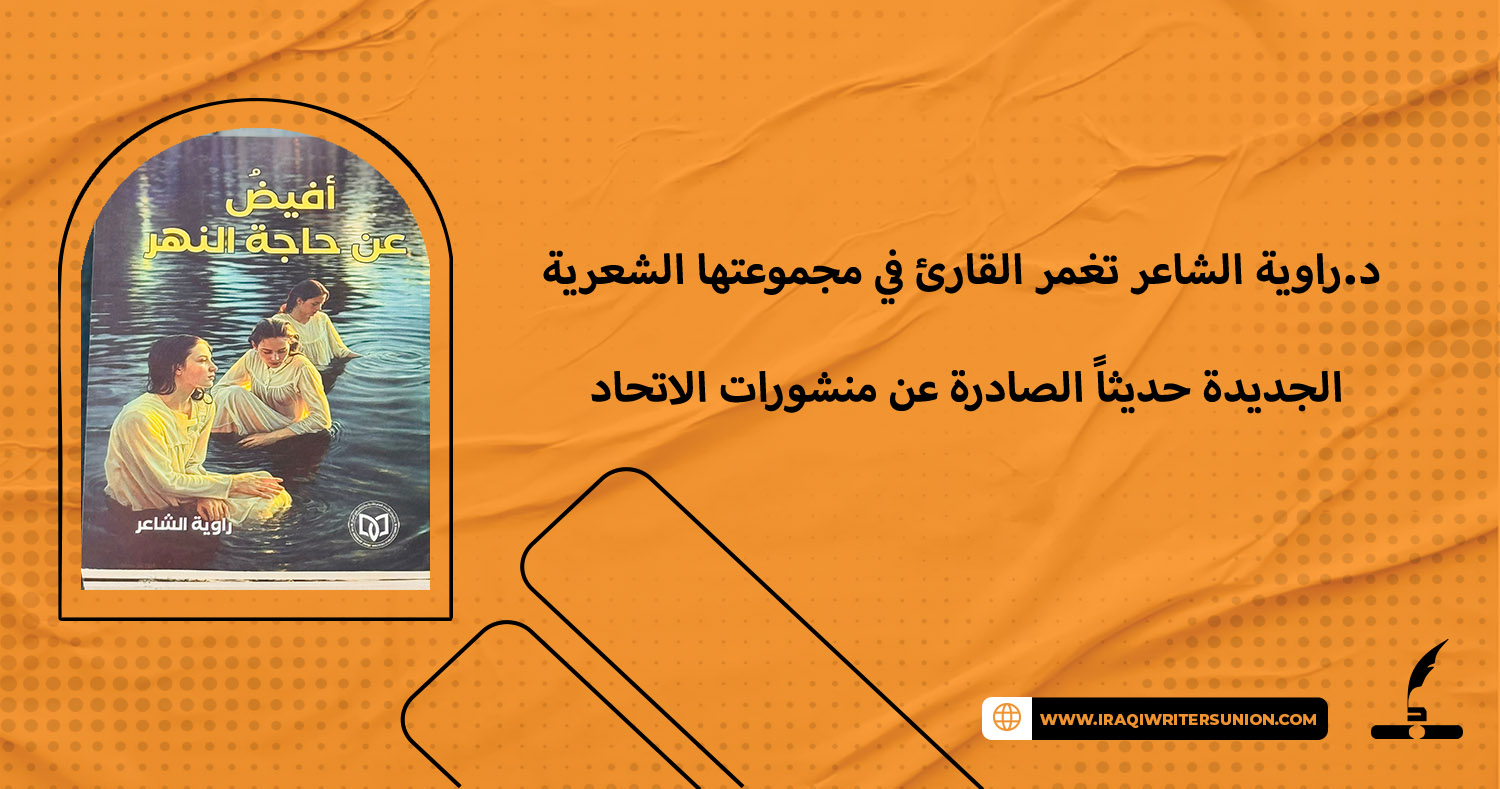المستقبل ممكن التحقّق في رواية مشروع أومّا للطفيّة الدليميّ
عقيل عبد الحسين
مدخل
انحازت الرواية، الآن، إلى البيئة؛ فهي عند عدد من كتّابها تقدّم وعيًا بمشكلات البيئة والإنسان، وصلته بها، كاشفة، عبر التمثيل السرديّ، عن أبعاد تؤثّر سلبًا في الحياة والمجتمع، مثل السلطة، والهيمنة، والعنف، وتهميش الآخر المختلف في الجنس. ويخصّ الكاتبات أنهن كنّ يسعين إلى عالم خالٍ من الهيمنة على البيئة، ومن ثمّ على المرأة وعلى الإنسان عمومًا، يرافق ذلك السعي إلى تخليص البيئة مّما يضرّها ويهدّدها(1)، ويرافقه، غالبًا، بعد رؤيويّ، أو تنبّؤيّ، أو مستقبليّ؛ لأنّه يشخّص أزمة ويقترح حلًّا لها، والبعد المستقبليّ يولد من الأزمة، وغايته تغيير المستقبل، لا التنبّؤ به، والتحذير مّما سيصير إليه الإنسان إذا لم يراعِ البيئة، ولم يستعد ما تفترض، أي الرواية البيئيّة، إنّه انسجامه الأصليّ معها، الذي افتقده بسبب الأيديولوجيا والسلطة(2).
ولعلّ هذا الجانب إذا ظهر في الرواية البيئية ظهورًا صريحًا، أدخلها في اليوتوبيا؛ لأنّ اليوتوبيا، رؤية تقترح عالمًا أفضل أو أكثر تكاملًا. ولأنّ هدفها زيادة الانسجام، والابتعاد عن الصراعات والمشاكل، وتحقيق توافق قناعات قليلة، أو محدّدة، أو منتسبة لأشخاص معيّنين، أفضل من المعتاد، رؤية وفكرًا وحسًّا إنسانيًّا، فيما يؤدّي إلى حفظ التنظيم الاجتماعيّ، وتحقيق التكامل بين الرؤى والرغبات(3)، التي تكون منفلتة عادة، ولا عقلانيّة، تنتهي بتخريب الحياة، وينبغي السيطرة عليها بالعقل، وتجسيد تلك السيطرة في الكتابة؛ ليتجلّى الانسجام والتوافق بين العقل والعالم؛ لتحقيق التوازن والجمال والسلام للحياة.
وهنا نكون إزاء رواية يصحّ، إلى حدّ بعيد، تسميتها: رواية ايكوتوبيا(4) (Ecotopia)، أو اليوتوبيا الخضراء، الذي هو مفهوم يجمع بين الواقع المتحقِّق، والرؤية الطامحة إلى مستقبل مثاليّ خالٍ من مسبّبات دمار البيئة، التي تكون إمّا ماديّة، أي تدمير وتعدٍ وإهمال وسوء استعمال للبيئة ومواردها، أو أيديولوجيّة، أي حروب تؤدّي إلى القضاء على البيئة، أو على مخطّطات حمايتها، أو على الأفراد الاستثنائيّين الخيّرين الذين يصونونها؛ ففيها واقع اجتماعيّ وسياسيّ واقتصاديّ مؤثّر سلبًا في البيئة، وفيها محاولة لإيجاد مجتمع مثاليّ مصمّم لتقليل تأثير الجماعات السلبيّ في البيئة. وبين هذين يوجد صراع، وتوجد مراجعة الوضع القائم ونقده، وتقديم رؤية تصلح لأنْ تكون بديلًا عنه، وتحلّ محلّه.
وذلك، كلّه، هو ما ستتمثّله رواية مشروع أومّا للكاتبة لطفيّة الدليميّ؛ فهي تحاول فيها تجاوز معضلة الواقع العراقيّ، الناجمة عن الصراع الأيديولوجيّ المرافق لتاريخه الحديث، وعن الحروب المتتابعة ونتائجها الكارثيّة، إلى اقتراح الحلّ، أو البديل، على مستويات الوعي، والرؤية، والفعل؛ فهي في روايتها مشروع أومّا، تجعل البيئة بمعناها الأخضر، والمستدام، والمواجه لقيم الاستهلاك، والتسلّط، موضوع تأمّل ونقد. وهي، في الوقت ذاته، تضمّنه تلويحًا بمخرج واقعيّ، ممكن التحقّق، من أزمة مستعصية تعصف بالعراق منذ عقود طويلة، لم تنفع الحلول السياسيّة، متمثّلة بتغيّر الأنظمة السياسيّة، ملكيّة وعسكريّة وديموقراطيّة، والثورات، في تخليصه منها، بل زادت العنف والتخريب، والصراع الناتج عنها، وكثّرته.
دور الشخصيّات الأمثوليّ في ايكوتوبيا الدليميّ
تتضمّن الايكوتوبيا انتقالة من عالم الصفاء إلى عالم الدنس، يتطلّب، إحداثَ تعديل لمساره، تدخّلُ فاعل ثانٍ، له سمات فاعليّة، وذهنيّة، متميّزة. ويجسّد الانتقال في شخصيّة ذات طبيعة أمثوليّة، هي في رواية مشروع أومّا، الجدّة التي تّتسم بملامح قريبة من الأرض؛ فهي ببشرة سمراء وملامح حادّة جميلة(5). وهي مالكة أرض قرية الصافية (الافتراضيّة)، آلت إليها بالوراثة من جدّها الذي خرج على طاعة العثمانيّين، وقال: إنّ الأرض ملك أهلها الذين يزرعونها وليست للعثمانيّين(6). وكانت هذه بداية اليوتوبيا الخضراء النقيّة؛ إذ كان كلّ شيء متآلفًا ومنسجمًا مع الطبيعة. والأطفال ينشأون مثل كائن بريّ وسط الحقول والبراري والمياه، ويعتادون التحدّيات، ويتغلّبون عليها، ويتعلّمون كيف ينبت البذر وينمو الزرع ويذوي ويموت، ويدركون أنّ الحياة تولد مع الفجر، وأنّ الموت مصير الأشياء، وهو مكمّل للحياة، وأن كلّ لحظة يعيشونها تماثل لحظات النبات، وهو يتغذّى وينمو ويزدهر، وأنّ عليهم أنْ يحبّوا الطيور والدود والنمل والضفادع والزواحف والقنافذ والنخل(7)؛ فمنها يستمدّون الحياة والشفاء مثل ما حصل في مداواة الفتاة علياء بعد أن اغتصبها مجرمون: وضعت الجدّة زيت جوز الهند على الجراح والخدوش الملتهبة، وسقت الفتاة مغلي عشبة الناردين لتهدأ فاستغرقت في النوم. وحين أفاقت فركت الجدّة جبينها وأصابعها بقشر البرتقال وورق الغار، وسقتها شاي القرفة والأعشاب لإيقاف النزيف(8).
تخضع شخصيّة الجدّة لبراديكما (أنموذج)، سأدعوه براديكما السقوط أو التلوّث: (الصفاء-السقوط أو التلوّث-الصفاء)، ذي البعد اليوتوبيّ؛ فما يتبع الصفاء والسلام التامّ والانسجام، هو التشوّش والعداوة؛ إذ يفترس الجشع روح الجدّة، وتتنكّر للأقارب، وتسلبهم الأرض التي يعملون فيها، فيكون ذلك سببًا لهجرتهم ولتمرّدهم، ولاحتمال انضمامهم إلى الجماعات المسلّحة. وترى أنّهم طامعون بأموالها. ويحدث التحوّل في شخصيّة الجدّة، التي كانت خيّرة-نتيجة للتغيّر في الزمان والظروف السياسيّة؛ فالبلاد منهوبة، والناس، أقارب وأباعد يتأهّبون للانقضاض علينا، ما إن نتراخى قليلاً- تقول الجدّة - كلّهم: الحكومات وعصابات الأحزاب والميليشيات المسلّحة والأقارب، وسوف يهاجمونني كالضباع إذا تهاونت، وكلّهم جاحدون(9). وهي تتحكّم في أفراد عائلتها فتدمّر حياتهم؛ إذ ترسل ابنها لدراسة الزراعة في كاليفورنيا، ولكنّ الدراسة لا تنفعه في العمل؛ لأنّ أوضاع البلد منهارة، ولأنّه يعاني من مشاكلها مع زوجه المكسيكيّة، ليطلّقها ويظلّ تعيسًا بعدها(10). وتقرّر على صعيد البيئة بيع الأرض لمستثمر، يحوّلها إلى مجمّع سكنيّ تباع وحداته لأناس من خارج البلدة، وتحوّلها إلى طاغية تريد التحكّم بمصير ابنها وحفيدتها زهيرة نتيجة لانهيار أوضاع البلد وفقدان القيم الإنسانيّة(11)، كما يقول الابن عادل. وكانت قبل ذلك رفضت زواج ابنتها روضة ومن تحبّ لفوارق طبقيّة بين العائلتين، فدفعتها إلى الانتحار(12). وكان الخير الذي تفعله أحيانًا - تقول الرواية - لأحد ما، يصبّ في ترسيخ جبروتها ودكتاتوريّتها؛ فرعايتها وحمايتها لعلياء، وعاطفتها الزائدة عليها كان مِنّة استجابت لها الضحيّة خانعة، فقدمت لها ثمن انقاذها استسلامًا لتظلّ خانعة في فيء جبروت الجدّة الحامية، فتتيه عن سبيل الخلاص حتّى بعد موتها(13). وهو الشيء ذاته الذي تريده الجدّة لابنها ولحفيدتها، ولمن تقرّبه منها، وتضعه في دائرة الأحباب، من معارفها.
ولعلّ دور الجدّة في أنموذج السقوط، فضلًا عن تمثيله في شخصيّة مُتحقَّقة داخل العمل الروائيّ، يساعد في نقد الانحراف الظاهر من حياة الصفاء والإنسانيّة والألفة واستقرار العلاقات العائليّة والاجتماعيّة، إلى حياة العداوة والتنافر وتخلخل العلاقات العائليّة، وأثر الاثنين في البيئة؛ إذ عن الأوّل نجمت بيئة معافاة، وعن الثاني ولد تهديد البيئة بالخراب والدمار الكلّيّ. وستكون لذلك الوعيّ وظيفتان الأولى نقديّة، أي نقد التغيّرات السياسيّة، وما تبعتها من تغيّرات اجتماعيّة، والثانية سرديّة؛ إذ تبني الرواية عليها انتقالتها إلى استعادة عالم الصفاء والألفة.
أمّا الشخصيّة التي ستعدل براديكما السقوط أو التلوّث؛ فهي الحفيدة زهيرة، ابنة الطبيعة، التي أيقنت من صغرها أنّ الطبيعة اختارتها لتكون ابنة التراب والنهر والشمس والجذور والشذا. وهي تصغي لنداءات الطبيعة وتفهمها وتحتفي بها، وتتعلّم منها. تعلّمت منها أنّ كلّ ما يفنى ويتحطّم لا يرتسم بأقواس، الاستدارة شكل البدء والحياة والأشياء تولد بانحناءات واستدارات: قطرة الماء وثمار الأرض.. وعندما تعطب الأشياء وتشيخ، ينثلم القوس وتنكسر الدائرة(14). وتأخذ زهيرة السرد إلى البيئة، وإلى الطبيعة، فتجعله رواية بيئيّة، بالإفصاح المستمرّ عن علاقة الشخصيّة بالبيئة، كما مرّ؛ فهي تنقاد إليها وتتوحّد بها، وهي تتعلّم منها، وتعرف العالم عبر تأمّلها، وهي تراها بعين استثنائيّة ليست عند غيرها: الغرين الأحمر المتيبّس يتكسّر بملامسة الريح كرغيف خبز محمّص ويتهشّم تحت قدميها، تشكّل قشرة الغرين خرائط بخطوط منكسرة وزوايا حادّة(15). ولديها القدرة على الرفض والمقاومة؛ فقد قاومت محاولات جدّتها لإرغامها على الدراسة في كليّة الزراعة مثل والدها وعمّها(16). ولها سمات ضروريّة للفعل؛ فهي جريئة، تُقدم على ما لا يُتوقّع منها، وتزلزل المخاوف(17). والفعل مبنيّ على بصيرة ورؤية مستقبليّة تّتصل بالبيئة والواقع؛ فلزهيرة توقّعات مذهلة؛ إذ تتنبّأ بالمطر وتنذر بالعاصفة وتمتلك بصيرة العرّافات المتوحّدات مع الريح وحركة الأفلاك. لديها مرآة المصير(18). وهي ترى أنّها بموازاة سوء الوضع العراقيّ، سياسيًّا، عليها أنْ تجد حلولًا ممكنة لمشكلات مثل الطاقة والجفاف، ولحماية بيئة القرية. وتعمل على شراء مئات الأمتار من القماش القطنيّ لصنع أكياس التسوّق ونقل الخضار بها بدل البلاستك، وتوزّعها على بيوت القرية وتنشئ مشروع حياكة للفتيات لحياكة سلال الخوص والحصر والحقائب، للتخلّص من المنتجات البلاستيكيّة(19). وحلول أخرى كثيرةً تخفّف الإضرار بالبيئة. والبصيرة، كما يظهر من أغلب السّرد المتّصل بزهيرة، متأتية من علاقتها الاستثنائيّة بالبيئة. وذلك كلّه، أي الصلة بالبيئة والتعلّم منها، والمقاومة، والجرأة، والفاعليّة، هو ما يؤهّل الشخصيّة لتكون ذات دور أساسيّ في اقتراح الحلّ، والخلاص، والرؤية المستقبليّة لمشكلة البلد الحاليّة، وفي أنموذج السقوط.
سياسات المقاومة في مشروع أومّا
تعدّ المقاومة أساسيّة في الانتقال إلى حالة السلام، والنجاة من وضع الحرب والخراب المسيطر في العراق. ولا تكون المقاومة بالسلاح؛ لأنّ الشخصيّات التي تسعى إلى تعديل الوضع شخصيّات مسالمة، لا تملك السلاح، ولا تعرف استعماله، وإنّما تكون بـ:
أوّلًا: التثقيف الذاتيّ بقراءة التراث اليوتوبيّ العربيّ والعالميّ، واستنتاج عنصر القوّة منه، وما ينفع في تأسيس يوتوبيا بيئيّة صالحة للتحقّق. واستبعاد أسباب الفشل. يقول إبراهيم عن الفيلسوف الأمريكيّ ديفيد هنري ثورو الذي كتب كتاب (والدن) عن تجربة عيشه الاختياريّ في الغابة: إنّه كان يمجّد الطبيعيّ مثل الرومانسيّين، وإنّ مشروعه كان شخصيًّا ومنعزلًا عن مشاركة الآخرين، لا يشبه روبنسون كروزو وحيّ بن يقظان، اللذين اجتهدا ليديما حياتهما بتطوير وسائلهما لضمان البقاء(20). والمقارنة بين التوجّهين تضمر توجّهًا إلى أنْ يكون المشروع جماعيًّا، يشترك في التخطيط له عدد من الأفراد، وتشترك في تنفيذه الجماعة، وتضمر توجّهًا إلى الاعتماد على الوسائل المتاحة لإدامة الحياة والبيئة. والتوجّهان كلاهما يميلان إلى تجنّب التعالي في التفكير، أو التخطيط، أو التنفيذ. ويصل، هذا النوع من القراءة، الرواية بتراث واسع من الكتابة في البيئة، وفي اليوتوبيا، وصلًا نقديًّا قائمًا على التمييز والاختيار، ويجعل الرواية إضافة في نوعها، إلى ذلك التراث، ويمدّها بقيمتها القرائيّة والثقافيّة. وهو، قبل ذلك كلّه، يشدّد على أهميّة التثقيف الذاتيّ في مقاومة الخراب والفساد.
ثانيًا: الانتباه والتنبيه إلى معزّزات السلطة الجائرة، السياسيّة والاجتماعيّة، وفي مقدّمتها المؤسّسات التعليميّة والعلوم التي تعلّمها، والمعرفة التي تنتجها. ويشخّص (فلّاح، بتشديد اللام) عيوب التعليم بعد دراسته الجامعيّة ثلاث سنوات، ويقول: إنّ من الحمق تبديد السنوات مع أساتذة يردّدون أفكارًا عتيقة مقنّنة كأنّها مقدّسات تحرم مناقشتها. ويرى أنّ جدوى الفلسفة-التي كان يدرسها وتركها- تكون في مساعدة الإنسان على الارتقاء بحياته ، لا في ترديد الأفكار المجرّدة وعبادتها(21). ومثل الكليّات المدارس التي تقسو على الصغار، ولا تهبهم فرصة نمو العقل، بل تحشو طراوة نفوسهم الساذجة بهراء مكرور، وتحوّلهم من كائنات جميلة إلى مسوخ وببغاوات، وتعلّمهم أنْ يتنافسوا، ويوقّع أقواهم بالضعيف الهشّ ويحتلّ موقعه(22). ومن دون الانتباه إلى ما تضمره العلوم التي تتبنّاها الجامعات ومعاهد التعليم ومؤسّساته، من سلطة، والتمرّد عليها، يصعب تغيير الوضع القائم، ويصعب اقتراح حلول له.
ثالثًا: رفض الأساليب التقليديّة في التغيير، وعلى رأسها الثورة؛ لأنّها تبقى عقيدة دمويّة، ونمطًا فوضويًّا مدمّرًا، وغير مضمون النهايات، فيه بدايات صفريّة وبحار دماء وانحرافات تصاحب امتلاك السلطة(23). وهي أيديولوجيا تسعى، باستخدام القوّة، إلى إزاحة أيديولوجيا أخرى والحلول محلّها. وكلتاهما-الثورة والأيديولوجيا-متعالية على الإنسانيّ، وعلى المتحقِّق الذي يتجسّد في البيئة والطبيعة ومصادر الحياة المختلفة، تستنزفها لمصالحها وحروبها. وستكون قوّة الرواية، ومشروعها، في أنّه لا يتأسّس على أيديولوجيا، ولا على تصوّرات متعالية على الواقع، بل من مراقبة مشكلات البيئة، وممّا يتسبّب في استنزافها ودمارها، والتخفيف منه.
رابعًا: رفض الميول الاستهلاكيّة والاكتفاء بالقليل من الممتلكات، حتى أنّ زهيرة ترفض أنْ ترتدي أيّة حلية ذهب على الرغم من إغراء الجدّة(24). ومقاومة شهوة الاستهلاك سبيل من سبل مقاومة التعدّي على البيئة؛ فمن يريدون إزالة الأراضي الزراعيّة من القرية، والوجود، هم مستثمرون يريدون تحويلها إلى أسواق ومجمّعات سكنيّة. وهم يتحالفون، لتحقيق ذلك، مع الجماعات المسلّحة، والحكومة، مستغلّين تغلغل، وقوّة، شهوة الاستهلاك في نفوس الناس، ولن يتوقّفوا، أو تخفّ هجمتهم على الطبيعة ما لم تقلّ النزعة الاستهلاكيّة عند الناس. وتنبغي مقاومة النوازع تلك حتّى على المستوى الفرديّ بمساءلة أصولها العميقة؛ فزهيرة التي ترفض التضحية بخيولها من أجل بيئة خالية من فضلاتها، وتخلّصًا من تكاليف رعايتها وإطعامها وعلاجها، تدرك أنّها سجينة تعلّقها بها، وسجينة رغبة استحواذ قهريّ، جاء من غرس جدّتها في رأسها، وهي بعد طفلة في الخامسة من عمرها، إنّ الفروسيّة جزء أساس من حياة نساء البراري. وما لم تحصل هذه المقاومة للرغبة في التملّك للتخلّي عن متعلّقات كثيرة، فلن ينجح مشروع حماية البيئة، ولن يتغيّر واقع القرية(25).
توجيه العواطف الوجهة الصحيحة
ليست العواطف حادّة ونهائيّة في مشروع أومّا؛ إذ لا تكره الشخصيّات الداعية إلى مقاومة الحرب والصراعات، ومقاومة تخريب البيئة والحياة، الشخصيّات المضادّة لها؛ فإبراهيم لا يكره الجدّة، على الرغم من أنّها تمنعه من أنْ يتزوّج حفيدتها، لأسباب الحقد والكراهية، ولاعتقادها أنّ عائلته هي السبب في موت ابنها، والد زهيرة. والابن عادل لا يتغيّر على الجدّة التي تحكّمت بمصيره، وقضت على زواجه بمن كان يحبّ. والأخت زهيرة لا تكره اختها زهور التي كانت تتعالى عليها؛ لأنّها نشأت في المدينة ودرست الطبّ، وعلى الرغم من أنّها حاولت إغواء إبراهيم والفوز به، ولاحقًا حاولت تخريب مشروع إنقاذ القرية، وكانت تحسدها وتغار منها(26). وقد يكون الضعف الذي يعتري الشخصيّات الكارهة، أو الأنانيّة، أو الحاقدة، وسيلة لكشف أسباب الهيمنة؛ فمن يسعون إلى الهيمنة على الآخرين، وعلى البيئة، يعانون في حقيقتهم من اضطرابات نفسيّة. وتكمن مقاومة الهيمنة تلك وآثارها على البيئة، في تفهّم مشكلاتهم النفسيّة، وتجنّب الانجرار إليها، والوقوع في دائرتها؛ فالردّ على العداوة بالعداوة لن ينقذ البلد والقرية والناس ممّا هم فيه من دمار. وفي المقابل يكون الحبّ هو الوسيلة لإصلاح الوضع والحياة. والرواية والمشروع، مشروع أومّا لإنقاذ القرية، تُبنى كلّها على حبّ زهيرة وإبراهيم، وزواجهما، بعد أنْ تضعف الجدّة، وينتهي تأثيرها فيهما، وفي القرية.
ويتجلّى توجيه العواطف الوجهة الصحيحة في علاقة فيصل معلّم القرية، الثوريّ، المتحمّس للتغيير، بزهور التي مال إليها طيشًا وشغفًا، مدفوعًا بالظمأ لأنثى جميلة، ثمّ عدوله عنها إلى أماني. وكان قد أنهى خطوبتها وهجرها، ليرجع إليها بعد أنْ يتعلّم من مشروع أومّا تغيير الواقع، وتغيير الذات، وطريقة التفكير، لتناسب المتغيّرات والمشاكل؛ فالمنتصر، في النهاية، ليست الرغبات من طمع وجشع وجنون سلطة وشهوة، إنّما السيطرة عليها وتطويعها لخدمة المشروع والحياة والآخرين. يقول فيصل: ((مع أماني اختلف الأمر؛ فهي التي أغتني بحكمتها المقرونة بالحبّ المضيء... كنّا متّفقين على تمجيد الحياة الإنسانيّة وإعلاء شأن الإنسان في عملنا... كانت أماني باصطبارها الأنثويّ العجيب تنظّم فورات حماستي برقّة ووعيّ وسماحة))(27).
ومقاومة الخراب بتوجيه العواطف وجهتها الصحيحة أعلى درجات المقاومة؛ لأنّها تّتصل بضعف الإنسان أمام رغبته، وسطوة اللاوعي على تفكيره الواعي، ولأنّها واحدة من أكبر شرور الواقع، والدستوبيّات عمومًا. وما موقف الشخصيّة من الصراع بين الجسد والشهوة والطمع الذي تمثّله زهور، والعقل والحكمة والولاء للمصلحة العامّة التي تمثّلها أماني، إلا تعبير عن موقف أخلاقيّ تجاه الصراع الذي يعيشه عالمنا، ورهان على قدرة الذات، إذا حصّلت التأهيل العقليّ والأخلاقيّ اللازم، على حسمه لصالح الحياة. وهو في الأحوال كلّها يحافظ على البعد التهذيبيّ، الذي تضمره الكتابة الايكوتوبيّة، في مصائر الشخصيّات؛ فمن يسيطرون على العواطف يفوزون بالحبّ والزواج والإنسانيّة والجدوى الاجتماعيّة، مثالهم إبراهيم وزهيرة، وفلاح ومها (علياء)، وفيصل وأماني. ومن لا يفعلون يخسرون كلّ شيء، وينهزمون، ومثالهم المنذريّ وشيرين اللذان يُسجنان، وزهور التي تحاول الانتحار لتواجه احتمال-إن نجت من الموت-الإصابة بفشل كلويّ، وتشوّش في النطق، ولتغادر الصافية(28). ولعلّ البعد التهذيبيّ المُضمَن في حبكة المصائر ضروريّ في سياق مناقشة العواطف ثقافيًّا؛ إذ هي تولد، وتتحرّك، استجابةً لثقافة المجتمع، وجزءًا لا يتجزّأ منها، ولو فُكّكت، وأُعيد التفكير فيها، وتمّ تغييرها، فإنّها ستوجّه العواطف الوجهة المناسبة لبناء الإنسان والمجتمع والبيئة. ومن غير ذلك التفكيك، وتلك المناقشة يصعب إحداث أيّ تغيير، ويتعسّر نجاح أيّ مشروع.
المواجهة البيضاء والنهايات الاستشرافيّة الخضراء
المواجهة: الفعل الذي تقرّر الشخصيّات الرافضة للدمار والخراب، عمله، للخروج من الأزمة ولإصلاح البيئة والحياة. وتكون المواجهة-كما هو معروف في أغلب اليوتوبيات-باقتراح طوباويّ، بعيد عن الواقع، يتوخّى قلبه. اقتراح غير قابل للتطبيق، وغير إنسانيّ. وهو ما ترفضه الرواية فتقول على لسان إحدى الشخصيّات: ((إنّنا لا نحبذ مجتمعًا يوتوبيًّا منظّمًا تنظيمًا كليًّا ومسيطرًا عليه، لا نسعى لذلك وإلّا تحوّلنا إلى نوع من البهائم الحمقاء التي تستطيب الخضوع للطغيان اليوتوبي))(29). وكثير من الفلسفات والحلول الفكريّة لمشكلات الإنسانيّة في جوهرها استبدال دكتاتوريّة بدكتاتوريّة. وفي حال تطبيقها-يشهد التاريخ-كانت أسوأ من الواقع الذي خرجت عليه. ولذا تكون أولى خطوات المواجهة الوعيّ بما على المقترح البديل تجنّبه ليكون إنسانيًّا، وواقعيًّا، ولا علاقة له بالسياسة، أو الإيمان، أو الدين، أو أيّة سلطة(30).
الخطوة الثانية، من خطوات المواجهة، اقتراح مشروع وتنفيذه. والمشروع هو مشروع أومّا(31). وميزته الأساسيّة أنّه يعتمد على مبادرة فرديّة، ويتضمّن حلّ مشكلة تحدث في الواقع، مثل مشكلة نقص الطاقة التي شرعوا، لحلّها، بإقامة أبراج خشبيّة، وصنّعوا عليها المراوح الكبيرة التي تحتاج إلى داينمو صغير وعجلات ودراجات هوائيّة قديمة. وتطوّع أحدهم لشراء أنابيب بلاستيكيّة تصمد للاستعمال الدائم، وسينجزون ثلاثة أبراج هذا الأسبوع، واتّفقوا مع كهربائيّ، لصيانة وتصليح المضخّات المهملة(32). وحلًّا لمشكلة استنفاد الخيول موارد بيئيّة، وتكاليف رعاية صحيّة، تتخلّى زهيرة عن خيولها وتستبدلها بدراجات، تهدي عشرًا منها إلى أهل القرية لاستخدامها في التنقّل(33). ولحلّ مشكلة الكهرباء ثبّتوا ألواحًا خشبيّة على أسطح المنازل، ومدّوا الأسلاك إلى داخل البيوت، وزوّدوها بالطاقة، وكذلك زوّدوا منشآت الصافية(34). واعتمدوا لحلّ مشكلة تعرية الأرض بسبب الحراثة الجائرة، التقليب الخفيف للتربة، ونثر البذور بشكل سطحيّ، مع الحرص على الريّ بالتنقيط(35). وهيّأوا التربة الممزوجة بالرمل ونقّوها وسمّدوها للشروع بحملة إحياء البساتين التي أحرقتها العصابات، وزراعتها بفسائل النخل، للتوسّع في ثقافة مجتمع النخيل الذي سينهض في قرية الصافية(36). وبذلك ذهب المشروع إلى ما يتطلّع إليه أفراده، أعني تحديد المشكلات، ووضع حلول مناسبة لها، وبالتشاور مع المجموع. الشيء الذي يتضمّن إدامة للبيئة، وتوعية للقارئ بمشكلاتها وبسبل إدامتها، ويتضمّن أيضًا، على مستوى آخر مواجهة بالفعل الأخضر للخراب، ومسبّبيه، من دون تبنٍ لموقف أيديولوجيّ، ومن غير كره أو عداوة، وبما يمكن تسميته: مواجهة بيضاء.
ويترتّب على المواجهة بالفعل، استشراف، أو رؤية مستقبليّة للبيئة، أقرب إلى التصحيح؛ فمواجهة الفساد السياسيّ والاجتماعيّ ونقد أنساقه الثقافيّة الكامنة في سلوكيّات الأفراد الاستهلاكيّة، واللامبالية تجاه الآخر، والبيئة، بالوعيّ، وبالفعل، ينتج عنه تصحيح للوضع القائم، وإرجاعه إلى صورته الأصليّة المثاليّة قبل أنْ يخرب: ((ظهرت ملامح المشروع الأوليّة خلال ثمانية شهور، ازدهرت مزارع افترسها الجفاف وجار عليها الإهمال، سوّرت المزارع لردع المواشي والحيوانات البرّيّة بصبّار التين الشوكيّ المثمر بديل الأسلاك الشائكة، غطّى نبات الصبّار- بخضرته المائلة إلى الزرقة- الحافّات الترابيّة التي تفصل بين المزارع، استعادت البساتين التي لم تتعرّض للحرق رونق الإثمار وشعّت روائح الفواكه في فضاءاتها، أينعت أشجار السدر وتشامخت أشجار اليوكالبتوس سريعة النموّ وألقت ظلالًا رطبة مفعمة برائحة الكافور على حافّات البلدة؛ بينما ازدهرت أشجار الزيتون والسرو على الطرقات التي أتمّ المتطوّعون تعبيدها وتنظيم أرصفتها))(37). في مقطع آخر تقول الرواية: ((أعطى النخل الجديد خلال عامه الثالث تمرًا يكفي لسدّ حاجة البلدة عامًا كاملًا، وزّعت طلائع التمر الناضج على سكّان الصافية واحتفلوا جميعًا بيوم عيد اخترعوه لتمجيد النخل، زيّنوا مداخل البيوت والمدرسة، وكلّ الأماكن العامّة بالسعف الأخضر، ووضعوا سلال التمر الجديد في الساحة يأكل منه العابرون))(38). وعلى صعيد البناء، بنوا في القرية مدرسة ((تمتثل لمتطلّبات الاستدامة البيئيّة فلا تحتاج حديدًا ولا موادّ بناء مصنّعة ولا مقاولين نهّابين ولا مكيّفات هواء ولا مدافئ نهمة للكهرباء))(39).
فلسفة الاختراق وإمكانيّة التحقّق
تجيء قيمة المشروع من تكوّنه في سياق تاريخيّ، زمانيّ ومكانيّ، حافل بالمشكلات السياسيّة التي حصلت في العراق نتيجة الاحتلال الأمريكيّ له، ونتيجة الفوضى وتفتّت السلطة المركزيّة فيه إلى قوى تمتلكها جماعات مسلّحة وأحزاب وقوى مضادّة للدولة المدنيّة ولصيغة الدولة الرسميّة، المعلنة في العراق، ديمقراطيّة الصبغة، ولم تنسَ الرواية في سياق سرد أحداثها وتقديم رؤيتها للحاضر وللمستقبل، التذكير بتلك المشكلات، ووصف خطرها على الإنسان العراقيّ، وعلى البيئة: ((البلاد تتآكل بالفساد والتخلّف وتواجه انهيارًا كاملًا وإفلاسًا غير مسبوق، أخشى أنّ القادم ينذر بمخاطر مروّعة لا يمكن تجنّبها))(40). وفي مقطع آخر تصف إحدى الشخصيّات الوضع فتقول لأخرى: ((هل سمعت ما تداولته الأنباء عن إعلان بعض مناطق العاصمة باعتبارها كانتونات طائفيّة مغلقة، وكيف تحوّلت مدن أخرى في شرق البلاد وغربها إلى كانتونات قبليّة وعرقيّة، وحدثت خلال هذا الأسبوع صدامات مسلّحة في مدن أخرى))(41). وغيرها كثير من الإشارات إلى واقع البلد الذي استدعى التفكير في مشروع خلاص مثل مشروع أومّا؛ فهو مشروع إبداليّ يسعى إلى إبدال السلطة والهيمنة والأنساق الثقافيّة (استهلاك وتشييء ومتع حسيّة سريعة)، بالعمل والتكافل الاجتماعيّ والإنسانيّ، وثقافة الاكتفاء، والانتماء إلى الطبيعة، والمتع الروحيّة العميقة، الناتجة عن مشاعر سامية، مثل الحبّ ومساعدة الغير، وتخفّف معاناتهم من الجوع أو المرض، ومن ثقل الحاجة إلى الطعام، وجعل حياتهم ممكنة بتوفير الحاجات الأساسيّة من طعام وكهرباء وعمل.
وكذلك تجيء قيمة المشروع والرواية، في محاولتها كسر حدّة وجمود الأنموذج اليوتوبيّ؛ لأنّه في صورته المتعارَف عليها، يلتقي مع براديكما كثير من السّرديّات، التي تصنّف في خانة السّرديّات الكبرى، مثل الدينيّة التي تعتقد أنّ الزمان يتحوّل من صفاء إلى كدر ثمّ يعود إلى الصفاء. وسرديّات الحداثة التي تؤمن بالتطوّر والوصول إلى تحضير العالم كلّه. وسرديّات اليسار، المؤمنة بدكتاتوريّة البلورتارية والعدالة الاجتماعيّة. وكلّها فيها بعد سلطويّ ومثاليّ، يصعب تحقيقه. ويتحقّق كسر الأنموذج اليوتوبي من خلال الاختراق المستمرّ له بالواقعيّ، أو المتوقَّع حدوثه.
والاختراق قد يُحدّثه الكارهون لمشاريع تضرّ مصالحهم: ((كمن المهدّدون في بعض الليالي وراء أجمات نبات الدفلى وأطلقوا النار على حقل الألواح الشمسيّة الرئيس الذي يغذّي بالطاقة الكهربائيّة الدوائر الخدميّة المجمّعة في مبنى واحد فانهارت المنظومة، عمّ الظلام الطرقات ومبنى الخدمات))(42). والمهدّدون أشخاص يفرضون الأتاوات على أصحاب المولّدات، مستفيدين من أزمة الكهرباء؛ فالآخر المعاديّ، بنزوعه إلى المصلحة الشخصيّة، يظلّ حاضرًا في المشروع، ولعلّه ضروريّ لاستمراره؛ لأنّ ما يخرّبه يستدعي تفكيرًا في الحلّ. وذلك يجعل التفكير والتفاعل حاضرين ومستمرّين، ويضمن للمشروع الصمود والاستمرار. وهنا تقرّر إدارة المشروع تعيين حرّاس ليليين لحراسة مبنى الطاقة الرئيسيّ، ثمّ يتّفقون على أنْ يتكفّلوا بصيانته في العام الأوّل. وبعدها يستوفون مبالغ بسيطة من الأفراد ليشعروا، بأهميّتهم في إنعاش البلدة، وليتحمّلوا مسؤوليّة حماية دوّارات الرياح والمصابيح والمضخّات(43).
ولا يأتي اختراق المشروع من المعادين له فقط، بل من المستفيدين منه؛ فمن المزارعين من احتكر ماء إحدى المضخّات ليغمر مزرعة الرز، مخالفًا اتّفاق مزارعي الصافية على ألّا يزرعوا محاصيل تحتاج حقولًا مغمورة بالماء مثل الرز والذرة(44). والحلّ سيكون باقتراح عقوبة عادلة تناسب الفعل الضارّ. والعقوبة هي حرمان الفلّاح من محصول الرزّ، وتوزيعه على أهل القرية. وكذلك تأتي التهديدات من الجماعات المسلّحة التي تهجم على المشروع بين حين وآخر وتخرّب ما تستطيع تخريبه: لقد ((سمعوا ضجّة فخرجوا لاستطلاع الأمر؛ فما كان من المسلّحين إلا أنْ يطلقوا النار في الهواء لترويعهم، وقام اثنان منهم بسكب البنزين من صفائح يحملونها على النباتات المتسلّقة والنوافذ، كانوا خمسة رجال بسيّارات دفع رباعيّ سوداء ينتظرهم فيها سائق يتخفّى بقناع أسود))(45). والردّ على قسوة المسلّحين وعنفهم يكون بسلوك الطريق المعاكس، أي بالألفة والمحبّة؛ فسلوكهم جعلهم يعرفون الأعداء من الداخل، أي الذين يستقوون بالجماعات المسلّحة، ويدّعون أنّهم مع المشروع، ويتخلّصون منهم، أو كما يقول العمّ عادل: عليّ أنْ أشكر عصابة مشعلي الحرائق لأنّهم ((أيقظونا من بعض رخاوة تملّكتنا))(46).
وعلى صعيد الشخصيّات التي تدخل المشروع مثل الأخت زهور نجد أنّها ليست مثاليّة وإنّما تتعرّض للتغيّر المستمرّ؛ فمن فتاة أنانيّة ارستقراطيّة، إلى معنيّة بمشروع أومّا، تريد أنْ يكون لها دور فيه، إلى فتاة تتحكّم في فهمها للعلاقات الإنسانيّة نزعة استحواذ، تجعلها ترى أنّها أفضل من غيرها(47). ومثلها شخصيّات من أهل القرية تنعم بثمار المشروع، منها كريم الذي يسخّره زوج الخالة يونس المنذري وصاحبته شيرين بهاء الدين، لتخريب القرية وإفشال المشروع الذي تراه ضدّ الاستثمار. وهي تريد الاستثمار في القرية. وقد ضُبط كريم يتسلّل حاملًا حقيبة بنزين ومشاعل لحرق محطّة الطاقة الشمسيّة. ونعرف من الحوار بين عادل وكريم أنّ الأخير انتفع من المشروع في إحياء بستانه ومزرعته، وتمتّع بالكهرباء منه، وأنّ ابنته عملت في أحد معامل زهيرة، وتدرّب ابنه في ورشة تصليح الأجهزة الكهربائيّة التي افتتحها محمود في القرية(48). ولكنّ الطبائع الإنسانيّة، مثل الطمع وتقديم المصلحة الشخصيّة ونكران الجميل، تتغلّب على الإنسان، وتدفعه للخيانة، والتخريب. وذلك أمر واقعيّ، ولا يحسن إهماله في الكتابة حتّى اليوتوبيّة منها. والشخصيّة هنا لا تتحوّل إلى جزء من يوتوبيا الصفاء، مثل الجدّة وزهيرة، بل تحتفظ بطبيعتها الإنسانيّة، وما يتّصل بها من تقلّبات في المواقف والسلوك. وتمثّل في الوقت نفسه اختراقًا محتملًا للأنموذج، يضمر دعوة إلى التأمّل في الواقع والحياة، وإلى تجنّب النظرة المثاليّة للأشياء والوقائع والأشخاص التي تفسد أيّ مشروع، ولا سيّما ذلك الذي يُراد له أنْ يكون مؤثّرًا، في القارئ، وبطريقة ما، في الحياة، بوصفه إمكانيّة تحقّق، سيُكتب لها النجاح يومًا. وربّما بعد سنوات سيولد مجتمع جيّد، أو يحصل شيء مّما حلموا به(49)، تقول الرواية، التي تبدأ أحداثها في 2026، وتمتدّ حتّى عام 2028.
خلاصة
الانشغال بالمستقبل، والتركيز على البعد المستقبليّ، قليل في الرواية العراقيّة؛ لانشغالها بأزمة الواقع العراقيّ ومشكلاته السياسيّة والاجتماعيّة. وقد انجزته رواية مشروع أومّا باختيارها قالب الايكوتوبيا، الذي يجمع بين اقتراحات إدامة البيئة وحمايتها من الخراب، والرؤيا المستقبليّة لعالم يحصل فيه الانسجام بين الإنسان والبيئة، مع الحرص على ضرورة أنْ تكون الرؤيا قريبة من الواقع، ممكنة التحقّق. وقد خلص البحث إلى أنّ رواية مشروع أومّا أفلحت في تقديم كتابة روائيّة مغايرة للسائد، من الكتابة الروائيّة، موضوعًا وصوغًا ورؤية، مثبّتة تميّزًا خاصًّا بها. وأنها أفلحت، أيضًا، في مناقشة الوضع السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ العراقيّ، من غير مباشرة، وبموضوعيّة مكّنتها من اقتراح بديل مستقبليّ عنه، ممكن التحقّق.
هوامش الدراسة:
- عبير جودت حافظ عبد الحافظ، النقد البيئي ونظرية الأدب، دراسة في نماذج روائية عربية معاصرة، دار كنوز المعرفة، الأردن-عمّان، 2024، ص111.
- جورد جرارد، النقد البيئوي، ترجمة عزيز صبحي جابر، الكلمة، أبو ظبي، 2009، ص99.
- كامل شياع، اليوتوبيا معيارا نقديا، ترجمة: سهيل نجم، دار المدى، بغداد، 2012، ص 14.
- ورد المصطلح أول مرة عند ارسنت كالينباخ، أطلقه على رواية بالعنوان ذاته: ايكوتوبيا، صدرت عام 1975، وتحكي عن منطقة ريفية قريبة من روح الطبيعة، بعيدة عن الصناعة والتكنولوجيا وما ينتج عنهما من تلويث للبيئة واستننزاف لمواردها. ينظر: ديفيد سيد، الخيال العلمي، مقدمة قصيرة جدا، ترجمة: نيفين عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، 2016، ص93-95. وعرفه نونو كويلو قائلاً: إنه رؤية مستدامة لمستقبل أفضل. وأنه تصوّر مبنيّ على جزئيتين: الأولى مادية، والثانية افتراضية، وتتعلق المادية بالواقع الذي يعيش فيه الإنسان، وما فيه من مشكلات لها تأثير سلبيّ مباشر في البيئة. أما الافتراضية فتتعلق بالمأمول، أو بنسخة مقترحة لواقع خالٍ من المشكلات تلك، تتحقق فيه بيئة معافاة ومناسبة للحياة الإنسانية ومزدهرة. ينظر:
Nuno Coelho and Ecotopia team members, Ecotopia: A sustainable vision for a better future,First published in 2016 by the Faculty of Arts (Digital Library), University of Porto, p6-9.
- لطفيّة الدليمي، مشروع أومّا، المدى، بغداد، 2021، ص60.
- م.ن، ص66.
- م.ن، ص67.
- م.ن، ص74.
- م.ن، ص78.
- م.ن، ص80.
- م.ن، ص81.
- م.ن، ص186.
- م.ن، ص193.
- م.ن، ص86.
- م.ن.
- م.ن، ص60.
- م.ن، ص11.
- م.ن، ص11-12.
- م.ن، ص21.
- م.ن، ص49.
- م.ن، ص50.
- م.ن، ص194.
- م.ن، ص52.
- م.ن، ص102.
- م.ن، ص113.
- م.ن، ص124.
- م.ن، 228.
- م.ن، ص230.
- م.ن، ص104.
- م.ن، ص112.
- أومّا مدينة سومريّة اتّسم عهد ملكها لوكال زاكيسي بالسلام والازدهار. الرواية، ص108.
- لطفيّة الدليمي، مشروع أومّا (سابق)، ص109.
- م.ن، ص114.
- م.ن، ص127.
- م.ن، ص128.
- م.ن، ص141.
- م.ن، ص134.
- م.ن، ص151.
- م.ن، ص166.
- م.ن، ص51.
- م.ن، ص104.
- م.ن، ص160.
- م.ن، ص162.
- م.ن، ص174.
- م.ن، ص205.
- م.ن، 206.
- م.ن، ص178.
- م.ن، ص219-220.
- م.ن، ص214.












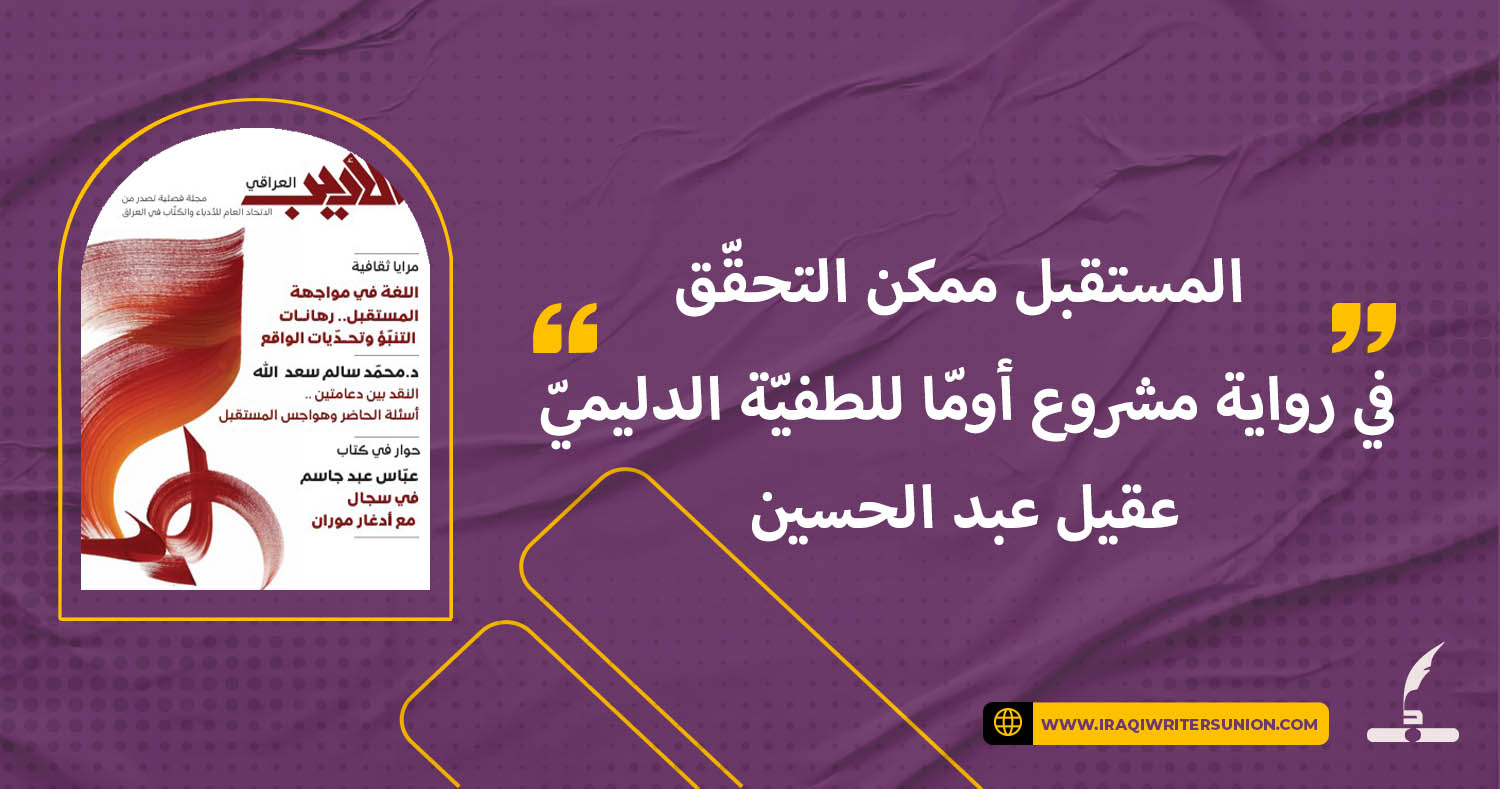




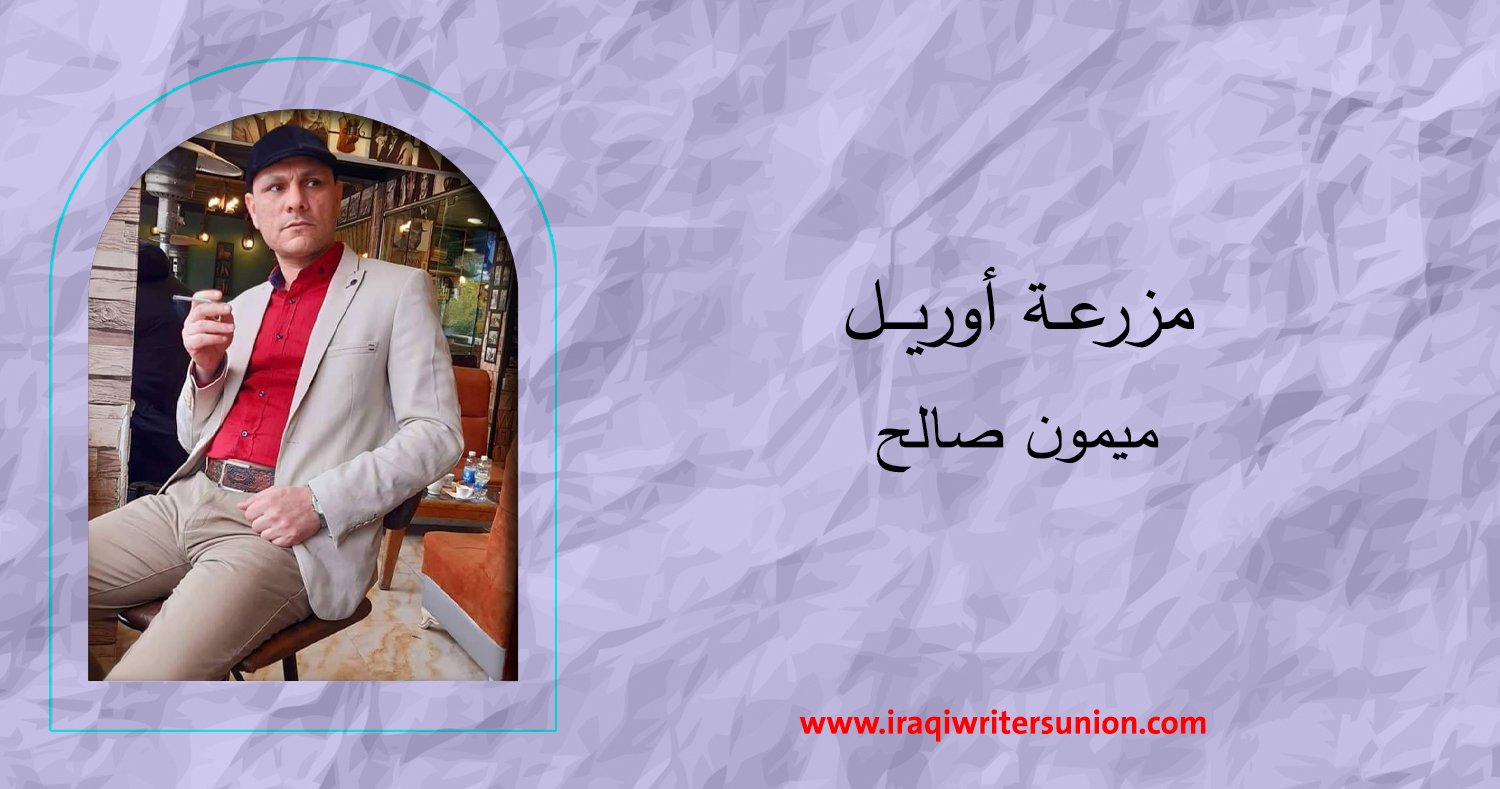

 خالد خضير الصالحي
خالد خضير الصالحي